الطّلاق التّعسّفيّ (تعريفه- أسبابه – معاييره وصوره في الشّريعة الإسلاميّة)
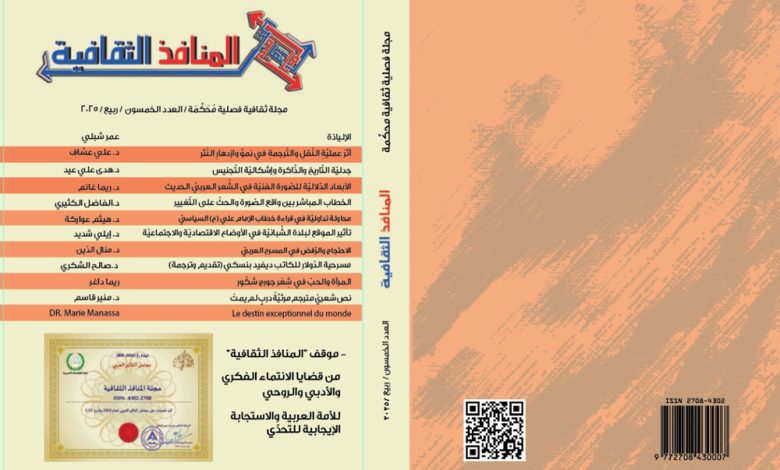
الطّلاق التّعسّفيّ (تعريفه- أسبابه – معاييره وصوره في الشّريعة الإسلاميّة)
Arbitraay divoece (definition, causes, standards and forms in Islamic law
منى حديفة
Mona Hdayfe
تاريخ الاستلام 15/11/ 2024 تاريخ القبول 5/12/2024
ملخص
جعلت الشّريعة الإسلاميّة الطّلاق بيد الزّوج كحقّ أصيل له، إلا أنّ هذا الحقّ ليس مطلقًا، إذ يمارسه الرّجل وفق ضوابط شرعية ووفق ما تدعو إليه الحاجة، وأهمها ألا يكون مضرًا بالزّوجة، فبذلك لا يكون الزّوج متعسفًا في استعمال حقه. أما إذا كان الطّلاق دون مبرر شرعي أو قانوني مقبول، عدّ الزّوج متعسّفًا في استعمال هذا الحق. ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الطّلاق التّعسّفي ومعاييره وأسبابه، وذكا أبرز صوره.
الكلمات المفتاحية: الشّريعة الإسلاميّة- الطّلاق- التّعسّف
Abstract:
Islamic law has placed divorce in the hands of the husband as his inherent right, but this right is not absolute, as the man exercises it according to legal controls and according to what the need calls for, the most important of which is that it should not be harmful to the wife, so the husband is not abusive in using his right. However, if the divorce was without an acceptable legal or legal justification, the husband is considered to be abusive in using this right. This research aims to explain the concept of arbitrary divorce, its criteria and causes, and mention its most prominent forms. Keywords: Islamic law- divorce – abuse.
مقدمة
خلق الله سبحانه وتعالى الانسان، وجعل منه الزّوجين الذّكر والأنثى، وأودع في كل منهما من الغريزة يجعله ينجذب للآخر، ليتم له التزاوج ويحصل له التّناسل وبقاء النّوع الإنسانيّ.
فشرع الله للإنسان الزّواج، وعني بعقد الزّواج عناية خاصة، وأسبغ عليه من القدسيّة ما جعله فريدًا من بين سائر العقود والتّصرفات، فعُدّ نعمة من أعظم النعّم وسنة من سنن المرسلين. لذلك شرّع الله له من الأحكام ما يحفظ ديمومته واستمراره، فأقامه على المودة والرّحمة والسّكينة والتّعاون مع الآخر، قال تعالى في كتابه الكريم: ﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ[1].
ولكن قد تخرج الحياة الزّوجيّة عن الإطار الذي رسم لها شرعًا، وقد يتعذّر استمراراها بين الزّوجين إلا بتحمل ضررًا يفوق ضرر انهائها، لذلك فقد شرّع الله لذلك مخرجًا وهو الطّلاق.
والطّلاق شرّع للضّرورة، خاصة إن كان استمرار الحياة الزّوجيّة على الحالة التي هي عليه متعذّرًا، والواجب ألا يستخدم إلا بقدره، وفق ما شرع له، فلا يجوز استعمال هذا الحق من قبل الزّوج تعسّفًا من دون حاجة دافعة أو سبب مشروع، أو من دون رضى الزّوجة وعلمها، فاستعماله بهذه الطّريقة فيه تعسّف ومناقضة لمقصد الشّارع من تشريعه. ومن ذلك كأن يطلق الرّجل زوجه لباعث غير مشروع، كطلاق المريض في مرض الموت بقصد حرمان زوجه من الميراث، هنا يكون الزّوج قد خالف مقصد الشّارع ، وكانت معاملة من استعمل حقّه في غير ما شرّع له أن يؤاخذ بنقيض قصده، ويمنع من الوصول إلى الهدف الذي يريد الوصول إليه.
وقد تعرّض العلماء للكثير من الأحكام المتعلّقة بالطّلاق والحقوق المترتبة عليه، ببيان الحكم الشّرعيّ لهذه الحقوق والآثار المترتبة عليه على استعمالها بشكل متعسّف، وعلى ذلك سارت قوانين الأحوال الشّخصيّة المستمدة من الشّريعة الإسلاميّة، فوضعت ضوابط لاستخدام هذا الحقّ، وحددت إجراءات تتبع في حال ظهر تعسّف في استعماله.
أوّلًا: تعريف الطّلاق
أ- تعريف الطّلاق لغة
الطّلاق مصدر الفعل الثّلاثيّ المجرد “طلق”، والطّلاق: تخلية السبيل. والطّلق من الإبل: ناقة تُرسل في الحي ترعى حيث شاءت ولا تعقل- أي لا تربط بقيد – وأطلقتُ النّاقة أي حللتُ عقالها فأرسلتها[2].
والطّليق: الأسير يطلق عنه إسارُهُ، فيُخلى سبيله.
ورجل طليق اليدين: سمح العطاء، وطليق اللسان: ذو طلاقة. ورجل مطليق ومِطلاق: كثير الطّلاق للنساء[3]، وطلاق المرأة يكون بحلّ عقدة النكاح[4].
ومن خلال استعراض أقوال الأئمة يتبين أن معنى الطّلاق في اللغة هو التّخلية والإرسال وحلّ القيد ورفعه.
ب- تعريف الطّلاق اصطلاحًا
لقد عّرف الفقهاء الطّلاق بتعاريف متقاربة تتفق فيما بينها على المعنى المقصود شرعًا، وتختلف إلى حدٍ ما في الصياغة. وسنعرض لتعريف الفقهاء للطّلاق في المذاهب الأربعة.
-الحنفيّة: ” رفع قيد النّكاح الثابت شرعًا في المال أو المآل بلفظ مخصوص”[5].
-المالكية: “إزالة عصمة الزّوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية”[6].
-الشّافعيّة: “حلّ عقدة النكاح بلفظ الطّلاق ونحوه”[7].
-الحنابلة: ” حلّ قيد النّكاح”[8].
نلاحظ أن تعاريف الفقهاء الأربعة اختلفت وتقاربت فيما بينها، إلا أنّه يمكن الجمع بينها في أنّ الطّلاق يقتضي إزالة عقدة النكاح التي تثبت بين الزّوجين بالعقد الصّحيح. كما نلاحظ من تعريفات الفقهاء في المذاهب الأربعة أنّها جميعها تدلّ على المقصود، ولكن أشملها لمعنى الطّلاق هو تعريف الحنفيّة وذلك لما اشتمل عليه من قيود، فكان جامعًا وشاملًا ومفصلًا.
ثانيًا: مشروعية الطّلاق
الطّلاق مشروع بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول والقياس. قال تعالى في كتابه الكريم: ﱡﭐ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ[9] .
وقال تعالى: ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[10].
أما مشروعية الطّلاق في السنة النبوية الشريفة فهناك أحاديث كثيرة، كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ” ما أحلّ الله شيئًا أبغض من الطّلاق”، وهذا دليل على مشروعية الطّلاق بشكل عام. وقوله عليه الصلاة والسلام ” ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطّلاق والعتاق.
وعن مالك عن يحيي بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطّلاق فقال لها: إذا حضتي فآذنيني، فلما حاضت آذنته فقال: إذا طهرتي فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها[11].
وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسّلام حول مشروعية الطّلاق منها ما روي عن عمر بن الخطاب أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه طلق حفصة ثم راجعها[12].
أما دليل مشروعيته في الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة من العهد الأوّل من لدنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية الطّلاق، وأنّه يجوز للرجل أن يطلق زوجه، وقد ثبُت أنّ المغيرة بن شعبة طلق زوجاته الأربع، وكذا عبد الرحمن بن عوف طلق زوجه تماضر، ولم ينكر أحد هذه الإباحة إلا إذا كانت من دون عذر[13].
وأما دليل مشروعية الطّلاق في المعقول فهو عندما شرع الإسلام الزّواج لحكمة عظيمة أهمها السّكن لتستقر به الحياة، وتحلّ المودة والرحمة، ذلك أن الطّلاق شرّع لمصالح متعددة، فإذا وجد ما يذهب هذه المصالح أو يفسدها كاستحكام الخلاف بين الزّوجين، وتعذّر العشرة وانعدام الرّحمة بينهما، وحلّ البغض والنّفور بينهما بشكل يستحيل معه العيش تحت سقف واحد، كان لا بدّ من علاج لتلك المشاكل، وكان الطّلاق هو الحل والمخرج[14] .
أما دليل مشروعية الطّلاق في القياس فقد دلّ القياس على الطّلاق، لأنّ العشرة إذا فسدت بين الزّوجين ولم يكن بالاستطاعة دوامها، يكون بقاء الزّوجة التي لا تطاق معاشرتها تفويت للهدف وللغاية المنشودة من الزّواج. من هنا شرّع الطّلاق في الإسلام كنعمة يتخلّص بها الزّوجان المتنافران والمتباغضان من قيد تلك الرّابطة، فيلتمس كلاهما من هو خير له وأحسن معاملة وأكرم عشرة، لقوله تعالى: ﭐﱡﭐﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ[15] .
ثالثًا- الحكمة من مشروعيّة الطّلاق
ابتدأ الله سبحانه وتعالى وجود البشرية بذكر وأنثى لغرض عمارة الأرض والاستخلاف فيها، وشرع لهذه الغاية النّكاح وجعله ميثاقًا غليظًا بين الزّوجين، وذلك لاشتماله على مصالح وفوائد عظيمة تعود على الزّوجين كاستقرارهما في الحياة، وعلى المجتمع لعمارته، فبالزّواج تنتظم مصالح العباد الدّينيّة والدّنيويّة.
لذلك فإنّ الله تبارك وتعالى جعل الزّواج سكنًا للزّوجين ومبعث ألفة ومحبة ومودة، فكل من الزّوجين تستقر حالته النّفسية إلى زوجه ويغمر كلّ منهما الآخر بالحبّ والاحترام. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﭐﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ[16] .
لكن في بعض الأحيان قد لا يؤدي الزّواج إلى هذه الأغراض، فلا يكون سكنًا لصاحبيه، ولا يعود بالفائدة على المجتمع وعليهما، وقد تختلف نظرة كلٍ منهما إلى الحياة، وقد ينقلب ما كان بينهما من ودٍ وحب إلى بغضاء وحقد ويصل الشّقاق إلى حد يستحيل معه الصلح، وتصبح الحياة الزّوجية جحيمًا لا يطاق.
وكما في كل نواحي الحياة جاء الإسلام لإصلاح حال هذه الأسرة، وحلّ مشاكلها، فوضع الكثير من التّدابير الوقائية والعلاجية، لكي تستمر العلاقة بين الزّوجين وتأصيل معني الخير فيها.
لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الطّلاق علاجًا وحلًا لتلك الحالات التي يكون فيها الفراق أحسن وأفضل، لأن البقاء على هذه الحالة يشتمل على مفاسد عدة، فيكون الطّلاق دافعًا لهذه المفاسد دون حرج لأحد الزّوجين.
وبذلك تتجلى لنا عظمة الدين الإسلامي بحيث وضع الحلول لكل المشكلات التي تواجه الأسرة في أي زمان ومكان حتى يعمر الكون وتستمر الحياة بشكل منظّم ودقيق.
رابعًا- أ- مفهوم الطّلاق التّعسّفي
أولًا: تعريف التّعسّف
أ-تعريف التّعسّف لغة: التّعسّف في اللغة مأخوذ من عسف، وعسف الركاب عن الطريق أي يخبطنّه على غير هداية، وعسف فلانة: أي غصبها نفسها[17]. وعسف عن الطريق معناه مال وعدل عنها[18].
وعسف عن الأمر: فعله بغير روية ولا تدبر، وعسف فلانًا: أخذه بالعنف والقوة وظلمه[19].
نلاحظ أن جميع التعريفات والعبارات التي ترد بها كلمة تعسف تدور حول الظلم والغضب، وهذه المعاني في جوهرها لها دلالة على المقصود من التّعسّف في الاصطلاح، ذلك أن التّعسّف لا يعدو أن يكون جورًا وظلمًا وعدوانًا.
ب-تعريف التّعسّف اصطلاحًا: لم يرد على لسان الفقهاء كلمة ” إساءة” أو ” تعسّف” في استعمال الحق، وإنّما هو تعبير وفد إلينا من فقهاء القانون المحدثين في الغرب. ولكن درج فقهاء القانون في جمهورية مصر العربية وفي الجمهورية السورية على استعمال كلمة ” تعسف”، أما في لبنان فآثروا استعمال كلمة ” إساءة”[20].
وسنعرض لتعريف التّعسّف لدى الفقهاء المعاصرين: فقد عرفه عبد الواحد كرم بأنّه ” استعمال شخص لحق ينشأ عنه ضرر بالغير “.[21]
أما الشيخ أحمد أبو زهرة فقد عرف التّعسّف بأنه ” استعمال الحق بشكل يؤدي إلى الإضرار بالغير، إما لتجاوز حق الاستعمال المباح عادةً، أو لإلحاق ضرر بالغير أكبر من منفعة صاحب الحق.” [22]
وعرّفه الدريني بأنه “مناقضة قصد الشّارع في تصرف مأذون فيه شرعًا بحسب الأصل[23].” ويقصد بقوله مناقضة قصد الشّارع أي مضادة قصد الشّارع ، وهذه المضادة لا تخلو إما أن تكون مقصودة، بأن يقصد المكلف في العمل المأذون فيه هدم قصد الشّارع عينًا، بأن يستعمل الحقّ لمجرد قصد الإضرار، أو أن يتذرع بمظاهر الجواز إلى تحليل ما حرّم الله، أو إسقاط ما أوجبه عليه.
ويقصد من قوله في تصّرف، أي تصرّف يكون إما بالقول كالعقود وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات كالبيع والوصية، وإما بالفعل كاستعمال الترخيص والإباحة.
أما قصده مأذون فيه شرعًا بحسب الأصل: أي يخرج الأفعال المشروعة لذاتها لأن اتيانها يعدّ اعتداء لا تعسف، وهذا القيد الذي يحدد مجال تطبيق نظرية التّعسّف.
هذا ومن الفقهاء المعاصرين من أطلق على هذا اللفظ ” المضار” على التّعسّف، ولكن يفضل استعمال كلمة تعسف لدقتها في تأدية المعنى المراد والمقصود.
من خلال ما تقدم عن تعريفات الطّلاق والتّعسّف نستنتج أنه يمكن تعريف الطّلاق التّعسّفي بأنه كل طلاق يكون بسبب غير شرعي ولغير حاجة يكون قد ناقض مقصد الشّارع من مشروعيته، وبذلك يكون الزّوج متعسفًا في استعمال حقه، ولكي يكون الطّلاق تعسفّيًا يجب توافر شرطين أساسيين هما:
-أن يكون مناقضًا لحكمة أو مشروعية، أو مؤديًا إلى مآل ممنوع شرعًا.
-ألا يكون الطّلاق بناءً على طلب الزّوجة أو برضاها لأن هذا من الأسباب المعقولة[24].
ويمكن تعريف الطّلاق التّعسّفي أيضًا بأنه ” مناقضة قصد الشّارع في رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص”[25].
ب- حكم الطّلاق التّعسّفي بين الحظر والإباحة
قبل التّطرّق إلى حكم الطّلاق التّعسّفي، لا بد أن نعرض بصفة موجزة إلى بيان الأصل في حكم الطّلاق بين الحظر والإباحة، فقد اختلف فيه الفقهاء إلى مذهبين:
-الموجزين بالطّلاق:
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أ-قوله سبحانه وتعالى: ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[26].ووجه الدلالة أن نفي الجناح يعني نفي الاثم والحرج وهذا ينافي الحظر فكان مباحًا.
ب-ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها، والظاهر أن النبي طلقها من غير ريبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يراجعها لأنها صوامة قوامة. وقد نوقشت أدلة القائلين بالإباحة بأن الآية الأولى انما تدل على نفي الجناح في تطليق حدث قبل الدخول لا في كل طلاق.
وأما ما ورد في طلاق النبي لحفصة فالحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه ينبغي أن يحمل على حاجة أو سبب، لا سيما أنه لم يرو في الخبر أنّ النّبي عليه الصلاة والسلام طلقها من غير حاجة أو سبب، فوجب حمله على الحاجة تنزيهًا لفعل النبي عن العبث[27]. وقال السرخسي: ” وايقاع الطّلاق مباح وان كان مبغضًا في الأصل عند عامة العلماء”[28].
-الأصل في الطّلاق الحظر:
ذهب جمهور من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن الأصل في الطّلاق الحظر لا الإباحة، وأنه لا يباح إلا لضرورة أو حاجة ملحة، واستدلوا على ذلك بما بلي:
أ- قوله تعالى: ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ[29]. تدل هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى عدّ الطّلاق من غير مبرر بغيًا وعدوانًا وفيه ظلم للزوجة فكان محظورًا.
ب- ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال ” ما أحلّ الله شيئا أبغض إليه من الطّلاق”. يدلّ الحديث أن المراد بالحلال ما قابل الحرام، وهذا الفعل الجائز أي المباح والمندوب والمكروه لا يتناول الحديث بقرينة إضافة البغض إليه، والمباح والمندوب لا يوصفان بأن الله يبغضهم، فإن البغض يتنافى مع الطلب على سبيل الاستحسان، أو الطلب على سبيل التخيير بين الفعل والترك،على وجه المساواة بينهما، وعليه فيكون المعنى أبغض المكروهات على الله الطّلاق.
وجاء في روضة الطالبين ” أما المكروه فهو الطّلاق عند سلامة الحال”. و عند الشافعية أن الأصل في الطّلاق الحظر، وقال ابن عابدين: أما الطّلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا بعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر، أما الإباحة فهي للحاجة إلى الخلاص.
خامسًا: معايير التّعسّف في الطّلاق
انطلاقًا من مفهوم التّعسّف الذي يعني إساءة استعمال الحق، بحيث يؤدي إلى الحاق الضّرر بالغير، أو بتعبير أدق ” مناقضة قصد الشّارع في تصرف مأذون فيه بحسب الأصل”[30]، نستطيع القول إن حصول التّعسّف يقتضي تحقيق أحد المعيارين التاليين:
-المعيار الأول: المعيار الشخصي أو الذاتي
وأساسه النظر في البواعث أو الدوافع النفسية المحركة لإرادة صاحب الحق لاستعمال حقه. ويقسم هذا المعيار إلى قسمين:
أ-تمحض قصد الاضرار: يعد الشخص مسيئا ً لاستعمال حقه إذا كان قصده الوحيد من ذلك هو الاضرار بالغير، بحيث لا يصحبه قصد إلى شيء آخر كالقصد إلى تحقيق منفعة معينة، ولو كانت ضئيلة، فعندئذٍ لا ينطبق عليه هذا المعيار وإنما يندرج تحت المعيار المادي.
وقد حرّم الشّارع الاضرار بالغير، بما جاء في الكتاب العزيز بالرجعة في الطّلاق، قال تعالى: ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ[31].
وقال عليه الصلاة والسلام: “لا ضرر ولا ضرار”. وهذا الحديث يتناول الاضرار بشكل عام، بكل صوره، فإيقاع الضّرر مذموم كيفما كان. والمقصود من هذا المعيار منع العقد من الاضرار لا منع وقوعه فحسب، فالمرفوض توجيه الغرض إلى الاضرار وتمحض القصد لذلك.
ب- استعمال الحق في غير الغرض الذي شرّع من أجله: يقول الشاطبي:” قصد الشّارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، والدليل على ذلك أن الشّريعة موضوعة لصالح العباد على الاطلاق والعموم، والمطلوب من المكلّف أن يجري على ذلك في أفعاله وألا يقصد خلاف ما قصده الشّارع “[32].
ويقول أيضًا ” كل من ابتغى من تكاليف الشّريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشّريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل”. من هنا كان استعمال الحق مرتبطًا بالغاية التي شرّع من أجله.
ونذكر مثالًا الولاية على النفس والمال حيث شرعت الولاية على النفس والمال لرعاية مصلحة المولى عليه وتحقيق الخير له وصلاح أمره في نفسه وماله، فإذا استعمل الولي هذا الحق في غير هذا القصد، كان متعسفًا.
ومثال ذلك الولاية على الصغيرة في الزّواج، فإذا زوّجها بأقل من مهر المثل أو دون رضاها كان متعسفًا.
-المعيار الثاني: المعيار المادي أو الموضوعي: وينطوي هذا المعيار على الضوابط التالية:
أ-الضّرر الفاحش: هذا المعيار قرره الفقه الإسلامي لتنسيق المصالح الفردية المتعارضة لا سيما العلاقات الجوارية، ولا شك أن تنظيمها وتنسيقها فيها رعاية للصالح العام[33].
والضّرر الفاحش هو كل ضرر يعطل الاستفادة من الملك، بحيث ترتفع عن صاحبه صفة الملكية، مع ما تحويه الكلمة من منافع وامتيازات[34].
أما الضّرر المألوف، فلا بد من تحمله والتّسامح فيه، إذ لو قيل بمنعه، لأدى ذلك إلى تعطيل في استعمال حقوق الملكية كافة، وذلك يخالف النصوص الواردة في ولاية التصرف في الملك، كما أنه مخالفة للإجماع والمعقول، لعدم استقامة إمكانية استعمال حق الملكية كما يريد.
ب-اختلال التوازن بين المصالح المتعارضة: ويُقصد به مراعاة التوازن بين المصالح المختلفة بحيث لا يطغى جانب على آخر، وذلك أن المصالح قد تشوبها مفاسد تُلحق بالآخرين، والفرد في تصرفه ليس مطلقًا من القيود، بل تبقى مصلحة الجماعة التي يحيا معها ملاحظة في تصرفه أوفي حقه.
وينطوي هذا المعيار على ضابطين عامين أولهما اختلال التوازن بين مصلحتين خاصتين، وثانيهما اختلال التوازن بين مصلحة عامة ومصلحة خاصة. فإذا تعارضت المصالح الفردية ونشأ عن استعمال الحق إضرار بالغير، فإن كانت مصلحة الغير هي الراجحة، فإنه يمنع من استعمال حقه، وإذا استعمله كان متعسفًا، وذلك استنادًا للقاعدة الفقهية ” الضّرر الأشد يُزال بالضّرر الأخف”[35] . أما إذا كانت مصلحة صاحب الحق هي الراجحة فتكون أولى بالتقديم للقاعدة السابقة. واما إذا تساوت المصلحتان أو تساوت المصلحة لصاحب الحق مع المضرة على الآخر، فإنه تُقدم مصلحة صاحب الحق حتى يكون لحقه ثمرة أو نتيجة. إلا أن من العلماء من يرى أن صاحب الحق يُعد متعسفًا إذا استعمل حقه في هذه الحالة بناءً على قاعدة ” درء المفاسد أولى من جلب المصالح”[36].
أما إذا تعاضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، فتقدم مصلحة الجماعة، عملًا بالقاعدة الفقهية” يتحمل الضّرر الخاص لدرء الضّرر العام”[37].
وخلاصة القول ان الأصل العام الذي يعد معيارًا عامًا للتعسف، هو استعمال الحق في غير ما شرع له، أي المناقضة بين قصد الفاعل وقصد الشّارع .
سادسًا- صور الطّلاق التّعسّفي
إنّ التّعسّف في استعمال الحق قد يكون له صور عديدة، ولكن هناك ثلاث صور بارزة للطلاق التّعسّفي لذلك سنطرق لهذه الصور على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:
1-الطّلاق لسبب غير معقول:
لم يرد في كتب الفقهاء القدامى والمعاصرين وقوانين الأحوال الشخصية تعريفًا للطلاق دون سبب، إلا أنه يمكن تعريفه بأنه ” مناقضة قصد الشّارع في رفع قيد النكاح في الحال أو المآل”. أي أن يقوم الرّجل بتطليق زوجته لغير سبب مشروع، ودون حاجة داعية. لأن الأصل في الطّلاق الحظر والمنع، وأولى أن يكون لداعٍ يدعو الزّوج لإيقاع الطّلاق أو سوء سلوك أو تعذر الحياة مع الزّوجة. أما الفقهاء المحدثون فاختلفوا في اعتبار التّعسّف في الطّلاق دون سبب على رأيين:
-الرأي الأول: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن من طلق زوجته بغير حاجة أو سبب مشروع لا يعتبر متعسفًا في استعمال حق الطّلاق وذلك بناء على أن الأصل الإباحة وأنه حق للزوج وله حرية التصرف، مع القول بأنه يكره الطّلاق إذا كان من غير حاجة أو سبب مشروع.
-الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي أنه من طلق زوجته من غير حاجة أو مبرر شرعي فقد تعسف في استعمال حق الطّلاق لأنه بذلك أضر بالزّوجة وأهلها وأولادها، كما أنه ناقض قصد الشّارع في مشروعية الطّلاق.
فالطّلاق وإن كان حقًا للزوج يوقعه ويستعمله بإرادته المنفردة، إلا أن استعماله ليس مطلقًا، وإنما هو مقيد إذا تحققت الحاجة له، فإذا أوقع الزّوج الطّلاق بغير سبب معقول، يكون قد أساء استعمال حقه ويلزم بتعويض الضّرر الناتج عنه سواء كان هذا الضّرر ماديًا أو معنويًا، كما لو كانت المطلقة تمارس عملًا معينًا وتكتسب منه قبل زواجها، وتركته بسبب الزّواج، أو أدبيًا كما لو كانت ظروف الطّلاق تشين بسمعة المطلقة وتثير الظنون حولها[38].
علمًا أنه لمعرفة حقيقة السبب إذا كان معقول أو غير معقول فيها اختلاف في التفسيرات، وهذا الاختلاف يكمن سببه في اختلاف الأعراف والتقاليد الاجتماعية من بلد إلى آخر وحتى ضمن البلد الواحد من منطقة إلى أخرى، ومن زمان إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، حيث يختلف مفهوم التّعسّف في إيقاع الطّلاق بحسب العادات والاعراف والتقاليد..
2-طلاق المريض مرض الموت
مرض الموت هو المرض الذي يخشى فيه الموت. وقد اختلف في إماراته، فقيل انه المرض الذي يُلزم المريض الفراش، ولا يقدر على الصلاة قائمًا، ولا يستطيع المشي إلا بمعين، بمعنى آخر هو المرض الذي يعقبه الموت في أكثر الأحيان كمرض السرطان، ولا بد من تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به. وللقاضي سلطة في أن يقدر مقدار انطباقه على حال المريض الذي تعرض تصرفاته عليه[39].
والطّلاق في مرض الموت هي صورة مبنية على نظرية التّعسّف في استعمال الحق، فإذا طلق الزّوج زوجته وهو مريض مرضًا انتهى به الى الموت، وكانت المرأة لا تزال في عدتها من طلاقه فإنها ترث منه ولو كان الطّلاق بائنًا، لأنه أراد ابطال حقها في الميراث ما دامت العدة قائمة لبقاء آثار الزّوجية، وإذا قام الدليل على أنه لم يرد من طلاقها حرمانها من الإرث، فترث منه ما دامت في العدة من الطّلاق الرجعي، ولا ترث من الطّلاق البائن[40].
ولا بد من الرجوع إلى أحكام الشّريعة الإسلاميّة في حالة طلاق المريض مرض الموت حيث يرى بأن الزّوجة ترث زوجها لو طلقها في مرض الموت.
3-الصورة الثالثة: إذا طلبت الزّوجة المطلقة الرجوع إلى بيت الزّوجية بأن تنازلت عن حقها في التعويض وتشبثت بالعودة إلى الحياة الزّوجية، وتمادى الزّوج في تمسكه بطلب الطّلاق فإنّه يعد متعسّفًا في استعمال حقه في نظر القضاء، ومن ثم فإنه يكون للزّوج إيقاع الطّلاق مع إلزامه بالتّعويض عن الضّرر الذي ألحق بالمرأة.
الخاتمة
أظهر البحث أنّ الدّين الإسلاميّ عدّ الزّواج عقدًا مقدّسًا بين الزّوجين وعُني به عناية خاصة. وأعطى الرّجل الحق في إيقاع الطّلاق طبقًا لما له من قوامة ورعاية على الأسرة، وهذا الحق شأنه شأن سائر الحقوق مقيد بقيود الشرع وضوابطه، فمتى انحرف المكلف عن هذه القيود، وجعل استعماله لذلك الحقّ وسيلة لتحقيق مصالح غير مشروعة عدّ ذلك مناقضًا للحكمة من مشروعيته وهو ما يعبر عنه بالطّلاق التّعسّفي. وأظهر البحث بيان مفهوم التّعسّف وأوصافه وحكم التّعسّف. وبيان معنى الطّلاق التّعسّفي والأسباب الداعية إليه.
لائحة المصادر والمرجع
1- الفيروز، أبادي مجد الدين، القاموس المحيط، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1417هـ/ 1997م.
2- الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عياد الطالقاني ( ت 1205هـ) المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بيروت، عالم الكتب، 1414هـ/.
3- مرتضى الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق الحسيني، ( ت1205هـ) ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، إنجلترا 1390هـ، 26/93.
4- الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية، بيروت، جار الكتب العلمية، حاشية ابن عابدين، 3/226م، 3472.
5- أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهج، بيروت، دار الفكر، د.ت، ج3.
6- ابن قدامة، موفق الدين محمد عبد الله أحمد بن محمد، المغني على الشرح الكبير، القاهرة، دار الحديث، ط21، ج3، 10/92.
7- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الحظيري السيوطي الشافعي، تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك، ضبطته وصححه وخرج أحاديثه الشيخ طه عبد الرؤوف سعد والأستاذ سعد حسين محمد القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2003م،.
8- الحاكم، محمد عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، 1411هـ، دار الكتب العلمية، كتاب الطّلاق،2/214.
9-أحمد ديب، قواعد الطّلاق وضوابط الفراق، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2013م.
10- محمد محيي الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية في الشّريعة الإسلاميّة، بيروت، 1428هـ/ 2007م.
11-الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود، أساس البلاغة، بيروت، 1988م، دار الكتب العلمية، ط1، ج1.
12- الفيروز أبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، مصر، دار إحياء التراث العربي، 1417هـ/ 1997م.
13- شوقي ضيف، المعجم الوسيط، مصر، مكتبة الشروق الدولية، 2004م، ص600.
14- فتحي الدريني، نظرية التّعسّف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط2.
15- عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشّريعة والقانون، بيروت، مكتبة النهضة، 1407هـ،
16- محمد أبو زهرة، التّعسّف في استعمال الحق، القاهرة، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، 1963م.
17- جميل فخري محمد جانم، متعة الطّلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطّلاق التّعسّفي في الفقه والقانون، الأردن، 2009م، دار حامد للنشر والتوزيع، ط1.
18- محمد علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، عمان، دار الفكر، 1428هـ/ 2007م،
19- الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه مصطفى أحمد زرقا 1977. دمشق، دار القلم، 1409هـ.
20- أحمد الغندور، الطّلاق في الشّريعة الإسلاميّة والقانون بحث مقارن، مصر، دار المعارف، 1967م.
21- بلحاح، العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة، الزّواج ولطلاق، الجزائر، ديوان المطبوعات الخارجية، 2004.
[1] سورة الروم: الآية 21.
[2] الفيروز، أبادي مجد الدين، القاموس المحيط، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1417هـ/ 1997م، ص1200.
[3] الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عياد الطالقاني ( ت 1205هـ) المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بيروت، عالم الكتب، 1414هـ/.
[4] مرتضى الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق الحسيني، ( ت1205هـ) ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، إنجلترا 1390هـ، 26/93.
[5] الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية، بيروت، جار الكتب العلمية، حاشية ابن عابدين، 3/226م، 3472.
[6] أحمد الدرير، الشرح الكبير، مصر، دار احياء الكتب العربية، 2472.
[7] أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهج، بيروت، دار الفكر، د.ت، ج3، ص79.
[8] ابن قدامة، موفق الدين محمد عبد الله أحمد بن محمد، المغني على الشرح الكبير، القاهرة، دار الحديث، ط21، ج3، 10/92.
[9] سورة البقرة: الآية 229.
[10] سورة البقرة: الآية 236.
[11] جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الحظيري السيوطي الشافعي، تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك، ضبطته وصححه وخرج أحاديثه الشيخ طه عبد الرؤوف سعد والأستاذ سعد حسين محمد القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2003م، ص516.
[12] الحاكم، محمد عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، 1411هـ، دار الكتب العلمية، كتاب الطلاق،2/214.
[13] محمد محيي الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، بيروت، 1428هـ/ 2007م، ص3.
[14] أحمد ديب، قواعد الطلاق وضوابط الفراق، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2013م،، ص22.
[15] سورة النساء: الآية 130.
[16] سورة الروم: الآية 21.
[17] الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود، أساس البلاغة، بيروت، 1988م، دار الكتب العلمية، ط1، ج1، ص652.
[18] الفيروز أبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، مصر، دار إحياء التراث العربي، 1417هـ/ 1997م، ص120.
[19] شوقي ضيف، المعجم الوسيط، مصر، مكتبة الشروق الدولية، 2004م، ص600.
[20] فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط2، ص44.
[21] عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، بيروت، مكتبة النهضة، 1407هـ، ص142.
[22] محمد أبو زهرة، التعسف في استعمال الحق، القاهرة، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، 1963م، ص91.
[23] فتحي الدريني ، مرجع سابق، ص84.
[24] جميل فخري محمد جانم، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه والقانون، الأردن، 2009م، دار حامد للنشر والتوزيع، ط1، ص196.
[25] جميل فخري محمد جانم، التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه والقانون، الأردن، دار حامد للطباعة والنشر والتوزيع، 2009م، ص21.
[26] سورة البقرة: الآية 236.
[27] محمد علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، عمان، دار الفكر، 1428هـ/ 2007م، ط2، ص184-185.
[28] جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص184.
[29] سورة النساء: الآية 34.
[30] فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1401هـ/ 1981م، ص45.
[31] سورة البقرة: الآية 231.
[32] الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي، (790هـ)، الوافقات في أصول الفقه، تحقيق عبد الله، بيروت، دار المعرفة، د.ت، ج4، 2/331.
[33] الدريني، النظريات الفقهية، مرجع سابق، ص 137.
[34] القدومي.
[35] البركتي، محمد عميم الاحسان المجددي، قواعد الفقه، كراتشي، 1407هـ، ص98.
[36] المصدر نفسه، ص81.
[37] الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه مصطفى أحمد زرقا197. دمشق، دار القلم، 1409هـ، ص234.
[38] أحمد الغندور، الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون بحث مقارن، مصر، دار المعارف، 1967م، ط1، ص78.
[39] بلحاح، العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة، الزواج ولطلاق، الجزائر، ديوان المطبوعات الخارجية، 2004م، ص213..
[40] محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص319.
عدد الزوار:1348


