تأثير الموقع لبلدة الشّبانيّة- قضاء بعبدا- في الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للسّكان
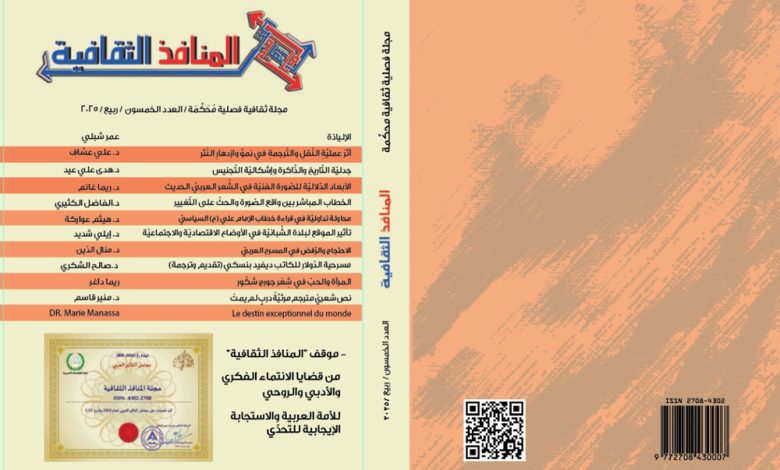
تأثير الموقع لبلدة الشّبانيّة- قضاء بعبدا- في الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للسّكان [1]
L’impact la situation de la ville de Chbaniyeh – Caza de Baabda – sur les conditions économiques et sociales de la population
د. إيلي شديد
Dr. Elie Chdid
تاريخ الاستلام 21/ 8/2024 تاريخ القبول 5/ 9/2024
الملخّص
أدّى الموقع الجغرافي لبلدة الشّبانيّة دورًا سلبيًّا على التّمركّز السّكاني في البلدة، إذ أدى إلى غياب الخدمات وفرص العمل، على الرغم من توفّر مقوّمات طبيعيّة فيها كغابة الشّبانيّة، ومجرى نهر حمانا الذي يمرّ في جنوب بلدة الشّبانيّة، فضلًا عن وجود العديد من المنازل والسّاحات والأدراج التّراثيّة فيها، ومن الممكن أن تكون مصدر جذب سياحيّ، وتسهم في خلق فرص عمل بدل نزوح وهجرة السّكان من بلدة الشّبانيّة. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضّوء على الأوضاع السّكانيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في بلدة الشّبانيّة، لا سيما في الآونة الأخيرة، وما شهدته البلدة من حركات سكانيّة داخليّة وخارجيّة، وانعكاساتها على البلدة من جميع النّواحي.
الكلمات المفتاحيّة: الحركات السّكانيّة- تدهور اقتصاديّ- تنمية مستدامة- سياحة بيئيّة- بطالة.
Résumé:
La situation géographique de la ville de Chbaniyeh a joué un rôle négatif sur la localisation de la population, car l’absence de services et d’opportunités d’emploi, malgré la présence d’atouts naturels tels que la forêt de Chbaniyeh et le cours de la rivière Hmanna qui traverse le sud de la ville, ainsi que la présence de nombreuses maisons, places et escaliers patrimoniaux pouvant constituer une attraction touristique et créer des opportunités d’emploi, ont conduit à l’exode et à la migration des habitants de Chbaniyeh. Cette recherche vise à mettre en lumière les conditions démographiques, économiques et sociales de la ville de Chbaniyeh, notamment ces dernières années, en abordant les mouvements de population internes et externes, ainsi que leurs répercussions sur la ville sous tous ses aspects.
Mots-clés : Mouvements de population – Déclin économique – Développement durable – Tourisme écologique – Chômag
1- المقدمة
يعدّ توفّر الخدمات على مختلف أنواعها وتوفّر فرص العمل أحد العناصر الرّئيسة للجذب السّكانيّ في منطقة معينة، غير أنّ غياب هذه المقومات في هذا المجال الجغرافي قد يدفع بسكانه للبحث عن مجال آخر للعيش ويؤمّن مستوى معيشي لائق، وهذا ما حدث في بلدة الشّبانيّة، حيث إنّ تقهقر الخدمات على جميع أنواعها دفع بالقسم الأكبر من سكانها إلى النّزوح إلى المدن اللّبنانيّة الأخرى أو الهجرة إلى الخارج، حيث بلغ عدد السّكان المقيمين في البلدة 594[2] فردًا في حين أنّ المسجّلين 2413[3].
2- الإشكاليّة
يتبين من المشاهدات الأولية ومن بعض المقابلات الفردية التي تمّت مع فعاليات البلدة الإدارية والاقتصاديّة أن الشّبانيّة تعاني من مشكلة تنموية شاملة إذ تصيب العناصر الأساسية فيها، وهي الاقتصاد والمجتمع والبيئة، وهي على تفاقم مستمر، مما يؤدي إلى إزدياد العوامل المسببة لهذه المشكلة والمتحكمة بها بنويا وديناميا، والتي هي في الأساس عوامل اقتصاديّة، حيث يؤدي غياب فرص العمل وتدهور الأوضاع الاقتصاديّة، إلى إزدياد حركة النّزوح والهجرة يوما بعد يوم. ويصاحب ذلك عدم قيام أبناء المنطقة، سواء على صعيد القطاع الخاص أو القطاع العام أو المجتمع المدني أو السّلطات المحليّة، بخطوات تنموية حاسمة تساعد على النهوض بالبلدة.
3- الفرضيّات
– تشجيع النّازحين والمهاجرين من أبناء هذه البلدة على العودة إليها عبر خلق مناخ إيجابي يتمثل بإقناعهم بمنافع الاستثمار الاقتصاديّ فيها والعودة إليها لإنعاشها وتطويرها.
– خلق نشاطات متعددة فيها على جميع الصعد الاجتماعيّة والسياحيّة والثقافية بحكم أن ضعف هذه النشاطات أسهم في تفاقم هذه المشكلة، كما ساهم في نزوح شبابها إلى مناطق أخرى طلبًا للترفيه عن النفس وتمضية العطل الأسبوعيّة والسّنويّة.
– جذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة عن طريق هذه البلدة للقيام بنشاطات وقرارات لمصلحة سكانها المقيمين والنازحين عنها.
4- أسئلة الدّراسة
ما هي المشاكل الاجتماعيّة السّكانيّة التي تعاني منها بلدة الشّبانيّة؟ ما هي النتائج المترتبة عن استمرار انخفاض عدد السّكان في البلدة؟ كيف يمكن معالجة هذه المشاكل للحؤول دون مفاقمتها؟
5- الموقع
تبلغ مساحتها[4] 4،85 كلم2 وتقع في قضاء بعبدا ضمن محافظة جبل لبنان، وتحديدا بين خطي طول 35 درجة و41 دقيقة و 20 ثانية و35 درجة و41 دقيقة و 20 ثانية شرق خط غرينتش، وبين دائرتي عرض33 درجة و49 دقيقة و 30 ثانية و 33 درجة و48 دقيقة و 15 ثانية. يحدّها من جهة الشمال بلدتي بمريم والخريبة، وحمانا من جهة الشرق، قبيع وصوفر من جهة الغرب، وقتالة والشميسة من جهة الشمال الغربي[5]. ويمكن الوصول إليها عبر عدة طرق، الأولى عبر طريق عام حمانا، الثاني عبر طريق قبيع، الثالث عبر طريق راس الحرف. وتبعد عن العاصمة بيروت 30 كلم وعن مركز القضاء (بعبدا) 21كلم.
6- الموضع
تقسم بلدة الشّبانيّة إلى قسمين: القسم الأول ويتميز بطبيعة أرضه السهلية، وهو يتمركز في القسم الشمالي من البلدة، كما تغطي غابات الصّنوبر القسم الأكبر من هذا القسم، وتتمركز معظم المؤسسات التجارية في هذا القسم. ويفصله عن القسم الثاني طريق عام حمانا- الشّبانيّة – قبيع، والقسم الثاني يتميز بطبيعة انحداره الخفيف حيث تصل نسبة الانحدار[6] إلى حوالي 15% في بعض الأحيان، وفي هذا القسم يتمركز القسم الأكبر من السّكان حيث بلغت نسبتهم 87% من مجموع السّكان القاطنين في البلدة، ويتراوح ارتفاعها بين 640 جنوب القرية و965 في شمالها[7] ويأخذ هذا القسم طابعا انعزاليا. وقد أدّى هذا الموقع الانعزالي نسبيًا، وبعده عن الطريق الرّئيسة، دورًا رئيسًا يدفع سكان البلدة للنّزوح أو الهجرة منها بحثًا عن مصدر عيش في العاصمة وضواحيها.
خريطة (1): بلدة الشّبانيّة[8]
خريطة (2): موقع بلدة الشّبانيّة بالنسبة إلى قضاء بعبدا ولبنان[9]
خريطة رقم (3): بلدة الشّبانيّة والقرى المجاورة لها[10].
خريطة (4): موقع بلدة الشّبانيّة بالنسبة إلى القرى والبلدات اللّبنانيّة[11]
7- المنهج المتبع
أ- المنهج الكميّ
يعرف هذا المنهج بأنّه يصف الظواهر أو مشكلة ما وصفًا كميًا، ويعبّر عنها تعبيرًا رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع الظاهرات المختلفة الأخرى. ويتمثل من خلال الجداول الإحصائية المستندة على الاستمارة الميدانيّة[12].
ب- المنهج الخرائطيّ
يعتمد هذا المنهج على إعداد خرائط تفصيلية للظواهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة، ثم إلى مطابقة هذه الخرائط من أجل اكتشاف العلاقات بين العوامل أو تطور الظاهرات مكانيًا[13].
ج- المنهج الوصفيّ التّحليليّ
ويهدف هذا المنهج إلى وصف المظاهر الجغرافية من خلال الدّراسة الميدانيّة في البلدة وتدوين الملاحظات.
8 – جمع ومعالجة المعطيات الإحصائيّة
أ – وثائق رسميّة وغير رسميّة لها صلة بموضوع البحث .
ب- دراسات عن المنطقة
ج – دراسات عن خارج المنطقة قد تفيد الباحث من ناحية النّظريّة المعتمدة والمنهجية والتقنيات المستخدمة،
بسبب النقص الحاصل في المعطيات الإحصائية، اعتمدت على البحث الميداني، الخرائط المتنوعة، الصّور الجوية وغيرها من الأمور، من أجل الحصول على المعلومات الضرورية للدراسة، وقد قمت بالخطوات التالية واعتمدت على تنفيذ الإستمارة إضافةً إلى المقابلات، وقد مرّ العمل الميداني بمرحلتين :
– الأولى : تحديد قاعدة المعاينة
– الثّانية : المسح الشّامل
من أجل تحديد قاعدة المعاينة قمت بمسح شامل ميداني للوحدات المأهولة بشكل دائم، أي لفترةٍ تزيد عن 6 أشهرٍ، وتبيّن لي بأن عدد هذه الوحدات هو 132 وحدة مشكّلةً بالتالي قاعدة المعاينة، وبما أنّ عدد هذه الوحدات صغير لم يتم اختيار أي عيّنة، بل جرى مسحٌ شامل لهذه الوحدات، باعتبار أن الأسرة هي الوحدة الإحصائية التي ستوجه إليها أسئلة الاستمارة، هذا على الصّعيد السّكاني، أما على الصّعيد الاقتصاديّ فقد قمت أيضًا بمسح شامل لكافة المؤسسات الاقتصاديّة المختلفة. أما بالنسبة إلى المقابلات، فقد تمت مع العديد من أبناء البلدة، لتغطية ما لا يمكن جمعه بوسائل أخرى من جهة، وللوقوف على آرائهم ونظرتهم فيما يخصّ الأعمال التنموية والتوجيهية للبلدة من جهةٍ أخرى .
د – الخرائط
تمّ استخدام مجموعة من الخرائط، أساسها الخريطة الطوبوغرافية 1/20000، والتي وضّحت شكل الأرض إضافةً إلى التمركز العمرانيّ، والتوزع النباتي، وشبكة الطرقات، إضافةً إلى أمور جغرافية أخرى.
ه – الصّور الجوية
استخدمت الصّور الجوية الموضحة للمعطيات الطّبيعيّة والعمرانيّة والنباتية .
و – الزّيارات الميدانيّة
قمت بعدة زيارات ميدانية من أجل الاطلاع على الواقع العمرانيّ والطّبيعيّ للبلدة، وأخذت مجموعة من الصّور الفوتوغرافية من أجل دعم هذا البحث.
9- الخصائص السّكانيّة للبلدة
أ- عدد السّكان
بلغ عدد السّكان المقيمين في الشّبانيّة 594 فردًا، وهؤلاء يتوزّعون بين 318 للنساء وبنسبة 53.5%، و276 للذكور وبنسبة 46.5%. ومن خلال المقارنة مع عدد السّكان في البلدة عام 2016 كان عددهم آنذلك 876 فردا، أي تراجع عددهم 282 فردا[14] بنسبة حوالي 32%، يعود التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأول هو النّزوح الرّيفيّ نحو البلدات المجاورة بسبب نقص فرص العمل والخدمات الأساسيّة في القرية، مثل الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، أما العامل الثّاني فهو هجرة جزء آخر من السّكان إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل أفضل وتحسين مستوى المعيشة، أما نسبة الذكورة فقد بلغت 86.8 %[15](جدول رقم 1).
| الفئات العمريّة | إناث | الذكور | المجموع | نسبة الذكورة | |||
| العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||
| 0-4 | 8 | 2.5 | 9 | 3.2 | 17 | 2.9 | 160 |
| 5-9 | 15 | 4.7 | 16 | 5.8 | 31 | 5.2 | 114.3 |
| 10-14 | 28 | 8.8 | 26 | 9.4 | 54 | 9.1 | 92.8 |
| 15-19 | 21 | 6.6 | 19 | 6.9 | 40 | 6.7 | 90.5 |
| 20-24 | 24 | 7.5 | 21 | 7.6 | 45 | 7.5 | 87.5 |
| 25-29 | 28 | 8.8 | 26 | 9.4 | 54 | 9.1 | 92.9 |
| 30-34 | 40 | 12.6 | 29 | 10.5 | 69 | 11.6 | 72.5 |
| 35-39 | 38 | 11.9 | 33 | 11.9 | 71 | 11.9 | 86.8 |
| 40-44 | 31 | 9.7 | 26 | 9.4 | 57 | 9.6 | 83.8 |
| 45-49 | 25 | 7.8 | 20 | 7.2 | 45 | 7.5 | 80 |
| 50-54 | 21 | 6.6 | 19 | 6.9 | 40 | 6.7 | 90.5 |
| 55-59 | 19 | 6 | 17 | 6.2 | 36 | 6.1 | 89.5 |
| 60-64 | 13 | 4 | 11 | 3.9 | 24 | 4.2 | 84.6 |
| +64 | 7 | 2.2 | 4 | 1.5 | 11 | 1.8 | 45.4 |
| المجموع | 318 | 53.5 | 276 | 46.5 | 594 | 100 | 86.8 |
جدول(1): التوزع العددي والنسبي للسّكان ومعدل الذكورة[16]
ب – توزع السّكان حسب الفئات العمريّة الكبرى[17]
يُعَدُّ التركيب العمريّ والنّوعيّ للسّكان من العناصر الأساسيّة في دراسة الدّيموغرافيا، إذ يعكس الخصائص السّكانيّة للمجتمع من حيث التوزيع بين الذكور والإناث[18]، ويُحدِّد الفئات العمريّة المنتجة التي تتحمّل مسؤولية إعالة باقي السّكان. يشكّل التّركيب العمريّ والنّوعيّ نتاجًا للعوامل المؤثّرة في النمو السّكاني[19]، مثل المواليد، والوفيات، والهجرة التي ترتبط ببعضها البعض بشكل وثيق، حيث يؤدّي أي تغيّر في أحدها إلى تأثير مباشر في البقية. لذلك، تسهم دراسة التّركيب العمريّ في فهم اتّجاهات النّمو السّكاني وتحليل تأثير هذه العوامل، إلى جانب ارتباطها بدراسة الحالة المدنية، والنشاط الاقتصاديّ، والتّعليم، وغيرها من المجالات الحيوية.[20]
| الفئة العمريّة | العدد | النسبة |
| 0-14 | 102 | 17.2 |
| 15-64 | 481 | 81 |
| +64 | 11 | 1.8 |
| المجموع | 594 | 100 |
جدول(2): توزع السّكان حسب الفئات العمريّة الكبرى[21]
يتوزّع سكان القرية على ثلاث فئات عمريّة أساسيّة، فتشكّل نسبة الفتيان 17.2 % من نسبة السّكان المقيمين حيث تبلغ نسبة الإناث الفتيان 16%، وهي ٌأقل من نسبة الذكور التي تبلغ 18.4%، بينما القسم الأكبر من الفئات يشكله الراشدون 80.9% موزعين بين إناث 81.5% وذكور 76%، وأخيرًا تبلغ نسبة المسنّين 1.8%، وهي النّسبة الأقل بين الفئات الثّلاث حيث تشكل نسبة الإناث النّسبة الأكثر، ويعود السّبب إلى تعرّض الذكور لحالات وفاة في هذه الفئة العمريّة أكثر مما هي عليه عند الإناث.
رسم بياني(1) هرم أعمار بلدة الشّبانيّة[22]
هرم أعمار بلدة الشّبانيّة
يتم اعتماد هرم الأعمار كأساس لرسم بنية السّكان، حيث يتم تقسيم السّكان إلى ثلاث فئات عمرية متجانسة، فنحصل بذلك على جدول الفئات العمريّة الذي يجري تمثيله بيانيًا لنحصل على هرم الأعمار. تكمن أهمية هرم الأعمار أنه يسمح بتوقع المستقبل السّكاني لمنطقة معينة، كما يسمح بالمقارنة بين الإناث والذكور؛ بمعنى آخر يلخص هرم الأعمار التاريخ السّكاني لشعب معين[23]. يتميّز هرم أعمار هذه القرى بقاعدة متوسطة العرض (فئة الفتيان)، يقابله اتساع في الوسط أي في مرحلة البالغين حيث تسجل أعلى نسبة لها، كما ويظهر في الرسم البياني لهرم الأعمار انحسار ملحوظ في القمّة إذ إنّ عدد المسنين قليل جدًّا.
ب- الكثافة السّكانيّة
تساهم الكثافة السّكانيّة إلى حد كبير في إعطاء واقع التّوزّع السّكانيّ في منطقة معينة بالكيلومتر المربع الواحد، ويتأثر هذا النوع بالعوامل الاقتصاديّة والطّبيعيّة والبشرية، وهذا ما يؤدي إلى اختلاف الكثافة السّكانيّة بين منطقة وأخرى[24]. ويمكن الحصول على الكثافة من خلال المعادلة التالية: عدد السّكان
المساحة
ومن خلال المعادلة التالية تكون الكثافة السّكانيّة في الشّبانيّة على النحو التالي:
وهذا الرّقم يعتبر منخفضا مقارنة مع النسب المسجلة على مستوى قضاء بعبدا والبالغ 2631ن/كم2 وعلى مستوى لبنان البالغ حوالي 575ن/ كلم2. ويعود انخفاض هذا الرقم إلى هجرة ونزوح عدد من أبناء البلدة إلى بلدان ومناطق أخرى بحثا عن مصدر عيش آخر.
ج- حجم الأسرة:
بلغ عدد الأسر المقيمة في بلدة شبانية 132 أسرة أي بمعدل 4،5 في كل أسرة. يشير تراجع عدد أفراد الأسرة في القرية إلى تغيّر ملحوظ في العادات والتّقاليد المحليّة، لا سيما مع انخفاض دور القطاع الزّراعيّ مقارنةً بالسنوات الماضية. في السّابق، كانت الأسر تتألّف من حوالي عشرة أفراد، حيث كان الأطفال يشكّلون جزءًا مهمًا من اليد العاملة الزّراعيّة. أما اليوم، فإن معظم الأسر تتكون من أربعة أفراد فقط، وهو ما يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها العامل الاقتصاديّ وتكاليف العيش وعمل المرأة وعلمها.
د- نسبة الإعالة العمريّة الإجماليّة
إن نسبة الإعالة هي عدد الأشخاص الذين هم دون 15 سنة وما فوق 64 سنة لكلّ 100 شخص في سن ّ العمل[25] ( أي الذين تتراوح اعمارهم بين 15-64 سنة)؛ ويمكننا الحصول على هذا المعدل من خلال المعادلة التالية :
عدد السّكان أقل من 15 سنة+عدد السّكان 65 سنة وأكثر x 100 = %
عدد السّكان في المدى العمريّ( 15-64 سنة )
د-1- نسبة إعالة الفتيان[26]
عدد السّكان أقل من 15 سنة = %
عدد السّكان في المدى العمريّ( 15-64 سنة )
د-2- نسبة إعالة المسنين[27]:
عدد السّكان + 64 = %
عدد السّكان في المدى العمريّ( 15-64 سنة)
هـ- معدل الولادات
تحسب نسبتهم لكل ألف من عدد السّكان وتعرف هذه النسبة بقسمة عدد المواليد في نفس السنة على عدد السّكان العام مضروبًا بألف[28] أي تكون المعادلة على الشكل التالي :
معدل الولادات = عدد الولادات x 1000
عدد السّكان بالعام
استنادًا إلى المعطيات السّكانيّة التي تم الحصول عليها من المختار في القرية، فإن معدل المواليد الخام في هذه القرية يكون وفق المعادلة التالية :5 x1000/ 594 = 6.73 ‰. انطلاقًا من معدل المواليد الذي حصلنا عليه نلاحظ أن هذه القرى تواجه مشكلة سكنية، إذ تعدّ هذه النسب متدنية جدًا إذا ما قورنت مع معدل العام في لبنان البالغ 24.89 [29]، وما يجب ذكره أنّ هذه الولادات تتأثر بعدد من العوامل أبرزها أنّ المرأة اللّبنانيّة دخلت معترك العمل، وارتفع مستواها الثقافي، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الجمعيات الأهلية في مجال تنظيم الأسرة، وقد ينعكس تراجع معدل الولادات إلى تقلّص في قاعدة هرم الأعمار سنة بعد سنة، فضلًا عن الواقع الاقتصاديّ الذي تتمتع به الأسرة.
يمكننا الحصول عليه على معدل الوفيات وفق المعادلة التالية :
معدل الوفيات الخام[30] : عدد الوفيات خلال سنة معينة x 1000
مجموع عدد السّكان
ووفقا ً للمعادلة التالية يكون معدل الوفيات الخام على النحو التالي :
و- النمو الطّبيعيّ للسّكان
هو متوسط المعدل الأساسي النمو السّكان خلال فترة معينة[31]، ومن خلال الدّراسة الميدانيّة تبين لنا أن الفارق بين المواليد والوفيات 6.73-5.05= 1.68 ‰ وهي نسبة نمو سكاني منخفض جدا.
10- حركات السّكان
لقد أصبحت ظاهرة الهجرة الدّاخليّة أو الخارجية، للعمل أو لأي سبب آخر، من الظواهر الاجتماعيّة العامة في معظم المجتمعات. كما أصبحت في حد ذاتها من المتغيرات الرئيسية بالنسبة لهذه المجتمعات[32]. ولم تعد قضية محلية أو وطنية تخص بلدًا معينًا، وإنما تشترك فيها الدول العربية والدول النامية، بل و الدول المتقدمة. ومن خلال المعطيات التي تنوّعت بنمو وتفاقم مشكلاتها وعوامل استقرارها، فإن قضية الهجرة تطرح إشكاليات عديدة، منها ما هو على مستوى المجتمعات المصدرة للعمالة، أو على مستوى الدول المستقبلة للمهاجرين، وعلى حدّ سواء أكانت من دولة عربية إلى أخرى، أو من دولة معينة إلى أخرى، لذلك صارت الهجرة قضية لها آثارها وانعكاساتها الإيجابية والسلبية، وعلى مختلف نواحي الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسية والثقافية، وبذلك صارت الهجرة قضية اجتماعية هامة، وقد تفاوتت خصائص تلك الهجرات من حيث نوعيتها وأماكن توجهها وحجمها حسب الظروف الزمانية.
وتعدّ الهجرة الخارجية أشمل من الهجرة الدّاخليّة من حيث الكم والنّوع والسّبب. ومهما كانت الهجرة الدّاخليّة تنحصر في الهجرة من الرّيف إلى المدينة، وفي مقدمتها الهجرة إلى المدينة. فإن الهجرة الدّاخليّة في المجتمع اللبناني قد أصبحت بمثابة ديناميه مهمة تؤثر على التغير في المجتمع، ولها مساهمة عميقة في التغير الاجتماعي داخل شرائح المجتمع حضرًا وريفًا. ولذلك فإن ظاهرة الهجرة لم تكن في أي وقت حركة عشوائية أو فوضوية بقدر ما كانت ظاهرة اجتماعية، عبرت بشكل ما عن الواقع الذي أفرزها ودفعها للاستمرار بالشكل والحجم الذي عرفت وتعرف بهما في الوقت الحاضر[33]. أضحت الحركات السّكانيّة في زمننا الحاضر، وأكثر من أي وقت مضى، المحدد الأساسي لتطور عدد السّكان في بلدان ومناطق عدة من العالم. يخضع تطور عدد السّكان في منطقة معينة لتأثير عوامل أساسيّة هي: النّزوح والهجرة.
10-1- النّزوح
النّزوح تمثل عملية انتقال الفرد من الرّيف إلى المدينة أو من ريف إلى آخر أو من مدينة إلى ريف أو من مدينة إلى أخرى، أي بمعنى آخر هي عملية انتقال الفرد من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد[34]. يلعب العامل الاقتصاديّ دورا رئيسيا في عملية النّزوح فضلًا عن عوامل أخرى كالتّعليم والصحة والترفيه.
1-1- تتمثل أنواع النّزوح بالأشكال التالية
أ- الحركة المكوكية للسّكان: وهي عملية انتقال يومي من المنزل إلى مكان العمل وبالعكس، وهي ترتبط بدوام العمل، حيث تندفع باتجاه المدينة صباحا ًأعداد كبيرة من السّكان للعمل فيها ثم العودة مساء، مما يسبب ازدحامًا على مداخل العاصمة وفي شوارعها الرئيسية.
ب- الحركة الدورية للسّكان أو الموسمية : وهي عملية انتقال بعض السّكان في فترة معينة من السنة من منطقة إلى أخرى للعمل أو للاصطياف أو السكن المؤقت ومن ثم العودة بعد انتهاء المهمة.
ج- النّزوح القسري: سببه حوادث عنف سياسية أو دينية أو عرقية كما حدث في لبنان أبان الحرب الأهلية اللّبنانيّة، ولا سيما المناطق التي كانت ساحات للمعارك الدامية.
د- النّزوح الدائم: يشمل الذين تركوا البلدة منذ فترة زمنية طويلة، واستقروا في مدن ومناطق أخرى حيث أسسوا هناك معامل لهم، وعملوا على بناء أو شراء منازل يسكنون فيها، وهم لا يرجعون إلى قراهم إلا في المناسبات الدينية الكبيرة والسياسية.
10-2- أسباب النّزوح
أ- الأسباب الاقتصاديّة
إنّ تراجع إنتاجية القطاع الزّراعيّ تحديدًا، والذي كان يؤمن دخلًا لبعض الأسر في هذه القرى، أدى إلى تحويل الأراضي الزّراعيّة إلى أراضٍ بور تغطيها الأعشاب البرية، كما أدى التراجع في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى في هذه القرى إلى زيادة حركة النّزوح اليومي والموسمي إلى العاصمة وضواحيها لتأمين دخل مناسب، حيث توفر المراكز التجارية والتوظيفية والخدماتية.
ب- الأسباب الخدماتيّة
مع غياب أي نشاط خدماتي في القرية دفع بعدد من السّكان إلى الانتقال نحو مناطق تتوفر فيها تلك الخدمات وبمستويات متقدمة، خاصة لجهة التّعليم الجامعي والمدرسي والمهني، وتوفر معظم المؤسسات الصحيّة، وتمركز العديد من مراكز اللهو في العاصمة والضواحي المحيطة بها.
10-2-1- توزيع السّكان النازحين حسب مكان الإقامة:
بالنسبة إلى توزيع النازحين على المحافظات، نلاحظ من خلال الدّراسة الميدانيّة أن محافظة جبل لبنان تستأثر بالقسم الأكبر من النازحين بحوالي 91% مقابل 6% لمحافظة بيروت و3 % للمحافظة الشمال. ومن الملاحظ أن عملية النّزوح تنحصر في ثلاث محافظات وهي جبل لبنان والشمال وبيروت. أما بالنسبة إلى التوزيع على الأقضية نلاحظ أن قضاء المتن يستقطب القسم الأكبر من عملية النّزوح من هذه القرى.
10-2-2- النّزوح الأسريّ
إن معظم النازحين الدائمين ينتظمون في شكل عائلات أي (هجرة عائلية) حيث أظهرت الدّراسة الميدانيّة نزوح حوالي 60 أسرة، بينما بلغ عدد النازحين إفراديًا حوالي 390 شخصًا أي ما نسبته 65 % من مجمل النازحين. ويعود سبب إرتفاع هذه النسبة الغلاء في المعيشة، مما يرفع عمر المتوقع للزواج. اما لجهة توزيع الأسر النازحة حسب عدد أفرادها، فيتبين من خلال الدّراسة الميدانيّة أن الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين أربعة وستة أفراد هي الأسر الغالبة إذ تشكل نسبة 93،56% من إجمالي الأسر النازحة، أما الأسر التي يبلغ عدد أفرادها اثنين وثلاثة أفراد فإن نسبتها تشكل 6،44 % من حاصل الأسر النازحة. أما معدل أفراد الأسر النازحة فيمكن الحصول عليه وفق المعادلة التالية:
معدل أفراد الأسرة الواحدة[35] : مجموع أفراد الأسر النازحة =
عدد الأسر النازحة
أما على صعيد توزيع الأسر والأفراد على مناطق النّزوح، فقد شكلت مدن ساحل المتن الشمالي المركز الرئيسي لمعظم النازحين، وذلك لإمكانية توفر فرص العمل بمردود أكبر بما هو عليه في بلدته.
11- الهجرة
بلغ عدد المهاجرين من الشّبانيّة 57 شخصا موزعين بين 41 ذكور و16 إناث وهؤلاء يتوزّعون على الشكل التالي:
| البلد | الجنس | |
| ذكور | إناث | |
| الإمارات | 15 | 6 |
| السعودية | 7 | 0 |
| قطر | 8 | 0 |
| بحرين | 6 | 0 |
| الكويت | 7 | 0 |
| برازيل | 4 | 4 |
| كندا | 3 | 3 |
| أوستراليا | 1 | 3 |
جدول (3): توزع المهاجرون على عدد من دول العالم[36]
12- مقترحات تنمويّة
تعاني القطاعات الاقتصاديّة في هذه القرية مشاكل مشتركة تعيق عملها وإمكانية تطورها، وهذه المشاكل تتمثل بارتقاع كلفة الإنتاج وما تتضمنه من ارتفاع أجرة اليد العاملة وارتفاع أسعار المواد الأوليّة، فضلًا عن المنافسة التي تتعرض لها منتجات هذه القرى، إضافة إلى الموقع الجغرافي المنعزل نسبيًا عن الطريق الرئيسية مما قد يسبب في المنتجات الزّراعيّة من وقت إلى آخر. وبما أن هذه القرى تعدّ فقيرة نوعًا ما، من هنا يبدو ضرورة التعاون بين بعضها البعض للتنشيط قرراها وذلك يتم خلال المقترحات التالية:
1- تنمية القطاع الزّراعيّ
إن القسم الأكبر من الزراعات هي للاستهلاك الذاتي أي غير مخصصة للتجارة، أما بالنسبة إلى القسم المخصص للتجارة فيعاني مثل كافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى من ارتفاع كلفة اليد العاملة(25$) يوميًا فضلًا عن ارتفاع المواد الأولية (الأسمدة الزّراعيّة وحراثة الأرض) فضلًا عن تذبذب في الإنتاج الزّراعيّ من سنة إلى أخرى، ولتنشيط هذه الزراعات يجب العمل على دعمها من خلال قروض ميسرة بفائدة قليلة، وتشجيع العمل التعاوني الزّراعيّ، وإدخال زراعات ذات قيمة مضافة، ويحتاج هذا النوع من الزّراعة إلى إكتساب مهارات وإلى معرفة الأنواع المطلوبة، وطرق الإنتاج والتوضيب، والعرض بعلاقات تجارية أو ماركات (label) تحمل اسم المنشأ الجغرافي في البلاد.
1-1- التّصنيع الغذائي والزّراعيّ
ويتطلب التّصنيع الغذائيّ الاهتمام بشروط التّصنيع لجهة جودته ونوعيته، وإقامة علامة تجاريّة تخضع لتنميط الإنتاج وتتبع مقاربة جودة شاملة. يمتلك أهالي هذه القرى معارف ومهارات زراعيّة متواضعة يمكن أن تطور وتدعم بتقنيات تخفف الكلفة وتدخل أصنافًا جديدة من الإنتاج. من ناحية أخرى، يمكنها أن تساهم في دراسة وتسويق وتحويل بعض المنتجات المتعثرة التي تتوفر مثل الزّيتون والكرمة والحليب أحيانًا بشكل سريع وفعال بتصريف الإنتاج، وتاليًا بتحسين الأوضاع المعيشية لأهل المنطقة( الزّيتون والزيت مع المطيبات والأعشاب البرية، الزبيب، صناعة الكشك والأجبان والألبان).
1-2- الحفاظ على الغابة الصّنوبريّة والتّنوّع البيولوجيّ (الأحراج والغابات)
يمكننا المحافظة على هذه الغابة من خلال:
– تشجيع إقامة المنازل التي يتم فيها استخدام الحطب، فاستخدام الحطب للتدفئة يخفف نسبة التلوث، ويؤمن بيع الأخشاب الناجمة عن تقيلم أغصان الغابة الصّنوبرية وبقايا أكواز الصّنوبر، مما يرفع عائدات استثمار الغابة الصّنوبرية من جهة، ويقلل من إمكانية حصول الحرائق فيها نتيجة بقاء الأغصان.
– صيانة الطرقات الزّراعيّة، وشق طرقات إضافية بشرط عدم تعبيدها من أجل عدم تشجيع إقامة أحياء سكنية، وتوعية الناس وتوجيههم إلى سبل الاهتمام بثروة القرى الحرجية ومكوناتها، وذلك قد ينطوي على إقامة المحاضرات والندوات لتعريفهم بدور الطبيعة في تكريس التوازن .
– التخفيف من المضاربات الخارجية والتي قد تؤدي إلى انخفاض في أسعار الصّنوبر المحلي، مما يؤدي إلى عزوف عدد من المواطنين عن العمل في هذا القطاع.
ولشجرة الصّنوبر أهمية كبرى من الناحية البيئيّة، فبالإضافة إلى كونها ملجأ للحياة البرية، فهي تعمل على الحد من انجراف التربة، والانزلاقات الأرضية، والانهيارات الصخرية، كما تُساعد على زيادة المياه الجوفية وعلى تلطيف المناخ، والحد من التلوث، فضلًا عن توفير الأوكسجين[37]. ومن الناحية الصحيّة، ينصح ذوو أمراض الربو والذين يُعانون مشاكل في التنفّس، بالعيش بين أشجار وأحراج الصّنوبر باعتبارها تُنقّي الهواء وتوفّر الجو الصحيّ الملائم لهم.
1-3- الاهتمام بالثّروة الحيوانيّة
من خلال الدّراسة الميدانيّة التي أجريناها يتبين لنا أن هناك فجوة بين قسمي الزّراعة (الزّراعة العضوية والزّراعة الطّبيعيّة) ويمكن تصويب هذا الخلل من خلال :
- من ضمن التّعاونيّات التي يتم إنشاؤها لمساعدة القطاع الزّراعيّ يمكن إنشاء فرع لمساعدة القطاع الحيوانيّ، وتأمين المساعدات الماليةّ لأصحاب المزارع.
ب- العمل على تحديث مزرعة الأبقار الموجودة في هذه القرية، وذلك من خلال مساعدات مالية تقدم
من قبل التعاونية، حيث يمكن الاستفادة من حليبها ولحومها و تزويدها بالمعدات والآلات الحديثة.
- التوسع في تربية النحل وذلك عن طريق زيادة قفران النحل لأهميتها في توفير دعم إضافي اقتصاديّ لعدد من الأسر التي تهتم بهذا القطاع (سعر الكيلو الواحد 25$) فضلًا عن أهمية الغذائية للعسل.
2- الصّناعات الحرفيّة:
الخطوات الضّرورية لتطوير القطاع الصّناعيّ والتي من الممكن أن يقوم تجمع هذه القرى بها هي اعتماد سياسة محلية ترتكز على ربط الحرفيين بمؤسسات إقراضية، وتشجيع المنشآت التي تتطلب يدًا عاملة نسائية(كشك، لبنة، جبنة، المونة)، وتسهيل عمليات الاستثمار في القطاع الصّناعيّ، وتأمين البنى التحتية الملائمة وبأقل كلفة ممكنة.
3- في الأعمال التجارية والخدماتية:
تم تأسيس عدد من المحلات التجارية والخدماتية في هذه القرى لتأمين حاجات السّكان، لكن جاء اليوم الذي أصبح من الحاجة إلى تطويرها أكثر فأكثر من خلال إقامة سوق تجاري أسبوعي تعرض فيه البضائع المختلفة والمتنوعة، مما يؤدي إلى توسيع المجال التجاري في البلدة ،وإيجاد مداخيل إضافية لعدد من السّكان.
4- في القطاع السّياحيّ
4-1- واقع ومقومات القطاع السّياحيّ
يعتبر القطاع السّياحيّ من أهم القطاعات الاقتصاديّة، شرط أن تكون السّياحة مسؤولة وتؤدّي دورًا إيجابيًا في المحافظة على البيئة وعلى سلامة التّراث الثّقافيّ كالمواقع البيئيّة والتّاريخيّة. بدورها هذه القرى تتمتع بمقومات سياحيّة هامة، فهي قرية ذات مواقع طبيعيّة متنوعة ومناظر خلابة تصلح لأن تكون محميات، ووجود أديرة وكنائس قديمة، فضلًا عن حسن الضّيافة وكرم أهالي هذه المنطقة والموقع الجغرافيّ لهذه القرى وقربها من العاصمة. جميع هذه المقومات تؤهل هذه القرى أن تكون ناشطة سياحيًا .
–جعل غابة الشّبانيّة كمنتزه طبيعيّ والعمل على تنظيمه في مشروع متكامل يسهم في التّنمية المستدامة، ويرتكز على حماية التّراث والإرث الطّبيعيّ والثقافي وذلك بمشاركة المجتمعات المحليّة وإقامة أبحاث وتجارب مرتبطة مباشرة بطبيعة الأرض والبيئة[38]. وهذا المنتزه قد يشجع السّياحة البيئيّة والإقامة في المخيمات، حيث تجذب هذه السّياحة زوارًا إلى مواقع بيئيّة وطبيعية، كما تستدعي تأهيل الدروب للمشي، تأمين طرقات خاصة للدراجات، إضافة إلى مخيمات وورش عمل هدفها المساهمة في مشاريع التنمية.
د- تشجيع سياحة الشباب ومحبي المغامرات الذين يرغبون باستكشاف مناطق جبلية وحرجية وتسلق الجبال وتمضية ليلة أو أكثر في بيوت ضيافة ريفيّة بأسعار مقبولة.
صورة(1): مدخل غابة الشّبانيّة[39]
صورة(2): نشاط ترفيهي في الغابة[40]
4-2- التّرويج المنطقة إعلامّيًا
يترافق التّطوير السّياحيّ لهذه القرية مع الدّعاية لها. فمحليًا اعتماد خطة إعلاميّة تبرز خصائصها وما تقدمه من إمكانيات سياحيّة متنوّعة. كذلك ينبغي لهذه الخطة أن تتوجه إلى السّياح الأجانب من خلال التوجه إلى وكالات السفر والسّياحة المحليّة والعالمية والمؤسسات التي تنظم رحلات سياحيّة ريفية ودينية.
4-3- إعادة إحياء العادات والتّقاليد
يرغب عدد كبير من الجيل الجديد والسّياح بالتعرف على العادات والتّقاليد التي كانت سائدة قديمًا في هذه القرية، فبإمكان السّلطة المحليّة بالتعاون مع أبناء البلدة إعادة إحياء هذه العادات، وذلك من خلال تنظيم عرس قروي من فترة إلى أخرى وما يتضمنه من عادات وتقاليد، فضلًا عن تنظيم مباراة في رفع الجرن ودقّ الجرس، فضلًا عن إقامة حفلات من الزجل الشّعبيّ الذي لا يزال يلقى إقبالًا لدى العديد من أبناء هذه القرى، إضافة إلى معارض تعرض فيها المنتوجات المحليّة.
5- في المواصلات
تفتقر الطّرقات إلى تخطيط مدني، كونها تمرّ من داخل البلدة من دون مراعاة شروط السلامة العامة، بحيث تكثر التّعديّات على حرم الطّرق العامة ويكثر تضييقها بدل توسيعها. فهي تحتاج إلى صيانات متعددة، وإن كان قد جرى عليها تعبيد جزئي متقطع لبعض أقسامها.
6- في مجال التّعليم
يمكن تفعيل هذا القطاع أكثر فأكثر من خلال إعادة تطوير المدرسة الرّسميّة، وذلك لإنعدام الثقة بالمدرسة الرّسميّة وتدعيم وتجهيز المدرسة بمستلزمات ووسائل عمليّة وعلميّة مما قد يحدّ أو يخفف من عملية نزوح التّلامذة، وقد يسهم في تنشيط الحركة الاقتصاديّة في القرى من خلال تأمين وظائف لبعض أبناء هذه القرى.
7- في المجال الصحيّ
لم تحظ بمستشفى لمعالجة المرضى وإجراء الفحوصات، وقد يكون من المفيد في إطار تنمية الواقع الصحيّ على مستوى البلدة والمنطقة أن يعمد إلى:
- العمل على تشييد مستوصف أو مركز صحيّ يتعاون على عمله أبناء هذه القرى وعدد من الاختصاصيين فضلًا عن تأمين الدواء بأسعار منخفضة.
- إقامة النّدوات والمحاضرات الصّحيّة التي تعزز الثقافة الصّحيّة لدى الأفراد .
8- على الصّعيد العمرانيّ
تعاني حاليًا من مشاكل عدة أبرزها صعوبة البناء، وذلك بسبب التصنيف الذي فرضته الدولة على أراضي هذه القرية، حيث أصبح الفرد بحاجة إلى مساحة تزيد عن 2000 متر2 لكي يستيطع بناء منزل ضمن شروط متواضعة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأراضي في هذه القرى (200$ للمتر الواحد) للأراضي القريبة من الطرقات فيما يتدنى السعر بإتجاه الداخل. فيمكن للسلطات المحليّة(البلديات) أن تعمل مع الجهات الفاعلة لإعادة النظر بالتصنيف لهذه الأراضي، مما قد يسمح لأبناء هذه القرى بالبناء في قراهم ويحدّ من عملية النّزوح.
- في المجال الترفيهي والرّياضيّ
إنّ الرّياضة والتّرفيه حاجة أساسية لدى الفئات الشّابة والأسر. لقد أصبحت أكلاف تلبية هذه الحاجة في العاصمة وبعض المناطق الأخرى مرتفعة، وضمن ميادين تقتصر على ارتياد المقاهي والمطاعم وبعض المنتزهات العامة ودور اللّهو والنّوادي اللّيلية. أما ممارسة الرّياضة فهي أيضًا محصورة ضمن الأندية الخاصة وبعض الأماكن العامة لأنواع رياضة الرّكض والمشي .
10- على صعيد الغابات والثروة الحرجية
للحفاظ على هذا الغطاء يجب أن تعمل البلدية والجهات المحليّة مع بعضها البعض على تنظيف هذه الغابات بطريقة دورية للتخفيف من إمكانية حدوث حرائق، إضافة إلى تشحيل هذه الغابات بطريقة منظمة ومدروسة.
خلاصة
إنّ الإقتراحات المقدمة هي محاولة للتّخفيف قدر الإمكان من التّفاوت بين المناطق اللّبنانيّة وتحديدًا بين الرّيف والمدينة والتخفيف من نسبة البطالة، ولكنّها تبقى من دون قيمة ما لم ترافقها نصوص قانونيّة وتشريعيّة على المستوى الوطنيّ. وفي الحقيقة، تبدو إجراءات الحماية التي ينص عليها التشريع الحالي، غير كافية لصون الأملاك العامة والثّروة الحرجيّة والغابات والحفاظ على نوعيّة المياه ومجاريها. إنّ جهدًا تشريعيًّا مكملًا قد يسمح بتفعيل المفاهيم ويقدّم الأجوبة والحلول للمارسات غير القانونيّة على الأملاك العامة، وتنفيذ هذه الاقتراحات مرتبط بالتّنسيق القائم في ما بين المخطط التوجيهي والسّلطات المحليّة.
المراجع
- الفرن، جورج – منهجية البحث الجغرافي – مقرر الفصل الرابع – الجامعة اللّبنانيّة 2012 –ص 36 .
- الإنسان والأرض في الجغرافيا العامة البشرية والاقتصاديّة- مجموعة مؤلفين.
- أبو عيانة فتحي : التحليل الإحصائي في الجغرافيا البشرية، دار النهضة العربية، بيروت 2000.
- أبو عيانة فتحي: جغرافية السّكان، دار النهضة العربية، بيروت 2000.
- برسا رولان : معجم مصطلحات الديمغرافيا، ترجمة الدكتورة هلا نوفل رزق الله، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1990
- لبيب علي : جغرافية السّكان، الثابت والمتحول، الدار العربية للعلوم، بيروت 2004
- د. سعاد نور الدين: السّكان والتنمية مقاربة سوسيوتنموية- دار المنهل اللبناني .
- فاعور علي : جغرافية التهجير السّكاني، دار المؤسسة الجغرافية، بيروت 1993
- الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا – كشوفات البيانات الديموغرافية العدد 8 ص 6 – 1995
- نظم المعلومات الجغرافية
- مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني
Sites electroniques
- 13. esri.com
- 14. unescwa.org
المقابلات:
رئيس بلدية الشّبانيّة
مختار بلدة الشّبانيّة
[1] – د. إيلي شديد- أستاذ مساعد لمادة الجغرافيا في الجامعة اللبنانية – كلية التربية – الفرع الثاني
[2] مختار بلدة الشبانية
[3] دائرة نفوس حمانا
[4] نظم المعلومات الجغرافبة
[5] مراجعة الخريطة رقم 1
[6] استنادا الى الخريطة الطوبوغرافية
[7] المرجع نفسه
[8]– تنفيذ الباحث إستنادا الى نظم المعلومات الجغرافية
[9]– المرجع نفسه
[10] تنفيذ الباحث استنادًا إلى الدّراسة الميدانيّة
[11] المرجع نفسه
[12] – جورج الفرن – منهجية البحث الجغرافي – مقرر الفصل الرابع – الجامعة اللبنانية 2012 –ص 36 .
[13] www.esri.com
[14] إحصاء أجراه اتحاد بلديات المتن الأعلى
[15] استنادا الى الدّراسة الميدانية
[16] تنفيذ الباحث استنادا إلى الدّراسة الميدانية
[17] المرجع نفسه
[18] ابو عيانة فتحي : التحليل الإحصائي في الجغرافيا البشرية، دار النهضة العربية، بيروت 2000.
[19] ابو عيانة فتحي: جغرافية السكان، دار النهضة العربية، بيروت 2000.
[20] الإنسان والأرض في الجغرافيا البشرية والإقتصاية- مجموعة مؤلفين- بيروت 2008.
[21] تنفيذ الباحث إستنادا الى الدّراسة الميدانية
[22] المرجع نفسه
[23] برسا رولان : معجم مصطلحات الديمغرافيا، ترجمة الدكتورة هلا نوفل رزق الله، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1990
[24] لبيب علي : جغرافية السكان، الثابت والمتحول، الدار العربية للعلوم، بيروت 2004
[25] أبو عيانة فتحي : جغرافية السكان، مرجع سابق
2- د. سعاد نور الدين : السكان والتنمية مقاربة سوسيوتنموية- دار المنهل اللبناني .
[28] فاعور علي : جغرافية التهجير السكاني، دار المؤسسة الجغرافية، بيروت 1993
1– الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – كشوفات البيانات الديموغرافية العدد 8 ص 6 – 1995 .
2– د. سعاد نور الدين، مرجع سابق.
[31] www.unescwa.org
[32] د.علي فاعور: جغرافية التهجير، مرجع سابق
[33] الإنسان والأرض في الجغرافيا البشرية والاقتصاية- مرجع سابق
[34] فاعور علي : جغرافية التهجير السكاني، مرجع سابق
[35] – الدّراسة الميدانية
[36] الدّراسة الميداينّة
[37] الإنسان والأرض في الجغرافيا الطبيعية- مجموعة مؤلفين- بيروت 2008.
[38] الخطة المبسطة للتنمية المحلية لقرى المتن الأعلى
[39] تصوير الباحث
[40] المصدر نفسه
عدد الزوار:52


