إطلالة تاريخيّة على أحوال الشّيعة ونشأة مؤسّساتهم التّعليميّة
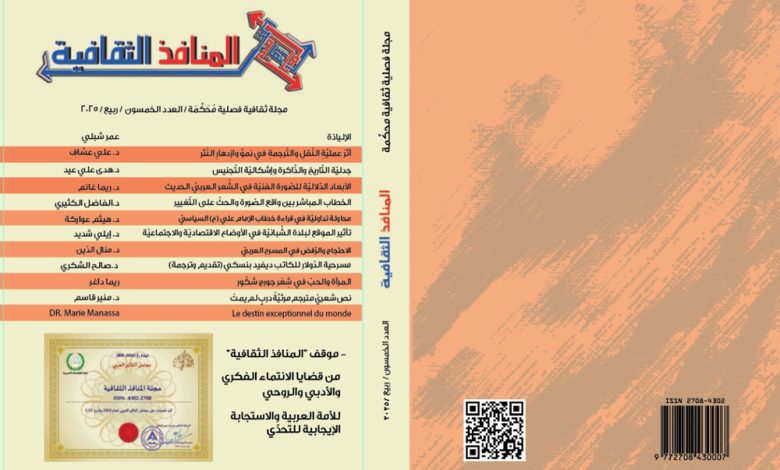
إطلالة تاريخيّة على أحوال الشّيعة ونشأة مؤسّساتهم التّعليميّة
Ahistorical overview of the conditions of the Shiites and the emergence
of their educational institutions
بلال شمص
Bilal Shams
أ.د خالد الكردي. مشرفًا رئيسًا أ.د محمد علي القوزي مشرفًا مشاركًا
تاريخ الاستلام 1/8/2024 تاريخ القبول 18/8/2024
ملخص الدّراسة
تناولت هذه الدّراسة تاريخ التّعليم الشّيعي في لبنان، مركّزة على تطوّر المؤسّسات التّعليميّة عند الطّائفة الشّيعيّة منذ نشأتها وحتى مطلع القرن العشرين. وأظهرت الدّراسة أن المدارس الدّينيّة، أو ما يعرف بـ”الحوزات”، لعبت دورًا محوريًا في نشر العلوم الدّينيّة واللغة العربيّة بين الشّيعة. كما استعرضت الدّراسة تأثير التّحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة على التّعليم ومؤسّساته لدى الشّيعة، وكيف تمكّنت الطّائفة من الحفاظ على هويّتها وتعاليمها رغم التّحدّيات التي واجهتها. تناولت الدّراسة أيضًا دور الهجرة إلى العراق وإيران في تعزيز الرّوابط العلميّة ونشر المعرفة بين الشّيعة في لبنان والعالم الإسلامي.
الكلمات المفتاحية: الحوزات، المدارس الدّينيّة، الهوية الدّينيّة، التّحوّلات السياسيّة، جبل عامل.
Abstract
This study explored the history of Shia education in Lebanon, focusing on the development of educational institutions within the Shia community from their inception to the early 20th century. The study revealed that religious schools, known as “hawzas,” played a pivotal role in spreading religious sciences and the Arabic language among Shias. The research also examined the impact of political and social transformations on Shia education and how the community managed to preserve its identity and teachings despite numerous challenges. Furthermore, the study highlighted the role of migration to Iraq and Iran in strengthening scientific ties and spreading knowledge among Shias in Lebanon and the wider Islamic world.
Keywords:
Hawzas, Religious schools, Religious identity, Political transformations, Jabal Amel.
ـ المقدمة
شهدت الطائفة الشّيعيّة في لبنان تطورًا ملحوظًا في مؤسساتها التّعليمية منذ نشأتها وحتى مطلع القرن العشرين. لعبت المدارس الدّينيّة (الحوزات) دورًا محوريًا في نشر العلوم والمعارف، وكانت مصدرًا رئيسيًا لتعليم العلوم الدّينيّة واللغة العربية. ورغم التّحدّيات السياسيّة والاقتصادية التي واجهتها، تمكنت الطائفة الشّيعيّة من الحفاظ على هويتها وتعاليمها من خلال نظام تعليمي مستقل ومتميز. خلال العهد العثماني وما بعده، استمرت هذه المؤسسات في التطور والتأقلم مع الظروف المحيطة، مع التركيز على تنمية المجتمع الشّيعي في لبنان.
كيف أثرت التّحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة على التّعليم ومؤسساته عند الشّيعة في لبنان عبر التّاريخ؟
أهداف الدّراسة
- تحليل التّحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة للشّيعة في لبنان منذ العصور الوسطى وحتى العصر الحديث.
- دراسة تأثير هذه التّحوّلات على التّعليم ومؤسساته لدى الشّيعة في لبنان عبر المراحل التّاريخيّة المختلفة.
- تقييم دور المدارس الدّينيّة (الحوزات) في نشر العلوم والمعارف وتعزيز الهوية الدّينيّة لدى الشّيعة.
- فهم التّحدّيات التي واجهتها المؤسسات التّعليمية الشّيعيّة وكيفية التغلب عليها والاستمرار في تطوير التّعليم.
أهمية الدّراسة
- الإسهام في فهم أعمق لتاريخ التّعليم عند الشّيعة في لبنان وتطوره في ظل التّحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة.
- تسليط الضوء على الدّور البارز للمدارس الدّينيّة (الحوزات) في تعزيز الهويّة الشّيعيّة والحفاظ على التعاليم الدّينيّة.
- تقديم معلومات دقيقة ومفصلة للباحثين والمختصين في مجال الدّراسات الإسلامية والتّاريخيّة حول دور التّعليم في الحفاظ على الهوية المذهبية والثقافية.
منهجية الدّراسة
المنهج التّاريخي: تحليل تاريخي للحقبات الزمنية المختلفة التي مرت بها الطائفة الشّيعيّة في لبنان منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث. والمنهج الوصفي: وصف وتحليل أوضاع التّعليم ومؤسساته لدى الشّيعة في لبنان عبر المراحل التّاريخيّة المختلفة.
أوّلًا: التّعريف بالشّيعة
أ ـ تعريف الشّيعة
الشّيعة هم الفرقة الإسلامية التي تميزت عن غيرها من الفرق الإسلامية الأخرى في أنها تمسكت بالنص على إمامة الإمام علي(ع) وأبنائه كخلفاء للنبي محمد (ص)، وأئمة للدّين. وهم يعتقدون بإمامة ا لأئمة كأصل من أصول الدّين، وأن الاعتقاد بها ضرورة من ضرورات مذهبهم. وأن الأئمة الاثني عشر هم معصومون عن الكبائر والصغائر كالنّبي محمد(ص)، أولهم الإمام علي بن أبي طالب(ع) وآخرهم الإمام محمد بن الحسن(ع) الغائب عن الأنظار(حسب اعتقادهم) منذ ما يزيد عن ألف سنة وهو لا يزال حيًا، وسيظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا. والفارق الوحيد بين الإمام المعصوم(ع) والنّبي(ص) هو في كون الأخير يتلقى الوحي من الله، في حين أن الإمام لا يُوحى إليه، “وإنما يتلقى الأحكام منه (أي من النّبي) مع تسديد إلهي. فان النّبي مبلّغ عن الله، والإمام مبلّغ عن النّبي، والإمامة متسلسلة في اثني عشر كل سابق ينصّ على اللّاحق، ويشترطون أن يكون معصومًا كالنّبي عن الخطأ والخطيئة وإلّا زالت الثقة به”[1].
كما “يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله يختار من يشاء من عباده للنبوة والرّسالة، ويُويّد بالمعجزة…. فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ينصّبه إمامًا للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان عليه النّبي أن يقوم بها”[2].
كلمة الشّيعة أطلقت على “الذين شايعوا أمير المؤمنين علي(ع)، وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصيّة، إما جليًا وإما خفيًا، وإن الإمامة لا تخرُج من ولده”[3].
وكلمة شيعة “من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة. وقد اختُص هذا اللفظ بمن تولى عليًا وبنيه عليهم السلام، وأقرّ بإمامتهم، حتى صار (أي اللفظ) ينصرف إليهم إذا أُطلق عند الاستعمال من دون قرينة وإمارة”[4].
إن ما يميز الشّيعة عن غيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى إيمانهم واعتقادهم بأصل ومبدأ الإمامة باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وقد أحدثت هذه القضية (أي الإمامة ومعها الخلافة) اختلافًا وتباينًا بين الفرق الإسلامية وقسمها إلى قسمين رئيسيين، فالسنة يرون أن النّبي(ص) ترك مسألة خلافته شورى بين المسلمين من دون نص أو وصيّة، بينما يرى الشّيعة أن النّبي(ص) قد نص وأكد ـ كما ورد آنفًا ـ على إمامة وولاية الإمام علي بن أبي طالب(ع) في أكثر من مقام.
ركزت أغلب المؤلفات والكتب التي تناولت التّاريخ السّياسي والاجتماعي والعلمي عند الشّيعة في لبنان، على شيعة جنوب لبنان دون سواهم من مناطق الشّيعة الأخرى، ربما لأن أكثرية الشّيعة كانت تسكن هناك. وهذا ربما يكون عائدًا لشهرة ونبوغ علمائهم ولعددهم الكبير، ولأهمية آثارهم الفكرية والعلمية والدّينيّة التي خدمت المذهب الشّيعي على مر التّاريخ، وهذا ما سنلحظه في سياق البحث.
لذلك يعد جبل عامل رمزًا للتشيع والشّيعة في منطقة بلاد الشّام عمومًا، فهو يختزل تاريخهم، ويختزن معظم همومهم وتطلعاتهم. وفي زمن سابق كان مركزًا هامًا من مراكز التّعليم الدّيني عند الشّيعة. “يؤمه الطلاب من كل فوج وصوب. ولم ينقطع فيه مدد العلم ولا خبا نوره، إلا في حقب قصيرة كانت تعقب الحروب والفتن، التي يرافقها التدمير والخراب، وإقفال المدارس وتعطيل معاهد التدريس. وكانت هذه المدارس أشبه بالكليات منها بالمدارس العادية”[5].
ب التّعليم والمؤسسات التّعليمية عند الشّيعة تاريخيًّا
كيف بدأت مسيرة إنشاء المدارس ومؤسسات التّعليم عند الشّيعة في عصورهم الأولى، وكيف كانت أوضاعهم السياسيّة والاجتماعيّة خلالها؟
هذا ما سنتعرض له في هذا الفصل، ونظرًا للعلاقة الوثيقة التي ربطت بين شيعة لبنان والعراق وإيران، وهجرة اللبنانيين الشّيعة إلى الحوزات والمدارس الدّينيّة هناك، سنتطرق هنا لظروف إنشاء هذه الحوزات التي درس وتخرج منها طلاب العلوم الدّينيّة اللبنانيون، ليعودوا بعد فترة إلى بلادهم، وليؤسسوا بعد عودتهم حوزات مشابهة لها. فكيف كانت ظروف وأهداف نشأة هذه الحوزات وما هي أبرزها؟
منذ العصور الإسلامية الأولى سعى الشّيعة إلى تأسيس مؤسسات التّعليم الخاصة بهم، التي تهدف إلى تعليم أحاديث وعلوم الرسول(ص) وأهل بيته المعصومين(ع)، فهم وجدوا أن الكتاتيب كمؤسسات تعليم أولي لدى المسلمين لا تتناسب مع رؤيتهم وعقيدتهم ولا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة لتربية وتعليم أبنائهم، لأن هذه الكتاتيب لا تعلم فضائل الإمام علي(ع) إنما تعلم فضائل غيره كعثمان بن عفان ومعاوية، لهذا نصح الأئمة أتباعهم بتجنب هذه الأمكنة التي تغفل ذكر فضائل أهل البيت(ع)[6].
وكان تدريس علوم وفضائل أهل البيت(ع) يشكل خطرًا بالنسبة إلى بعض الحكام المسلمين، لأنه يشكك بشرعية سلطتهم. كما أنه لا يعترف من ناحية ثانية بالمذاهب الإسلامية الأخرى. وهذا ما يفسر أن أهل السّنة لم يكونوا ينظرون غالبًا بعين الرضا إلى علوم أهل البيت(ع) وتدريسها، وكانوا يتهمون الفقهاء الشّيعة بأنهم يُعلمون ما يسمونه بـ البدع. “ولم ينفرد السلطان بمضايقة الشّيعة، بل إن طائفة من علماء أهل السّنة أسهمت في تأييد إجراءات السلطان في هذا الصدد والإسهام فيها … وكان رد الفعل من جانب الأئمة والإمامية وأسلافهم معًا أن لجأوا إلى التستر وعدم البوح في الغالب بعلومهم أمام من يخالفهم في العقيدة وأمام من له صلة بالسلطان”[7]، وأنشأوا مؤسساتهم الخاصة والمستقلة حيث كان يجري التدريس في مراقد الأئمة والمساجد والكتاتيب والمنازل.
عمل كل من الأيوبيين والمماليك والعثمانيين على إنشاء المدارس في مصر والعراق لمحاصرة المذهب الشّيعي. “وكان من الطبيعي أن يجد الطلاب الشّيعة صعوبة في الانخراط بهذه المدارس، لعزوف علماء السنة عن تعليم علوم أهل البيت(ع). لذا كانت الحوزات العلمية ضرورة تربوية وفكرية من أجل الحفاظ على التراث الشّيعي العلمي والفقهي، ومن أجل إمداد أبنائه بالمقومات الفكرية والدّينيّة، الكفيلة لاستمراريتهم في مواجهة المدارس الفقهية الرسمية لدى السنة، والتي كانت ترعاها السلطات الموجودة آنذاك”[8].
الضغوط التي مورست على الشّيعة دفعتهم إلى التستر وإخفاء عقائدهم، ولجأوا إلى مقامات وأضرحة الأئمة(ع) وأقاموا فيها حلقات تدريس، لأن هذه المقامات تتصف بالقدسية، ولم يكن من السهولة الاعتداء عليهم داخلها، وإن كانت قد تعرضت في بعض المراحل لأعمال تخريب وهدم. يأتي مقام الإمام علي(ع) في النجف الأشرف في العراق كواحد من أوائل المقامات التي اتخذها الشّيعة كأماكن للتعليم والتدريس، إضافة إلى مرقد المعصومة (أخت الإمام علي الرضا(ع)) في مدينة قم الإيرانية.
كانت هذه المراقد تجذب إليها المعلمين والطلاب، ويستأنس الشّيعة بالسكن والتدريس بقربها، إضافة إلى كونها تضم مساجد، كل هذا ساعد على تحولها إلى مراكز للعلم والتّعليم، وأضحت أمكنة لإقامة وسكن العلماء، فأقاموا حلقات التدريس فيها، ثم تحولت مع الوقت إلى مدارس مستقلة قائمة بذاتها.
ويعد عهد الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق(عليهما السلام) من أكثر عهود أئمة الشّيعة التي انتشرت فيها علومهم وعقيدتهم وأفكارهم وآراؤهم، حيث كان عصرهما مؤاتيًا من الناحيتين السياسيّة والثقافية لتأسيس وإطلاق قواعد المذهب الشّيعي. ففي عصر الإمام الصادق(ع) انتقلت السلطة من الأمويين إلى العباسيين، وفيه تراجعت الرقابة على الشّيعة عمومًا، الأمر الذي أتاح لهم التحرك لنشر علومهم. فانتشرت خلاله معظم العلوم الإسلامية من فقه وحديث، كما ظهر خلاله أيضًا علم الكلام. استغل الإمام الصادق(ع) هذه الفرصة المتاحة لتركيز مبادئ المذهب، وللدفاع عنه أمام الفرق والتيارات الأخرى المخالفة. ومن المُسلّم به عند المسلمين بمختلف مذاهبهم، أن كبار أئمة المذاهب الإسلامية درس عند الإمام الصادق(ع)، كأبي حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي، ومالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي، وغيرهما الكثير من العلماء والفقهاء، وحتى في الميادين العلمية كالطب والفلك والحساب وغير ذلك.…. حتى ورد في بعض المصادر التّاريخيّة أنّ ما يقرب من تسعمائة محدثٍ وفقيه وعالم ومجتهد كان يحضر دروس الإمام الصادق(ع) في المدينة.
بلغ النشاط التّعليمي للشيعة ذروته في القرن الرابع للهجرة والنصف الأول من القرن الخامس، ولعل انشغال الخلفاء العباسيين وعلماء أهل السنة في المشكلات التي ظهرت مع ظهور المعتزلة، وضعف الخلفاء العباسيين في أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع للهجرة، كانا من العوامل المساعدة على تسهيل مهمة نشر المذهب الشّيعي وتعاليمه. كما أنّ قيام الدولة البويهية في العراق وإيران التي تبنّت المذهب الشّيعي، سهل الحركة، فعمل علماء الشّيعة كالشيخ الصدوق والمفيد والشريفين الرضي والمرتضي والشيخ الطوسي (الملقب بـ شيخ الطائفة) على تحقيق هذه المهمة، واستغلوا الحرية التي أتاحها ووفرها العهد البويهي للشيعة أحسن استغلال[9].
ج ـ ظروف إنشاء المدارس الدّينيّة (الحوزات)
أطلق الشّيعة على المدرسة التي تعنى بدراسة العلوم الدّينيّة عامة وعلم الفقه وأصوله خاصة تسمية “حوزة “. فصارت كلمة المدرسة أو الحوزة تستعملان كأنهما واحدة. “كلمة الحوزة مشتقة من فعل حاز، وحاز الشيء حيازة واحتيازًا، إذا ضمه وجمعه، أو إذا حصل عليه … فالحوزة إذًا بمفهومها اللغوي العام هي المكان المحدد،… وأصبح مصطلحًا للمدارس الدّينيّة”[10]. وتعني الحوزة العلمية كمصطلح، مركز التّعليم الدّيني الذي يتم فيه التدريس على شكل حلقات[11].
ظهرت المدرسة عند الشّيعة بمعناها المعروف في القرن الخامس الهجري في مدينة النجف في العراق على يدي الشيخ الطوسي، وهو أحد أبرز علماء الشّيعة الملقب بـ “شيخ الطائفة“.
شكّلت الحوزة كمدرسة دينية عند الشّيعة بديلًا عن المدارس الدّينيّة الإسلامية الأخرى التي كانت تُقام برعاية السلطات التي تتبع مذاهب أهل السنة، وتُخصص لها الأموال والأوقاف والأراضي، وكافة التسهيلات. ويأتي اهتمام الشّيعة بإنشاء مدارسهم الدّينيّة الخاصة منذ ذلك الوقت كجزء من مسعى لـ “الإبقاء على نشاط فكري وفقهي شيعي، يواجه محاولات الإقصاء والتهميش”[12]. لذلك كان لابد للشيعة من إيجاد بديل عن هذه المدارس، يكون بمثابة مرحلة متقدمة عن التّعليم السائد في الكتاتيب، وحلقات العلم في المساجد للصغار.
تمتّعت الحوزة عند الشّيعة منذ نشأتها باستقلاليتها، فهي منذ وُجدت كانت منفصلة إداريًا وتنظيميًا وماليًا عن إرادة السلطات والحكام و نفوذهم. فتمويلها يكون غالبًا من خلال الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والصدقات والنذورات والكفارات وغيرها. أما إدارتها فهي من صلاحيات مرجع التقليد عند الشّيعة الذي هو رأس الهرم فيها، ويشرف على إدارتها وتنظيمها بمعاونة مجموعة من طلابه.
د – مراحل الدّراسة في المدارس الدّينيّة (الحوزات)
تتوزع الدّراسة في معظم الحوزات الشّيعيّة على وجه العموم، على ثلاث مراحل أساسية، لا تزال معتمدة حتى اليوم، ولم يطرأ عليها أي تعديل، وهي:
أ ـ مرحلة المقدمات: في هذه المرحلة الأولى، تُدرّس العلوم التي تعتبر مقدمة للتخصص في الفقه، وهي تتضمن دراسة الفقه، والنحو، والصرف، وعلوم البلاغة، والمنطق، والفلسفة، وعلم الكلام.
ب ـ مرحلة السطوح: يُدرّس فيها علم أصول الفقه بمستوى من العرض والاستدلال، إضافة إلى علم الفقه، ومن ينتهي منها يطلق عليه لقب “حجة الإسلام والمسلمين“
ج ـ مرحلة البحث الخارج: سُميت هذه المرحلة بهذا الاسم، لأن الدرس يكون فيها دون الاعتماد على كتاب معين (أي خارج الكتاب). بل اعتمادًا على طريقة المحاضرة فقط.
في هذه المرحلة يتم تدريس أصول الفقه والفقه أيضًا، ولكن على مستوى الاستدلال فقط[13]. والطلاب الذين يتجاوزون هذه المرحلة (وهم عادة قليلو العدد) ينالون إجازة علمية من أستاذهم (الذي يكون عادة من مراجع التقليد عند الشّيعة) هي بمثابة شهادة تخرّج من الحوزة تخوّل الواحد منهم أن يفتي في الأمور الشرعية والفقهية، وأن يعمل برأيه الخاص في هذا المجال. حيث يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد ويطلق عليه لقب “مجتهد أو فقيه أو آية الله“، وهي مرتبة علمية تُطلق على من بلغ مرحلة من العلم والتعلم أصبح قادرًا معها على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية، وهي عند الشّيعة القرآن الكريم، وسنة النّبي(ص) والأئمة(ع). بينما المرجع الذي يقلده عامة الناس يطلق عليه لقب “آية الله العظمى“.
ه ـ أشهر المدارس الدّينيّة
أسس الشّيعة في العراق وإيران عددًا من المدارس أو الحوزات، نشير إلى أبرزها وهي:
1 ـ مدرسة (حوزة) النجف: كانت حوزة النجف ولمدة تصل إلى تسعة قرون ونصف تقريبًا أي حتى السبعينيات من القرن العشرين تعتبر أعرق الحوزات والمعاهد الدّينيّة عند الشّيعة ومركزًا للمرجعية ومصنعًا للفقه والفتاوى. فهي تقع قرب مقام الإمام علي(ع) وخرّجت عشرات الألوف من العلماء[14]. ولكن قيام نظام صدام حسين البائد في العراق، أدى إلى إفراغ هذه الحوزة من المراجع والعلماء وطلبة العلوم الدّينيّة، بعد أن قضى على عدد كبير منهم، ووضع البعض الآخر تحت الإقامة الجبرية، وأجبر آخرين على الهجرة والرحيل. فانتشروا في مختلف دول العالم، وكان لإيران وحوزة قم فيها النصيب الأوفر منهم، لا سيما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وسيطرة الشّيعة على الحكم فيها.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تعاظم دور حوزة قم، وأن تلعب دروًا مشابهًا للدور السابق لحوزة النجف على صعيد الدّراسة، فتحولت إلى مركز للمرجعية الدّينيّة عند الشّيعة، خصوصًا قبل رحيل الإمام الخميني(قده).
وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ نشأة مدرسة النجف، لكن معظم علماء ومؤرخي الشّيعة يرى أنها تأسست على يد الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ). ومنهم من يرجعها إلى الشيخ المفيد (أستاذ الشيخ الطوسي، توفى عام 431هـ)[15].
لكن الثابت أنّ الشيخ الطوسي هاجر من بغداد إلى النجف، إثر اعتداءات وفتنة طائفية أثارها المغول بعد دخولهم العراق واستيلائهم على بغداد (سنة 1258م) كان لها انعكاسات سيئة على أوضاع الشّيعة، ماأدى إلى اضطراب أوضاع الدارسة في حوزة النجف[16]، فتعرض منزل الشيخ الطوسي للتخريب، وأحرقت مكتبته. منذ ذلك الوقت شهدت النجف مراحل عدة كانت تزدهر فيها حينًا وتتراجع في أحيان أخرى، وبكل الأحوال لسنا هنا في معرض يتيح لنا التعرض لهذه المراحل والظروف والملابسات بالتفصيل.
إضافة إلى مدرسة النجف في العراق، أسس الشّيعة مدارس أخرى عديدة، شبيهة بمدرسة النجف إلى حد بعيد لناحية مراحل الدّراسة وطريقة التدريس. سنتعرض باختصار لمدرسة قم في إيران التي هي الأخرى صرحًا علميًا كبيرًا ولها شهرتها أيضًا.
2 ـ المدرسة الدّينيّة في مدينة قم :
شكّل الضغط الشديد الذي كان يلاقيه فقهاء الشّيعة وعلماؤهم وطلبة العلوم الدّينيّة من قبل العباسيين في العراق، سببًا رئيسيًا لانتقال معظم علماء وطلاب هذه المدرسة من العراق إلى إيران. وقد تأسست في الربع الأول من القرن الرابع للهجرة حتى النصف الأول من القرن الخامس[17]. وقد وجد علماء الشّيعة في بلدة قم مكانًا آمنًا يطمئنون فيه على حياتهم من القتل والتشرد. حيث وردت روايات عن بعض أئمة الشّيعة، تشير إلى أن مدينة قم وساكنيها سيكونان مستقبلًا بمأمن من البلايا[18]. “إلا أنّ هذه الحوزة عرفت فترات أوج وركود، ثم تجددت ونهضت بفضل مساعي الشيخ عبد الكريم الحائري (1276 ـ 1355 هـ) الذي اعتنى بالحوزة وطلابها عناية فائقة”[19]. وبرز في هذه المدرسة فقهاء ومحدثين كبار ولامعين، مثل الشيخ يعقوب الكليني، المتوفى 329هـ، صاحب كتاب “الكافي“ الذي يُعد أول محاولة من نوعها لجمع الحديث، وتبويبه، وتنظيم أبواب الفقه والأصول. كما يُعد أحد الكتب الأربعة المعتمدة لدى الشّيعة في مجال الحديث، وهي: “من لا يحضره الفقيه“، “ التهذيب“، “ الاستبصار“[20].
3 ـ مدرسة بغداد:
ظهرت مدرسة بغداد بعد النصف الأول من القرن الخامس للهجرة واستمرت حتى احتلال بغداد وسقوطها بيد المغول[21]، ويعود الفضل في نشأة هذه المدرسة إلى مدرسة قم في إيران، فبعد أن تكاملت مدرسة قم، استفادت مدرسة بغداد منها، وظهرت ملامح الاستقلال عليها، وتبلورت أصولها وقواعدها[22]. ومن أشهر علمائها أيضًا الشيخ الطوسي، الذي كان يحضر درسه ثلاثمائة مجتهد تقريبًا. ومن علمائها أيضًا أستاذه الشيخ المفيد[23].
تكمن أهمية هذه المدارس الدّينيّة أو الحوزات باعتبارها تشكل المنبع الأصيل للعلوم الإسلامية عند الشّيعة، وستكون برامجها ومناهجها وطريقة تنظيمها وأساليب تدريسها وآلية منح الدرجات العلمية فيها، القاعدة والأساس والمعوّل عليه لدى الحوزات التي ستنشأ في مناطق شيعية أخرى من العالم ومنها لبنان أيضًا.
ثانيًا: التّعليم عند الشّيعة في لبنان في العهد العثماني
بعد العرض التّاريخي للأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة للشيعة في لبنان، سنتعرف في هذا الفصل على التّعليم والمؤسسات التّعليمية خلال عهد العثمانيين.
أ ـ أبرز أمكنة التّعليم
أقام شيعة لبنان عدة مؤسسات كالمدارس والكتاتيب وبيوت العلماء، ونظموا عملية التّعليم عندهم وفق أشكال متنوعة، سنتوقف عند هذه الكتاتيب وبيوت العلماء أولًا، ثم نأتي للحديث عن أبرز المدارس والحوزات العلمية.
1ـ الكتاتيب
لم تحظَ الكتاتيب بالاهتمام الكافي من قبل المؤرخين، لأنها تعتبر بمثابة محطة أولية في التّعليم لا تختلف عما يتعلمه سائر المسلمين، فهي “لا تمثّل حالة خاصة بالشّيعة أو بجبل عامل. إذ ليس هناك خلاف في مناهج الكتاتيب الشّيعيّة مع مناهج المذاهب الأخرى من المسلمين. فالتّعليم في الكتّاب مختص بالقراءة والكتابة، ومنها قراءة القرآن الكريم وحفظه وكتابة آياته. وكذلك الأمر بالنسبة للغة العربية التي يتعلمها الصبي المسلم، وهي واحدة لا يشكل الاختلاف فيها اختلافًا دينيًا أو مذهبيًا. أما ما تفترق فيه المذاهب الإسلامية في التّعليم فهو ما يتصل بالعقائد والتّاريخ والتفاسير والفقه، وهذا ما لا يتعلمه الولد في الكتّاب، باستثناء ما يرد من ذكر فضائل رموز المسلمين، فيهتم الشّيعة بالنّبي(ص) والأئمة(ع)“[24]. ولكن رغم ذلك فإن الشّيعة في لبنان أنشأوا كتاتيب خاصة بهم، وابتعدوا عن الكتاتيب العامة التي تمولها وتنشئها السلطات القائمة[25].
تم إنشاء الكتاتيب لتعليم الصبيان مبادئ القراءة والكتابة وأوليات المعرفة العمومية، إضافة إلى حفظ بعض السور من القرآن الكريم. وكان شكل الكتّاب “في غالب الأحيان عبارة عن غرفة صغيرة في المسجد أو في بيت المعلم، حيث يتربع الطلاب على الحصير أو على جلود المواشي. وتمتد فترة الدّراسة من ثلاث إلى أربع سنوات، يُعلن بعدها تخرّج الطالب وختمه للقرآن”[26]. وكانت البساطة طابعًا مميزًا للكتاب فهو “يتألف عادة من غرفة وفسحة دار. وإنشاء الكتّاب لا يتطلب سوى الشيخ أو الشيخة على الأغلب، زادهما حفظ القرآن الكريم وإلمام بالخط. وتبدأ الدّراسة في سن الخامسة أو بعدها، ورفيق الطالب فيها لوح للكتابة وجزء من القرآن الكريم. يفتتح التلقين بالتهجئة وينتهي بالقراءة السريعة”[27].
ومن التقاليد التي كانت شائعة يومها أن يُقدم الصبي لشيخه مكافأة إذا حفظ بعض السور القرآنية، “ثم يختم الطالب بحفلة بهيجة يشترك فيها الشيخ والزملاء الطلاب، يرافقونه من دار الكتّاب إلى منزل والديه وسط الأناشيد الدّينيّة”[28].
ومن المشهور أنّ نمط التّعليم في الكتاتيب كان معتمدًا حتى نهاية العهد العثماني، ولم يبدأ تنظيمه فعليًا إلا بموجب نظام المعارف الذي صدر عام1869م، ورغم ذلك فإنّ الكتاتيب لم تندثر حتى فترة متأخرة نسبيًا عن هذا التّاريخ[29].
وكان للكتّاب أهمية بارزة في هذه المرحلة، فهو “لعب الدور الرئيس في محو الأمية يوم غابت المدارس النظامية، واستمر وجوده حتى منتصف القرن العشرين. والكتاتيب كافحت في العهد التركي حيث غلب الجهل وتراجعت المدرسة النورية لأسباب سياسيّة ومذهبية وغدت المعارف تقتبس من مصدر واحد هو الكتّاب”[30].
ليس ثمة معلومات حول أعداد هذه الكتاتيب وانتشارها، أو بالأحرى لم أعثر خلال البحث على معلومات تشير إلى أعداد هذه الكتاتيب وإلى كيفية انتشارها وتوزعها على القرى والمدن والأرياف. وفي هذا الإطار يقول السيّد محسن الأمين في كتابه (خطط جبل عامل) إنه “أنشئت في جبل عامل مدارس عصرية وكتاتيب، بعضها أهلية وبعضها على نفقة الحكومة”[31]. لكن السيّد الأمين يكتفي بهذا النص فقط كما ورد، ولا يشير إلى عدد هذه المدارس والكتاتيب. وإن كانت معظم القرى التي قطنها المسلمون في لبنان قد عرفت الكتاب كما هو شائع، كما هي حال ما كان يطلق عليه اسم “مدرسة تحت السنديانة” في القرى المسيحية. وكان في كل قرية أو عدة قرى صغيرة متجاورة كتّابٌ، حيث يقوم أحد كبار السن فيها بتعليم الأولاد في غرفة أو غرفتين، يعمل الأهالي على ترتيبها وتجهيزها بما تيسر من مستلزمات بسيطة. يكون للمعلّم مطلق الصلاحية في أمور تعليمهم وتربيتهم، فهو يقوم بأدوار متعددة، ويختزل أدوار الهيئتين التّعليمية والإدارية في أيامنا. وله وحده صلاحية وضع النظام المناسب وتنفيذه، وهو المدير والناظر والأستاذ والآمر الناهي. وثمّة من اشتهر بهذا النوع من التّعليم[32].
2 ـ بيوت المعلمين والعلماء
عرف الشّيعة إلى جانب التّعليم في الكتاتيب نوعًا آخر من التّعليم كان يجري في بيوت المعلمين ومنازل العلماء، حيث يُخصص المعلم في منزله إحدى الغرف ويتخذها مجلسًا للدرس والتدريس، يكون مخصصًا في الغالب للطلاب في مرحلة تعليمية متقدمة عن مرحلة الكتّاب.
وجرت العادة على أنه عندما يلمع أو يبرز اسم معلم ما، فإنه سرعان ما يجتمع حوله عدد من الطلبة، يقصدونه لتلقي أنواع محددة من العلم كالفقه واللغة وما شابه ذلك. وأحيانًا يتحول المنزل إلى مدرسة تقدم دورة كاملة من العلوم، ويكون ارتباطها بالمعلم مباشرةً وتبعًا لقدرته على الاستمرار في إلقاء الدروس على طلبته.
وقد استدعت الدّراسة في بيوت العلماء تخصيص أماكن محددة للدرس، “إذ كان إنشاء البيت يراعي وجود قاعة فسيحة، يستقبل فيها العالم زواره، ويلقي فيها درسه على طلابه، المحليين أو الوافدين من الخارج. وعدد الطلاب ينقص أو يزيد حسب شخصية الأستاذ وشهرته العلمية وإمكانياته المادية، إذ كان العالم يصرف على طلابه أمور معاشهم، مما يتوفر لديه من أموال الخمس والتبرعات والهبات، وكان أول من يبتدئ بالدّراسة في المنزل أبناء العلماء أنفسهم”[33].
ويعود اعتماد الشّيعة على هذا الشكل من التّعليم بالدرجة الأولى إلى الأوضاع السياسيّة والظروف المتوترة التي كانت تحيط بهم وبحركتهم. “والغالب أن العوامل السياسيّة كانت تمنع من الدّراسة بالصورة الظاهرة، فكان الأبناء يتلقون عن الآباء تحت طي الخفاء”[34]. إضافة إلى العوامل السياسيّة، فإن العامل الاقتصادي كان له دوره أيضًا، إذ لم يكن بمقدور الشّيعة في تلك العصور إقامة مدارس مستقلة وخاصة بهم. فكان الولد يتلقى تعليمه على يدي والده، أو أخيه الذي يكبره سنًا أو أحد أقاربه، وغالبًا ما كان طلاب آخرون يلتحقون بهذا الدرس في مرحلة لاحقة.
وعندما تتوفر مجموعة من الطلاب ويتلقون العلم على يدي أحد المعلّمين، فإنهم وعند انتهاء مرحلة معينة يتعلمون خلالها بعض المعارف والعلوم الدّينيّة الأولية، ينتقلون إلى مرحلة جديدة، فإما أن يستمروا مع المعلّم نفسه، أو يتولى أمر تدريسهم معلّم آخر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة في التدريس ترتبط ارتباطًا مباشرًا بشخصية المعلم، إذ يعد هو المنهج، فيدرّس طلابه ما يراه مناسبًا لهم ويكون متلائمًا مع إمكانياته من جهة وقدرات طلابه من جهة أخرى[35]. وليس ثمة معلومات وافية عن هذا النمط من التّعليم في لبنان، لجهة عدد المعلمين وأسمائهم.
ب ـ النهضة العلمية عند الشّيعة في لبنان وارتباطها بالهجرة إلى العراق وإيران
رغم كل ما مرّ على أبناء الطائفة الشّيعيّة في لبنان من ظروف قاسية، فقد شهد الشّيعة في هذه المنطقة ولفترات تاريخية طويلة إلى حد ما، نهضة علمية بارزة.
ارتبطت انطلاقة هذه النهضة العلمية ارتباطًا مباشرًا بحركة الهجرة التي قام بها رعيل من طلاب العلوم الدّينيّة باتجاه العراق وإيران لتلقي العلم، وإليهم يعود الفضل في حصول تلك النهضة بعد عودتهم وتحصيلهم للعلوم الدّينيّة. ومن المفيد أن نشير بلمحة سريعة إلى حركة الهجرة هذه، وآثارها العلمية وانعكاساتها على صعيد العلم والمعرفة، بين شيعة لبنان والعراق وإيران. فكيف ولماذا وفي أي ظروف تمت هذه الهجرة؟
أدت هجرة بعض الطلبة اللبنانيين نحو العراق وإيران لطلب العلم إلى بناء جسر صلة مع المدارس والحوزات والمراكز العلمية الشّيعيّة هناك. هذه الهجرة مثلّت مقدمة ضرورية، ونقلة نوعية كان لها أثر مهم في تاريخ الشّيعة اللبنانيين على أكثر من مستوى. إذ لولا هؤلاء العلماء واتصالهم بالمراكز العلمية في العراق، لما كان من الممكن أن تحصل نهضة علمية شيعية في ذلك الوقت.
فقد هاجر عدد كبير من أبناء جبل عامل إلى العراق طلبًا للعلم، بسبب ظروف التنكيل والاضطهاد الذي طال علماءه، لأسباب سياسيّة ومذهبية، بلغ عددهم نحو سبعين عالمًا في فترة واحدة[36]. كما هاجر علماء آخرون إلى إيران ولهم يعود الفضل في تشيّع إيران وفي تأسيس حوزة أصفهان.
حصلت هذه الهجرة إلى إيران بحثًا عن الطمأنينة وهربًا من الاضطهاد من جهة، وإلى العراق طلبًا للمعرفة من ينابيعها من جهة أخرى. تكثفت الهجرة إلى إيران بعد أن تبنّى الشاه إسماعيل الصفوي المذهب الشّيعي، واعتمده مذهبًا رسميًا للدولة، فوجد أنه لابد له من توفير عدد من علماء المذهب يُعلّمون الناس مبادئه وأحكامه. وكان وجود العلماء نادرًا في تلك الفترة هناك، لذلك استقدم الصفويون عددًا من كبار العلماء الشّيعة من لبنان والعراق.
من أشهر هؤلاء الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي (المعروف بالمحقق الكركي نسبة إلى بلدة الكرك البقاعية توفي عام 1535م) الذي فوض إليه (الشاه الصفوي طهماسب) منصب شيخ الإسلام في الدولة الصفوية، وهو منصب يوازي منصب المفتي في هذا العصر. وترأس مجلس العلماء فيها، وأسس الحوزة العلمية في أصفهان، وترك أكثر من أربعين كتابًا[37].
ومن العلماء اللبنانيين المشهورين الذين انتقلوا إلى إيران وعاشوا فيها، الشيخ بهاء الدّين العاملي، المشهور باسم الشيخ البهائي (1546 ـ 1622) وتولى أيضًا مشيخة الإسلام في عهد الشاه عباس في أصفهان، وكان فيلسوفًا وفقيهًا ورياضيًا ومهندسًا. ترك في إيران عددًا من المنجزات العلمية المذهلة من خلال استخدام الطاقة الحرارية[38]، ومن العلماء أيضًا الشيخ محمد بن الحسن الملقب بـ “الحر العاملي“ صاحب كتاب “أمل الآمل في علماء جبل عامل“ (توفي 1104هـ/ 1692م)، والشيخ حسين بن عبد الصمد (والد الشيخ البهائي توفي سنة 1576م).
والسؤال المطروح هو متى بدأت هذه الهجرة؟
حول بدايات الهجرة، يقال إن إسماعيل بن الحسين العودي الجزيني (توفي في العام 1184م)، هو أول رجل خرج من جبل عامل طلبًا للعلم في العراق[39]. وبعد ما يزيد على القرن ونصف، انتقل طومان بن أحمد المناري (نسبة إلى قرية المنارة التي تقع اليوم في فلسطين المحتلة توفي في العام 1327م)، إلى إيران فدرس في الحلة، وكان أول فقيه عاملي ينال رتبة الاجتهاد، ويفتتح حركة التدريس في جبل عامل[40]. وكان الشهيد الأول (محمد بن مكي الجزيني 1333 ـ 1384م)، الذي يُعد أبرز علماء جبل عامل، قد توجه أيضًا إلى العراق لطلب العلم، وتنقل بين الحلة وبغداد ودمشق ومكة والمدينة، وتردّد على العلماء والفقهاء من المذاهب المختلفة. وحاز على إجازات من كبار الفقهاء في ذلك العصر، وعاد إلى قريته جزين، ليبدأ نشاطًا فكريًا امتد إلى خارج بلدته، التي أنشأ فيها أول مدرسة علمية سنة 1370هـ، إثر غزو المغول لبغداد، وتخريب مدارسها وحرق مكتباتها[41]. “ولم تأت نهاية القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد، حتى كانت جزين قد غدت أول مركز علمي في جبل عامل، وذلك على يد ابنها الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني (ت 786هـ/ 1384م) أول فقيه عاملي كبير، إليه يعود الفضل في تأسيس الحركة العلمية المستقلة في وطنه”[42].
ج ـ دوافع إنشاء المدارس الدّينيّة تاريخيًا في لبنان
سعى الشّيعة في لبنان وغيره من الأقطار كما رأينا إلى إنشاء مدارسهم الخاصة التي تُعد تتمة لما يتعلّمه الصغار في الكتاتيب، وحلقة وصل مع التّعليم العالي الذي تؤمّنه الحوزات ومراكز التّعليم المتخصصة في العراق وإيران.
أما بالنّسبة للأسباب التي حدت بعلماء الشّيعة في لبنان في عهدي المماليك والعثمانيين، ودفعتهم إلى تأسيس مدارسهم الخاصة، فيمكن الوقوف على بعض هذه الأسباب ومنها:
1 ـ عودة عدد من العلماء والمجتهدين ممن تلقوا العلم في الحوزات في إيران والعراق، وبالتالي فقد أصبح بإمكانهم تأسيس مدارس صغيرة في مناطقهم بعد عودتهم إليها، تكون شبيهة بالحوزة الأم التي تلقوا علومهم فيها.
2 ـ حرص الشّيعة في جبل عامل على تأسيس مدارس خاصة بهم، خشية تأثر أبنائهم بأفكار وعقائد المذاهب الأخرى في المدارس المنسجمة مع السلطات القائمة التي يختلفون معها عقائديًا وفقهيًا من الناحية المذهبية.
3 ـ بعض التّحوّلات السياسيّة التي ألمت بالعالم الإسلامي، فعلى سبيل المثال فإن حوزة جزين التي أسسها الشهيد الأول ـ والتي تعتبر أول مدرسة شيعية أنشئت في جبل عامل (حوالي القرن الرابع عشر ميلادي)، ترافق إنشاؤها مع غزو المغول للعالم الإسلامي، وأصبح من الصعوبة بمكان تلقي العلم في حوزة النجف التي تعرضت للخراب والضعف، فكان لابد من التعويض بمدارس تكون خارج سيطرة الغزاة المغول. “وذلك وضع عبئًا ثقيلًا على معاهد العلم في جبل عامل. وقد نهضت هذه المدارس بالعبء وكانت على قدر المسؤولية. ففي أواخر القرن الرابع عشر نجد الشهيد الأول محمد بن مكي، بعد عودته من العراق، يجعل من جزين مركزًا لمدرسة عالية للفقه الإمامي”[43].
4 ـ بعض الأوضاع والظروف السياسيّة والاقتصادية والمعيشية، التي كانت تحول دون سفر بعض طلبة العلوم إلى إيران أو العراق، نظرًا لما في الهجرة من غربة عن الأهل، ومشقة ووحشة، مع وجود رغبة عارمة لدى هؤلاء الطلبة لتلقي العلم[44].
هذه أبرز الدوافع والأسباب التي مهدت لإنشاء الحوزات والمدارس الدّينيّة لدى الشّيعة في لبنان.
لدى دخول العثمانيين إلى بلاد الشام كان الركود العلمي يسيطر فيها، ومع العثمانيين استمر هذا الركود، إلا أن جبل عامل شكل حالة استثنائية، حيث كانت تنتشر فيه المدارس التي تخرّج منها العديد من العلماء والفقهاء. ففي الوقت الذي كان فيه الانحطاط السياسي والاجتماعي يخيمان على معظم أرجاء العالم الإسلامي ـ بعد انحسار النشاط العلمي والفكري نتيجة الغزوات المتتالية التي عرضت لها البلاد الإسلامية ـ كان جبل عامل في ذلك الوقت يُمثّل واحة علمية خصبة للفكر والعلم، ويشهد نهضة علمية.
د ـ أشهر المدارس الدّينيّة
يعد القرن الرابع عشر هجري، وتحديدًا سنة 1369م لحظة البداية في إنشاء المدارس الدّينيّة عند الشّيعة في لبنان. ويعود الفضل بذلك إلى الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني، الذي كان أول من افتتح مدرسة دينية في جبل عامل في الرابع عشر ميلادي، هي مدرسة جزين المشهورة في تاريخ الشّيعة. ومن خلال انطلاقة هذه الحوزة بدأت أولى علامات النهضة العلمية والفكرية عند الشّيعة في هذه المنطقة. حيث “يكاد يُجمع كل من تناول النهضة الفكرية في جبل عامل على أن الشهيد الأول هو المؤسس الفعلي للنهضة الفكرية”[45]. فله يعود الفضل في تأسيس أول وأشهر مدرسة في لبنان، هي مدرسة جزين التي سنتوقف عندها نظرًا لأهميتها وأهمية مؤسسها ولدورهما الريادي في هذا المقام.
1 ـ مدرسة جزين
تأسست هذه المدرسة سنة 1369م في بلدة جزين الجنوبية، وهي تعتبر أول مدرسة تعليمية شيعية أنشئت في جبل عامل، “حيث انتظم فيها التدريس بالمعنى المعروف، أنشأها العلامة السعيد شمس الدّين محمد بن مكي الجزيني العاملي، المعروف بالشهيد الأول (عاش بين 1320 ـ1382م) وهو من أشهر علماء الإمامية على الإطلاق وأوفرهم علمًا”[46]. فقد تخرّج من مدرسة جزين عدد من العلماء والفقهاء، ونشروا العلم، وأنشأوا المدارس في مختلف مناطق جبل عامل[47]. وكانت تمثل في ذلك الوقت “طليعة النشاط الثقافي والسياسي الشّيعي في جبل عامل”[48]. وأصبحت محطة ومقصدًا للطلاب والعلماء والمفكرين، وهي ارتبطت بشخصية مؤسسها، وأخذت دورها وأهميتها من موقعه وطاقته العلمية النادرة. أما بالنسبة لسيرة الشهيد ودراسته فهو ولد ونشأ في جزين، وأخذ دروسه الأولى عن أبيه، ثم ارتحل إلى الحلة في العراق وتتلمذ على يد العلامة الحلي، ولما عاد إلى وطنه أسس مدرسة جزين. ونالت هذه المدرسة شهرة واسعة في جبل عامل وخارجه، واستمرت في عطائها قرابة أربعة قرون إلى حين إخراج الشّيعة من جزين في العام 1757م، إثر الحروب التي دارت بينهم وبين سكان الشوف من الدروز “حيث استقدم هؤلاء فلاحين من المسيحيين إلى جزين، وتم إجلاء الشّيعة منها”[49].
نال الشهيد الثاني شهرة علمية واجتماعية لفتت نظر المؤيدين والمعادين له على السواء، وخصوصًا الحاسدين منهم، وعلى رأسهم ” ابن جماعة “(قاضي القضاة في الشام في ذلك الوقت)، الذي أفتى بهدر دم الشهيد، فسيق إلى حاكم دمشق “بيدمر“، (في عهد برقوق أول الأمراء المماليك الذين حكموا من سنة 784 حتى 922 هـ) فأمر باعتقاله لمدة سنة، وألصقت إليه تهمة الرفض وسب الصحابة، وهو ما نفاه في مجلس المحاكمة الصورية التي أجريت له، فأُعدم، وصُلب وأُحرقت جثته[50].
وأُطلق عليه لقب الشهيد الأول، لأنه أول عالم قتل في سبيل الدّين والعلم في جبل عامل، وتجدر الإشارة إلى أنه كان أول من أطلق نظرية ولاية الفقيه بين طلابه، ولكن الظروف لم تساعده على إطلاقها بصورة واضحة، هذه النظرية هي نفسها التي استند إليها الإمام الخميني(قده) في قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، بعد أن عمل على بلورتها وتأصيلها من الناحية الشرعية الإسلامية.
وتكفي الإشارة إلى أن كتاب “اللمعة الدمشقية” للشهيد الأول ـ الذي يعد من أبرز المؤلفات الفقهية لدى الشّيعة ـ قام الشهيد بتأليفه خلال فترة سبعة أيام فقط، أثناء اعتقاله في سجن القلعة في دمشق، كما يرى بعض المؤرخين ومنهم محمد جابر آل صفا في كتابه تاريخ جبل عامل[51]. لكن بالمقابل فالشيخ محمد مهدي الآصفي ـ الذي وضع لكتاب اللمعة مقدمة غنية بمعطياتها وطويلة بعدد صفحاتها 194 صفحة ـ لا يتبنى الرأي القائل بأن الشهيد قام بتأليف كتاب اللمعة في السجن، إنما قام بذلك في بيته حيث كان “يعيش في بيته مراقبًا من قبل السلطة، ولذلك كان يتكتم في الكتابة”[52].
هذا الكتاب وضعه الشهيد على شكل رسالة إلى حاكم خراسان “علي ين المؤيد” الذي وجه إليه دعوة للإقامة عنده، فاعتذر عن تلبية الدعوة، واستعاض عنها بتصنيف هذا الكتاب وإرساله إليه، وهو عبارة عن رسالة فقهية جمع فيها الشهيد بصورة ملخصة مختلف أبواب الفقه وموارد الابتلاء في ذلك العصر. ولهذا الكتاب مكانة رفيعة بين الكتب الفقهية الشّيعيّة، ولا يزال من الكتب الدراسية الأساسية المعتمدة في معظم الحوزات العلمية عند الشّيعة حتى اليوم[53].
إضافة إلى مدرسة أو حوزة جزين أنشأ الشّيعة عددًا آخر من المدارس، لا تختلف عن مدرسة جزين لناحية مراحل وطريقة التدريس وأيام العطل وغيرها من تقاليد الدّراسة الأخرى، أبرز هذه المدارس هي:
2 ـ مدرسة ميس الجبل
سُميت بهذا الاسم نسبة إلى بلدة ميس الجبل الواقعة في جنوب لبنان. بلغت هذه المدرسة درجة كبيرة من الأهمية. فهي وإن لم تكن بأهمية مدرسة جزين، إلا أنها تعتبر في المرتبة الثانية بعدها مباشرة. هذه المدرسة أسسها سنة 1526م الشيخ علي بن عبد العالي الميسي (1475 ـ 1535) المعروف والمشهور باسم المحقق الثاني أو المحقق الكركي، نسبةً إلى بلدة الكرك في البقاع التي انتقل إليها وأقام فيها مدة من الزمن، “وكانت مدرسته مثابة طلاب العلوم من أنحاء جبل عامل عمومًا، ورحلة فضلاء الشّيعة من العراق وإيران وشيعة سوريا. وقد بلغ عدد طلابها في ذلك العصر أربعمئة طالب”[54]. وكان الشهيد الثاني (زين الدّين الجبعي) ممن تلقى علومه في هذه المدرسة. واستمرت بعد وفاة الشيخ الميسي ردحًا من الزمن، حيث تخرج منها عدد كبير من علماء الشّيعة المشهورين أبرزهم الشيخ الحر العاملي والشيخ لطف الله الميسي الذي مات ودفن في أصفهان وله مسجد باسمه لا يزال قائمًا حتى اليوم وهو مشهور ببنائه الرائع[55].
3 ـ المدرسة النورية في بعلبك
وهي مدرسة نالت شهرة واسعة، تولى الشهيد الثاني زين الدّين الجبعي (1505 ـ 1559م) التدريس فيها بأمر من السلطان العثماني، ودرّس فيها الفقه على المذاهب الإسلامية الخمسة[56]، وهي أصبحت بعد أن توجه إليها سنة 935هـ “مركزًا علميًا كبيرًا يقصده الناس من الأنحاء المختلفة، ويأتيه العلماء من القريب والبعيد، وكان الشهيد مُشجعًا كبيرًا لهذه الحركة العلمية التي حدثت في بعلبك”[57]. وجذبت إليها العلماء والطلاب.
وهنا ينبغي التوقف قليلًا لنتعرف أكثر على سيرة الشهيد الثاني، نظرًا لدوره البارز في حركة العلم والتّعليم عند الشّيعة، فقد ألف من الكتب “ما يزيد على ستين كتابًا ورسالة أشهرها كتاب “الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية“ في مجلدين”[58] (وهو شرح لكتاب اللمعة الذي وضعه الشهيد الأول وقد مرّ ذكره).
ومن الكتب التي وضعها أيضًا كتاب “منية المريد في آداب المفيد والمستفيد” وهو من أبرز المؤلفات التوجيهية والإرشادية في ميدان التربية والتّعليم الإسلامي. تناول فيه فضل العلم والمتعلمين، وآداب المعلم والمتعلم، وآداب مجلس الدرس والمعلم والمتعلم. وتضمن أيضًا آداب المفتي والمستفتي، وشروط المناظرة وآدابها، وآداب الكتابة ومسائل تربوية أخرى مهمة.
وهو كان قد ارتحل في مقتبل عمره من بلدته جباع، إلى بلدة ميس بهدف التعلم والدّراسة على يد المحقق الميسي لمدة ثماني سنوات، ثم انتقل معه إلى بلدة الكرك البقاعية أيضًا، وتزوج ابنته بعد أن لمس منه نبوغًا وذكاءً لافتًا. وقام برحلات بين موطنه وبعلبك والشام والحجاز ومصر والأستانة[59] للاحتكاك بالعلماء وإقامة صِلات معهم. وسعى لتوضيح عقائد وآراء الشّيعة بهدوء وروية، وبعيدًا عن الضوضاء. واستطاع أن يحصل من الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية، على إذن بالتدريس في المدرسة النورية في بعلبك.هذه الرحلات سهّلت عليه الإلمام بفقه المذاهب الإسلامية، وأصبح يتمتع بثقافة إسلامية واسعة.
أما استشهاده، فجاء بعد أن بلغ من الشهرة ما أوغل صدر حاسديه من أصحاب النظرة المذهبية الضيقة، وخصوصًا بعد أن أسس مدرسة في بلدته جباع، فتخوفت السلطة منه ومن المكانة الرفيعة التي وصل إليها، “فوشاه الحاسدون إلى الوزير الأعظم (رستم باشا) مسندين إليه تهمة نشر التشيع في الأصقاع الشامية للانقلاب على الدولة العثمانية، فأرسل الوزير في طلبه”[60].
وكان قاضي صيدا “معروف الشامي“ قد استاء من الشهيد لأنه لم يستأذنه في الذهاب إلى الأستانة. ولم يحصل على إذن بالتدريس في مدرسة بعلبك كما درجت العادة في هذا المجال. فأرسل في طلبه، وكتب إلى السلطان العثماني بأنّه رجل مبدع خارج عن المذاهب الأربعة. فأرسل السلطان أحد رجاله لاصطحاب الشهيد، حتى يجمع بينه وبين علماء البلاد ليباحثوه، ويتثبتوا مما يشاع عنه، فيحكم حينها عليه. فلحق الرجل بالشهيد إلى مكة، وطلب منه القدوم إلى الأستانة، ولكن رجلًا آخر حذر الرسول من مغبة أن يصل الشهيد حيًا إلى السلطان، فأقدم الرسول على قتله[61]. وبذلك انتهت حياة الشهيد الثاني.
4 ـ مدرسة شقرا
أسسها العلامة السيّد أبو الحسن موسى بن حيدر الحسيني (المتوفى سنة 1780 م) في أواخر القرن الثاني عشر هجري، وكانت من أهم مدارس جبل عامل حيث بنى فيها السيد “ما يزيد على أربعين حجرة، وحفر في وسط دارها بئرًا يكفي ماؤه طلبتها،…. ووقف لها أرضًا، وزيتونًا…. وهي أول مدرسة لها أوقاف في جبل عامل”[62]. “وكان المعدل الوسطي لطلابها ثلاثمئة طالب يحضر درس رئيسها منهم نحو مائتي طالب، هم في الوقت نفسه أساتذة لمن دونهم من التلاميذ”[63].
5 ـ مدرسة الكوثرية
وهي قرية في جبل عامل أسس فيها الشيخ حسن قبيسي (توفي سنة 1843 م) بإيعاز من علماء الشّيعة في النجف الأشرف “أول مدرسة علمية في العهد العثماني، تُدرس فيها العلوم العربية والدّينيّة وآداب العربية. وكان الناس في ظمأ لارتشاف مناهل العلم بعد تلك الصدمة التي دهمت البلاد. فتهافت عليها الطلاب من كل حدب وصوب، وحفلت بالمشتغلين والمدرسين”[64]. ودامت هذه المدرسة حتى سنة 1258هـ، حيث توفي مؤسسها في هذه السنة، فانتهت المدرسة بوفاته، وانتقلت حركة التدريس إلى مدرسة جبع[65].
6 ـ مدرسة جبع
نسبة إلى بلدة جباع في جبل عامل، كان قد أسسها الشهيد الثاني بعد مدرسة جزين من الناحية الزمنية. لكن اللافت للنظر أن المعطيات التّاريخيّة لا تتحدث عن هذه المدرسة خلال زمن الشهيد الثاني، إنما تتحدث عنها في المرحلة الثانية، أي بعد أن أعيد تجديدها من قبل الشيخ عبد الله نعمة (ت 1885) الذي تعلم في مدرسة الكوثرية، ثم انتقل إلى حوزة النجف، وبعدها إلى إيران، ولما بلغ مرتبة الاجتهاد عاد إلى بلدته وافتتح مدرسة فيها. فانتقل إليها معظم طلاب مدرسة الكوثرية، وتخرج على يديه عدد من كبار العلماء. واستمرت هذه المدرسة أربعين عامًا، وأحدثت حركة علمية واسعة النطاق. ثم تراجع دورها، وأفل نجمها بعد وفاة مؤسسها سنة 1303هـ/ 1885م، فانتقلت حركة التدريس إلى بلدة حنويه، حيث اشتهرت فيها مدرسة حملت اسمها[66].
الخلاصة
شهدت الطائفة الشّيعيّة في لبنان تطورًا ملحوظًا في مؤسساتها التّعليمية منذ نشأتها وحتى مطلع القرن العشرين. لعبت المدارس الدّينيّة (الحوزات) دورًا محوريًا في نشر العلوم والمعارف، وكانت مصدرًا رئيسيًا لتعليم العلوم الدّينيّة واللغة العربية. على الرغم من التّحدّيات السياسيّة والاقتصادية التي واجهتها، تمكنت الطائفة الشّيعيّة من الحفاظ على هويتها وتعاليمها من خلال نظام تعليمي مستقل ومتميز.
لقد تأثرت مسيرة التّعليم الشّيعي بالتّحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة، حيث أُجبرت الطائفة الشّيعيّة على التكيف مع الظروف المحيطة بها. استمرت هذه المؤسسات في التطور والتأقلم مع الزمن، مع التركيز على تنمية المجتمع الشّيعي في لبنان. لعبت المدارس الدّينيّة دورًا مهمًا في نشر العلوم وتعزيز الهوية الدّينيّة. تأسست هذه المدارس في مناطق متعددة مثل جبل عامل والنجف وقم، وكانت مراكز هامة للعلماء والطلاب.
هاجر العديد من الطلاب الشّيعة من لبنان إلى العراق وإيران لتلقي العلوم الدّينيّة، وعادوا ليؤسسوا مدارس دينية مماثلة في وطنهم. هذا التبادل العلمي ساعد على نشر المعرفة والعلوم الدّينيّة وتعزيز الروابط بين الشّيعة في لبنان والعالم الإسلامي.
وشهد العهد العثماني تطورًا في المؤسسات التّعليمية عند الشّيعة في لبنان، مع إنشاء الكتاتيب وبيوت العلماء والمدارس. كانت هذه المؤسسات تعكس الاستقلال التّعليمي والثقافي للطائفة الشّيعيّة، وساهمت في بناء مجتمع علمي متكامل.
وقد واجهت الطائفة الشّيعيّة العديد من التّحدّيات، بما في ذلك الضغوط السياسيّة والاقتصادية. رغم ذلك، تمكنت من التكيف مع هذه التّحدّيات والحفاظ على نظامها التّعليمي المستقل. استخدمت الحوزات الدّينيّة وسائل متعددة للتغلب على العقبات، بما في ذلك التستر وتعليم العلوم في البيوت والمراقد المقدسة.
لقدت سلّطت هذه الدّراسة الضوء على الدور البارز للمدارس الدّينيّة في تعزيز الهوية الشّيعيّة والحفاظ على التعاليم الدّينيّة. كما تساهم في فهم أعمق لتاريخ التّعليم عند الشّيعة في لبنان وتطوره، مع تقديم معلومات دقيقة ومفصلة للباحثين والمختصين في مجال الدّراسات الإسلامية والتّاريخيّة حول دور التّعليم في الحفاظ على الهوية المذهبية والثقافية.
لائحة بالمصادر
- آل كاشف الغطاء، محمد حسين. (1982). أصل الشّيعة وأصولها (الطبعة 4). مؤسسة الأعلمي، بيروت.
- الشهرستاني. (1994). الملل والنحل (الطبعة 1). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
- المظفر، محمد حسين. (1985). تاريخ الشّيعة (الطبعة 1). دار الزهراء، بيروت.
- آل صفا، محمد جابر. تاريخ جبل عامل. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
- فياض، عبد الله. تاريخ التربية عند الإمامية. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
- خشيش، انتصار. (1987). الحوزات العلمية في جبل عامل، جباع وجزين. رسالة دبلوم غير منشورة، الجامعة اللبنانية، معهد العلوم الاجتماعيّة.
- الحوزة العلمية في فكر الإمام الخامنئي. (2002). سلسلة بحوث تخصصية، معهد الرسول الكرم العالي للشريعة والدّراسات الإسلامية، بيروت.
- الفضلي، عبد الهادي. (1994). تجربتي مع التّعليم الحوزوي. مجلة الجامعة الإسلامية، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، لندن.
- فضل الله، حسن نظام. (1999). التربية والتّعليم عند الشّيعة في جبل عامل. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت.
- هواري، زهير. (2003). جريدة السفير اللبنانية، 14 أغسطس.
- زيادة، نقولا. (1970). أبعاد القومية اللبنانية. جامعة الروح القدس، بيروت.
- العاملي، محمد بن جمال الدّين مكي. (1403هـ). اللمعة الدمشقية (الطبعة 2). دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- عتريسي، طلال. البعثات اليسوعية ومهمة إعداد النخبة السياسيّة في لبنان. جامعة القديس يوسف، بيروت.
- نصر الله، حسن. (1984). تاريخ بعلبك (الجزء الثاني). مؤسسة الوفاء، بيروت.
- الأمين، محسن. خطط جبل عامل. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
- الأمين، حسن. (2003). جبل عامل: السيف والقلم. دار الأمير، بيروت.
- درويش، علي. (1993). جبل عامل: الحياة السياسيّة والثقافية بين 1516 ـ 1697 (الطبعة 1). دار الهادي، بيروت.
- مروة، يوسف. (1994). دور علماء جبل عامل في بناء الفكر الفقهي والفلسفي والعلمي المعاصر. مجلة نور الإسلام، بيروت.
- المهاجر، جعفر. ستة فقهاء أبطال. دار الأضواء، بيروت.
[1]ـ محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشّيعة وأصولها، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط4، 1982، ص 58 ـ 59.
[2] ـ محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشّيعة وأصولها، المصدر السابق، ص 58 .
[3] ـ الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 131، عن هاشم عثمان، تاريخ الشّيعة في ساحل بلاد الشام الشمالي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 1994، ص17 .
[4]ـ محمد حسين المظفر، تاريخ الشّيعة، دار الزهراء، بيروت، ط 1/ 1985، ص 13 .
[5] ـ محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 231 ـ 232 .
[6] ـ راجع عبد الله فياض، تاريخ التربية عند الإمامية، المصدر السابق، ص 65 .
[7] ـ عبد الله فياض، تاريخ التربية عند الإمامية، المصدر السابق، ص 55
[8] ـ انتصار خشيش، الحوزات العلمية في جبل عامل، جباع وجزين، رسالة دبلوم غير منشورة، الجامعة اللبنانية، معهد العلوم الاجتماعيّة، 1987، ص 40
[9] ـ راجع عبد الله فياض، تاريخ التربية عند الإمامية، مصدر سابق، ص 150 ـ 151 .
[10] ـ الحوزة العلمية في فكر الإمام الخامنئي، سلسلة بحوث تخصصية، معهد الرسول الكرم العالي للشريعة والدّراسات الإسلامية، بيروت، الطبعة 1، 2002، ص 18 .
[11] ـ راجع عبد الهادي الفضلي، تجربتي مع التّعليم الحوزوي، مجلة الجامعة الإسلامية، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، لندن، العدد الأول، 1994، ص 194 .
[12] ـ حسن نظام فضل الله/ التربية والتّعليم عند الشّيعة في جبل عامل، رسالة ماجستير في التربية غير منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت، 1999، ص 39 .
[13] ـ راجع انتصار خشيش، الحوزات العلمية في جبل عامل، مصدر سابق، ص195 ـ 196 .
[14] ـ راجع زهير هواري، جريدة السفير اللبنانية، 14 ـ 8 ـ 2003 .
[15] ـ راجع انتصار خشيش، الحوزات العلمية في جبل عامل، مصدر سابق، ص 49 .
[16] ـ راجع نقولا زيادة، مقال حول المدرسة اللبنانية نشر في كتاب “أبعاد القومية اللبنانية”، جامعة الروح القدس ، بيروت 1970، ص 67 .
[17] ـ راجع محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1403هـ، ص 26 .
[18] ـ راجع محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، المصدر السابق، ص 42 ـ 43 .
[19] ـ الحوزة العلمية في فكر الإمام الخامنئي، سلسلة بحوث تخصصية، معهد الرسول الكرم العالي للشريعة والدّراسات الإسلامية، بيروت، الطبعة 1، 2002، ص 22 .
[20] ـ محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، المصدر السابق، ص 46 .
[21] ـ راجع محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، المصدر السابق، ص 26 .
[22] ـ راجع انتصار خشيش، الحوزات العلمية في جبل عامل، مصدر سابق، ص 61 .
[23] ـ راجع انتصار خشيش، الحوزات العلمية في جبل عامل، مصدر سابق، ص 52 .
[24] ـ حسن فضل الله، التربية والتّعليم عند الشّيعة في جبل عامل، مصدر سابق، ص 35 .
[25] ـ راجع حسن فضل الله، التربية والتّعليم عند الشّيعة في جبل عامل، مصدر سابق، ص 36 .
[26] ـ طلال عتريسي، البعثات اليسوعية ومهمة إعداد النخبة السّياسيّة في لبنان/ مصدر سابق، ص 52.
[27] ـ حسن نصر الله، تاريخ بعلبك، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط1، 1984، الجزء الثاني، ص 714 .
[28] ـ حسن نصر الله، تاريخ بعلبك، المصدر السابق، ص 714 .
[29] ـ راجع طلال عتريسي، البعثات اليسوعية، مصدر سابق، ص 52 .
[30] ـ حسن نصر الله، تاريخ بعلبك، المصدر السابق/ ص 714 .
[31] ـ محسن الأمين، خطط جبل عامل، مصدر سابق، ص 186 .
[32] ـ راجع حسن نصر الله، تاريخ بعلبك، مصدر سابق، ص 714 ـ 715 .
[33] ـ حسن فضل الله، التربية والتّعليم عند الشّيعة في جبل عامل، مصدر سابق، ص 36 .
[34] ـ محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 234 .
[35] ـ راجع حسن فضل الله، التربية والتّعليم عند الشّيعة في جبل عامل، مصدر سابق، ص 37 .
[36] ـ راجع محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 137 .
[37] ـ يوسف مروة، دور علماء جبل عامل في بناء الفكر الفقهي والفلسفي والعلمي المعاصر، مجلة نور الإسلام، بيروت، العددان 49 ـ 50، 1994، ص 20 .
[38] ـ يوسف مروة، دور علماء جبل عامل في بناء الفكر الفقهي والفلسفي والعلمي المعاصر، المصدر السابق، ص 20 ـ 21 .
[39] ـ راجع جعفر المهاجر، ستة فقهاء أبطال، مصدر سابق، ص 31 .
[40] ـ راجع جعفر المهاجر، ستة فقهاء أبطال، مصدر سابق، ص 232 .
[41] ـ راجع حسن فضل الله، التربية والتّعليم عند الشّيعة في جبل عامل، مصدر سابق، ص 23 .
[42] ـ جعفر المهاجر، ستة فقهاء أبطال، مصدر سابق، ص 233 .
[43] ـ نقولا زيادة، المدرسة اللبنانية، كتاب “أبعاد القومية اللبنانية”، مصدر سابق، ص 67 .
[44] ـ راجع انتصار خشيش، الحوزات العلمية في جبل عامل، مصدر سابق، ص 87 .
[45] ـ علي درويش، جبل عامل: الحياة السّياسيّة والثقافية بين 1516 ـ 1697/ دار الهادي/ طبعة 1/ بيروت 1993/ ص 126 .
[46] ـ محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 234 .
[47] ـ راجع محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 235 .
[48] ـ محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، ص 15 .
[49] ـ علي درويش، جبل عامل: الحياة السّياسيّة والثقافية بين 1516 ـ 1697، مصدر سابق، ص 128 .
[50] ـ راجع محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، ص 145 ـ 146 .
[51] ـ محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 235 .
[52] ـ محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، ص 102 .
[53] ـ محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، ص 101 و ص 176 .
[54] ـ محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 236 ـ 237 .
[55] ـ نقولا زيادة، المدرسة اللبنانية، كتاب “أبعاد القومية اللبنانية”، مصدر سابق، ص 68 .
[56] ـ راجع محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 237 ـ 238 .
[57] ـ محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، ص 137 .
[58] ـ يوسف مروة/ دور علماء جبل عامل في بناء الفكر الفقهي والفلسفي والعلمي المعاصر/مصدر سابق/ ص 21.
[59] ـ محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 237 ـ 238 .
[60] ـ محمد بن جمال الدّين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، ص 190 .
[61] ـ راجع محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 194 .
[62] ـ محسن الأمين، خطط جبل عامل، مصدر سابق، ص 183.
[63] ـ حسن الأمين، جبل عامل: السيف والقلم، دار الأمير، الطبعة 1، 2003، بيروت، ص 366 .
[64] ـ محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 241 .
[65] ـ راجع محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 242 .
[66] ـ راجع محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، ص 242 ـ 244 .
عدد الزوار:38




