مفاهيم الأدب ونظريّاته في شعريّة النّص عند العرب
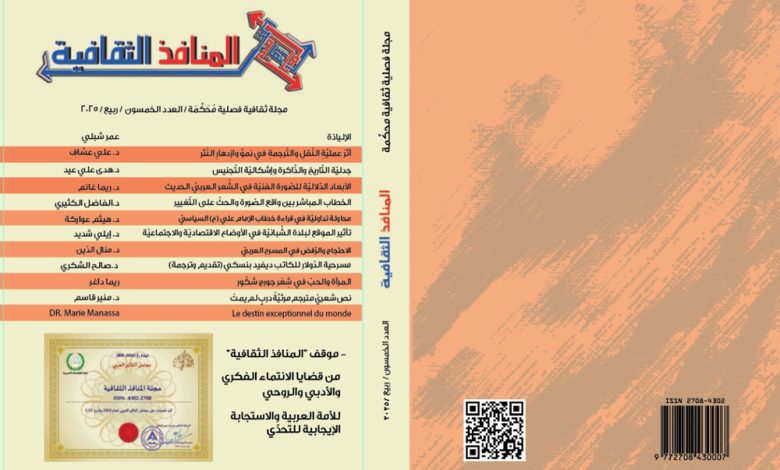
مفاهيم الأدب ونظريّاته في شعريّة النّص عند العرب
Literary conepts and theories in the poetics of the text among Arabs
عامر علي خريوش[1]
Amer Ali khreiwich
تاريخ الاستلام 28/11/2024 تاريخ القبول 19/12/2024
ملخص
لا شكَّ أنَّ لفظة “أدب” قد وردت في بعض كتُب التراث العربيّ، والحديث الشّريف، وكتاب نهج البلاغة، ومن ثمّ أخذ هذا المفهوم يتطوَّر مع ظهور الإسلام، وشمل المحامد، والمسلك الحسَن، والثّقافة والتّعليم. لكنَّه، وبشكلٍ عام، فإنّ مفهوم “الأدب” لا يزال في أذهان النّاس غامضًا ملتويًا، لم تبرز حدوده الواضحة التي تميِّزه عن غيره من الفنون والعلوم.
وقد تبيَّن من خلال هذا البحث، أنَّ سبب ذلك يعود إلى احتمال وروده في ما ضاع من نصوصٍ جاهليّة، وهي كثيرة، والاختلاف حول مصدره اللّغوي، وعلاقته بالمؤثِّرات الفنّية والنّفسيّة من جهة، والمؤثِّرات الخارجيَّة المحيطة به من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحيّة العرب، المفاهيم والنّظريَّات الأدبيَّة
Abstract
There is no doubt that the term “Adab” has appeared in some Arabic heritage books, the Hadith, and the book Nahj al-Balagha. Subsequently, this concept began to evolve with the emergence of Islam, encompassing virtues, good conduct, culture, and education. However, in general, the concept of “Adab” remains ambiguous and convoluted in people’s minds, its clear boundaries distinguishing it from other arts and sciences have not yet emerged.
It has been found through this research that the reason for this ambiguity may be due to its occurrence in lost pre-Islamic texts, which are numerous, the disagreement over its linguistic source, and its relation to artistic and psychological influences on one hand, and the surrounding external influences on the other hand.
Keywords: Arabs, Literary Concepts and Theories.
المقـدّمة
يهدف البحث إلى استعراض بعض النّظريات الأدبيّة التي راجت عند العرب، من خلال رصد الحركة التطوُّرية لمفهوم الأدب لدى العرب، وإثبات أهمّية تلك النّظريات القديمة التي أسّست للأدب، ووضعت له أصوله وقواعده، وكذلك النّظريات الحديثة التي تحاول التّأسيس لمفهوم أدبيّ جديد.
أما مادّة البحث، فقد شملت دراسة مفهوم الأدب عند العرب، تاريخًا واصطلاحًا وتطوُّرًا، ونظريّة الأدب في التّراث العربيّ من حيث تعريف الشّعر، ومصدره، وعلاقته بالفلسفة، والمنظوم والمنثور، ووظيفة الشّعر، وتناولنا مفاهيم حديثة، وأخيرًا علاقة الشّعر بالنثّر إنْ من حيث، الشّعر وأهمّيته، وإنْ من حيث الإيقاع، والنثّر قسيم الشّعر.
أولًا: مفهوم الأدب عند العرب
كثيرون هم الذين أدلوا بدلْوِهم في تحديد الأدب عند العرب، لكنّهم اختلفوا في المفهوم والمنهج، وعنهم قال طه حسين: “فلا تكاد ترى باحثًا محدّثًا عن الأدب العربيّ إلا عُني بكلمة “الأدب” ومعانيها المختلفة… حتى إذا فرغ من هذا عُني بتحديد المعنى الذي ينبغي أن نفهمه الآن من هذا اللّفظ، وهو في هذا التحديد يتكلّف؛ فإنْ كان من أنصار القديم سجّع وزاوج، وأسرف في السّجع والزّواج، وإنْ كان من أنصار الجديد تحذّق وتكلّف، ووضع لك جُملًا غريبة كأنه يحدّد أصلًا من أصول الفلسفة العليا، أو كأنه يستنزل وحيًا من السّماء”[2].
فما هو الأدب عند العرب “مفهومًا” و”مصطلحًا”؟ “تاريخًا” و”دلالة”؟
أ. المصطلح تاريخيًّا
يعتقد طه حسين أنّ مصطلح “أدب” لم يكن معروفًا في العصر الجاهليّ، أو عصر صدر الإسلام، ويرى أنّ الرّوايات والأحاديث التي وردت في هذا المجال ضعيفة وغير مؤكدة[3]. وأنّ هذا المصطلح لم يُعرف إلا في العصر الأمويّ حيث كانت كلمة “أدب” شائعة مستفيضة[4]. “ولعلَّ معظم النقّاد والدّارسين العرب، بعد طه حسين، قد تأثَّروا به، فزعموا الزّعم نفسه، وعمَّموا تلك المقولة دون أن يُصدِروا على ما يبدو، في آرائهم عن بحث وتنقيب في كلّ ما وصل إلينا من نصوص”[5].
وإذا عُدنا إلى آراء طه حسين، فإننا نرى أن عدم معرفته نصوصًا جاهلية وردت فيها لفظة “أدب”، لا يعني بالضَّرورة عدم اشتمالها على هذه اللّفظة، خصوصًا وأنّ هذه اللّفظة “أدب” وردت في بعض كتب التّراث العربي[6] والحديث الشّريف، وكتاب نهج البلاغة الذي نُسب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب، كقوله: “لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب”.
“ولعلّنا من باب توخِّي الدقّة والحذر، نقول بأنّه لا يمكن لهذه اللّفظة أن تأتي من فراغ، لذا نترك الباب مفتوحًا أمام احتمال ورودها في ما ضاع من نصوص جاهليّة، وهي كثيرة”[7].
ب. المصطلح: لغة ودلالة
أما المصدر اللّغوي لهذا المصطلح، فهو أمرٌ متنازعٌ عليه هو الآخر، ففي حين يرى البعض أنّ كلمة “أدب” كانت تعني “الدَّعوة إلى الولائم، يرى آخرون، وعلى رأسهم “تللينو” أنّ أصلها “داب” وجُمعت على أداب ومع الزمن أصبحت “الآداب”[8].
وبالعودة إلى لسان العرب، نجد أنّ من معاني الأدب ليس فقط الدَّعوة إلى الطَّعام وإنما الدَّعوة إلى المحامد والفضائل. وأما بالنّسبة إلى الرأي الثّاني، فهو احتمال واجتهاد شخصيّ، لا يمكن قبوله أو ردّه. مرجِّحين “الدّاب” هنا بمعنى الكدّ والتّعب” أو بمعنى “الاجتهاد”، كما ورد في لسان العرب[9].
ج. تطوُّر مفهوم الأدب
تطوُّر المفهوم مع ظهور الإسلام، وشمل المحامد والمسلك الحسن، والثّقافة والتّعليم وهذا ما تشير إليه الكثير من الرّوايات والأحاديث، كالحديث النبويّ: أدَّبني ربي فأحسن تأديبي”[10]. ويعمّم البعض معنى التّثقيف والتّعليم على كلمة أدَّب خلال عصر صدر الإسلام، مستندًا إلى جملة من أقوال الصَّحابة والخلفاء، منها قول ابن مسعود: “إنَّ هذا القرآن مأدبة الله في الأرض، فتعلَّموا من مأدبته، وإنْ كان هذا القول لا يؤدّي تمامًا معنى التّثقيف والتّعليم[11] الذي رمى إليه”.
وإذا كان هناك إجماع على شيوع كلمة “أدب” في العصر الأمويّ، فإنّ ذلك يعني أنَّ هذا المصطلح كان معروفًا من قبل وإنْ كنّا لا نستطيع تحديد زمن ظهوره، ولا الجزم بدلالاته الأولى.
وقد استُعمل المصطلح أيّام بني أميَّة “اسمًا” “أدب”، و”فعلًا” “أدب”، وغلب على استعماله “اسم الفاعل” “مؤدّب” وذلك لوجود مؤدّبين، كان الخلفاء وبعض الخاصَّة يوكلون إليهم تأديب أبنائهم.
وهؤلاء المؤدِّبون تفنَّنوا في أساليب البيان والمعاني، وعُرفوا “بأصحاب البيان”، فيما أُطلق على أولئك الذين عنوا بتعليم اللّغة وقواعد الصَّرف والنَّحو “أصحاب العلوم”.
ويبدو أن مصطلح “الأدب” راح بعد ذلك يتَّخذ منحىً تكسُّبيًا يُعتاش منه. ويُقال إنَّ أوّل مَن أُطلق عليه تسمية حرفة كان الخليل بن أحمد (ت ١٧٥هـ) حين قال: “حرفة الأدب آفة الأدباء”.
وهكذا تطوّرت دلالة مصطلح “الأدب” حتى شملت علوم اللّغة والبيان وكلّ أسلوب مُستحسن، فعُرف أدب الإسلام، وأدب الملوك، وأدب المجالسة وغيرها.
وفي العصر العباسيّ أُلحقت علوم اللّغة بالأدب، واتَّسع مفهومه ليشمل المعنى التّعليمي التّثقيفي، إضافة إلى المعنى الخُلقي التّهذيبي.
وفي القرن الثّالث الهجريّ استقلّت علوم اللّغة عن الأدب، واقتصر مصطلح “الأدب” على المأثور من الكلام شعرًا ونثرًا.
وقد استمرّ هذا المصطلح في التّنامي عندما برزت الكتابات النّقدية “كالبيان والتّبيين” للجاحظ، و”طبقات الشّعراء” لابن سلام، و”الشّعر والشّعراء” لابن قتيبة، و”الكامل للمبرّد”، و”أسرار البلاغة” و”دلائل الإعجاز” لعبد القاهر الجرجاني، وسوى ذلك من كتابات.
ولكنَّ علوم النّقد والبلاغة خرجت هي الأخرى من دائرة الأدب ليعود إلى الضّيق بعد السِّعة، مُقتصرًا على مأثور الكلام الفنّي شعرًا ونثرًا[12].
ثانيًا: نظريّة الأدب في التّراث العربيّ
بالعودة إلى الكتب التراثيّة يتبيَّن لنا أنَّ جهودًا قد بُذلت بهدف تأصيل الكثير من المفاهيم النظريّة في الأدب، وإنْ لم تستطع هذه الجهود أنْ تُنتج نظريّات متكاملة، وجلّ ما نجده هو ملاحظات وأقوال وآراء نظريّة هنا وهناك، وغالبيّتها يتمحور حول أنواع الأدب وأشكاله، أو حول علاقة الأدب بالمؤثّرات الخارجيّة المحيطة به[13].
ولعلَّ الجاحظ كان أوّل مَن وضع البِنية الأساسيّة في مدماك النّقد الأدبيّ، كآرائه المتعلّقة بالعوامل المؤثّرة في الشّعر، وفي اللّفظ والمعنى والتي قاربت مستوى النّظرية المستقلَّة.
وفي القرن الرّابع الهجريّ، حاول العرب تأصيل المفاهيم العامّة للشّعر، مُستخدمين في هذا السَّبيل منهجًا نقديًّا واضحًا. من هذه المفاهيم[14]:
أ. تعريف الشّعر
يبدو أن تعريف الشّعر قد تباين بين النقّاد الذين كانت ثقافتهم عربيّة خالصة، وبين أولئك الذين تأثّروا بالثّقافة اليونانيّة، وبكتاب “الشّعر” لأرسطو. بحيث أنَّه لو طلبنا تعريفًا للشّعر، قبل أن يكون قولًا مؤلّفًا ممّا يحاكي الأمر”[15].
وقد ذهب الفارابي أبعد من ذلك عندما قال بمحاكاة المحاكاة”، متأثّرًا بأفلاطون، ثمّ إنّ الشّعر لدى الفارابي صناعة تشبه الرّسم. ويبدو أنّ الفارابي استوعب نظريّة المحاكاة إلا أنّه لم يستطع توظيفها كما يجب[16].
أمَّا قدامة بن جعفر (۳۳۷هـ) فقد ألحّ في تعريفه للشّعر على أمرين:
الأوّل يتعلّق بتوفُّر العناصر اللازمة، وهي المعنى والوزن والقافية، وعرّف الشّعر بأنّه: “قولٌ موزونٌ مقفىً يدلُّ على معنى”[17].
أما الأمر الثّاني فيقوم على الصّناعة والذّوق الذي يقدّر على مدى جودة الشّعر أو رداءته.
أما ابن سينا، فالشّعر عنده “كلام مخيّل مؤلّف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفّاة”[18].
وأبو العلاء المعرّي في مفهومه للشّعر يعتمد الذّوق حكمًا ومقياسًا لجودة الشّعر أو لرداءته، مستعملًا مصطلح “الحسّ” تارة، ومصطلح “الغريزة” تارة أخرى، حيث يقول: “الشّعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط، إنْ زاد أو نقص به الحسّ”[19].
وابن طباطبا (۳۲۲هـ) يعرف الشّعر بقوله: “الشّعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله النّاس في مخاطباتهم بما خصّ به النّظم الذي إنْ عدل عن جهته مجّته الأسماع وفسد على الذّوق، ونظْمه معلوم محدود، ضمن صحّ طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظْم الشّعر بالعروض التي هي ميزانه، ومَن اضطّرب عليه الذّوق لم يستغنِ من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به”[20].
أما حازم القرطاجني (٦٠٨-٦٨٤) قد أفاد من كلّ السّابقين له في هذا المضمار، وأعطى عدة تعريفات للشّعر، ومن أهمّها قوله: الشّعر كلام موزون مقفّى، من شأنه أن يحبّب إلى النّفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمِل بذلك طلبه أو الهرب منه، بما يتضمّن من حُسن تخييل له، ومحاكاة مستقلّة بنفسها أو متصوّرة بحسن هيئة تأليف الكلام وقوّة صدقه”[21].
ولإبن رشيق (٤٤٠هـ) في الشّعر تعريف طريف، حيث يشبّه البيت الشّعري بالبيت من الأبنية: “قراره الطّبع، وسمكه الرّواية، ودعائمه العلم، وبابه الدَّربة، وساكنه المعنى، ولا خير في بيتٍ غير مسكون”[22].
ولعلّ ابن الأثير (٦٣٧هـ) قد انفرد باعتماد “النّاس” مقياسًا لجودة الشّعر أو رداءته، “فإذا شئت أنْ تعلَم مكانة شاعر (أو كاتب) فانظر إلى رأي النّاس فيه”[23] وهذا ما اصطُلح عليه حديثًا بـ”المتلقي”.
ب. مصدر الشّعر
اعتقد العرب كغيرهم من الأمم أنَّ الشّعر وحي وإلهام، وأنَّ هناك قوّة خارقة خفيّة تُلهم الشّعراء.
ولقد اعتقد العرب في جاهليّتهم أنّ وراء كلّ شاعر شيطانًا يُلهمه الشّعر. ويبدو أن هذا المعتقد استمرّ بعد ظهور الإسلام، كما جاء في “رسالة الغفران” للمعرّي في القرن الخامس الهجري.
إلا أنّ هذا المعتقد أخذ ينحسر شيئًا فشيئًا، حيث أصبح تعليل ظاهرة الشّعر يقوم على أُسس علميّة منطقيّة، حيث تُردُّ إلى أسبابها الطبيعيّة. فمنهم مَن يعيدها إلى الفِطرة، كما أنّ العامل الوراثيّ لا تنكَر أهميّته، فضلًا عن أنّ الشّعر صناعة يتدرَّب عليها الشّاعر النّاشئ.
وهكذا سنحت فكرة الوحي والإلهام، وساد الاقتناع بأنّ لغة العرب شاعريّة في أساسها، لما تتمتَّع به من أساليب الكناية، والاستعارة والغنى في المترادفات[24]…
ج. الفلسفة والشّعر
عالج النقّاد العرب علاقة الشّعر بالفلسفة، وتداخل الشّعر معها، ولا سيما في القرن الرّابع الهجريّ وما تلاه، وتأثَّر الشّعراء آنذاك بالفلسفة اليونانيّة، ما أدَّى إلى غزو الأفكار الفلسفيّة ميدان الشّعر والأدب. وقد أثار ذلك حفيظة بعض النقّاد الذين حملوا بشدّة على هذا النّهج الذي انتهجه بعض الشّعراء أمثال أبي تمَّام والمتنبّي وأبي العلاء المعرّي الذي عُرف “بفيلسوف الشّعراء”، ولقد كتب الكثير حول هذه المسألة، فوضعها البعض تحت باب السَّرقات الشّعرية، حين راحوا يقارنون بين ما جاء في بعض الشّعر العربيّ، وما جاء في فلسفة اليونان وخصوصًا فلسفة أفلاطون وأرسطو[25].
د. المنظوم والمنثور
اتَّخدت هذه المسألة حيّزًا واسعًا في النّقد الأدبيّ عند العرب، ولعلّ السبب في هذا يعود إلى شعور بالغبن أحسَّ به أصحاب النثّر، إزاء ما أصابه الشّعراء من شهرة وحظوة بين الشّعر والنثّر. ومن النقّاد الذين قاموا بهذا، إبن طيغور وأبو حيّان التّوحيدي ( – ۳۸۰هـ ) الذي فاضل بين هذين الشّكلين الأدبييّن، تبعًا لمدى تأثيرهما في النّفس ومدى ما يبعثانه من الطّرب[26].
فأبو إسحاق الصّابّي ( – ٣٨٤هـ ) يقول: فأفخر الترسُّل ما وضح معناه.. وأفخر الشّعر ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه لك”[27]…
أمّا أبو فاضل الحاتميّ فقد رفع “المنظوم” عن منزلة “المنثور” لمزاياه المتأتّية من التزام الوزن والقافية[28]. والمرزوقيّ (٤٢١هـ) فضَّل النثّر على الشّعر، لجملةٍ من الأسباب، لعلّ أهمها أنّ القرآن المعجِز جاء نثرًا وليس شعرًا. وأنّ العرب في جاهليّتهم فضَّلوا الخطابة وهي النثّر.
أمّا ابن رشيق (هـ ٤٤٠ )، آثر الشّعر على النثّر، معلّلًا نزول القرآن نثرًا، وهو ليس بشعر، ولا خطبة ولا ترسُّل[29].
أمّا بالنّسبة إلى مسألة الخطابة، فقد وازن النقّاد العرب في نظريّتهم الأدبيّة بينها وبين الشّعر، وكأنّها الوجه الآخر للأدب، دونما اعتبار إلى كونها لونًا من ألوان النثّر[30].
فالمبرّد (٢٨٦هـ) خلط بل ساوى بين الخطابة والترسُّل والشّعر. أمّا الفارابي (۳۳۹هـ) فقد فرَّق بين الشّعر والخطابة من حيث المحاكاة التي يقوم عليها الشّعر دون الخطابة، ويرى أنّ الخطبة صادقة والقول الشّعري تخييل وكذب[31].
أمّا حازم القرطاجني (٦٠٨-٦٨٤ هـ) فقد استخدم المصطلحات “الأقاويل الإقناعيّة” و”الأقاويل التخييلية”، ورأى أنّ الأقاويل الصّادقة تقع في الشّعر لكنّها لا يصحّ أنْ تقع في الخطابة لأنَّ الإقناع بعيد عن التّصديق، فهو مبنيٌّ على الظنّ الغالب، والظنّ منافٍ لليقين”[32].
هـ. وظيفة الشّعر
هذه المسألة شغلت حيّزًا مهمًّا لدى أفلاطون، الذي رأى في الشّعر سِحرًا وإمتاعًا من جهة، وإفسادًا للأخلاق وإضعافًا للنّفس من جهة أخرى. فيما رأى فيه أرسطو مطهِّرًا للعواطف والأحاسيس والانفعالات المكبوتة الزّائدة في دواخلنا[33].
أما النقّاد العرب فقد كانت لهم مواقف متباينة من هذا الأمر، فإبن وكيع مثلًا، في معرض تعليقه على الشّعر، المحدّث خصوصًا، يرى أنَّ الشّعر لا ينهض بوظيفة ثقافيّة، ولا يقدِّم فائدة علميّة، وإنَّما وظيفته تقتصر على العذوبة الفنّية الأسلوبيّة وعلى المتعة الطربيّة النفسيّة. وقد عني بعض النقّاد العرب بالجانب الطّربي من الشّعر كابن دحية الكلبي (٦٣٣هـ)، وإبن سعيد (٦٨٥هـ) الذي ذهب أبعد من الطّرب لدرجة أنَّ المتذوِّق قد يصل لحدّ الرّقص. وهذا ما فعله شعراء الأندلس، بدايةً بابن حزم وانتهاء بابن بسَّام، وكذلك فعل قدامة بن جعفر (۳۳۷هـ) من قبل حين دافع عن هذا التوجُّه في إطار تبنِّيه لمبدأ “الغلوّ” في الشّعر[34]، هذا وقد أخذت مسألة الصِّدق والكذب في الشّعر حيّزًا مهمًّا من جهود العرب النقديّة، لكنَّ ابن طباطبا تمسَّك بمبدأ الصِّدق بمعناه الحقيقيّ الماديّ، وكأنّه لم يعايش عصر الشّعراء المحدثين الذين انفتحوا على كلّ حضارة وعلى كلّ جديد.
مفهوم الصِّدق لدى ابن طباطبا هو صدق الذّات، وصدق المعاني، وصدق التّجربة والمعاناة، وصدق التّجربة الإنسانيّة عامّة، وهو صدق أخلاقيّ يتمثَّل في المديح والهجاء، وصدق تاريخيّ يتمثَّل في نقل خبر أو حكاية، وصدق تصويريّ يتمثَّل في صدق الصُّورة والتشبيه. وهذا يعطي شِعرًا جميلًا معتدلًا مؤثّرًا، ترتاح إليه النّفس ويقبله الفهم.
أمّا عبد القاهر الجرجاني، فيعالج هذه المسألة معالجة مختلفة ويعطيها مفهومًا متطوِّرًا ينمُّ عن فهم وعمق ونضج. ذلك أنَّ الصِّدق والكذب في الشّعر ليسا برأيه، صدقًا وكذبًا حسب المفهوم الأخلاقيّ عند النّاس العاديّين. أمّا ابن خلدون فإنّه يعيد هذا المفهوم” إلى التّعميم بعد التّخصيص، بل يتجاوزها إلى ما يتَّصل بهما من لغةٍ ونحوٍ وأخبارٍ وأيامٍ وأنسابٍ وما شاكلها. وأخذ عليه خلطه بين “الأدب” و”التأدُّب” و”العلم” و”الفن” وغير ذلك. ويقوم معيار الأدب عند ابن خلدون على معايير معيّنة، كالبيئة والظُّروف المحيطة، والصِّدق والبُعد عن التكلُّف، متأثّرًا بالجاحظ الذي اعتبر اللّفظ هو الأصل في النَّظم والنثّر[35].
ثالثًا: مفاهيم حديثة
ظلّ مفهوم الأدب يدور في فلك ابن خلدون حتّى بدايات النّهضة، حيث نجد آراء غالبيّة النقّاد لا تخرج عن هذا المجال، وهو ما نلاحظه مثلًا في كتاب روحيّ الخالديّ تاريخ علم الأدب، حيث يكرّر تقريبًا آراء ابن خلدون ومصطلحاته، بل وطريقة التّعبير أيضًا[36].
ويری محمّد مندور أنّ المفهوم التقليديّ للأدب عند العرب لم يتبلور قطّ في تجديد فلسفيّ لهذا اللّفظ، حتّى إذا ابتدأت نهضتنا المعاصرة… استقرَّ الرّأي على تعريفٍ سطحيّ ضيّق يقول: إنّ الأدب هو الشّعر والنثّر الفنيّ أي نثر الخطب والرّسائل والمقامات والأمثال السّائرة، ثم الأخذ من كلّ شيء بطرف… وهذا تعريف لا يحدّد للأدب أصولًا ولا أهدافًا. ولذا تتالت على الأدب تعريفات متنوّعة، تحدّد مصادره وأصوله وأهدافه ووظائفه، منها ما يرى أنّ الأدب “صياغة فنّية لتجربة بشريّة” أو “لتجربة شعوريّة”، وقد شاع هذا التّعريف لفظًا ومدلولًا عند دعاة التّجديد من أدباء النّهضة، فعنه يصدر المازني والعقَّاد عند نقدهما لشوقي وحافظ… كما نجد مدلوله الواضح في كتاب “الغربال” لميخائيل نعيمة.
بيد أنّ تلك التّجربة اتّخذت مفاهيم متفاوتة لدى أدبائنا تتراوح بين الذاتيّة والموضوعيّة، حتى رأينا “شاعرًا كبيرًا كخليل مطران لا يمنعه هذا الفهم الجديد لمعنى الأدب من أن ينحو في شِعره منحىً موضوعيًّا، منكرًا تجاربه الشخصيّة أو يسوقها في تضاعيف تجارب الغير من القدماء أو المعاصرين”. ومن الأدباء من يوسّع إطار تجربته لتشمل تجارب تاريخيّة وأسطوريّة وفلسفيّة، وهذا ما راح الكتَّاب يسعون إليه تشبُّهًا منهم بالآداب الغربيّة الرّاقية.
بيد أنَّ هذه التّجربة اتَّخذت لدى بعض الأدباء والشّعراء مدلولًا ضيّقًا، حين اعتبروا أنّه ينبغي للشّاعر أنْ يصدر عن تجربة شخصيّة، وإلا كان شعره كاذبًا. وبذلك حدَّدوا مقولة الصّدق والكذب في الأدب، مفسِّرين الصّدق بأنّه “ما كان صادرًا عن تجربة شخصيّة ومعاناة حقيقيّة وفسَّروا الكذب بالتصنُّع المفتعل”. حتّى أصبحت صفة الصّدق والكذب لدى البعض، شرطًا من شروط الأدب العالميّ الذي قوامه “معنى صادق في لفظ جميل، وعاطفة مشبوبة في بيان بليغ، ورأي صحيح يزيّنه الخيال الرّفيع”[37].
وقد شاع مفهوم جديد للأدب في العالم العربيّ، بل هو قديم متجدّد، عبّر عنه بمصطلح “المرآة”، حيث يشبّه الأدب بالمرآة. ويُعتبر أفلاطون أوّل مَن استخدم هذا المصطلح. ويبدو أنّ مجموعة من الأدباء قالوا بهذا المفهوم في العالم العربيّ إبّان عصر النّهضة، لعلَّ أوّلهم عائشة التيموريّة في كتابها “مرآة التأمُّل في الأمور”، والمويحلي في قصّته “مرآة العالم” وفي “المرآة”، ومحمّد روحي الخالديّ في كتابه “مرآة النّفوس” وطه حسين في “مرآة الإسلام”[38].
إضافة إلى البُعد الطّبيعي والإجتماعيّ لمرآة الأدب، تحدَّث البعض عن البُعد الأخلاقيّ حين فهموا الأدب على أنّه انعكاس للأخلاق، فنَجيب حدَّاد يقول: “الشّعر مرآة الأخلاق وتاريخ ما كانت عليه الأمم”[39].
إنّ العمل الأدبيّ كما يراه طه حسين هو تصوير وتمثيل وانعكاسُ الأصل ثابت، قد يكون فردًا أو مجتمعًا، وقد يكون داخليًّا أو خارجيًّا، وهذا العمل هو كالمرآة، لكنها مرآة تختلف عن مرايا الآخرين، لأنّها تقوم على الاتّصال تارة، وعلى الانفصال تارة أخرى، ففي الأولى تعكس لنا صلة ذلك الأدب بالخارج وبالمجتمع والآخر؛ وفي الثّانية تنفصل عن الجماعة وعن الخارج لتعكس لنا ذات الأديب الفرديّة فقط[40].
وهكذا فإذا كان الأدباء الكلاسيكيُّون العرب قد فهموا الأدب على أنّه مرآة تعكس الخارج، بما في ذلك المجتمع والعادات والتّقاليد والأخلاق، فإنَّ أدباء الاتّجاه التعبيريّ الرومانسيّ، فهموا هذا الأدب على أنّه انعكاس العالم الدّاخل، وما ينطوي عليه من أحاسيس ومشاعر وانفعالات، من فرح وحزن[41].
إلا أنّ مفهومهم للأدب الذي بقي محصورًا ضمن دائرة “المنظوم والمنثور”، فرَّق في هذا بين الأدب الإبداعيّ والدراسة الأدبيّة فقالوا بوجود أدبين: الأدب الإنشائيّ وهو “الأدب حقًّا” لأنّه مرآة لنفس صاحبه ولعصره وبيئته؛ وهناك تاريخ الأدب الذي هو أدب وصفيّ يتناول الأدب الإنشائيّ بالتّحليل والتّفسير والتّاريخ بطريقة تجمع بين العلم والذّوق[42]. كما أنهم نظروا إلى الأدب من زاوية مختلفة وعلى ضوء مناهج متعدِّدة، كالمنهج السياسيّ الذي يدرس الأدب على أساس التقلُّبات السّياسية التي طرأت عليه وتركت أثرها فيه، والوقائع تشهد بعدم صحّة ربط الأدب دائمًا بعجلة السّياسة. كالمنهج العلميّ الذي شاع في فرنسا إبّان القرن التّاسع عشر على مجموعة من النقّاد ومؤرّخي الآداب، وفي مقدّمتهم “هيبوليت تين” و”سانت بوف” و”برونتبير” وغيرهم. لكنّهم “لم يوفّقوا دائمًا لأنّ تاريخ الأدب لا يستطيع.. أن يكون موضوعيًّا” صرفًا… ولأنّ العلم شيء والأدب شيء آخر، ولأنّ العلم يحرمه الذّوق ويضطرّه إلى أن يكون عقيمًا”[43]. وهناك مَن دعا إلى الوصْل بين الأدب الخاصّ وبين الأدب بمعناه العام. إنّ هذه التّعريفات المتعدّدة المختلفة، تُظهر صعوبة الاتّفاق على مفهوم موحَّد واضح للأدب عند العرب، وهذا أمر طبيعيّ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأمم.
وهكذا فإنّ مفهوم الأدب لا يزال في أذهان النّاس غامضًا ملتويًا، لم تبرز حدوده الواضحة التي تميّزه عن غيره من الفنون والعلوم. لذا يرى البعض ضرورة الاتّفاق على معنى الأدب وأصول الشّعر قبل أن نمضي في الإنتاج الفنيّ، ونُمعن في النّهضة الأدبيّة[44].
واليوم عدنا مرّة أخرى إلى تعريف قديم متجدّد، حيث لا نعني بالأدب سوى المأثور من الكلام شِعرًا ونثرًا، دون أنْ نقطع الصّلة بينه وبين العلوم الإنسانيّة الأخرى، كعلوم اللّغة والتّاريخ والفلسفة وعلم النّفس وسواها[45].
رابعًا: بين الشّعر والنثّر:
درج النقّاد والدّارسون القدماء والمعاصرون على النّظر إلى النثّر على أنّه “اللاشعر” أو على أنّه “قسيم الشّعر”.
أ. الشّعر وأهمّيته
ومع ذلك فإنّ اهتمام النقّاد بالشّعر يفوق بكثير اهتمامهم بالنثّر، لما له من هالة عظيمة لدى الشُّعوب، فالتّراتيل القديمة وكل ما كان يلقى في المحافل إنّما كان في غالبيّته شِعرًا. أمّا القليل الذي كان سجعًا فلم يكن من نفحه الشّعر.
أما المنظّرون والنقّاد العرب، فقد تمحور تنظيرهم الأدبيّ حول الشّعر بشكل خاص.
وما قالوه في النثّر، كان جدّ يسير. فلِمَ هذه الهالة تعطى للشّعر؟ إذا كان الشّعر فنًّا، فهو إذن، واحد من الفنون التي تتميّز عن سائر النّشاطات الإنسانيّة، باعتبارها أرقى أنواع العلاقات الجماليّة والإبداعيّة في واقعنا. كما أنه يتميّز عن سائر الفنون بتميُّز أداته التي هي اللّغة، ولأنها أداة العلاقات الإنسانيّة برمّتها، وعلّة قيام المجتمعات وتفاهم الأقوام، لأنّها تختزن سياقًا تاريخيًّا اجتماعيًّا يرقى إلى بداية التكوين الإنسانيّ.
وأهمّ ما في القصيدة فنّيتها أو ما بات يطلق عليه النقّاد “شعريّته” و”شعريّة القصيدة أو فنّيتها في بُنيتها لا وظيفتها” كما يقول أدونيس الذي يحدّد شروطًا لهذه الشّعريّة، منها الجودة وترتيب معاني الكلم كما تحدّدها “نظريّة النّظم” للجرجاني، ومنها الغموض بدل الوضوح، والإبداع المتجاوز للعادي والمشترك الموروث[46].
ولهذه الشّعرية الآن تعريفات كثيرة، منها ما يراه جان كوهين، من أنَّ “الشّعرية علم موضوعه الشّعر”، ومنها ما يراه تودوروف، الذي يجعل من الشّعرية “بحثًا مستمرًّا عن كيفيّة تشكُّل المعنى في الظّواهر الأدبيّة” وهدفها “دراسة الأدبيّة” واكتشاف الأنساق الكامنة التي توجّه القارىء في العمليّة التي يتفهّم أدبيّة هذه النّصوص”. أمَّا “جنيت” فإنّه يدخل في نطاق الشّعرية: مجموع الخصائص العامّة، من بينها أصناف الخطابات وصِيغ التّعبير والأجناس الأدبيّة” و”الشّعرية” لدى كمال أبو ذيب هي “اكتناه العلاقات التي تتنامى بين مكوّنات النّص على الأصعدة الدلاليّة والتركيبيّة والصوتيّة والإيقاعيّة”. وهو يرى أنّه “لا يكون ثمّة كبير جدوى في تحديد الشّعرية على أساس الظّاهرة المفردة كالوزن أو القافية أو الإيقاع الداخليّ أو الصُّورة أو الرُّؤيا أو الانفعال أو الموقف الفكريّ أو العقائديّ”[47].
وهكذا يتّضح أنّ وضع تعريف جامع مانع للشّعر، ليس بالأمر اليسير، وربّما أولى العرب أكثر من غيرهم، اهتمامًا بالشّعر، فحظي عندهم بمنزلة عظيمة.. ولمّا كانت للشّعر كلّ تلك الهالة أقبل النقّاد: أدباء وفلاسفة وعلماء، على دراسته وتحديد ماهيّته، فإذا هو موهبة وخطرة، واكتساب وصنعة، ووزن وإيقاع وتقفية[48].
ب. الإيقاع
لقد استأثرت مسألة الإيقاع في الشّعر باهتمام النقّاد والدّارسين لدى جميع الأمم، وعلى مدى العصور، حيث عدّوا ذلك من العوامل المميّزة للشّعر عن النثّر.
وقد أجمع النقّاد على أنّ الإيقاع عنصر أساسيّ في الشّعر، فلا يعدُّ شِعرًا ما ليس موزونًا أو مقفَّى، حتى ولو تشابهت الأساليب بين الكلام المنثور والكلام المنظوم.
وقد رأى النقّاد العرب أنّ الوزن يساعد على تأكيد وحدة البيت الشّعري واستقلاليّته، ممّا يؤدّي إلى استقلاليّة دلاليّة، وخصوصًا في الأبيات الحكميّة وما شابهها.
كما أنّ لهذا الوزن الإيقاعيّ وظائف أخرى، عدا عن كونه يسهّل حفظ الشّعر ويحقّق ديمومته، ويتمثّل ذلك في التنغيم الغنائيّ الذي يبعثه الشّعر، وربّما كان هذا هو السَّبب في ميل الجمهور إلى تلقّي الشّعر عن طريق الإلقاء والإنشاد، ولهذا كان القدماء يعلّقون أهمّية على حُسن الإنشاد، فيميّزون بين الجيّد والرّديء منه.
ويغالي البعض في إبراز أهمّية الإيقاع الصّوتي في الشّعر، بحيث يعيد إليه وحده، دون المعنى، كلّ ما يحدث للنّفس. وهذا هو رأي بعض الفلاسفة النقّاد أمثال ابن رشد وابن سينا. ولهذا، ربّما، تقتضي بعض الأشعار لين الصّوت أو شدّته، خفضه أو رفعه تفخيمه أو تنغيمه بما يلائم المعنى، ومن هنا كانت قصائد تصلح للغناء دون غيرها من الشّعر[49].
ويرى النقّاد العرب أنّ الإيقاع هو إحدى الخصائص العامّة التي يتميّز بها الأدب، شعره ونثره، وكذلك سجعه الذي يرى فيه هؤلاء “نظمًا للكلام” وأساسًا لتشكُّل اللّغة الأدبيّة نفسها.
ويرى البعض بأنّ الأنواع النثّريّة أيضًا، تتميّز بالإيقاع، بحيث “يعوَّض إيقاع الوزن والقافية … بمكوّنات إيقاعيّة أخرى كالسَّجع والازدواج والتّكرار” لأنّ افتقار النثّر إلى مثل هذه الإيقاعات يقرّبه من الكلام العاديّ غير الأدبيّ.
وذهب آخرون أبعد من ذلك ونفوا عن النثّر أيّة فضيلة من الفضائل التي تتأتَّى للشّعر بفضل الإيقاع[50].
وقد بقي هذا المفهوم سائدًا حتّى القرن الثّامن الهجريّ، حيث نرى ابن خلدون لا يحيد كثيرًا عنه[51]. ثم استمرّ العنصر الإيقاعيّ هذا يقف حدًّا فاصلًا بين ما هو شعر وما هو نثر، بل حكما يحدّد شعريّة نص، ونثريّة آخر حتّى بدايات القرن العشرين. حيث نجد أنّ العقّاد مثلًا، رغم أنّه أحد أركان “جماعة الدّيوان” التي نادت بالتّجديد والتخلّي عن النّهج التقليديّ للقصيدة العربيّة، يحيل إلى النثّر كل ما ليس موزونًا أو مقفّى. وناهض الشّعر الحرّ معتبرًا إيّاه شكلًا من أشكال النثّر الفنيّ مهما انطوى عليه من خيال أو وجدان[52].
إلا أنّ هاجس الوزن والقافية، راح يخفّ وقعًا، مع تبدُّل مفهوم الشّعر في العصر الحديث، في العالمين العربيّ والغربيّ، لأنّ معيار الشّعرية قد تبدَّل ليقوم على الاختراع والإبداع، وليس الوزن والإيقاع[53].
ونذكر من أوائل الذين نادوا بالتخلّي عن القوافي والأوزان في عصر نهضتنا، أمين الرّيحاني الذي أشاد “بملتون” و”شكسبير” اللّذين “أطلقا الشّعر من قيود القافية”[54].
لقد أصبح أهل الشّعر ينظُرون إلى الشّعر على أنّه ذلك الشُّعور المشبوب المعبّر عن التّجربة[55]. فالشّعر هو الشُّعور، سواء أثار الشّاعر هذا الشّعور في تجربة ذاتيّة محضة كشف فيها عن جانب من جوانب النّفس، أو نفذ فيها إلى مسائل في الحياة والكون، شرط أن تتوافر له قوّة التّصوير والإيحاء والإبداع[56].
ج. النثّر قسيم الشّعر
النثّر في اللّغة هو من “نثر الشيء وينثره نثرًا ونثارًا رماه متفرّقًا”[57]. فالنثّر هو الوجه الآخر للشّعر أو هو “قسيم الشّعر” يسير بمحاذاته، وإنْ كان النقّاد القدامى يرجّحون أسبقيّة النثّر على الشّعر، ولذلك جعلوا “النثّر هو المعيار الذي لا تتحدّد شعريّة الشّعر إلا بما يخالفه، وجعلوا الشّعر في المقابل معيارًا يقود لإبراز أدبيّة النثّر لقيمه الخلافيّة”[58].
ورغم ذلك، فهم يميّزون بين الشّعر والنثّر على أساس أنّ الأول يمثّل الوجدان والثّاني يمثّل الفكر، وهذا هو المفهوم الشّائع في النّقد الحديث، والذي كان قد عبّر عنه نقّادنا القدامى حين اعتبروا أنّ الأدب الفنيّ لا يكون إلا شعرًا، أما النثّر فيدخل ضمن إطار الأدب الفكريّ، لذا قالوا بفنّية الشّعر وفكريَّة النثّر، معارضين الشّعر بالنثّر في كل شيء جاعلينهما نقيضين، وقالوا بشفويّة الشّعر وكتابيّة النثّر، وقدّموا الأول على الثّاني لتأخّر الكتابة عن المشافهة. والشّعر يعمل على إثارة الشّعور والأحاسيس، بينما الأعمال النثّريّة تهدف إلى إثارة الفكر، أما موقف الشّاعر فتجميعيّ تخييليّ، بينما موقف النّاثر تحليليّ. ثمّ إنّ لغة الشّعر هي لغة العاطفة، أمّا لغة النثّر فهي لغة العقل، وغاية النثّر نقل أفكار الكاتب وإيضاح القصد، لذا يعتمد الأسلوب التقريريّ التوضيحيّ.
وميّز النقّاد أيضًا بين النثّر الفنّي والنثّر العاديّ الذي يستعمل لغة الحياة اليوميّة[59]. ومهما يكن، فإنّ اختلاف لغة الشّعر عن لغة النثّر، أمرٌ متّفق عليه منذ القديم. أمّا اليوم فإنّ اختلاف اللّغة بين هذين بات هو الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الشّعر الحداثيّ. ويعتبر أصحاب الحداثة أنّ لغة شِعرهم ينبغي أن تكون بعيدة عن المألوف، وذات دلالات مختلفة عن دلالاتها المعجميّة المعروفة[60]. إلا أنّ كل ما سقناه من أوجه اختلاف بين الشّعر والنثّر لا يعني تناقضًا بينهما، بقدر ما هي مسألة تفاوت هذه الفنيّة، شكلًا ومضمونًا، فالشّعر والنثّر قالبان أدبيّان، والمسألة الجماليّة ليست مسألة شعر أو نثر بقدر ما هي “مسألة الرُّؤيا الفنيّة المجسّدة بأسلوب تشكيليّ إيحائيّ يجلو رؤية المحتوى وفنّية المضمون. وبقدر ما تتكاثف هذه الفنّية شكلًا ومحتوى في عمل أدبيّ، يقرّب العمل من دائرة الفنون الجميلة.. وبمقدار ما تتضاءل أنوارها وتخبو… يبتعد الأثر الأدبيّ عن محور الفنّ الجميل”[61].
ومن هنا يرى البعض أنّ خلوّ النثّر من الوزن والقافية، لا يحطّ من شأنه ومن فنّيته.
بيد أننا لا نستطيع أن ننكر على الشّعر تلك الميزة التي يتميّز بها، وهي ميزة الوزن والقافية والنّغم والإيقاع، فموسيقى الشّعر ممثّلة بأوزانه وقوافيه تضفي على الكلمات حياة جديدة، تصل إلى قلوبنا لمجرّد سماعها، ممّا يثير فينا الرّغبة في إنشاده أو الاستماع إليه. وربّما يقال بأنّ الشّعر الجيّد يُقاس بالرّعشة التي يمكن أن يثيرها في عمودنا الفقري أو بما يُعرف “بالهزة الكيانية” للشّعر[62]..
ممَّا لا شكّ فيه أنّ الجانب الصّوتي عامل مهمّ في البناء العام الذي يظهر بأشكال عديدة كالوزن والسّجع والقافية والإيقاع وغير ذلك. وعلى هذا الأساس الشكليّ الإيقاعيّ أضاف بعضهم شكلًا أدبيًّا ثالثًا بعد الشّعر والنثّر، هو السّجع، الذي عدُّوه شكلًا من أشكال الأدب مختلفًا عن الشّعر والنثّر[63].
وإذا كان شعراء الحداثة الشّعرية يشعرون بوطأة الأوزان الشّعريّة التقليديّة، ويقولون بإمكانيّة التحرُّر منها، لأنّها تحدّ من إمكانيّة الإبداع، ولأنّه بإمكان الشّعر الفنّي أنّ يستقي من منابع الموسيقى الداخليّة التي تشيع في القصيدة النثّرية، تقوم على الصّورة والرّمز والإيحاء، فهناك مَن يرى أنّ أوزان الشّعر العربيّ هي “أنغام فلكلوريّة شعبيّة في أساسها الأبعد.. وهي مرتبطة عضويًّا باللّغة التي جاءت فيها”. وأنّ الوزن الشّعريّ أصيل في أدب هذه اللّغة، ولا يزول إلا في الحالات الثوريّة النّادرة وفي فترات التّغيير الجدري الحاسم. ثمّ إنّ العيب ليس عيب الأسلاف الذين صبوا شعرهم في ستة عشر وزنًا. ولكنّ العيب عيب مَن أتى بعدهم فقدّسوا هذه الأوزان وفرضوها على أذواق النّاس، وأبوا أن يقولوا الشّعر إلا وفقًا لها، دون تعديل أو تبديل أو تطوير[64]. وبالتّالي فإنّه ينبغي أن ندع هذا الشّعر يتطوّر ويتغيّر بشكل طبيعيّ وفقًا لتطوّر الظّروف والعقول والأذواق. وإذا حدث ذلك، فلا ينبغي لنا أن ندين الأساليب القديمة… وهذا ما تحدَّث عنه بعض النقّاد الروس “ورومان جاكبسون” واللّغوي الفرنسي “أنطوان مليت” وغيرهم.
واستنادًا إلى ما قدَّمه هؤلاء، يقوم بعض علماء الوزن الموسيقيّ اليوم، بالتّفريق بين الشّعر الخطابيّ والشّعر الغنائيّ معتمدين على العلوم اللّسانية والدّلالية في دراسة الوزن والصّوت على أنّهما عنصران أساسيّان في أيّ عمل فنّي[65].
خـلاصة واستنتاج
يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
- اختلاف النقّاد والدّارسين حول مفهوم الأدب لغة واصطلاحًا.
- تطوُّر مفهوم الأدب عند العرب بعد ظهور الإسلام، وتحديدًا في العصر الأمويّ.
- استخدام العرب مناهج نقديّة واضحة في أثناء محاولاتهم تأصيل المفاهيم العامّة للشّعر.
- إنّ مفهوم الأدب لا يزال في أذهان النّاس غامضًا ملتويًا، لم تبرز حدوده الواضحة التي تميّزه عن غيره من الفنون والعلوم.
- درج النقّاد والدّارسون القدماء والمعاصرون على النّظر إلى النثّر على أنّه “اللاشعر” أو على أنه “قسيم الشّعر”.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، جمال الدين محمد، لسان العرب، م1 وم5، دار صادر، بیروت، لاط، لات.
- القالي، أبو علي، كتاب الأمالي، تقديم محمد عبد الجواد الأصمعي، دار كتب المصرية، مصر، لاط لات.
- عباس، إحسان، تاريخ النّقد الأدبيّ عند العرب، دار الشّروق، الأردن، ۱۹۹۳.
- المعري، أبو العلاء، رسالة الغفران، تحقيق وشرح عائشة عبد الرّحمن طه، دار المعارف بمصر، ١٩٦٩.
- ابن طباطبا، محمّد بن أحمد العلويّ، عيار الشّعر، تحقيق الحاجري وسلام، القاهرة، ١٩٥٦.
- طاليس، أرسطو، فن الشّعر، ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الثّقافة، بيروت، ط3، ۱۹۷۳.
- الحسن، ابن رشيق أبو علي، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، جزءان، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، ط، ۱۹۷۲.
- ابن الأثير، المثل السائرة، ج 4، لاط، لات.
- أدونيس، علي أحمد سعيد، زمن الشّعر، دار العودة، بيروت، ط ۲، ۱۹۷۸.
- المبرّد، الكامل في الأدب، ج1، لاط، لات.
- عصفور، جابر، مقال بعنوان: الأدب، مجلة الفكر العربي، عدد ٢٦ آذار ۱۹۸۲، بیروت، لبنان.
- جبر، جميل، الريحاني، أمين، الإنسان والكاتب، لاط لات.
- حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب مفاهيم وأنواع، دار المواسم للطّباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت لبنان، ط ١، ١٤٢٤ هجري – ٢٠٠٤ ميلادي.
- القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء، لام، لاط، لات.
- حسين، طه، في الأدب الجاهليّ، دار المعارف، مصر، ط ۱۲، لات.
- يحياوي، رشيد، شعريّة النّوع الأدبيّ، لاط لات.
- مجاهد، عبد الكريم، شعريّة الغموض، بيروت، لات.
- عتيق، عبد العزيز، في النّقد الأدبيّ الحديث، دار النّهضة العربيّة، بيروت، لاط، لات.
- بن جعفر، قدامة، نقد الشّعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لات.
- الفيصل، محمد روحي، في النّقد والأدب، منشورات اتحاد الكتّاب العربيّ، ١٩٨٤.
- هلال، محمد غنيمي، النّقد الأدبيّ الحديث، دار العودة، بيروت، ط۱، ۱۹۸۲.
- مندور، محمد، الأدب ومذاهبه، دار النّهضة القاهرة، مصر، لاط، لات.
- عاصي، ميشال، الفنّ والأدب، مؤسّسة نوفل، بیروت، ط3، ۱۹۸۰.
[1] طالب في المعهد العالي للدّكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، قسم اللّغة العربيّة وآدابها.
[2] حسين، طه، في الأدب الجاهلي، دار المعارف، مصر، ط۱۲، لات، ص ۲۲.
[3] م.ن، ص ۲۳.
[4] م.ن، ص 24.
[5] حمزة، مريم، الأدب بين الشرق والغرب مفاهیم وأنواع، دار المواسم للطّباعة والنّشر والتوزيع بيروت-لبنان، ط١، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٤، ص٥٧.
[6] القالي، أبو علي، كتاب الأمالي، تقديم محمَّد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصريَّة، مصر، ج ۲، لاط، لات، ص١٠٤.
[7] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م.س، ص ٥٨.
[8] حسين، طه، في الأدب الجاهلي، م.س، ص٢٣.
[9] حمزة، مريم، م.س، ص ٥٩.
[10] م.ن، ص ٦٠.
[11] ابن منظور، جمال الدين محمد، لسان العرب، م1، دار صادر، بیروت، لاط، لات، ص٢٠٦-٢٠٧.
[12] حمزة، مريم، الأدب بين الشرق والغرب، م.س، ص٥٩-٦٣.
[13] م.ن، ص ٦٣.
[14] م.ن، ص ٦٣-٦٥.
[15] عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبيّ عند العرب، دار الشروق، الأردن، ۱۹۹۳، ص204-205.
[16] م.ن، ص ۲۰۷.
[17] بن جعفر، قدامة، نقد الشّعر، تحقيق محمَّد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ص٦٤.
[18] طاليس، أرسطو، فن الشّعر، ترجمة وتحقيق عبد الرَّحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، ط۳، ۱۹۷۳، ص161.
[19] المعري، أبو العلاء، رسالة الغفران، تحقيق وشرح عائشة عبد الرَّحمن طه، دار المعارف بمصر، ١٩٦٩، ص٢٥١.
[20] ابن طباطباء، محمَّد بن أحمد العلوي، عيار الشّعار، تحقيق الحاجري وسلام، القاهرة، لاط، ١٩٥٦، ص١٥.
[21] القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء، لام، لاط، لات، ص٦٢-٧١.
[22] العمدة، ابن رشيق، في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، ج۱، دار الجيل للنشر والتوزيع والطّباعة، ط٤، ۱۹۷۲، ص۷۸.
[23] عباس، إحسان، تاريخ النّقد، م.س، ص٦٠٧.
[24] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م.س، ص۷۰-۷۱ و۷۲.
[25] م. ن، ص۷۲-۷۳.
[26] م.ن، ص ۷۳.
[27] ابن الأثير، المثل السَّائرة، ج4، لات، ص7.
[28] عباس، إحسان، تاريخ النّقد، م.س، ص۲۳۱.
[29] العمدة، ابن رشيق، ج1، م.س، ص5.
[30] المبرد، الكامل في الأدب، ج۱، لاط، لات، ص۱۷.
[31] عباس، إحسان، تاريخ النقد، م.س، ص۲۱۰.
[32] القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء، م.س، ص٦٢-٧١.
[33] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م.س، ص٧٦.
[34] – م.ن، ص٧٦-٧٧.
[35] م.ن، ص۷۸-۸۱.
[36] م.ن، ص ۸۲
[37] مندور، محمد، الأدب ومذاهبه، دار النّهضة، القاهرة، مصر، لاط، لات، ص۷-۱۸.
[38] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م.س، ص٨٤.
[39] عصفور، جابر، مقال بعنوان الأدب، مجلة الفكر العربيّ، عدد ٢٦، بيروت – لبنان، آذار ۱۹۸۲، ص١٤٦-١٥٥.
[40] م.ن، ص١٤٦-١٥٥.
[41] م.ن، ص١٥٧.
[42] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م س، ص٨٦.
[43] حسين، طه، في الأدب الجاهلي، م.س، ص43-51.
[44] الفيصل، محمد روحي، في النّقد والأدب: منشورات اتحاد الكتّاب العرب، ١٩٨٤، ص٨٩.
[45] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م.س، ص۸۹.
[46] أدونيس، علي أحمد سعيد، زمن الشّعر، دار العودة، بيروت، ط۲، ۱۹۷۸، ص٢٧٦-٢٨٤.
[47] مجاهد، عبد الكريم، شعريّة الغموض، بيروت، لاط، لات، ص٢٣-٣٤.
[48] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م.س، ص٩٣-٩٤.
[49] يحياوي، رشيد، شعريّة النّوع الأدبيّ، القاهرة، ١٩٨٤، ص١٣٤-١٣٦.
[50] م.ن، ص۹۷.
[51] عتيق، عبد العزيز، في النّقد الأدبي، م.س، ص١٦٥.
[52] حمزة، مريم، م.س، ص۹۸.
[53] م.ن، ص۹۸.
[54] جبر، جميل، الريحاني، أمين، الإنسان والكاتب، لاط، لات، ص۱۹۲-۱۹۳.
[55] هلال، محمد غنيمي، النّقد الأدبيّ الحديث، دار العودة، بيروت، ط۱، ۱۹۸۲، ص۳۸۰.
[56] حمزة، مريم، م.س، ص۹۹.
[57] ابن منظور، لسان العرب، م.س، ص۱۹۱.
[58] يحياوي، رشيد، شعريّة النوع، م.س، ص۱۱-۱۲.
[59] م.س.ن، ص۱۲.
[60] عتيق، عبد العزيز، النّقد الأدبيّ الحديث، م.س، ص١٦٧–١٦٨.
[61] عاصي، ميشال، الفن والأدب، مؤسَّسة نوفل، بيروت، ط۲۳، ۱۹۸۰، ص84-85.
[62] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م.س، ص۱۰۳.
[63] يحياوي، رشيد، شعريّة النّوع، م.س، ص۱۷.
[64] عتيق، عبد العزيز، في النّقد الأدبيّ الحديث، م.س، ص۱۷۲.
[65] حمزة، مريم، الأدب بين الشّرق والغرب، م.س، ص١٠٥.
عدد الزوار:1328



