“جدليّة التّاريخ والذّاكرة وإشكاليّة التّجنيس” في كتاب ” كما الإعصار” لجان عبدالله توما أنموذجًا
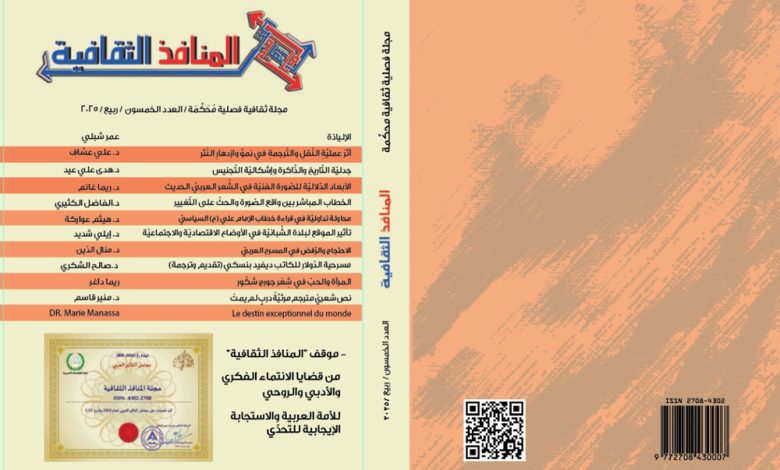
“جدليّة التّاريخ والذّاكرة وإشكاليّة التّجنيس”
في كتاب ” كما الإعصار” لجان عبدالله توما[1] أنموذجًا
“The dialectic of history and memory and the dilemma of gendering”
in the book “As a hurricane” by Jean Abdallah Touma as a sample
د.هدى علي عيد[2]
Dr. Houda Ali Eid
تاريخ الاستلام 2/9/ 2024 تاريخ القبول 20/9/2024
ملخّص
يسعى هذا البحث إلى تقصّي تجلّيات انصهار التّجربتين الحياتيّة والفنّيّة، في كتاب “كما الإعصار”[3] لجان عبدالله توما، وذلك انطلاقًا من تنوّع المادة النّفسيّة، الاجتماعيّة، والّلغويّة الّتي رفدت أحوال الأنا السّاردة في تأمّلاتها، وفي خطابها السّرديّ، وفي الشّكل الّذي اتّخذته مضامينها.
يتبنّى الكاتب في بعض نصوص كتابه، صِيغتي “المذكرات” و”اليوميّات”، جاعلًا منهما موضوعًا، وسبيلَ كشف تأمّلات الذّات، والتّعريف بعلاقاتها، وبرحلتها الوجوديّة ما بين الحياة والموت، انطلاقًا من المكان/ المَنبت (طرابلس/ الميناء -لبنان- وما يجاورهما)، مفيدًا من مقاربة النّصّ الأدبيّ المستند إلى ثنائيّة الدّاخل/الخارج، وذلك بوساطة نصّ مختلف الهويّة، والنّمط لكونه يمتَحُ من التّاريخ الشّخصيّ الحميم، إلّا أنّه يفرّ من الانغلاق على الذّات، في دعوته القارئَ الفرد، والقارئ/ الجماعة إلى مشاركته تجربته الذّاتيّة، بأبعادها الفنّيّة الإنسانيّة.
تتبلور الإشكاليّة في السّؤال عن هويّة هذا النّصّ/ النّصوص؟ وعن مدى إمكانيّة التّأسيس لأدبيّته انطلاقًا من آليّات اشتغاله، واحتكامًا إلى مرجعيّاته الفاعلة؟ أمّا المنهجُ المعتمد، في هذا البحث، فهو المنهج الاستقرائيّ التّحليليّ وقوامُه السّرديّة[4] البنيويّة السّيميائيّة.
كلمات مفتاحيّة: المذكّرات- اليوميّات- الأدبيّة – المرجعيّة- السّيميائيّة- التّأويليّة
Abstract
This research seeks to investigate the manifestations of the fusion of life and artistic experiences, in the book “As a Hurricane” by Jean Abdallah Touma, based on the diversity of psychological, social, and linguistic material that supplemented the conditions of the narrated ego in its reflections, narrative discourse, and the form taken by its contents.
In some of the texts in his book, the author adopts the forms of “memoirs” and “diaries,” transforming them into a subject, and a way to reveal the reflections of the self, introduce its relationships, and its existential journey between life and death. By selecting the place/source (Tripoli-Lebanon the port and its vicinity), as a starting point, the author benefits from the approach of the literary text relying on the duality of the inside and the outside through a text of different identity and style given that it emanates from his intimate personal history, yet escapes from closing in on the self. Thus, he asks both the individual reader and the collective reader to share their personal experiences with the human and artistic dimensions.
The problem arises in enquiring about the authorship of this text(s), and about the possibility of establishing its literature based on its work mechanisms and its effective references. As for the method adopted in this research, it is the inductive analytical approach and its basis is the semiotic structural narrative.
Keywords: Memoirs – diaries – literary – reference – semiotics – hermeneutics
المقدّمة والإشكاليّة
تنعكس مركزيّة الذّات في الكتابة الأدبيّة، على النّوع الأدبيّ الّذي تتخيّره وسيلةً للتّعبير عن هاجسها القوليّ، وعن تمثّلاته، ما يبرّر مشروعيّة السّؤال عن أهمّية الكتابات الذّاتيّة، وعن وضعيّتها في المنتج الثّقافيّ، لكونها قد باتت تشكّل حقلًا نظريًّا خصبًا، في المعرفة النّقديّة العربيّة والعالميّة، وصارت تحتلّ مركزًا نقديًّا لا يخفى على النّاقد المتتبّع، لا سيّما منذ أوائل سبعينيّات القرن الماضي.
وإذا كانت للكاتب الفرنسيّ جان جاك روسو[5]Jean-Jacques Rousseau الرّيادة في كتابة السّيرة الذّاتيّة، من خلال كتابه “الاعترافات” Les Confessionsمشرّعًا من بعده السّبل أمام آخرين، لكتابة النّوع، في أوروبا، والعالم، فإنّ من الإنصاف أن نستذكر بعض أسماء روّاد هذا النّوع من الكتابة الأدبيّة، في عالمنا العربيّ، برزت أعمالُ أصحابها في الثّلث الأوّل من القرن العشرين، وهم طه حسين في كتاب “الأيّام” (1929)، وتوفيق الحكيم في كتابه “يوميّات نائب في الأرياف” (1937)، أحمد أمين “حياتي” (1950)؛ لأنّ لكتابة السّيرة الذّاتيّة، لا سيّما العربيّة منها، أهمّيّة خاصّة لكونها تمثّل “حمّالةً للذّاكرة التّاريخيّة العربيّة خارج حدود التّاريخ الرّسميّ”[6]، فهي تتبدّى مرآة للوعي الفرديّ، في تفاعله مع معطيات عصره، ومع قضايا الهويّة والانتماء والوجود، في عالم كثير الاشتباك والتعقيد. لكن ما المقصود بمصطلح الهويّة؟
الهُويّة في الّلغة من هَوِيَ. اسم منسوب إلى هُو. وهُويّة الإنسان حقيقته المطلقة وصفاته الجوهريّة. هُويّةٌ: حقيقةٌ مطلقة في الأشياء والأحياء مشتملةٌ على الحقائق والصّفات الجوهريّة: “هُويّة النّفس الإنسانيّة، بطاقة الهُويّة (في الفلسفة) حقيقة الشّيء، أو الشّخص التي تميّزه عن غيره”[7]. (هُويّة: ما يجعل، من طبيعة شيء، نفسَ طبيعة الآخر).[8]“Identité: Ce qui fait q’une chose est de même nature q’une autre” ، وفي الاصطلاح: الهُويّة مصطلح يُستخدم لوصف مفهوم الشّخص وتعبيره عن فرديّته، وعلاقته مع الجماعات (كالهُويّة الوطنيّة أو الهويّة الثقافيّة). ويستخدم هذا المصطلح كثيرًا في علم الاجتماع، وفي علم النّفس[9]، وتلتفت إليه الأنظار بشكل كبير؛ يقول الفارابي: “هُويّة الشّيء، وعينيّته، وتشخّصُه وخصوصيّته، ووجوده المنفردُ له كلٌّ واحدٌ”[10].
ولكن ماذا عن مفهوم الهُويّة على صعيد الكتابة الذّاتيّة، بوصفها نوعًا أدبيًّا؟ وكيف يمكن تصنيف بعض نصوص كتاب ” كما الإعصار”، وتبيّن الهُويّة الأدبيّة التي تمثّلها؟ وما مدى أهمّية هذا النّوع من الكتابة، في علاقته بالمجتمع الّذي يشكّل أحد أبرز روافده؟ بل هل ينضوي ما كتبه توما في خانة “السّيرة الأدبيّة” الّتي روى فيها وقائع حياته، وأحداثها في خطّية زمنيّة متوالية، أم أنّه اتّخذ لمسروده أنواعًا أدبيّة أخرى تشترك مع الأولى، في عدد من الخصائص والسّمات، لا سيّما “المذكّرات”، واليوميّات؟ وتاليًا، ما الخصائص الّتي أمكن لنا تبيّنها، فشكّلت معيارًا في عمليّة التّصنيف؟
يسعى البحث للإجابة عن كلّ ما سبق، مع التّأكيد أنّ لكلّ كاتب سمات يتفرّد بها عن سواه، تمنحه امتياز الاختلاف في توليد طقسه، وفضاءه الأدبيّ.
في المنهج: المعلوم أنّ اتجاهات النّقد المعاصر قد انبثقت من نوعين رئيسين، من الرّؤية هما: النّقد الاجتماعيّ، والنّقد البنيويّ؛ وشكّل هذان النّوعان تيّارين كبيرين شملا كافّة الجهود النّقديّة، واتّفقا على الرّغم من افتراقهما، في بعض المسائل الجوهريّة، على عامل قوي يوحّد أفراد كلّ اتّجاه، ويحسم موقف هؤلاء “النّقّاد” ألا وهو الموقف من قضيّة الوعي، ومن علاقته بالوجود، والموقف من “الأدب” في علاقته بالواقع الاجتماعيّ، وذلك انطلاقًا من مقولة كارل ماركس[11]Karl Marx: “ليس وعي البشر هو الّذي يحدّد وجودهم، بل إنّ وجودهم الاجتماعيّ هو الّذي يحدّد وعيهم”[12].
وفي ضوء التّتبّع لهذا الوعي/ الموقف، وملاحقة تمثّلاته، برز الاشتغال في هذه الدّراسة، على تقصّي دلالة العنوان، حيث تمّت الاستفادة من إجراءات المنهج الاستقرائيّ التّحليليّ، وقوامُه السّرديّة البنيويّة السّيميائيّة الّتي أتاحت دراسته كعتبةٍ من عتبات النّصّ، اهتمّ بها علم السّيمياء اهتمامًا ملحوظًا، حاسبًا إيّاه علامة إجرائيّة ناجحة، في مقاربة النّصّ الرّوائيّ، وفي حسن استقرائه، لكونه أُولى الفواتحِ النّصيّة: “وعلامة سيميوطيقيّة*[13] تضمن أفق تفكيك النّصّ، وضبط انسجامه، فهو المحور الّذي يتوالد ويتنامى، ويعيد إنتاج نفسه”[14]، والكاتب الذّكيّ هو الّذي يتمكّن، من اجتذاب القارئ/ المتلقّي، إلى عالمه السّرديّ الواقعيّ أو التّخييليّ، من خلال الإضاءة الأولى الّتي يسلّطها على نصّه، أي من خلل العنوانِ المتخيَّر، لمنتجه الفنّيّ الجماليّ.
كذلك تمّ البحث في إشكاليّة العلاقة بين النّصّ والنّوع، عبر دراسة مفهوم السيّرة الذّاتيّة ومساراتها المعروفة، من خلال استقراء نماذج دالّة من نصوص “كما الإعصار” (سبع نصوص من اليوميّات/ سبع نصوص من المذكّرات)، أي البحث في مسألة التّجنيس وحدوده، بحسبانها إحدى القضايا الّتي تحظى باهتمام المنشغلين بعمليّة الإبداع الأدبيّ الّتي تتخطّى دائمًا منتجِها، لتدخل في علاقة مشتبكة، مع قارئ النّصّ وناقده. وهذا فعلٌ أتاح لنا تظهير حقيقة الانتماء الأجناسيّ، لبعض نصوص الكتاب، وتعالقها مع أجناس أدبيّة تماثلها، أو تتقاطع معها، ومع أخرى مفارقة لها.
دلالة العنوان
يؤدّي العنوان ببعده الدّلاليّ والإيحائيّ، دورًا مهمًّا في عمليّة تأويل النّص واختزاله، فهو يقوم بتعيّين طبيعة النّصّ الذي يَسمه، ويشكّل الإشارة الأولى الّتي تواجه المتلقّي لتكون أحيانًا مفتاحًا دلاليًّا يستطيع اختزال النّصّ.
يضعنا الكاتب الّلبنانيّ جان عبدالله توما، من خلال عنوان كتابه “كما الإعصار”، أمام تركيب بيانيّ تشبيهيّ يستحضر بوساطته، وطأة المرجعيّ/ الهاجس على وجدان الكاتب المتأمّل، في أحوال مجتمعه، وفي تفحّصِ أحوال حيوات أبنائه؛ فهذا التّركيب الّلغويّ المكثّف، والّذي اقتصر على شبه الجملة (الكاف حرف جرّ، وما المصدريّة + المبتدأ الإعصار الّذي حذف خبره وجملته الإسميّة = الإعصار… واقعة في محلّ جرّ بحرف الجرّ الكاف)، يجعل القارئ يتساءل عن ماهية هذا الأمر، أو هذا الشّيء الّذي يهزّ وجدان الشّاعر بحيث يتبدّى فعله قويًّا مزعزعًا، كما يزعزع الإعصار ما يمرّ به أو عليه، اتّكاء على المعنى التّعيينيّ لمفردة “إعصار = جمع أعاصر وأعاصير: ريحٌ تهبّ بشدّة وتثير الغبار، وترتفع كالعمود إلى السّماء”[15].
تتيح لنا القراءة التّحليليّة لعنوان كتاب توما “كما الإعصار” البحث، في دائرتين مشتبكتي العلاقة هما: عنوان النّصّ ومتن النّصّ، فالعنوان: “يثير لدى القارئ توقّعات قويّة حول ما يمكن أن يكوّنه موضوع الخطاب الّذي يتحكّم في تأويل المتلقّي”[16]، وقراءة نصوص الكتاب تجعلنا ننحاز إلى الفعل التّشبيهيّ المتبنّى، من كاتبه، لما تنّضح به هذه النّصوص من مشاعر حبّ واعتزاز، وتجذّر في المكان، ومشاعر فيّاضة تؤزّ وجدان الكاتب، وتجعله يُعنى بحفظ ذاكرة المكان، وناسه. وهو يهجس بذلك، ويعبأ بتفاصيله وبتحوّلاته المباغتة القاسية الّتي تكاد تشبه الإعصار الذي يغيّر معالمَ الأمكنة، في سرعة قياسيّة أحيانًا، فيقلق الذّات بما يحدثه من تحوّل قد يصل إلى حالة الدّمار.
وإنّ العنوان/العتبة النّصيّة يؤكّد على أهمّيّة توظيفه، من حيث هو- العنوان- مؤشّر “تعريفيّ وتحديديّ، ينقذ النّصّ من الغُفلة، لكونه يشكّل الحدّ الفاصل بين العدم والوجود، بين الفناء والامتلاء؛ فأن يمتلك النّصّ عنوانًا، هو أن يحوز كينونة، والاسم/ العنوان، في هذه الحال هو علامة هذه الكينونة”[17].
تعريف مصطلح السّيرة الذّاتيّة ومساراتها: هل يشكّل حضور ضمير المتكلّم مفردًا وجماعة، واستعادة صاحبه الكثير من الأحداث الّتي عاينها، أو عايش أصحابها مبرَّرًا لإدراج كتاب ما، ككتاب “كما الإعصار”، في خانة كتابة “سيرة الذّات”؟
يبرز الكتاب، منذ صفحاته الأولى، منتجًا أدبيًّا ملتبس الهُويّة لناحية المضامين الّتي يعالجها، والأشكال الّتي تتّخذها تلك المضامين، ومن حيث الضّمائر الّتي يتمّ إسناد السّرد إليها، ما يستدعي التّمييز بداءة، ما بين السّيرة الذّاتيّة، وبين أنواع أدبيّة أخرى تشترك وإيّاها، في عدد من الخصائص، وأبرز هذه الأنواع اليوميّات والمذكّرات.
مفردة السّيرة مأخوذة لغويًّا من المادّة سَيَرَ؛ وورد في تاج العروس للزّبيدي: “السّيِرة بالكسر السُّنّة والطّريقة، يقال سار الوالي في رعيّته سيرة حسنة”[18]، وفي لسان العرب لابن منظور: “السّيرة الطّريقة، يقال: سار بهم سيرة حسنة، وسيّر سيرة حدّث أحاديث الأوائل”[19]، وفي المعجم الوسيط: “سيّر سيرة: حدّث أحاديث الأوائل”[20].
يتطابق هذا المعنى الاصطلاحيّ مع تعريفي لسان العرب، والمعجم الوسيط للمفردة، ففي هذا الأخير تقترن السّيرة بنقل أحاديث الأوّلين، ما يتوافق مع تعريف فيليب لوجون[21] Philippe Lejeuneللسّيرة الذّاتيّة Autobiographie بحسبانها: “حكيًا استعاديًّا نثريًّا يقوم به شخصٌ واقعيّ، عن وجوده الخاصّ، عند التّركيز على حياته الفرديّة، وتاريخ شخصيّته”[22]، مفترضًا توافر عناصر فيها، تنتمي إلى أربعة أصناف، وهي: الموضوع المتعلّق بتاريخ شخصيّة لها حياة خاصّة، وشكل اللّغة القائم على النّثر المترسّل، ووضعيّة السّارد عند قيامه بالحكي الاستعادي، ووضعيّة المؤلّف الّذي يحيل اسمه على شخصيّة واقعيّة، إلى حدّ التّطابق بينهما.
وصِفة الاستعادة تقنيّة من تقنيّات السّرد، وطريقة من طرائقه، في التّعامل مع مفصل الزّمن ومساراته، بدءًا من الماضي، وانتهاء باللّحظة الآنيّة الّتي تعدّ والحال هذه، محطّة البدء الأولى.
فالسّيرة الذّاتية: “طريقة لتوثيق الصّلة بالحاضر، ووسيلة دائمة لوضع العالم والإنسان موضع التّساؤل[23]“، حيث تتيح إبراز علاقة المبدع بمحيطه المنتمي إليه، والّذي يتميّز بخصوصيّته الواقعيّة، فيغدو النّصّ السّيريّ في حال صياغته، مركز التّبئير الذي يستعيد شتات الأنا الّتي توزّعتها أحداث الحياة وأمكنتها، وتتمثّل المادّة الأوّليّة للسّيرة الذّاتيّة في سرد وقائع حياة شخصٍ ما، يصف ويروي من منظوره بواقعيّة وأمانة، ملتزمًا الحقائق التّاريخيّة بلغة سهلة بسيطة، توظّف العاميّة أو مفردات أجنبيّة عند الاقتضاء، ملتزمة قِصر العبارة، والابتعاد عن الزخرفة والتّعقيد، وقد تجنح إلى الشّعريّة أحيانًا وفق المقتضى.
على أنّ التزام السّيرة بالحقائق الواقعيّة يقرّبها من التّأريخ، أمّا بناؤها على التّخييليّ فيفسح المجال للحديث عن أدبيّتها؛ ويميّز النّاقد عبد المجيد زراقط بين السّيرة/ التّرجمة أي كتابة قصّة حياة شخص ما “تكون ترجمة تاريخ الحياة الموجز للفرد”[24]، في كونها تقترب من التّاريخ إلى درجة استحالتها تاريخًا في بعض الأحيان، وبين السّيرة- القصّة، وفيها تؤَدّى المادّة التّاريخيّة من منظور الرّاوي، في بناء متخيّل ينطق برؤية صاحبه، فتكون أدبًًا أو تأمّلًا في الواقع، وهذه السّيرة الأدبيّة أي السّيرة المتّخذة “ترجمة الحياة مادّة أوليّة لإقامة بنائها القصّصيّ النّاطق برؤية صاحبها، تكون إمّا سيرة شعبيّة مثل “سيرة بني هلال” و”سيرة عنترة”…، أو سيرة ذاتيّة مثل “الأيّام لطه حسين… وسيرة شخص آخر أي سيرة غيريّة مثل سيرة “جبران خليل جبران” لميخائيل نعيمة، وقد يعمد الأديب إلى كتابة سيرة ما نصًّا روائيًّا، من دون أن يعلن عن ذلك، مثل “بقايا صور” لحنّا مينا”[25]، أو هو قد يعلن ذلك شأن النّاقدة يمنى العيد، في سيرتها الرّوائيّة الواقعة في جزئين، هما: “أرق الرّوح” (2013)، و”زمن المتاهة” (2015).
يتبلور مفهوم مصطلح “الأدبيّة” في تخطي الّلغة قدرة الإيصال والتّعبير عن المعنى، إلى إحداث الأثر الممتع، من خلال الصّياغة الفنّيّة الجماليّة الّتي تتجلّى صورًا، وعبارات، وتراكيبَ، ومفارقات، أي بما يعرف بالبعد الأدبيّ (نعت منسوب إلى المنعوت الأدب) للّغة، أو بأدبيّة الأدب التّي تمثّل: “الحقيقة الكامنة في الشّكل، والّتي يحوّلها المؤلّف بالصّياغة الخاصّة إلى تجربة قابلة للتّفاعل، وللمشاركة القائمة على الجدل ما بين العمل الأدبيّ والمتلقّي”[26]؛ هذا المتلقّي الّذي يشكّل جزءًا لا يتجزّأ في منظومة الفعل الإبداعي، من خلال تحاورِه الفاعل مع النّصّ، وعبر إعطائه الأهميّة للدّال في موازاة المدلول، ما ينقل الاهتمام من العناصر الخارجيّة، إلى العناصر الدّاخليّة للنّصّ.
مسارات الكتابة الذّاتيّة كما برزت في كتاب “كما الإعصار”:
- تعريف “اليوميّات”: إنّ الخلط بين السّيرة الذّاتيّة واليوميّات لا يعزى إلى صعوبة التّجنيس، بقدر ما يعود إلى الجهل بالفروقات، فالتّأريخ والتّقويم هما أبرز ما يميّز اليوميّات، بحسبان كل يوم وحدة زمنيّة، ووحدة كلاميّة مستقلّة، نظرًا لما تفرضه الذّاكرة من فراغات قد تعتريها، ما يجعل وتيرتها غير ثابتة، ويفتحها على التّغيّر المستمرّ، فنصّ اليوميّات كما ترى الباحثة المغربية جليلة طريطر[27]: “هو نصّ لا بنية له؛ لأنّه نصّ يتخيّر فيه كاتبه ما يكتبه، وما يرى أنّه يستحقّ الكتابة بحسب رغبته التّعبيريّة، وما أرادت ذاته التّنفيس عنه بوساطة الكتابة”[28].
يسجّل الكاتب في اليوميّات “ما يجري في أيّامه من أحداث، ويعلّق عليها، ويكون هذا التّسجيل متقطّعًا، لا يشكّل بنية نصيّة متكاملة ومتماسكة، وفي الغالب لا تتمّ العناية بأدبيّة النّصّ على مستويي البنية الكلّية والأسلوب”[29]، ولذلك تنعدم إمكانيّة الالتباس ما بين اليوميّات والسّيرة الذّاتيّة، وإن اندرجت الأولى ضمن مكوّنات كتابة “السّيَر الذّاتيّة”، إلّا أنّها ليست كذلك؛ وهذه اليوميّات لا تكتب لغرض النّشر أصلًا، بل هي عبارة عن سجلّ للتّجربة الشّخصيّة أسرارًا ومشاعر وانطباعات، ويمكن لها أن تكون شكلًا تعبيريًّا، إذا ما عبَرَ الكاتب من خلالها، إلى كتابة حياة النّاس.
وتُطرَح قضية النّوع الأدبيّ لكتاب “كما الإعصار” منذ العتبة النّصيّة/ التّصدير ص 5، والّذي يشكّل إحدى “النّصوص الموازية المحيطة بالنّصّ لتحقّق تجسيرًا لفظيًّا وسيطًا يمهّد الكاتب بوساطته، السّبيل أمام القارئ للولوج إلى داخل النّصّ”[30]، حيث تبرز اليوميّات نوعًا متّضح المعالم، كما يتأكّد، من خلال قراءتنا تمثيلات متعدّدة لها في متن الكتاب. ونستقرئ النّصوص الآتية على سبيل التّمثيل:
- النّصّ: “أجمل المواعيد” ص5، أدرج تاريخ كتابته في الحاشية السّفلى، من الصّفحة عينها ( 8 آذار 2021)، على أنّه تاريخ مثّل “أجمل المواعيد” بالنّسبة إلى الكاتب، لأنّه اليوم الّذي أصبح فيه ولده والدًا، متيحًا لجان ولزوجته نوال رتبة الجدّ والجدّة؛ وتحيلنا ضمائر المتكلّم المفرد، الجمع والمخاطب (ولدي- علينا- شبابنا-حماك) على المنحى الذّاتيّ في الكتابة/ التّسجيل.
- النّصّ: “الّلغة العربيّة: اليوم العالميّ في 18 كانون الأوّل” ص11، يترافق وحاشية سفليّة أظهرت موقع وزمن نشره (11 ك1 2021) – في حين أنّ النّصّ السّابق في ترتيب مادّة الكتاب لاحق زمنيًّا، على النّصّ الثّاني- يحدّثنا الكاتب عبر سطوره، متبنيًّا ضمير المتكلّم المفرد، عن قصّة “حدثت معي بالأمس، إذ اتصلت بي أمّ طالبة في صفّ البريفه…” مفادها اعتقاد الابنة بموت كلّ أصحاب النّصوص العربيّة الّتي يُدّرَسها الطّلاب في مدارسهم، ما يجعل الكاتب يتفكّر في ظاهرة تكريمنا للمبدعين الرّاحلين، متجاوزين الاحتفاء بالأحياء منهم.
- النّصّ “ماجد الدّرويش: أيّام الماضي عودي” ص 17، نقرأ في الحاشية السّفليّة موقع وتاريخ النّشر: موقع ALEPH-LAM، 25 أيلول 2020. تاريخ يشي مجدّدا بفقدان ترتيب زمن الأحداث تصاعديًّا، فالكاتب في هذا النّصّ مسكون بهاجس تفاصيل الّلقاء الأوّل الّذي جمعه بالشّيخ ماجد الدّرويش “أعود إلى بدايات معرفتنا: كان الّلقاء الأوّل معه حول كتاب، أردت أخذ رأيه قبل نشره، ففاجأني بمقدّمة مسبّقة للكتاب…”؛ ومن ثمَّ يستنبط في نصّه، تمايز هذا الشّيخ حضورًا، وثراءً معرفيًّا، وتواضعًا يحفّز على حبّ العلماء الّذين يماثلونه فكرًا وروحًا؛ وبذلك، نجد الكاتب يستحضر هذه الشّخصيّة عبر توصيف سلوكيّاتها المحمودة، ومن خلال إطرائها.
- النّصّ: “أرجوحة نوم” ص 67، الحاشية السّفليّة: موقع ALEPH-LAM 8 حزيران 2021، يقف الكاتب في موقع المتأمّل لجزئيّة من جزئيّات الحياة اليوميّة للمخلوق البشريّ، يتفكّر في ذكاء من نحت من كلمتي المخّ والخدّ كلمة المخدّة، وهو يلقي برأسه مجهدًا عليها، يوصّف مجرّدًا من ذاته آخر يخاطبه، حالة التّنازع في الذّات أمام تدفّق العوامل المتعدّدة الّتي “تناديك” “من لوحات الجدران، والضّوء من السّقف، ومعارج طفولتك، ووجوه من أحببت”[31]؛ ليخلص إلى أنّ هدأة ما قبل الغفوة استيقاظ لعالمه الدّاخليّ، وتنبّهٌ إلى ما كان، وإلى ما سيكون.
- النّصّ: ” المولد النّبويّ الشّريف”، في الحاشية السّفليّة: موقع وزمان النّشر: الفايسبوك- 28-10- 2020، تأمّل في معنى عيد المولد النّبويّ، وفي استدعائه المحبّة في قلوب البشر، ودعوته إلى التّفلّت من إسار المحدوديّة وقصور الرّؤية: “هي دعوة إلى الخروج من محدوديّتنا إلى حيث يأخذنا المولى بكلّيتنا إليه في مجانيّة الحبّ، ولا محدوديّة العطاء”[32]، تهيمن الخطابيّة على النّصّ.
- النّصّ: “جميل عكّاريّ”ص 262، الحاشية السّفليّة: موقع ALEPH-LAM، 262، استحضار لشخصيّة الطّبيب جميل عكاري، ولتفاصيل العلاقة مع هذه الشّخصيّة المنتمية إلى مدينة الميناء، والمُحبّة لناسها، والمتواضعة لهم ولحاجاتهم إليه. ويبرز في النّصّ توصيف الشّخصيّة/ الأنموذج للمتعلّم الفاعل في مجتمعه وبيئته.
- النّصّ: “هاشم الأيوبيّ: أمير موسم “قطاف الخريف”، في الحاشية السّفليّة: موقع ALEPH-LAM 6 شباط 2023، ينتقي الكاتب مناسبة عيد مولد المحتفى به، وبلوغه سنّ الخامسة والسّبعين، مقترنًا بصدور مجموعته الشّعريّة “قطاف الخريف”، فيحيي هذه الشّخصيّة الأدبيّة المبدعة، مستعيدًا بلغة شعريّة مائزة مسار صاحبها منذ بدايات رحلته التّعلميّة: “ورد الهاشم إلى موارد العلم بين بيروت وبرلين وعواصم أمّهات الكتب. أبحر في دكاكين الكتاتيب، لازم الخطّاطين، تلقّن الكلمة الموحية على يد شعراء كبار في حواضر الأماسي، ولو كلّفه ذلك العودة ليلًا سيرًا على القدمين من طرابلس إلى بلدته في الكورة”[33]، والنّصّ يغادر الانطباعيّة إلى عناية واضحة بالّلغة الّي تبنّاها الكاتب في صياغته نصّه، ما منحه أبعادًا شعريّة عكست مشاعر المحبّة الّتي يكّنها الكاتب حيال صاحب المناسبة، فتبلورت صورًا مؤثّرة من مثل: ( إنْ قصدته برأي خرجت بشال قصائد/ لا سلطان له إلاّ سلطان الحبّ/ إن استشرته خرجت متخايلًا بعباءة شواهد لكبارٍ من خليل حاوي، والسّيّاب وأدونيس…).
استنتاج
غلب المنحى السّرديّ الوصفيّ الواقعيّ الحميم والإنسانيّ، على النّصوص/ الشّواهد، ما يدرجها في خانة اليوميّات الّتي ترد فيها الأحداث متقطّعة، تفتقر إلى المنظور الاستعاديّ في القصّ الّذي يحكم مسار الكتابة السّيرة الذّاتيّة. واعتمدت هذه اليوميّات في أسلوبها على الّلغة المكثّفة، وتبنّت الطّريقة المركّزة، حيث تمّ فيها إخضاع عرض الأحداث إلى “سلطة الزّمن اليوميّ”، وتقيّد – كاتبها- كتابيًّا بالظّروف الزّمكانيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة، لكيفيّة اليوم الّذي تسجّل فيه كلّ يوميّة، وهي “لا تعتمد على آليّات السّرد الاسترجاعيّ كما هو الحال في سرد السّيرة الذّاتيّة؛ لأنّ الزّمن الحاضر الآنيّ هو الزّمن المهيمن في كتابة اليوميّة”[34]؛ لذلك، وجدناها تفتقد تقنيًّا إلى ترتيب زمن الأحداث بشكلها التّصاعديّ، حيث تمّ تدوينها منفصلة يومًا بيوم، مع رصد للأفكار والمشاعر والانطباعات، وميل إلى التّأمّل الذّاتيّ في انفعالات الذّات، وفي تأثيرات الآخرين على هذه الذّات.
- مصطلح المذكّرات: هي نوع من الكتابة الشّخصيّة الّتي يركّز فيها صاحبها على تسجيل مذكّراته، وتسجيل ما يجري من أحداث واقعيّة من منظوره، و”تعدّ بمثابة شهادة على مرحلة تاريخيّة معيّنة”[35]، بمعنى أنّ مضامين المذكّرات تهتمّ برصد الأحداث الواقعيّة وبتسجيلها، ويعنى كاتبها بتصوير الأحداث الواقعيّة أكثر من اعتنائه بواقعه الذّاتيّ؛ وعليه، فالمذكّرات تمثّل إعادة بناء لواقع غابت تفاصيله أثناء الكتابة، واتّجاه إلى: “التّاريخ والأحداث والموضوعات، والقضايا أكثر من اتّجاهها إلى البناء الشّخصانيّ للرّاوي كما هو”[36]، في حين يقتضي البناء السّيريّ التزامًا بحدود الشّخصيّة في خصوصيّاتها الّذاتيّة، وفي خروجها إلى الأحداث والموضوعات والقضايا؛ كذلك، نلحظ قِصَر الاسترجاعات في متون المذكّرات، والّتي تطول في كتابة السّيرة الذّاتيّة.
أمّا تمثيلات هذا النّوع فتبرز في النّصوص/ النّماذج الآتية:
- النّصّ: “ليلة رأس السّنة”، ص 52؛ نصّ قصير: يقع في عشرة أسطر، ويبدأ النّصّ بإسناد فعل التّذكّر إلى واو الجماعة في الصّيغة المضارعيّة “يستذكرون”، لاستعادة ما “جرى من مائة وثلاثين سنة لمّا اتصلت مدينة الميناء بالخارج عمليًّا”[37]؛ فالحدث هامّ وجلل، يتمثّل في تأسيس شركة مساهمة، برأسمال كافٍ لإنشاء طريق جديدة تسير عليها المركبات؛ ليتمّ بعد ذلك، تدشين الطّريق في شباط 1880، ويمثّل المكتوب بذلك، شهادة تاريخيّة يدلي بها الكاتب، ويرصد بوساطتها هذا الحدث التّاريخيّ، محتفظًا بمسافة زمنيّة فاصلة، عن المشهد المستحضر.
- النّصّ: “الميناء هبة البحر” ص 43؛ يرصد توما من خلاله، نهوض (إنشاءات معرض طرابلس الدّوليّ) (أدرجته منظمة الأونيسكو حديثًا ضمن لائحة التّراث العالميّ)، ويستذكر الجهود المبذولة من المهندس البرازيليّ أوسكار نيماير، في سبيل استيلاد أشكال المعرض الهندسيّة، مع التّنبّه إلى خصوصيّة العام 1977 تاريخ “انطلاق ورشة بناء ضخمة في المنطقة الغربيّة للمدينة، وصارت المربّعات السّكنيّة منعزلة عن بعضها البعض، في غياب وحدة الهمّ عند السّكان الجدد”[38]، منوّهًا بالتّطوّر العمرانيّ في المدينة، من دون أن تغيب عن باله، التّداعيات السّلبيّة له، والمتمثّلة في غياب “وحدة الهمّ” عند السّكّان الجدد، بمعنى انتفاء قيمة خلقيّة سامية لطالما اتّسم بها سلوك السّكّان الأصليّين من أبناء المدينة.
- النّصّ: “عصير الّليمون يحيي المكنون” ص37؛ يسلّط الكاتب ضوءًا في هذا النّصّ، على “التّراث المملوكيّ ومتفرّقات من الآثار الفينيقيّة والبيزنطيّة والإفرنجيّة والعربيّة”[39]؛ تلك الآثار الّتي منحت داخل المدينة العتيقة طابعها الأثريّ المائز، مُدينًا بشكل مباشر، تخريب مدينة طرابلس القديمة، بإقامة القيّمين مَسرىً باطونيًّا على مجراه، بسبب من طوفانه في يوم من الأيّام، “يوم حمّلوا نهر قاديشا أو (أبو علي) جريمة طوفانه وخراب المدينة عام 1955، وعاقبوا مجراه بمسرى باطونيّ”[40]، موجّهًا أصابع الاتّهام إلى المسؤولين المتقاعسين عن إنقاذ التّاريخ الطبيعيّ/ البيئيّ والإنسانيّ (وبائع عصير الّليموناضة أحد رموزه)، وتقصيرهم عن حماية المعالم الهندسيّة والعمرانيّة الرّاقيّة الّتي عرفها تاريخ المدينة.
- النّصّ: “من طرابلس، إلى الأسكلة، فالميناء” ص 40؛ يستعيد ابن الميناء في النّصّ المذكور، ذكرى تغيير اسم مدينته وفق مجرى الأحداث التّاريخيّ: “في مثل هذا اليوم 19 أيلول 1979، اتّخذ مجلس بلديّة الميناء، توصية طالب فيها بتغيير اسم (الأسكلة) إلى (الميناء). كان اسم المدينة قبل العام 1289م طرابلس، ولمّا انتصر سلطان المماليك قلاوون على الفرنجة، دمّر طرابلس البحريّة، وبنى قرب القلعة طرابلس النّهريّة على ضفاف نهر أبي علي”[41]. ويبدو الكاتب معنيًّا بتسجيل هذا الحدث التّاريخيّ مركّزًا على الوقائع، من دون العناية بأدبيّة نصّه.
- ” قلب المدن” ص 41؛ يشكلّ ما يشبه الأرشفة لذاكرة العمران في مدينة طرابلس، حيث يتمّ توثيق تواريخ افتتاح شارعي “بور سعيد”، و”مار الياس” فيها؛ ففي العام 1954 تمّ فتح شارع بور سعيد ومار الياس، في تخطيط وضعه الفرنسيّون عام 1936، واستكمل 1947. كذلك، يتّخذ الكاتب الذّكرى مناسبة لاستدعاء ذكرى أكثر قِدمًا، تمثّلت في إقامة متصرّف طرابلس عزمي بك العام 1908 شارعًا ما زال معروفًا باسمه، في قلب بساتين اللّيمون، وذلك قبل أن يصبح واليًا على بيروت العام 1915، منوّهًا كذلك بقسمة الشّارع الجديد “الميناء” إلى مربّعين: الميناء القديمة، والميناء الجديدة، مدرجًا المرسوم البلديّ 16352، وموثّقًا تاريخ صدوره 2/10/2006، مع ما حمله من قرار برفع التّخطيطات، عن أكثر من 500 بيت، في الميناء القديمة.
- النّصّ: “قطراني”، ص47؛ وفيه بسط للحديث عن خشب ” أرز لبنان” الّذي ارتفع أسقفًا داخليّة للبيوت، وتمييزه عن سواه، من أخشاب تُدهن بمادّة القطران، مثنيًا على نوعه، وعلى وجوه تصنيعه منتجاتٍ كالأثاث، والأبواب، والزّوراق لمتانته، معيدًا تاريخ استخدامه إلى زمن الهندسة العثمانيّة، مذكّرًا باستخدام المماليك له، في بنائهم طرابلس النّهريّة عام 1289م.
- النّصّ: “طرابلس… جامعة النّاس”، ص 63؛ وفيه يسلّط الكاتب الضّوء، في نصّه هذا، على تجذّر بعض السّلوكيّات الاجتماعية الخلقيّة من تكافل، وانفتاح، واحترامٍ للآخر ميّزت مدينة طرابلس منذ العهد التّركيّ، حيث يحتفي النّاس بالنّهوض للتّسحّر، مستضيئين بإشعال “الدّومري” للفوانيس، وتتمّ دعوة المسيحيّين لمشاركة الصّائمين المسلمين طعام الإفطار، فيحترم الآخرون مشاعر من دعا، ويلتزمون بفريضة الصّيام حتّى يصحّ الأجر: “اعتاد النّاس في العهد التّركيّ على “الدّومريّ” الّذي يمرّ ليلًا في الأحياء لإنارة الفوانيس… ومن المعروف أنّ المسيحيّ إذا دعي إلى إفطار صام نهاره؛ ليكون إفطارًا مباركًا ومحمودًا” [42]، مقدّمين بذلك أنموذجًا راقيًا عن تعايش الطّوائف، مع بعضها بعضًا، بمحبّة ووئام.
استنتاج: يلاحظ في الشّواهد الموظّفة، تسجيل جان توما مذكّراته عن المرجعيّ الواقعيّ الّذي عايشه، بلغة غلبت عليها الموضوعيّة، والمنحى التّأريخيّ في التّدوين، عبر استدعائه الكثير من الأحداث، والوقائع التّاريخيّة الّتي عرفتها مدينتا طرابلس والميناء وجوارهما؛ استعادها جميعًا من منظوره، متقاطعةً مع اهتماماته المتمثّلة، بضرورة الحفاظ على القيم الإنسانيّة الرّاقية الّتي تواضع عليها أهل المكان سابقًا، وحماية طبيعة المدينة الجماليّة الّتي كانت حافلة ماضيًا ببساتين الّليمون، وبروائح أشجارها العطرة، والّتي تمّ اختراقها، أو شطرها، أو إزالتها لصالح العمران وأطنان الباطون، مقدّمًا بذلك ما يعدّ شهادة حيّة على مرحلة تاريخيّة معيّنة، من خلال مضامين المذكّرات الّتي عُنيت برصد الوقائع، وبتسجيلها، وبتصوير الأحداث الواقعيّة أكثر من عنايتها، بواقع كاتبها الذّاتيّ.
أنواع أدبيّة أخرى: على أنّ في الكتاب أنواعًا أدبيّة أخرى يمكن رصدها، ودراسة تمثّلاتها، إلاّ أنّا نترك المجال، لباحث جديد يتحرّى غنى هذا المنتج الأدبيّ، في أبحاث أخرى، أذكر منها على سبيل التّمثيل، نصًّا أدرجه في باب الخاطرة الوجدانيّة (ما يخطر على البال)، وهو نصّ: القناديل، ص56: ضجرت قناديلُ بلادي / من العواصف والأنواء/ اشتاقت لشراعها يتهادى في وجه النّسائم/ شعبيّ واقفٌ على أرصفة الرّحيل كمصباح تتلوّى ناره/ بالقلق، بالشّوق والحنين/أمّهات تلوّح لأولادها بمناديل السّفر/ ودموع الوجع حالمةٌ بميناء أمين.
وفيها، كما نلحظُ، يشخّص الكاتب، بوساطة خاطرة -والخاطرة وليدة فكرة عبرت في ذهن قائلها- قناديلَ الوطن التي سئمت من المشقّات الكثيرة، كما يعبّر، ومن الأزمات الّتي لا تني تتوالد في أنحائه، فباتت تضيق بدموع الأمهات الّلواتي صرن يودّعن أفواجًا تلو أخرى من الأبناء، ويسكنها حلم الوصول إلى ميناء آمن لا يعرف الأوجاع.
تشي هذه الخاطرة بحالة شعوريّة عاشها توما، هي حالة الألم والحزن تسبّبه هجرة الأبناء المتوالية، فيعبّر بأدبيّة شفّافة، وبلغة بسيطة صافية، عن المعنى الّذي سكنه، وحرّك وجدانه.
هذا إضافة إلى الرّسالة الأدبيّة الّتي نضحت شعريّةً وجماليّة لغويّة ثريّة، فاستوت في الكتاب مرآةً تعكس وجدان الكاتب ورهافته الكامنة، مفارقَةً بلغتها بشكل عامّ الّلغةَ الّتي وظّفها توما في يوميّاته، وفي مذكّراته، والّتي بدت أقرب إلى الموضوعيّة، وإلى الاقتصاد. وأكتفي بتوظيف شاهد يؤكّد ما أذهب إليه:
- النّصّ: (4 آب: رسالة من أمّ إلى ابنها) ص 171؛ برزت بعد العنوان، لوحة موحية للفنان فضل زيادة تتقاطع في مضمونها، وفي ألوانها، مع مضمون النّصّ (مشهد صحراء ممتدّة باهتة الّلون، في مقدّمة الّلوحة حذاءان فارغان ( لرجل)، على مسافة أمامهما تلّة دارسة، وكأّنها قبر تُعمل الريح عملها تموّجاتٍ وأشكالًا، على سطحه). ويتموضع الكاتب، في الرّسالة، في موضع الأمّ الّتي مات ولدها في انفجار مرفأ بيروت، يحكي بلسانها، حسرتها متيحًا لها تصوير آلامها، وأحزانها الطّاحنة، وهي تخسر بعضها، أو كلّها “كأنّك بعضٌ من بعضي، بل كلّي، تسكن أملي ووعدي”.
يتمّ إسناد القول إلى ضمير المتكلّم، فيكتسب الكلام طابع البوح الوجدانيّ الشّفيف؛ ليتمكّن من توصيف كلّ الأذى الّذي لحق بالأمّ، وبمثيلاتها من الأمهات الّلواتي ثكلن أبناءهنّ: “تركتُ باب المنزل مفتوحًا لك يا ولدي، قلت: لربّما عدت من بين دخان الموت، وغبار البيوت المهدّمة”؛ فيدخل الكاتب إلى عمق تجربة الأمّ ومأساتها، فيصير لسان حالها، فتبدو تجربتها في لحظات، غير منفصلة عن حياته، ما يصيّر كتابتها كتابة للمجتمع، وتعبيرًا عنه، ورصدًا لتحوّلاته من فرح وطمأنينة إلى موت، وحسرة، وخواء، وتأمّلًا في تجاربه ووقائعه، وما يعنّ على بال الكاتب من أفكار وملاحظات وتداعيات؛ ليختلط بذلك، الوعي الفردي بالوعي الجمعيّ.
خاتمة البحث: تظهر الشّواهد الموظّفة الفعل الانتقائيّ الّذي مارسه الكاتب في ترصّد المذكّرات، واليوميّات المدوّنة، والّتي وردت فيها الأحداث متقطّعة، وكاتبها يؤرّخ الشّخصيّ مستعرضًا أبرز المحطّات الحياتيّة، عبر تعاقبِ الزّمنيّ غير المتوالي، متّخذًا الصّدق منهجًا في نقل الأحداث، والأمانة سبيلًا في عرضها، فكان تسجيله لها متقطّعًا، لا يشكّل بنية نصّيّة متكاملة ومتماسكة، ينصرف الكاتب إلى العناية بها، أو إلى تدبيجها.
التزم جان توما في تسجيل هذه الأحداث/الوقائع، بالظّروف الزّمانيّة، والمكانيّة، والاجتماعيّة، والنفسيّة الّتي تعرّض لها، أو غرق فيها، واكتفى أحيانًا بالتّعليق عليها، وأحيانًا أخرى بالاسترسال في ذكرها، أو في تذكّر تفاصيلها.
هيمن الزّمن الماضي في معظم تلك النّصوص، في استرجاعات سريعة مكثّفة: “كان الخشب- ارتفع- صنعوا/ ضجرت- اشتاقت- تركتُ- ابتلعك حوتُ الرّدى/ كنت أستعدّ لمهاتفته لتسليمه نسخة من كتابي الجديد، حين وصلني نعيه صباحًا”[43].
تجلّت لدى توما، قدرة الذّاكرة الّتي تعي تفاصيل المكان، وتفاصيل حياة إنسانه، وتعبأ بأحداثه المهمّة، فتعمل على التّسجيل والتّوظيف للحظات، ومواقف وأحداث فارقة، إلاّ أنّ الكاتب لم يلتزم في استرجاعاته بالزّمن الخطّي، ما جعل كتابته تخرج من تصنيف السّيرة الذّاتيّة، إلى بعض مساراتها الأخرى، لا سيّما اليوميّات والمذكّرات.
يكشف البحث سعي الكاتب، إلى مناوأة التّغيّر/ المسخ، من خلال المكتوب، فهو يكافح بالنّثريّ الّذي اتسم بالشّعريّة – في نصوص بعينها- كالرّسالة مثلًا، يغزل في رحابه، فضاءً متحدّيًا لهذا التّغيّر القسريّ، وظهر فعل التّأمل الذّاتيّ محاولة من قِبله، لمكافحة النّسيان، أو النّكران، واعتداء الزّمن على الوجود الإنسانيّ القيميّ الّذي منح المكان المحلّيّ هوّيته المميّزة، فتمكّن جان توما بذلك، من إقامة بناء سرديّ ناطق برؤيته، إلى العالم المحلّيّ الّذي أحبّه ويحبّه، مشكّلًا بوساطته الفضاء السّيريّ الّذي استعادَه كتابةً، ونعني بالفضاء المكانَ الجغرافيّ وأشياءَه، والعلاقات الّتي تتخلّق بينهما، وبين بعض الشّخصيّات المستحضرة بالذّكر: ( تأبينًّا- تكريمًا واحتفاء بخصالها) / أو بالقول المباشر، تحكي هي بأصواتها ( رسالة الأمّ في 4 آب)، ما ولّد وظائف المرجعيّة، والإيهام بالصّدقيّة، وتنمية السّرد الجاذب.
تميّز جان توما بأسلوب نثريّ بسيط، بعيد من التّعقيد والّلبس والغموض، والّلغة القاموسيّة، في نصوص متفاوتة الطّول، خضعت في تصميمها لرغبته التّعبيريّة، بدليل أنّ بعض النّصوص تصدّرتها لوحات موحية تقاطعت، مع مضامينها؛ وإذا كانت بعض نصوص الكتاب تصنّف ضمن أنواع أدبيّة سوى اليوميّات والمذكّرات، كالخاطرة الوجدانيّة والرّسالة الأدبيّة على سبيل التّمثيل، فإنّ القارئ المتمعّن سيقع حتمًا، بين دفتي الكتاب، على أنواع أخرى كالقصّة القصيرة، والمقالة، وترجمات بعض الشّخصيّات… ما يعكس ثراء المخزون الّلغويّ المعرفيّ عند هذا الأديب الملتزم.
هذا وقد توارت الأنا /الكاتبة أحيانًا، لصالح أنا /الآخر، تستحضر هواجسه، وترقّبه، وأرقه وحنينه، ما جعل الكتاب يتّسم بوحدة شعوريّة ذات أبعاد إنسانيّة، ظهّرت تجربة جان توما النّثريّة شكلًا من أشكال الوعي الإنسانيّ، في علاقته بالزّمان، وبالمكان، وفي توظيفه الّلغة السّاردة وسيلة مثلى لتسليط الضّوء على جدليّات: التّاريخ/ الذّاكرة، البقاء/ الهجرة، موت الجسد/ خلود النّفس، وبقاء ذكرها الحسن…
وإن كان لنا أن نستشفّ تأويلًا لمنظور أيديولوجيٍّ هيمن على ذهن الكاتب، في إنتاجه نصّه/ كتابه هذا، هاجسًا لم يصرّح به، وإنّما تشكّل في دلالة كلّية يدركها المتلقّي المستقرئ له، عند اكتمال الدّوال الّلفظيّة وتآلفها” على اعتبار أنّ كلّ نصّ له متصوّر ذهنيّ غائب، أو وهميّ في وعي المتلقّي، يتشكّل لديه من تراكم الخبرات القرائيّة، والمخزون الذّاكريّ، وما تضيفه قدراته الإبداعيّة من خلق وابتكار”[44]، فإنّ لنا أن نختصر ذلك بعبارة كاشفة مفادها: بالكتابة وحدَها يكون حفظ التّاريخ، وهزيمة الموت، وانتصار الإنسان على قسوة الزّمن.
مكتبة البحث: أوّلًا: المصادر
- عبدالله توما، جان، كما الإعصار، بيروت: منشورات منتدى شاعر الكورة الخضراء، ط1، 2022.
ثانيًا: المراجع: المراجع العربيّة
– ألفا روني، إيلي، ونخل، جورج، أعلام الفلسفة العرب والأجانب، بيروت/ لبنان: دار الكتب العلميّة، ط1، 1412ه- 1993م.
- تليمة، عبد المنعم، مقدّمة في نظريّة الأدب، القاهرة: دار الثّقافة، 1973.
- حسين حسين، خالد، في نظريّة العنوان، مغامرة تأويليّة في شؤون العتبة النّصيّة، دمشق: دار التّكوين للنّشر، 2007.
- حشيمة، كميل ( الأب اليسوعي)، المؤلفون العرب المسيحيون من قبل الإسلام إلى القرن العشرين، بيروت: دار المشرق، ط1، 2011.
- زراقط، عبد المجيد، في السّرد العربيّ… شعريّة وقضايا، بيروت: دار الأمير للثّقافة والعلوم، ط1، 2019.
- الرّباعيّ، عبد القادر، تحوّلات النّقد الثّقافيّ، عمان: دار جرير للنّشر والتّوزيع، ط1، 2007
- شربل، موريس حنا، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب. طرابلس/ لبنان: جروس برس، 1996، ص227.
- عبد الدّايم، إبراهيم يحيى، التّرجمة الذّاتيّة في الأدب العربيّ الحديث، بيروت: دار النّهضة العربيّة، 1974.
- عبد القادر فيدوح، معارج المعنى في الشّعر العربيّ، سوريا: دار صفحات، 2012،
- عبيد، محمّد صابر، السّيرة الذّاتيّة الشّعريّة، الأردن: عالم الكتب الحديث، ط1، 2008.
- الفارابي، أبو نصر محمد، التعليقات، الهند: طبعة حيدر آباد، 1929، ص21.
- لحمداني، حميد، أسلوبيّة الرّواية- مدخل نظريّ، الدّار البيضاء: مطبعة النّجًاح الجديدة، منشورات دراسات سيميائيّة أدبيّة لسانيّة (سال)، ط.1، 1989
- المسدي، عبد السّلام، النّقد والحداثة، بيروت: دار الطّليعة، ط1، 1983.
- مفتاح، محمّد، ديناميّة النّصّ ( تنظير وإنجاز)، الدًّار البيضاء: المركز الثّقافيّ العربيّ، ط.2، 1990م.
- هوّاري، عبد العاطي إبراهيم، لغة التّهميش – (سيرة الذّات المهمّشة)-، الشّارقة: دائرة الثّقافة والإعلام، ط1، 2008.
- يعقوب، إميل، موسوعة أدباء لبنان وشعرائه. بيروت: دار نوبيليس، ط1، 2006.
ثالثًا: المراجع المعرّبة:
- ويول، براون، تحليل الخطاب، تر. محمّد لطفي الزّليطيّ ومنير التّركي، الرّياض: دار الفجر للتّوزيع والنّشر، 1997.
- لوكاتش، جورج، الرّواية كملحمة بورجوازيّة، تر. جورج طرابيشي، بيروت: دار الطّليعة 1979، ص. 60.
- رابعًا: المراجع الأجنبيّة
- Philippe le Jeune: Le pacte autobiographique ,édition Seuil, collection : poétique, Paris 1975.
- Petit Larousse illustré. Librairie Larousse. Rue de Montparnasse. Paris. 1977
الدّوريّات:
- عرب الشّعبة، نجاة، عتبة التّصدير في الرّواية العربيّة المعاصرة، مجلّة النّصّ، الجزائر: مخبر النّصّ المسرحيّ، مج 8، عدد1، 2022.
خامسًا: المعاجم
– ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم، لسان العرب، بيروت: دار الكتب العلّميّة، ط1، مج4، 2003.
– البعلبكيّ، منير، المورد، بيروت: دار العلم للملايين، ط37، 2003.
– بوقرة، نعمان، المصطلحات الأساسيّة في لسانيّات النّصّ وتحليل الخطاب، عمان: عالم الكتب الحديث، ط1، 2009
– الزّبيدي، السّيّد المرتضى الحسينيّ، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: مكتبة الحياة،مج1، ط1، 1304ه.
– زيتوني، لطيف، معجم مصطلحات نقد الرّواية، مكتبة لبنان ناشرون- دار النّهار للنّشر، بيروت، ط1، لات. – مجمع الّلغة العربيّة، المعجم الوسيط، القاهرة: مكتبة الشّروق الدّوليّة، ط4، 2004.
سادسًا: المواقع الإلكترونيّة
[1] الأستاذ الدكتور جان عبدالله توما، من مواليد الميناء- طرابلس-[1] أديب وراوٍ، حائز الدكتوراة في اللغة العربيّة وآدابها- الجامعة اللبنانيّة (2001)، رئيس قسم اللغة العربيّة في جامعة الجنان حاليًّا- طرابلس – لبنان، أستاذ محاضر في كلّية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانيّة منذ العام 2011، أستاذ محاضر سابقا في جامعة سيّدة اللويزة ، في جامعة البلمند، مدير تحرير مجلة منارات ثقافية، وعضو في هيئات استشاريّة تحكيميّة عدّة منها مجلة المشرق ( الجامعة اليسوعية) ومجلة نشر بحث، له مقالات عديدة ودراسات، وله إلى تاريخه ١٨ كتابا في النقد والأدب، عضوفي اتحاد الكتّاب اللبنانيين- المجلس الثقافيّ للبنان الشماليّ (إميل يعقوب، موسوعة أدباء لبنان وشعرائه. بيروت: دار نوبيليس، ط1، 2006، ص186، وحشيمة، كميل ( الأب اليسوعي: المؤلفون العرب المسيحيون من قبل الإسلام إلى القرن العشرين، دار المشرق، بيروت: ط1، 2011، ص 288-289)
[2] باحثة متخصّصة في النّقد الأدبيّ الحديث. تُعدّ من الأصوات المبادرة في المشهد الثّقافيّ الّلبنانيّ. أسهمت بمقالات نقدّية وثقافيّة، في العديد من الدّوريّات، والمجلّات المحكّمة. لها تسع روايات، وعدد من الإسهامات القصصيّة. أستاذ مشارك في جامعة الجنان، ومحاضِرة في عدد من النّدوات، والمؤتمرات النّقديّة الأدبيّة الدّوليّة والمحلّيّة. حَائزة جائزة مؤسّسة الحريريّ للتّنمية البشريّة المستدامة عن روايتها “حبّ في زمن الغفلة”، وجائزة المطران الأب سليم غزال، للسّلم والحوار الوطنيّ الّلبنانيّ، عن أعمالها الرّوائيّة، بالإضافة إلى عدد من الجوائز الوطنيّة الأخرى. أُدرجت روايتها ” حبيبتي مريم” في القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرّواية العربيّة دورة 2023.
houdaeid@hotmail.com
[3] جان عبدالله توما، كما الإعصار، بيروت: منشورات منتدى شاعر الكورة الخضراء، ط1، 2022.
[4] يعدّ علم السّرد أحد تفريعًات البنيويّة الشّكلانيّة الّتي تبلورت في دراسات كلود ليفي- شتراوس Claude Lévi-Strauss، ثمّ:” تنًامى هذا الحقل في أعمال دارسين بنيويّين آخرين، وأبرزهم: تودوروف Todorov وغريماس Greimas. هذا ويتداخل السّرد مع السّيميائيّة: الّتي تتنًاول أنظمة العلامات، بالنّظر إلى أسس دلالتها وكيفيّة تفسيرنا لها”، ينظر في: حميد لحمداني، أسلوبيّة الرّواية- مدخل نظريّ، الدّار البيضاء: مطبعة النّجًاح الجديدة، منشورات دراسات سيميائيّة أدبيّة لسانيّة (سال)، ط.1، 1989، ص. 109.
[5] جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau( 1712-1778) كاتب وفيلسوف ومربّ فرنسيّ، أثّرت أعماله على القوى السياسيّة، فأحدثت الثّورة الفرنسيّة عام 1789. ( موريس حنا شربل، ، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب. طرابلس/ لبنان: جروس برس، 1996، ص227).
[6] يُنظر في: شفيع بالزّين، مؤانسات أدبيّة، برنامج شهريّ يعنى بالكتابات الأدبيّة والنّدوات، https://artpress.ma/article/8612 الأربعاء في 23 نوفمبر 2022/ تمّت الزّيارة في 18 ك2 2023م.
[7] أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم إبن منظور، لسان العرب، بيروت: دار الكتب العلّميّة، ط1، مج4، 2003، مادّة ( هَ ويَ ).
[8] Petit Larousse illustré. 1977.Librairie Larousse. Rue de Montparnasse. 114.Paris 19
[9] حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، بيروت: المركز الثّقافيّ العربيّ، ط2، 2009، ص2.
[10] أبو نصر محمد الفارابي، التعليقات، الهند: طبعة حيدر آباد، 1929، ص21.
* الفارابي (من المرجح أنه توفي سنة 339ه- 950م). ارتحل في شبابه إلأى مدينة السلام والتحق بأمير حلب ورافقه إلى دمشق، ثمّ اعتزل الناس، وعاش عيشة فاضلة حتى وفاته. فلسفته تجلّت في السياسة المدنية ويعتبر أن المدينة الفاضلة تكون تلك التي يحكمها فيلسوف له صفات خاصة وفضائل. ( إيلي ألفا روني، وجورج ونخل، أعلام الفلسفة العرب والأجانب، دار بيروت: الكتب العلميّة، ط1،، 1412ه- 1993م، ص 127-128)
[11] كارل ماركس Karl Marx (1818- 1883) فيلسوف ألماني وثوريّ اشتراكيّ وهو ناشر البيان الشّيوعيّ وكتاب رأس المال، أدّت أفكاره دوراً مهمّاً في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكيّة. ورد في: لوكاتش، جورج، الرّواية كملحمة بورجوازيّة، تر. جورج طرابيشي، بيروت: دار الطّليعة، 1979، ص. 60.
[12] ينظر في: عبد المنعم تليمة، مقدّمة في نظريّة الأدب، القاهرة: دار الثّقافة،1973، ص 3.
[13] السّيميوطيقيّة أو السّيمياء Sémiotique – Sémiologie وفق تعريف فردينًاند دو سوسير F. de Saussure: علم يدرس حياة العلامات في الحياة الاجتماعيّة. ووفق بيرس:” المنطق بمعناه العام اسم آخر للسّيمياء، وهي مذهب شبه ضروريّ وشكليّ للعلامات”. وقد وضع السّيميائيّون تحديدات متكًاملة للعلامة تعبّر عن مظاهر مختلفة من عملها. ورد في: لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرّواية، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون- دار النّهار للنّشر، ط1، لا ت. ص. 22.
[14] محمّد مفتاح، ديناميّة النّصّ ( تنظير وإنجاز)، الدًّار البيضاء: المركز الثّقافيّ العربيّ، ط.2، 1990م، ص. 72.
[15] www.almaany.com تمّت الزّيارة في 29 ك2 2023.
[16] ويول براون، تحليل الخطاب، تر. محمّد لطفي الزّليطيّ ومنير التّركي، الرّياض: دار الفجر للتّوزيع والنّشر، 1997، ص 90.
[17] خالد حسين حسين، في نظريّة العنوان، مغامرة تأويليّة في شؤون العتبة النّصيّة، دمشق: دار التّكوين للنّشر، 2007، ص 32.
[18] مرتضى الزّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: مكتبة الحياة،م1، ط1، 1304ه، مادّة: س ي ر، ص 387.
[19] ابن منظور، لسان العرب، م.س. مادّة س ي ر، ص 451.
[20] المعجم الوسيط، مجمع الّلغة العربيّة، القاهرة: مكتبة الشّروق الدّوليّة، ط4، 2004، مادّة سار، ص 465.
21 Philippe Le jeune french literature at the Université Paris-Nord until 2004. His work focuses on autobiography ( Le Pacte autobiographique: 1975, Les Brouillons de soi: 1998, Signes de vie: 2005). Shs.cairn. info
[22] Philippe Lejeune : Le pacte autobiographique, édition Seuil, collection : poétique, Paris 1975, p14.
[23] عبد السّلام المسدي، النّقد والحداثة، بيروت: دار الطّليعة، ط1، 1983، ص114.
[24] يحيى إبراهيم عبد الدّايم، التّرجمة الذّاتيّة في الأدب العربيّ الحديث، بيروت: دار النّهضة العربيّة، د.ط.، 1974، ص 31.
[25] عبد المجيد زراقط، في السّرد العربيّ…شعريّة وقضايا، بيروت: دار الأمير للثّقافة والعلوم، ط1، 2019، ص 301.
[26] عبد القادر الرّباعي، تحوّلات النّقد الثّقافيّ، عمان: دار جرير للنّشر والتّوزيع، ط1، 2007، ص 95. .
[27] تلحظ طريطر أنواعًا لليوميّات تدرجها وفاق الآتي: يوميّات وقائع يكون فيها حضور الآخر قويًّا/ يوميّات استبطانيّة تعبّر عن مكنونات الذّات والوجدان/ ويوميّات الرّوبورتاج الإخباريّ. يُنظر في: شفيع بالزّين، مؤانسات أدبيّة، برنامج شهريّ يعنى بالكتابات الأدبيّة والنّدوات، https://artpress.ma/article/8612 الأربعاء في 23 نوفمبر 2022/ تمّت الزّيارة في 18 ك2 2023
[28] م.ن.
[29] عبد المجيد زراقط، في السّرد العربيّ… شعريّة وقضايا، م.س. ص 299.
[30] نجاة عرب الشّعبة، عتبة التّصدير في الرّواية العربيّة المعاصرة، مجلّة النّصّ، مج 8، عدد1، 2022، ص 533.
[31] كما الإعصار، م.س، ص 31.
[32] كما الإعصار، م.س. ص 233.
[33] م.ن. ص 106
[34] محمّد صابر عبيد، السّيرة الذّاتيّة الشّعريّة، الأردن: عالم الكتب الحديث، 2008، ص 131.
[35] عبد العاطي إبراهيم هوّاري، لغة التّهميش – سيرة الذّات المهمّشة، الشّارقة: دائرة الثّقافة والإعلام، 2008، ص 23
[36] م.ن. ص 29
[37] كما الإعصار، م.س. ص 52
[38] م.ن. ص 43.
[39] م.ن. ص 37
[40] م.ن. ص 38
[41] كما الإعصار، م.س. ص 40
[42] م.ن. ص 63-64
[43] كما الإعصار، م.س. ص265.
[44] عبد القادر فيدوح، معارج المعنى في الشّعر العربيّ، سوريا: دار صفحات، 2012، ص 12.
عدد الزوار:42



