الاحتجاج والرّفض في المسرح العربيّ (مسرحيّة “مأساة الحلاج” لصلاح عبد الصّبور انموذجًا)
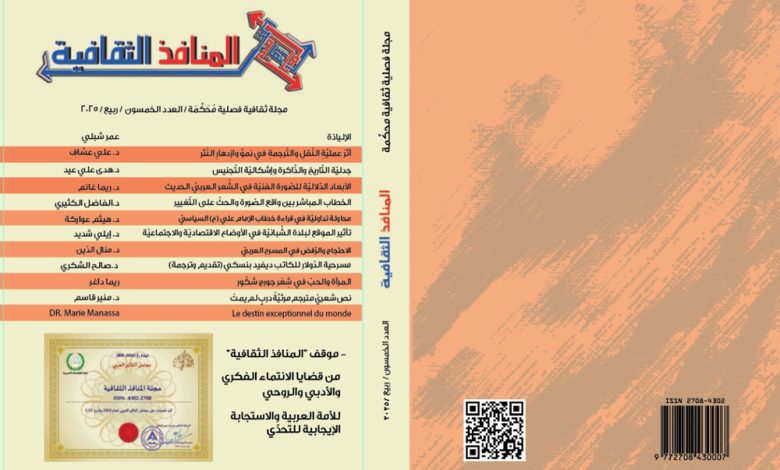
الاحتجاج والرّفض في المسرح العربيّ
(مسرحيّة “مأساة الحلاج” لصلاح عبد الصّبور انموذجًا)
Protest and Rejection in the Arab theater (The play “The tragedy of Al-Hallaj” by Salah-Abdel-Sabour as a model)
د.منال شرف الدّين
Dr. Manal Charafeddine
تاريخ الاستلام 5/9/ 2024 تاريخ القبول 21/9/2024
ملخّص البحث
بعد الحرب العالميّة الثّانية وما رافقها من دمار في جميع مرافق الحياة، وتهدّم القيم، والأخلاق، وشعور الإنسان بالإحباط واليأس، ظهر مسرح الغضب بوصفه أحد علامات الاحتجاج [1]والرّفض[2] السّياسيّ في المسرح العالميّ. وتزايد خلال مرحلة الحرب الباردة الّتي سادت بين القطبين، وكذلك ظهور كثير من الأنظمة القمعيّة والدّكتاتوريّة في العالم. واستمرّ مسرح الاحتجاج والرّفض في محاولاته للتأثير على مسار الحياة، ورفض القيم والمفاهيم السّائدة، ووضع مرجعية علميّة من خلال إدانته للحرب والسّياسات القمعيّة الفاشيّة، وفضح القرار الذي ساد وهيمن على السّياسات الدّوليّة، مثل: حالات الطّوارئ والاستعداد لصنع الحروب، والغزو، وقمع الشعوب، وكلّ أشكال الاحتلال. وقد اتخذ كتّاب المسرح من الخشبة المسرحيّة قاعدة مهمّة لانطلاق فعالياتها النّقديّة الرّافضة لكلّ أنواع الاستلاب والقمع، وذلك من خلال كتابة نصوص وتمثيلها، أو من خلال مشاهد مسرحيّة تمثّل الواقع الفاسد، وتقدّم ببراعة وذكاء ومضات فكريّة تهدف إلى رسم شكل القادة ومسرحة خططهم وفضحهم، من خلال قوالب مسرحيّة أعدّت بإتقان واستخدام المؤثّرات الموسيقيّة والعسكريّة والبيانات، وقد ظهرت في المسرح العربيّ كثير من النّصوص المسرحيّة الّتي تدين الواقع الفاسد والحروب، وماخلفته من دمار في كلّ مجالات الحياة في المجتمع العربيّ. وقد اخترت هذا البحث لأرى مدى استيعاب الكاتب “صلاح عبد الصّبور” لهذا المسرح، وكيف استطاع تطبيقه في نصّه؟
الكلمات المفتاحيّة: الاحتجاج، الرّفض، المسرح العربيّ، المسرحيّة، الكاتب المسرحيّ.
Abstract
After the Second World War and accompanied by destruction in all the facilities of life, destroying values, morals and human feelings of frustration and despair, the theater of anger emerged as a sign of protest and political rejection in the world stage. The theater of protest and rejection continued in its attempts to influence the course of life, reject prevailing values and concepts, establish scientific reference by condemning the war and repressive fascist policies, and exposing the resolution that prevailed and dominated international policies, to make wars, invasion and suppression of peoples, and all forms of occupation, has taken the book theater of the stage play an important base for the launch of their monetary and rejection of all kinds of oppression and repression, and through the writing of texts and representation, or through the scenes of the play represents the corrupt reality and brilliantly presented intelligence and intellectual flashes aimed at the formation of the leaders and the theater of their plans and expose them, through theatrical molds prepared with the proficiency and use of musical and military effects and data, has appeared in the Arab theater a lot of theatrical play that condemns the corrupt reality and wars and its aftermath of destruction in all areas of life in Arabi society. I chose this research entitled: Protest and Rejection in the Arab theater (The play “The tragedy of Al-Hallaj” by Salah-Abdel-Sabour as a model), to see the extent to which the writer Salah- Abdel Sabour absords this theater, and how he was able to apply it in his theatricalscript.
Keywords: Protest, Rejection, Arabic theater, Drama, Playwright.
مقدّمة
لعل أهم ما يشكل القاعدة المعرفيّة، ويوثق دلالاتها إطار نظريّ موثق بحسب أبعاده الثّقافية، وهي التي تحدّد المساق الذي يعتمده البحث، لذلك افترضنا جملة من المفاهيم التي رأيناها مناسبة لتأصيل الفهم الإجرائيّ الخاص بقيمة وعينة البحث.
أهميّة البحث والحاجة إليه:
تكمن أهميّة البحث في:
- تسليط الضّوء على المسرح العربيّ، وكيف ظهر مفهوم الاحتجاج والرّفض في هذا المسرح.
- تسيلط الضّوء على أحد كتّاب المسرح العربيّ الذي رفد السّاحة الأدبيّة بالكثير من النّصوص المسرحيّة.
- الحاجة إليه: يقدّم للطلبة معلومات عن مسرح الاحتجاج والرفض، وكيف ظهر هذا المسرح.
هدف البحث
يهدف البحث التّعرّف إلى الاحتجاج والرفض في المسرح العربيّ، وفي مسرحيّة “مأساة الحلاج” لصلاح عبد الصّبور.
في ما يخصُّ المنهج فقد اعتمدتُ المنهج التّحليليّ، كونه الأكثر قربًا من عمليّة تحليل النّصوص، والأقرب إلى بيان النّقاط الّتي تتفق مع مؤشرات الإطار النّظريّ.
أمّا الإشكاليّة فيمكن صياغتها من خلال التّساؤل الآتي:
كيف تجلّى مفهوما الاحتجاج والرّفض في المسرح العربيّ وفي مسرحيّة “مأساة الحلاج” لصلاح عبد الصّبور؟
الإطار النّظري
المبحث الأوّل: الاحتجاج والرّفض في النّصوص العالميّة
نتيجة للأوضاع غير المستقرة الّتي ولدتها الحروب، وما نتج عن ضعضعة الأمن وعدم الاستقرار وسوء الحياة، فضلاً عن الويلات والكوارث المأساويّة، نتيجة لكلّ ذلك ولد الإنسان الرّافض والمتمرّد والثّائر على هذه الظّروف والسّياسات القمعيّة والدّيكتاتوريّة التي تسلّطت على رقاب الشّعوب، وقد اختلفت ردود أفعال الرّفض والتّمرد حسب الظّروف، والأوضاع الاجتماعيّة والسّياسيّة والدّينيّة لكلّ مرحلة زمنيّة، وقد انبثق مسرح الاحتجاج والرّفض كردّة فعل على الظّروف الإنسانيّة المدمرة، ولعلّ هذه الوظيفة ليست صنيعة مسرح الآن، وإنّما هي امتداد لعصور مسرحيّة موغلة في القدم، إلّا أنّ ما يميّز هذه الوظيفة هو المظهر الذي تبدو فيه، فهي محكومة بطبيعة الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة، وبطبيعة المجتمع نفسه من حيث فاعلية اشتغالها، إذ تختلف المجتمعات في قدرتها على الاحتجاج والرّفض حسب أوضاعها وظروفها، فالمجتمعات مسلوبة الإرادة والوعي والثقافة، وطبيعة الحياة السياسيّة الأخرى لها دورها في الإسهام بشكل كبير في نوع التّحريض الذي يظهر على المسرح، إذ نجد عند بعض الشّعوب سلطة تشجّع المسرح الذي يتّسم بالتحريض ضدّها، لغاية منها هي امتصاص نقمة الشّعب عليها من خلال إباحة التّعرض للأزمات اليوميّة والسّياسيّة لغرض تسويف محتوى المشكلة التّحريضيّة واحتواء الأزمات، عندها تنتقل المشكلة أو الهمّ الجمعيّ من دائرة التّداول السّريّ إلى الكشف المسرحيّ المعلن الذي يُعنى بمغازلة الوعي الشّعبيّ، فيكون تحت مراقبة السّلطة وأنظمتها. ومنذ القدم كان المسرح قد عُني بالتواصل مع همّ المتلقي، ولعلّ ذلك نجده واضحًا في ما أظهره أرسطو من مصطلح (التّطهير) في المسرح؛ الذي لا يخلو من تحريض ضمنيّ على التّعاطف والانفعال من خلال إثارة عاطفتي الشّفقة والخوف، وأيًّا كان نوع التّحريض في السّلب أو الإيجاب فإنّه رسالة تسعى إلى المحافظة على سريانها؛ لتحقيق الهدف الذي ترنو إليه. ويدخل التّحريض في ثنائية افتراضيّة، فكلّ رفض هو احتجاج وكلّ رفض ينطوي على تحريض غايته توجيه سلوك معيّن على الضّدّ منه، فنبذ العنف والحرب هو تحريض واحتجاج، تحريض على السّلام، واحتجاج على الدّمار الذي تلحقه الحروب بالبشريّة، وإن رفض الخنوع هو تحريض على الثّورة، وهكذا يمكن النّظر من خلال هذه الثّنائيات إلى جميع العروض المسرحيّة التي تنطوي على أي شكل من أشكال الرّفض على أنّها مسرحيّات تحريضيّة أو ذات وظيفة تحريضيّة، وقد ظهر الاحتجاج والرّفض في النّصوص المسرحيّة منذ ظهور المسرح، إذ راح الكاتب المسرحيّ يتّخذ موقف الرّفض الذي يجعله في صراع مع القوانين المفروضة عليه، فهو يرفض الآلهة والكنيسة والمجتمع، مؤيدًا حقوق الفرد في العيش بحرية، وثائرًا ضدّ الحكومات الفاسدة، والعرف، والقواعد البائدة، ومتّخذًا موقف المتمرّد، وعاقداً العزم على تحطيم كلّ الحواجز والمفاهيم والظّلم والسّلوك الشاذ. فأطلع كتّاب المسرح منذ العصور الأولى قبل الميلاد بواجبهم برفض التّسلط، والظّلم، والاستلاب وقمع الحرّيّات الّتي يتعرّض لها الإنسان على يد الآلهة الّتي أصبحت قوّة للقمع والظّلم، فظهرت بعض النّصوص الّتي ترفض سطوة الآلهة وسيطرتها على الحياة العامّة، ومن هذه الأعمال مسرحيّة (أنتيكونا) لسوفوكليس الّتي تجسّد فيها مفهوم الاحتجاج والرّفض من خلال شخصيّة (أنتيكونا) الثّائرة والمتمرّدة، والرّافضة للقوانين الاثنية الظّالمة، وما تعرّض له أخاها من ظلم، ومعارضتها للقانون الوضعيّ الذي فرضته سلطة (كريون) على أخيها الذي أمر بتحقير جثة (بولينيس) وتركها بالعراء من دون دفن، بعد أن اتّهمه بالخيانة، ومهما كانت الأسباب الّتي دفعت (كريون) إلى اتّخاذ قراره وفرض سلطته، فقد رأت هذا القرار مجحفًا بحقِّ أخيها، فأصرّت على التّحدي والرّفض والاحتجاج على قانون (كريون) ودفن أخيها، فأغضب ذلك (كريون) الذي أمر بإعدامها[3]. وبذلك مثلت (أنتيكونا) قوّة الإرادة والتّحدي للسلطة الحاكمة والرّفض والاحتجاج على سلوكها وتصرفاتها ودكتاتوريتها. كذلك يمكن أن نلاحظ ذلك الاحتجاج والرّفض في مسرحيّة (ميديا) ليوربيدس فشخصيّة (ميديا) تمثّل الشّخصيّة الرّافضة المتمرّدة والمحتجّة على قوانين أثينا وقانون الأبوة وسلطتها وقمعها، فقررت الزّواج بمن تحبّ وتتحدّى السّلطة الأبويّة الجائرة . [4]
أما في عصر النّهضة فقد انتعشت حريّة التّفكير، وأصبح الكاتب أكثر قدرة على النّقد والتّصريح عن أفكاره بحرّيّة من دون خوف، وإذا كان أهم خصائص عصر النّهضة هو انتعاش حرّيّة التّفكير الّتي تتضمّن حرّيّة التّساؤل والبحث، وتدفع إلى إعادة امتحان القيم الموروثة للحياة والموت، وإذا كانت هذه الحرّيّة قد لقيت في كلّ مكان نوعًا من المعارضة الطبيعيّة لها، فإنّها لم تلقَ قطّ في تاريخها مثل تلك المعارضة الّتي أبدتها محاكم التّفتيش الإسبانيّة الّتي كانت تقمع أيّة حرّيّة للتفكير، إلّا أنّ التّاريخ يخلّد إسبانيا في عصرها الذّهبيّ على مستوى الاحتجاج والرفض الذي أظهره بعض كتّاب المسرح في تلك المرحلة، من أمثال (كالديرون ) (دي بومارشيه) و(لوب ديفيجا) الذي أظهر قوّة بمواجهة السّلطة والسّخرية منها، والتهكّم عليها والتّحريض ضدّها. ففي مسرحية (الخراف) لوب ديفيجا نجد نموذجًا يصوّر ثورة الفلاحين والقرويين في قرية صغيرة ضدّ الحاكم الاستقراطيّ الفاسد، وقتله انتقامًا لشرف إحدى بناة القرية الّتي اغتصبها ذلك الحاكم. إنّ ذلك الحدث حرض أبناء القرية على أن يوحدوا صفوفهم، وأن يهتفوا عاليًا باسم قريتهم، وأن يعترضوا ويحتجّوا على الرّغم من الخوف والقمع. كذلك تعدّ مسرحيّة (حلاق اشبيلية)، ومسرحيّة (زواج فيجارو) للكاتب (دي بومارشيه) من النّصوص الّتي ظهر فيها الاحتجاج والرّفض، إذ هاجم بومارشيه في مسرحيّة (زواج فيجارو) امتيازات النّبلاء، وسيطرتهم على الحياة الاقتصاديّة، ويذكر أنّ هذه المسرحيّة قدّمت عام 1784، وسببت غضبًا لدى الجمهور الذي اقتحم أبواب المسرح وحطّم العوائق، وتحوّل بومارشيه إلى قائد شعبيّ وموجه للرأي العام بعد أن امتازت مسرحيّاته بالجرأة، والصّراحة، والسّخرية اللاذعة. [5]
كذلك يظهر نموذج الاحتجاج والرّفض في المسرح الألماني من خلال كتابات الكاتب (جيرهاد هاوبتمان) في مسرحيّة (النّسّاجون)، إذ يتجسّد الغضب والاحتجاج من خلال ثورة (النّسجاون) في إحدى قرى سيليزيا، وثورتهم على الظّلم والاستغلال بعد أن شعروا أن جلودهم تسلخ وأتعابهم تُباع رخيصة، وظهورهم تتقوّس وهم لايجدون لقمة العيش من تعبهم، فتتفاقم النّقمة شيئًا فشيئًا، وتشتدُّ فتعصف ثورتهم بأرباب العمل لتحقيق حرّيّتهم. أمّا (برتولد بريخت) فثورته موجّهة ضدّ نفاق المجتمع البرجوازيّ وجشعه وظلمه، إذ تمثّل شخصيّاته المسرحيّة مثالًا للاحتجاج والرّفض والثّورة على الحرب وماخلفتها من دمار، كما في مسرحيّات: “الأم شجاعة”، أو “غاليو غالييه”، أو “أوبرا القروش الثّلاثة”. [6]
وازدادت شدّة الاحتجاج والرّفض بعد الحرب العالمية الثّانية، وماخلفته من ويلات على الشّعوب، ومانتج عنها من ضعضعة الأمن، وعدم الاستقرار، وسوء الحياة، فضلًا عن الكوارث المأساويّة، إذ ولد نتيجة لكلّ ذلك الإنسان الرّافض والمتمرّد والثائر. وظهرت حركات جديدة بعد تزايد الوعي الثّقافيّ والسّياسيّ لدى الشّعوب، وتطوّر المسرح وازدياد أهميّته على السّاحة، ففي أمريكا ظهرت نصوص مسرحيّة اتصلت بتزايد الوعي السياسيّ لدى هذه الشّعوب. ومن أمثلة ذلك نصوص(يوجين أونيل) المسرحيّة، الّتي تمثّل صرخات احتجاج ضدّ توحش المجتمع الرّأسماليّ واستغاله وقمعه للإنسان، ومثال ذلك: مسرحيّة (القرد كثيف الشّعر) الّتي تمثّل الصّراع بين طبقة الرّأسماليين المسيطرة، الّتي تمثّلها الفتاة (ميلدرد) ووالدها صاحب مصانع الصّلب من جهة، وبين طبقة العمال الفقيرة الكادحة الّتي يمثّلها (يانك) ومجموعة الوقادين من جهة أخرى، إذ يمثّل (يانك) شخصيّة الإنسان المتمرّد الرّافض للسلطة الرأسماليّة وقوانينها وأنظمتها، الّتي جعلت منه آلة يمكن الاستغناء عنها في أي وقت ورميها في الشّارع [7]. كذلك عبّرت الكاتبة الأمريكية (ميكاتيري) عن غضبها واحتجاجها من خلال أعمالها المسرحيّة، ونلاحظ ذلك في مسرحيّة (فيت روك) الّتي كانت عبارة عن وثائق احتجاج ضدّ الحرب الفيتنامية وماخلفته من دمار وقتل وتشريد. كذلك كان ظهور مسرح العبث واللامعقول بعد الحرب العالمية، وهو تجسيد لحال غضب الإنسان ورفضه واحتجاجه على القيم الجديدة التي ظهرت بعد الحرب، فاستخدم كتّاب هذا المسرح أسلوب التّهكّم والسّخرية للتعبير عن استيائهم ورفضهم ولاسيّما عندما يحاولون “تفريغ الواقع من إطاره المألوف، والتّعبير عمّا يدور في هذا الواقع من روابط، وعلاقات غير عادية، وغير متوقعة”[8]. وبرزت السّخرية في هذا المسرح بوصفها سلاحًا قويًّا في توجيه الازدراء إلى الرّياء، والنّفاق، كذلك برز التّمرّد كنوع من الاحتجاج والرّفض في هذا المسرح.
من أشهر كتّاب هذا المسرح (ألبير كامي)، الذي جسّد التّمرد في كثير من نصوصه المسرحيّة، غير أنّ التّمرد عند كامو نوعان: الأوّل تمرّد الإنسان على حاله من حيث هو، وهذا ما يسميه بالتمرّد الميتافيزيقيّ، والثّاني تمرّد الإنسان على وضعه من حيث هو عبد، وهو ما يسميه بالتمرّد التّاريخيّ، فالنوع الأوّل هو الذي ينبع منه الشّعور بعبث الوجود، وقد يؤدي إلى إنكار القيم جميعًا؛ أي إلى العدميّة المطلقة، أمّا النّوع الآخر فهو ما قد يتحوّل إلى ثورات جماعيّة فهو رفض واحتجاج على الواقع الفاسد، وعلى الأنظمة الدّيكتاتوريّة.[9] وقد جسّد ذلك من خلال أعماله المسرحيّة، كأسطورة سيزيف، “العادلون”، “الغريب”، كذلك حاول كتّاب هذا الأدب أمثال: (صموئيل بيكيت)، و(يوجين يونسكو) أن يعبّروا من خلال كتاباتهم عن رفضهم للواقع والثّورة عليه. فقد حاول (بيكيت) أن يطرح من خلال نصوصه المسرحيّة أزمة الإنسان، ووحدته ويأسه من المجتمع الذي يعيش فيه، وهذه النّظرة التّشاؤميّة عند (بيكيت) جاءت نتيجة إحساسه بعبثية الحياة وخلوها من أي منطق، وذلك لأن أحداث الحياة ” لها الشّكل نفسه المكرر، والزّمان أحداث متتابعة لا معنى لها يندمج كلّ منها بالآخر، بلا وعي حتّى ليصعب تمييزها” [10]، وهذا ما يمكن ملاحظته في مسرحيتي (في انتظار جودو)، و(نهاية اللّعبة)، إذ يلاحظ فيهما ما تتّسم به الحياة من تكرار، ورتابة، وانتظار، وزمن خامل ليس له تأثير، فالشّخصيّات الرّئيسة (ستراجون)، و(فلاديمير) في مسرحيّة (في انتظار جودو)، و(هام) [11]، ويتجسّد ذلك في نصوصه المسرحيّة، مثل: (المغنية الصّلعاء)، و(الكراسي)، و(أميديه) الّتي تصوّر عزلة الإنسان، وانقطاع العلاقات بين البشر، كذلك عبر كتّاب المسرح التّسجيليّ عن رفضهم واحتجاجهم على الواقع، ومن أشهر كتّاب المسرح التّسجيليّ (بيتر فايس)، إذ جسّد من خلال أعماله رؤيته الخاصّة في هذا المسرح، فيرى(فايس) أنّ المسرحيّة التّسجيليّة معنية بالدرجة الأولى بتوثيق حدث لمادة حقيقية مؤكدة من خلال الرّسائل، والخطب، والإحصائيات، والتّقارير الإخباريّة والسّينمائيّة. وعلى الرغم من أن هذه الحقائق هي الأساس المناسب للمسرحيّة الوثائقيّة فإنّه من الأفضل أن تكتب كشكل من الاحتجاج، وتكمن المساهمة الإبداعيّة للكاتب في اختيار وترتيب أفكار المسرحيّة، وكيفية المحافظة على المادة وترتيبها بشكل صالح . [12]كما في مسرحيّة (مارا صاد)، الّتي تتحدّث عن الثّورة الفرنسيّة، وما أصابها من إخفاقات. وقد طبّق من خلالها الكثير من الصّيغ الفنيّة، مثل: أغاني الكورس، والحوار الشّعريّ، ومسرح داخل مسرح، والبانتومايم، والرّقص، وتنوّع المشاهد، وعلى شاكلتها جاءت مسرحياته الوثائقيّة الأخرى، مسرحيّة (التّحقيق)، ومسرحيّة (أنشودة أنغولا)، ومسرحيّة(حديث عن فيتنام). ما صور الرّفض والاحتجاج الاجتماعيّ فقد جسّدها (إبسن) في مسرحيّة (بيت الدّمية) الّتي جسّدت رفض القيم والتّقاليد البالية، وطلب الحرّيّة من خلال شخصيّة (نورا) الّتي رفضت كلّ المظاهر البالية، فكانت بمثابة صرخة احتجاج فاضحة لكلّ أشكال النّظم، والعلاقات الاجتماعيّة، كذلك تمثّل مسرحيّات (لوركا) نوعًا من التّحريض، والرّفض، والاحتجاج الاجتماعيّ من خلال ماقدّمه من مسرحيّات مثل: (الإسكافية العجيبة) أو مسرحيّة (عرس الدّم) الّتي أظهر من خلالها نظرة المرأة الإسبانيّة، ومحاولاتها اليائسة لتحديّ الأحوال التّعيسة، والقيم، والتّقاليد البالية، والتي تجعل منها أثاثًا يُباع ويثشترى، ووعاء يحمل هموم الرّجال[13]. فضلًا على ذلك تجسّد مفهوم الغضب والرّفض والاحتجاج في كتابات عدد من الكتّاب المسرح الطّليعيّ الذين رفضوا الواقع والأعمال التقليديّة، فجاءت أعمالهم ترفض الشّكل التقليديّ، فلم تعد المسرحيّة تهتمّ بالبناء المتصاعد المتماسك، ولم يعد للحدث المشوّق والشّخصيّة المرسومة بدقة تلك الأهميّة، فلقد ثاروا على كلّ هذا، وسخروا منه وتمرّدوا عليه.
كذلك ظهر كتَاب في المسرح البريطانيّ الذين عبّروا عن الاحتجاج والرفض للسياسات الدّيكتاتورية وما تلاقيه الشّعوب من ويلات، ومن أهم كتّاب هذه المرحلة (جيل جون ازبون) و(روبرت بولت) و(جون أردن) و(أوارج بولد) و(بيتر شيفر)، فكانوا رواد حركة الغضب والاحتجاج، وظهرت هذه الحركة المسرحيّة في منتصف الخمسينات، واتّسمت بنغمة الغضب والسّخط وفقدان الوازع [14]. وقد كان هدف مسرح الغضب والاحتجاج هو كسر أسلوب سطوة القرار السّياسيّ، وتجنّب البشريّة حدوث حروب أخرى مدمرة، وذلك من خلال تناول الحقائق المغيبة، وكشفها من دون خوف، وقد قاد هذا إلى التّحرّر من الوهم والخوف والكتابة بحرّيّة تامة، وتعدّ مسرحيّة أوزبون (أنظر إلى الخلف بغضب) الانطلاقة الحقيقية لمسرح الغضب والاحتجاج والرّفض، فكانت علامة بارزة على استياء الشّباب من أوضاع ما بعد الحرب العالميّة الثّانية، والتّمرد عليها ورفض كلّ أسبابها. وقد هاجم (أوزبون) في مسرحيّة (أنظر إلى الوراء بغضب) الكنيسة، واستهزأ بها وبالطبقة الأرستقراطيّة، والصّحف المنحطة، والنّساء المترجلات، والتّفرقة العنصريّة، والقنبلة الذرية. كذلك عبّر (هارولد بنتر) في مسرحيّاته عن الرّفض والاحتجاج الذي تمثّل في خوف الإنسان ويأسه، وأسلوبه في بلورة الصّراع، وتعرية أعماق النّفس؛ لذا نجد في مسرحيّاته صورًا متنوّعة لمحاكمة الأباء للأبناء، ومحاكمة الأباء تُعرّى من خلالها العلاقات الاجتماعيّة والشّخصيّات الإنسانيّة [15].
ويلاحظ الرّفض والاحتجاج في أعمال (جون آردن) كما في مسرحيّة (رقصة العريف مسجرين)، وأيضًا في مسرحيّة الكاتب (أنولد ويسكر) (حساء دجاج بالشعير)، الّتي ظهرت في العام 1958؛ وهي واحدة من نصوص كثيرة هاجمت الإيديولوجيات والقوانين، ورصدت خيبة الأمل الّتي تتعرّض لها الجماهير، والسّياسات الفاشلة إبّان الحرب الصناعيّة، وخيبة الأمل الّتي ولدتها الحرب في نفوس النّاس، وقد مهد هذا الاتجاه فيما بعد لنصوص مختلفة أخرى، مثل: (القضاء والقدر)، ومسرحيّة (أعياد أول مايو) و(حياة الولد الصّاخب)، ومسرحيّة (قوّة الكلب) لباركر و(العيد العنصريّ) لإدجار، إذ هاجمت الحرب الباردة، وتردي القوانين، وفداحة الخسائر البشريّة والماديّة، التي خلفتها الحرب وتلوّث البيئة، وانتشار السّلاح المدمر، وقد تميّز مسرح الغضب من خلال تلك النّصوص بلغة السّخرية والهجاء الّتي تطلق انتقادات ذكية ولاذعة، كذلك استخدم مسرح الرّفض والاحتجاج في كشف المسكوت عنه في الجانب السّياسيّ من خلال التّوليف المستمد، والفلكلور الشّعبيّ، وإشاعة روح الكوميديا لتقليل الرّتابة والملل، ودقة الحوار في الوصف، والابتعاد عن العبرات الرّنانة الطويلة، كلّ ذلك من خلال حبكة مسرحيّة متقنة الصّنع لها ذروة قويّة تكشف الصّراع وتؤكده [16].
المبحث الثاني: الاحتجاج والرّفض في المسرح العربيّ
أمّا المسرح العربيّ فلم يستطع خطاب التّحريض العربيّ من أن يتخلّص من سطوة السّلطة عليه، سواء كانت هذه السّطوة سطوة مباشرة في التّحديّ والقمع، وأحيانًا بالمصادرة لخطاب التّحريض، ومحاولة لتسخيره لصالح السّلطة، وربّما كان ذلك متأتيًا من كون معظم السّلطات هي سلطات دكتاتوريّة ليس لها القدرة على احتواء طبيعة الخطاب وتفهمّه، ومن ناحية أخرى عجز الخطاب نفسه على أن يكون فعالًا في عمليّة التّغيير، كما أنّ خطاب التّحريض يصبح ضعيف الفعاليّة عندما يبثُّ إشاعات أو إشارات في مساحة ضيقة من فضاء التّلقيّ، ذلك لأنّ المساحة تضيق كلّما أصبح المسرح نخبويًّا، فإنّ أي نوع من أنواع التّحريض، سواء كان جماليًّا أم أيدلوجيًّا أم فلسفيًّا، سيكون غير قادر على إيصال رسالته بفعاليّة وتفعيلها في أي شكل كان، سواء كان تحريضًا صريحًا معلنًا، أم كامنًا في شفرات ما وراء السّطور، أم في دعوات التّمرّد على واقع معين. فالمسرح العربيّ بشكل عام لم ينتج خطابًا تحريضيًا بشكل مباشر، وذلك بسبب قمع السّلطات العربيّة للكاتب العربي. لذلك لجأ الكاتب المسرحيّ إلى التّاريخ، إذ بات يقتطع بعض المواقف والأحداث التّاريخيّة ويسخّرها لصالح فكرته المسرحيّة بعد أن يلبسها ثوب العصر، ليتلقاها المشاهد العربيّ كونها جزءًا من تاريخه، فيكون لها تأثير كبير عليه، وفي الوقت نفسه لا تعترض عليها السّلطات لأنّها تنتقد مراحل تاريخيّة ماضية، ولا تقترب من السّلطة الحاكمة، لذلك لم تُعالج هذه النّصوص المسرحيّة ما يتعرض له المواطن العربيّ من قمع واستلاب لحريته والخوف والاضطهاد الذي يمارس ضدّه، وإنّما راح الكاتب يعالج من خلال هذه الأعمال التّاريخيّة العزّة، والكرامة، ومقاومة الاستعمار، وبناء المجتمع الحرّ الكريم، كما نلاحظ ذلك في مسرحيّات (عسكر وحرامية)، و(الزّير سالم) “للافريد فرج”، و(كيف تركت السّيف) لممدوح عدوان، و(مغامرة رأس المملوك جابر) لسعد الله ونوس، وغيرها من الأعمال المسرحيّة الّتي قدّمت في البلدان العربيّة، لكن مع ظهور الثّورات العربية ضدّ الأنظمة الحاكمة، والّتي جاءت بعد مرحلة الاستقلال لتلك الدّول، والّتي أدّت إلى شيوع الكثير من الأفكار الثّوريّة الّتي تطالب بالثورة على الفساد، والظّلم الاجتماعيّ، والمساواة والتّفاوت الطبقيّ، وأدّى هذا إلى تحوّل كبير في كتابة المسرحيّات التّاريخيّة، إذ بات الكاتب العربيّ يعالج أحداثًا تاريخيّة جديدة تغاير ما اعتاد كتّاب المسرحيّة التّاريخيّة معالجته في المرحلة الأولى. فبعد أن كانت تطرح فكرة التّصديّ الأجنبيّ ومقاومة الاستعمار، أصبحت المسرحيّات التّاريخيّة تنتقد الظّلم والقمع والتّصديّ للسلطة الحاكمة. وبعد أن كان الصّراع التّاريخيّ يجري بين قوّة خارجيّة متعديّة وبين العرب، أصبح الصّراع يجري بين السّلطة العربيّة والشّعب، وبدلًا من اختيار المراحل التّاريخيّة الزّاهية بالانتصارات، اختيرت المراحل المظلمة الحافلة بالطغيان والظّلم، فمثلًا في المرحلة الأولى كان فتح الأندلس يقابلها في المرحلة الثّانية (غروب الأندلس)، و(أبطال المنصورة) حلّ محلهم (الحسين ثائرًا)، و(الحسين شهيدًا)، وفتوحات بلاد الشام يقابلها اجتياح بلاد الشام وسقوط بغداد، ومن النّقاط المهمّة في اختيار المادة التّاريخيّة في هذه المرحلة كان في انتقاء أبطال الحدث التّاريخيّ، فبعد أن كانوا من الطّبقات الارستقراطيّة، أو من القادة المشهورين بانتصاراتهم، صاروا من عامّة النّاس والفقراء والشهداء، فبرزت شخصيّات من أمثال (الحسين بن علي) و(صاحب الزّنج) و(أبو ذر الغفاري) و(أبو خليل القباني) و(رفاعة الطهطاوي) و(الحلاج) (ثورة الزّنج) و(المهرج). وهؤلاء جميعًا عُذبوا وقُهروا على يد أبناء جلدتهم، وذلك لما حملوه من أفكار مغايرة، ورفض واحتجاج ضدّ الأنظمة الحاكمة.
ما أسفر عنه الإطار النّظريّ:
- ظهر مسرح الغضب بوصفه أحد علامات الاحتجاج والرّفض السّياسي في المسرح العالميّ، وتزايد خلال مرحلة الحرب الباردة الّتي سادت بين القطبين. كذلك ظهور كثير من الأنظمة القمعيّة والدّكتاتوريّة في العالم كان علامة بارزة على استياء الشّباب من أوضاع ما بعد الحرب العالميّة والتّمرّد عليها ورفضه كل أسبابها.
- وضع مرجعيّة علميّة له من خلال إدانته للحرب والسّياسات القمعيّة الفاشيّة، وفضح القرار الذي ساد وهيمن على السّياسات الدوليّة، مثل حالات الطّوارئ والاستعدادت لصنع الحروب، والغزو وقمع الشعوب، وكلّ أشكال الاحتلال.
- أسهم كتّاب المسرح بواجبهم برفض التّسلّط، والظّلم، والاستلاب، وقمع الحريّات الّتي يتعرض لها الإنسان على يد السّلطة الحاكمة الّتي أصبحت قوّة للقمع والظلم والاستلاب.
- استخدم كتّاب هذا المسرح أسلوب التّهكم والسّخرية للتعبير عن استيائهم، ورفضهم للواقع من خلال كتاباتهم المسرحيّة، وذلك من خلال تفريغ الواقع من إطاره المألوف، والتّعبير عمّا يدور في هذا الواقع من زيف واغتراب، وتحلل الرّوابط الاجتماعيّة.
- برزت السّخرية في هذا المسرح بوصفها سلاحًا قويًّا ضدّ الرّياء، والنّفاق، كذلك برز التّمرد كنوع من الرّفض والاحتجاج في المجتمع.
- أصبحت أزمة الإنسان وغربته ويأسه في المجتمع، وعدم الانسجام بين وضع الإنسان ورغباته تهيمن على كتاباتهم.
- رفضوا الواقع والأعمال التّقليديّة، وجاءت أعمالهم ترفض الشّكل التقليديّ، فلم تعد المسرحيّة تهتمُّ بالبناء المتصاعد المتماسك، ولم يعد للحدث المشوق والشّخصيّة المرسومة بدقة تلك الأهميّة عندهم.
- كان هدف مسرح الغضب والاحتجاج هو كسر سطوة القرار السّياسيّ ومحاولة تجنب البشريّة حدوث حروب مدمّرة، وذلك من خلال معالجة الحقائق المغيبة، وكشفها من دون خوف، وقد قاد هذا إلى التّحرر من الوهم والخوف والكتابة بحرّيّة تامة.
- هاجمت نصوصهم المسرحيّة الأيديولوجيّات والقوانين، ورصدت خيبة الأمل الّتي تتعرض لها الجماهير والسّياسات الفاشلة أبّان الحرب الصّناعيّة، وخيبة الأمل الّتي ولدتها الحرب في نفوس النّاس.
- تميّزت نصوص مسرح الرّفض والاحتجاج بلغة السّخرية والهجاء وإطلاق انتقادات لاذعة وذكية للسلطة وأنظمتها القمعيّة، والكشف عن المسكوت عنه في الجانب السّياسيّ من خلال توظيف الفلكلور الشّعبيّ، وإشاعة روح الكوميديا والبهجة، وزرع روح الأمل من أجل تقليل الرّتابة، والملل، واستخدام الحوار الدّقيق، والوصف، ومحاولة الابتعاد عن العبارات المملة والطّويلة.
المبحث الثالث: مسرحيّة مأساة الحلاج تأليف صلاح عبد الصّبور[17]
ملخص حكاية المسرحيّة: اختار الكاتب حكاية تاريخيّة، وهي قصّة رجل من أقطاب الصّوفيّة هو (الحسين بن منصور الحلاج ) الذي عاش في بغداد في القرن الثّالث والرّابع الهجريين، ليجعل من هذه الحكاية فكرة لمسرحيته، تحكي المسرحيّة قصّة الحلاج الذي حاول إيقاظ الفقراء، وتبصيرهم بجهلهم وظلم السّلطات لهم، وقد حاول صديقاه (الشّبلي) و(إبراهيم) أن ينصحاه ويحذراه من متابعة السّلطة له، لكنّ (الحلاج) يصرّ على مواصلة طريقه في تثقيف النّاس، ممّا حدا بالسلطات إلى إلقاء القبض عليه بحجة تحريض النّاس ضدّ السّلطان، والكفر بالذات الإلهيّة، ويقدّم إلى المحاكمة، ويُحاكم من قبل قضاة، وهم من أعوان السّلطة، ويتهمّ بالزندقة والإلحاد، وبعد محاكمة صوريّة يحكم عليه بالإعدام شنقًا، ويعدم في إحدى ساحات بغداد على جذع شجرة[18].
تحليل المسرحيّة:
استلهم (صلاح عبد الصّبور) حكاية الحلاج التّاريخيّة، فجعلها ثيمة لنصّه المسرحيّ، ليتجاوز من خلالها حدود الزّمان والمكان، وليعبّر عن روح العصر ومشاكله المعاصرة، وما تثار فيه من مشكلات سياسيّة، واقتصاديّة، واجتماعيّة، وفكريّة، وليدين بها الأنظمة العربيّة القمعيّة، الّتي تحارب المفكرين والمثقفين المعارضين للسلطة، وتتهمهم بشتى التّهم من أجل قهرهم واستلابهم، وجعل المثقف أمام خيارين: إمّا أن يدجن للسير في ركاب السّلطة، وإمّا أن يُصفّى من قبل أجهزتها القمعيّة.
يتكوّن النّصّ من جزأين، وعنون الكاتب كلّ جزء بعنوان، فجعل الجزء الأوّل (الكلمة)، والجزء الثّاني (الموت)، ليعطي إيحاء بأنّ نهاية الكلمة الشّريفة المقاتلة هو القتل على يد السّلطات، وقد ظهر مفهوم الاستلاب في هذا النّصّ بأنواع مختلفة منها الاستلاب السّياسيّ، والثقافيّ، والدينيّ، والّنفسيّ، حيث سلّط الكاتب الضّوء على شخصيّة الحلاج، الّتي هي الشّخصيّة الرّئيسة في النّصّ الرافضة للسلطة لحاكمة، والّتي ترمز لكلّ المفكرين والمثقفين، وكلّ الطّبقات الواعية، الّتي تحاول السّلطات سلب حرّيّتها، وإرادتها، وفكرها الحرّ، وإسكاتها من أجل أن تظلّ أقلامها تصدح في مدح السّلطان وأعوانه، لذا تتابع السّلطة الحلاج، وما يقوم به من اتصال مع الفقراء، بعد أن شعرت بأنّ وجوده هو خطر عليها، فتحاول اعتقاله، ممّا جعل صديقة (إبراهيم بن فاتك) يحذّره من السّلطة الّتي تحاول القبض عليه بتهمة تحريض النّاس على السّلطان.
“إبراهيم : كنت أزور اليوم القاضي ابن سريج ونبأني أنّ ولاة الأمر يظنون بك السّوء.
الحلاج: بي يا إبراهيم ؟
إبراهيم: ويقولون هذا رجل يلغو في أمر الحكام، ويؤلب أحقاد العامة، ورجائي أن أنبيك رجاءه بالحيطة والكتمان”[19].
لقد حاول (الحلاج) إصلاح المجتمع، وتغييره باستخدام الكلمة وجعلها نوراً يضيءُ الطّريق إلى الخلاص، ولكن هذا يثير حفيظة السّلطة، مما جعل الشّرطة تقوم باستدراج (الحلاج) حتّى أوقعته في تهمة الزّندقة، واقتادته إلى السّجن، الذي حاول أن يجعل منه الكاتب رمزًا للظلام، والقهر، والتعفن، والحرب النّفسيّة، وسوط السّجّان، بل أداة القهر والتّعذيب وإسكات الأصوات المعارضة.
ويلاحظ في هذا النّصّ السّجّان المدجج بكلّ أسلحة التّعذيب، وهو يحاول إسكات صوت الحلاج وقهره، ممّا يفضح ساديّة الجلاد، ووحشيته، وهمجيته الّتي تمظهرت في الرّغبة في جعل الآخرين يعانون، أو أن يراهم يعانون جسميًّا وذهنيًّا، وفي داخل السّجن تحاول السّلطة ممارسة سياسة التّيئيس ضد(الحلاج) بقصد السّيطرة عليه، ومحاولة إخضاعه لرغباتها، وحجب الحقائق عنه، وإبراز حقيقة واحدة هي أنَّ القوّة الّتي تفرض سطوتها عليه قوة قدريّة، ليس له قدرة على التّخلّص منها أو استبدالها، بل عليه الخضوع لإرادتها وسطوتها، لذا تستلب حرّيّته وإرادته في داخل السّجن، ويعيش حالة من الاستلاب النّفسيّ والجسديّ من خلال المعاملة القاسيّة الّتي تتحوّل أحيانًا إلى الجلد بالسوط من أجل إخضاعه بالقوّة، لكنّ الحلاج هو من ينتصر على سوط الجلاد، فالكلمة دائمًا تبقى أمّا الجلادون فهم زائلون.
“الحارس: (يضربه بالسوط والحلاج هادئ مبتسم، يلمُّ ثوبه، ويزداد الشّرطي عنفًا، وتتلاحق ضرباته)، ثم (يهتف بالحلاج) لم لا تصرخ؟
الحلاج: هل يصرخ يا ولدي جسد ميت؟
الحارس: اصرخ .. اجعلني اسكت عن ضربك.
الحلاج: ستملّ وتسكت يا ولدي .
الحارس: اصرخ.. لن أسكت حتّى تصرخ .
الحلاج: عفوًا يا ولدي، صوتي لا يسعفني” [20].
أمّا في الفصل الثّاني فيلاحظ كيف يصوّر الكاتب المحاكمة الصّوريّة التي جرت (للحلاج) من قبل قضاة هم من زبانية السّلطة، وذلك بعد أن فشلت كلّ أساليب السّلطة القمعيّة في إطفاء جذوة الحماس والتّحديّ عند الرّجل، فتجري معه التّحقيقات المعبّرة عن خوف الحاكم من المحكوم، أكثر من خوف المحكوم من الحاكم لفساد أجهزة الدّولة الّتي تنافق بعضها بعضًا، وتتعامل بالجهل والغرور، فالشرطة خدام السّلطان، والمحكمة أيضًا ألعوبة في يده، والقضاة لا يحكمون إلا بما يرضي السّلطان الذي يصدر أحكامه قبل المحاكمة، وما على القاضي إلا أن يقرأ الحكم على المتهم، وهذا يعطي صورة واضحة للحال التي وصل إليها العدل في ظلّ الأنظمة القمعيّة العربيّة التي تهزأ بالعدل وبأرواح النّاس، وبذلك يكون المواطن العربيّ مدانًا من دون تهمة دائمًا، وينفذ به الإعدام من دون ذنب ما دام هو معارض وله صوت ينتقد السّلطة. لذا يلاحظ كيف تجري (للحلاج) محاكمة صوريّة من قبل قضاة يصدرون أحكامهم من دون محاكمة، مادام السّلطان من اتّهم الحلاج بالعصيان، فالأحكام تكون جاهزة قبل المحاكمة.
” ابن سريج: أفلا يعني وصفك للحلاج بالمفسد، وعدو الله قبل النّظر المتروي في مسألته، إنّه قد صدر الحكم ولا جدوى عندئذٍ أن يعقد مجلسنا.
أبو عمر: هذا رجل دفع السّلطان به في أيدينا موسومًا بالعصيان، وعلينا أن نتخير للمعصية جزاء عدلا(…) ما نصنعه أن نجدل مشنقة من أحكام الشّرع، والسّياف يشدّ الحبل” [21].
يحاول القاضي أن يؤول كلام (الحلاج) من أجل لف حبل المشنقة حول رقبته، وجعل الحكم الصّادر بحقه وكأنّه صدر فعلا بناء على تهم اعترف بها المتّهم، وبذلك يسعى الكاتب أن يعطي صورة عن كيفية توجيه التّهم للمواطن العربيّ البريء في دهاليز السّجون من قبل أعوان السّلطان، وكيف تستلب إرادته ورأيه.
“أبو عمر: معنى هذا أن الدّولة تشقى في ظلّ خلافة مولانا، ويقول إنّ الفقر يعربد في الطّرقات.. معنى هذا أن الأمّة لا تجد الأقوات.. ولتسأل عندئذٍ من سلب الأقوات.. وتؤدي هذي الألفاظ بالفقراء إلى نبذ الطّاعة ولزوم الفتنة ” [22].
وتستمر مؤامرة السّلطة على الحلاج، إذ يلاحظ كيف يحاول الكاتب تعرية السّلطة، ويبين مدى ظلمها لكلّ من يعارض سياستها، ومحاولتها تسقيطه سياسيًّا ودينيًّا واجتماعيًّا، وذلك عندما يصدر السّلطان أمرًا بإعفاء (الحلاج) من تهمة التآمر على السّلطة، أما تهمة الكفر والإلحاد فإنّ السّلطة لا يمكن أن تتنازل عنها حسب قرار السّلطان، لأنّها تمسّ الذّات الإلهيّة، والغرض من ذلك تشويه صورة الحلاج بين أبناء الشّعب، وعندما يعدم (الحلاج) لا يكون مناضلاً ضدّ الدّولة فيتحوّل إلى بطل، بل يعدم لأنّه كافر وملحد، وتجاوز على الذّات الإلهيّة حتّى تنبذه العامّة.
” أبو عمر: هبنا أغفلنا حقّ السّلطان، ما نصنع في حقّ الله (…) فالوالي قد يعفو عمن يجرم في حقّه، لكن لا يعفو عمن يجرم في حقّ الله.
ابن سريج: بل هذا مكر وخداع، فلقد أحكمتم حبل الموت، لكن خفتم أن تحيا ذكراه، فأردتم أن تمحوها، بل خفتم سخط العامّة ممن أسمع أصواتهم من هذا المجلس، فأردتم أن تعطوه لهم مسفوك الدّم، مسفوك السّمعة والاسم”[23].
لقد كان عذاب (الحلاج) رمزًا لعذاب المفكرين في معظم المجتمعات العربيّة الحديثة، وحيرتهم بين السّيف والكلمة، وقد اختار الكلمة سلاحًا له، ليقاتل من خلالها السّلطة، وهي من تنير طريق الفقراء، لذا عندما يطالب (السّجين الثاني) من (الحلاج) برفع السّيف ليقاتل به السّلطة الظّالمة يرفض ذلك، ويرى أنّ الكلمة أشدّ قوّة وتأثيرًا على الشّعب، لذا حاولت السّلطات إطفاء كلماته وإسكات صوته وفكره، وفرض أفكارها وثقافتها عليه، وبذلك استلبته السّلطة ثقافيًّا وفكريًّا من أجل إرهاب وإسكات الأصوات الحرّة الّتي تطالب بالإصلاح، والمساواة، والحرية، وشراء أصوات النّاس بالترهيب والتّرغيب، واستلاب شعب بأكمله وكتم صوته، وحرّيّته، وإرادته، وهذه إدانة لكلّ الأنظمة العربيّة أحادية الفكر والثّقافة، والتي تحاول تدجين المثقفين العرب على وفق أهوائها ومصالحها.
“السّجين الثاني: كي تحمل سيفك من أجل الناس.
الحلاج: مثلي لا يحمل سيفًا.
السّجين الثاني: هل تخشى حمل السيف؟
الحلاج: لا أخشى حمل السيف، ولكنّي أخشى أن أمشي به، فالسيف إذا حملت مقبضه كفٌّ عمياء أصبح موتًا أعمى” [24].
كذلك يلاحظ كيف يصوّر الكاتب الشّعب المستلب الذي يتحوّل إلى كتلة ليس لها أي رأي، بل يلتزم الصّمت، ويسكت على الظّلم والقهر والتّعذيب ولا يحرّكُ ساكنًا حتّى في أشدّ الحالات بطشًا، وذلك بعد أن استخدمت معه السّلطة أسلوب التّرهيب والتّرغيب، كأسلوب فعّال في مصادرة الحريّات، فتحوّل الشّعب إلى قطيع خانع تقوده كيفما تشاء وحسب أهوائها، بل جعلته أداة لقتل الحلاج، يلاحظ هذا في المشهد الأوّل من الفصل الأوّل، فالشعب يظلُّ صامتًا، ويأخذ موقف المتفرّج عندما يُعدم الحلاج، ويُعلق على جذع شجرة في إحدى الميادين العامة، ولم يجد الشّعب ومواليه سوى ندب حظّهم العاثر، وتوجيه التّهم إلى أنفسهم باشتراكهم في قتله بدل الثّورة على السّلطات.
“المجموعة : صفونا.. صفًّا.. صفًّا.. الأجهر صوتًا، والأطول.. وضعوه في الصّفّ الأول.. ذو الصّوت الخافت والمتواني.. وضعوه في الصّفّ الثاني.. أعطوا كلاً منا دينارًا من ذهب قانٍ برّاقًا.. لم تلمسه كف من قبل.. قالوا: صيحوا.. زنديق كافر.. صحنا.. زنديق كافر.. قالوا: صيحوا فليقتل إنّا نحمل دمه في رقبتنا..فليقتل إنّا نحمل دمه في رقبتنا.. قالوا: امضوا فمضينا.”[25]
ويحاول الكاتب من خلال الحوار بين القاضي (أبو عمر) و(الحلاج ) فضح أساليب السّلطة لتجويع النّاس من أجل أن يبقى الشّعب يسير في فلك السّلطة، وهذه إدانة للأنظمة العربيّة الفاسدة التي تستعبد شعوبها وتجوعهم تحت مقولة (جوع كلبك يتبعك).
“الحلاج: لا يفسد أمر العامة إلا السّلطان الفاسد يستعبدهم ويجوعهم.
القاضي أبو عمر: هل تبغي أن يرتفع الفقر عن النّاس.
الحلاج: الفقر؟ ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل إلى الكسوة، الفقر هو القهر، الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الرّوح، الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحبّ، وزرع البغضاء”(28) .
وكان (الحلاج) بكلماته الصّوت الوحيد الذي أدان الواقع المشوّه في مجتمع يحكمه الفرد الأوحد الذي يمسك مقاليد الأمور، وبطانة واسعة تستلب النّاس باسم السلطان، وأفراد الشّعب مستلبون ومبعدون بفعل الخوف، والتّصفية الجسديّة، والتعذيب. وقد ظلّ الشّعب خانعًا مستلبًا، ليس أمامه خيار سوى الابتعاد عن السّلطة وعدم المساس بها، وأصبح وعّاظ السّلاطين يزرعون الخوف والرّعب في قلوب النّاس من السّلطة، لذا يحذر الواعظ النّاس من الكلام عن السّلطة أو أعوانها، حتّى يحافظوا على أرواحهم.
“الواعظ: الأيام غريبة، والعاقل من يتحرّز في كلماته.. لا يعرض بالسوء لنظام، أو شخص، أو وضع، أو قانون، أو قاض، أو وال، أو محتسب، أو حاكم..[26]
كذلك يكشف الحوار بين الحلاج وبين صديقه (إبراهيم) عن بطش السّلطة، واستسلام النّاس لها، ويصبحون كأنّهم أموات ليس لهم رأي يسمع أو اعتراض، بل كأنّهم أموات قبل أن يموتوا، لقد قتلت فيهم السّلطة كلّ ما هو حيّ، وزرعت في قلوبهم كلّ ما هو مخيف، وهذا يمثّل استسلام شعب، وانقياده، وسلب حرّيّته، وخضوعه إلى السّلطة وأزلامها .
“إبراهيم : يا مولاي في عصر ملتاث قاس.. وضنين.. لن يصنع ربيّ خارقة أو معجزة كي ينقذ جيلاً منهكًا.. قد ماتوا قبل الموت.
الحلاج : كم أخطأت الفهم لا أطلب من ربيّ أن يصنع معجزة، بل أن يعطيني جلدًا كي أدرك أصحابي عنده”[27].
النّتائج
- ظهر الرّفض والاحتجاج في عينة البحث وذلك من خلال شخصيّة (الحلاج) الّتي ترفض الواقع وتتمرّد عليه.
- استطاع “صلاح عبد الصّبور” من خلال استخدامه شخصيّات شعبيّة أتعبتها السّلطات، أن يظهر رفضه وإدانته للواقع المعاش، ورفض كلّ أشكال الظّلم والاستبداد.
- استخدم الكاتب أسماء لشخصيّاته تتناقض مع حقيقة هذه الشّخصيّات، وذلك ليظهر كيف كانت هذه الشّخصيّات، وكيف أصبحت بسبب ظلم السّلطات الّتي تغيّر كلّ شيء حتّى الإنسان.
- استخدم الكاتب لغة شعريّة ليعبّر من خلالها عن رفضه واحتجاجه على السّلطة الحاكمة، ولتوعية الشّعب دينيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا.
- لجأ الكاتب إلى لغة التّهجم والازدراء والسّخرية، واستخدم انتقادات لاذعة وذكية للتعبير عن حالتي الغضب والاحتجاج على الأنظمة العربيّة القمعيّة.
- حاول الكاتب الكشف عن المسكوت عنه في الجانب السياسيّ من خلال استخدام بعض الأمثال الشّعبيّة.
- استخدم الكاتب لغة بسيطة مفهومة من قبل الجميع، ودقة في الحوار والوصف، وحاول الابتعاد عن العبارات الرّنانة الطّويلة.
أمّا ما يتعلّق بكتّاب المسرح العربيّ فقد:
- استطاعوا رفض الحروب والاحتجاج عليها من خلال بعض نصوصهم المسرحية.
- استخدموا لغة التّهجم والازدراء والنّكته للتّعبير عن المسكوت عنه خوفًا من السّلطات الحاكمة.
- استخدموا الفلكلور والأغاني الشّعبيّة والأمثال في بعض كتاباتهم للتّعبير عن رفضهم للواقع .
- استخدموا شخصيّات شعبيّة فقيرة للتّعبير عما تتركه الحرب من دمار في المجتمع.
- جعلوا من أبطال بعض نصوصهم المسرحيّة يحملون رمزًا شعبيًّا، وفكرًا سياسيًّا حرًّا ينادي بالعدالة الاجتماعيّة، والتّمرّد على كل ماهو ظالم والثّورة عليه.
المصادر والمراجع
- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنّشر، بيروت، 2009.
- اينز(كريستوفر)، المسرح الطليعي، ترجمة:سامح فكري، مركز اللغات والترجمة في أكاديمية الفنون، القاهرة، 1999.
- بكير عبدالله عبد الرّحمن، مفهوم جون آردن للغضب والاحتجاج، دار الحرّيّة للطباعة والنّشر، بغداد،1985.
- حافظ صبري، التّجريب والمسرح، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، القاهرة ،1984.
- ستيان (ج.ل)، الدراما الحديثة بين النظرية والتطبيق، ترجمة:محمد جمول، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، القاهرة،1992.
- صليبا جميل، المعجم الفلسفيّ، الجزء الأوّل، دار الكتاب اللبنانيّ،1982.
- العسكري أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل، كتاب الصناعتين: الكتابة والشّعر، تحقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط9، 1989.
- كروكشانك جون، البيركامي وأدب التّمرّد، ترجمة:جلال العشري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1986.
- ولورث جورج، مسرح الاحتجاج والتناقض، ترجمة: عبد المنعم إسماعيل، المركز العربيّ للثقافة والعلوم، بيروت.
المسرحيّات
- إبسن هنريك، مسرحية : بيت الدّمية، ترجمة: سمير عزت نصار، دار النّسر، 1999.
- أونيل يوجين، مسرحية :الغوريلا، ترجمة: محمد إسماعيل الموافي ضمن كتاب: من الأعمال المختارة يوجين اونيل-4.
- بيكيت ( صموئيل )، مسرحية: في انتظار جودو، ترجمة: بول شاوول ضمن كتاب: من المسرح العالمي،العدد270-271، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت،1993.
- خميس يسري، مقدمة مسرحية: مارا صاد، تأليف: بيتر فايس، ترجمة: يسري خميس، دار الكاتب العربيّ للطباعة والنّشر، بيروت.
- دي بومارشيه كارون، مسرحية حلاق إشبيلية، ترجمة: زكي طليمات، سلسلة المسرح العالمي، الكويت،1975.
- سوفوكليس، مسرحيّة انتيكونا، ترجمة: علي حافظ، سلسلة من المسرح العالميّ، الكويت، 1973.
- عبد الصبور صلاح، مسرحيّة: مأساة الحلاج، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1996.
- يوربيدس، مسرحية ميديا، ضمن كتاب: مسرحيات يوربيدس، ترجمة: احمد سلامة، مكتبة مدبولي، القاهرة،1984.
[1] : للوقوف على دلالة المصطلح لغة واصطلاحًا ينظر: أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري، كتاب الصّناعتين: الكتابة والشّعر، تحقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط9، سنة 1989، ص 470، وينظر أيضًا: عبدالله عبد الرّحمن بكير، مفهوم جون آردن للغضب والاحتجاج، دار الحرّيّة للطباعة والنّشر، بغداد،1985، ص57.
[2] : للوقوف على دلالة المصطلح لغة واصطلاحًا: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنّشر، بيروت، 2009، ص242، وللمزيد ينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفيّ، الجزء الأوّل، دار الكتاب اللبنانيّ،1982، ص 618 .
[3]: سوفوكليس، مسرحية انتيكونا، ترجمة: علي حافظ، سلسلة من المسرح العالميّ، الكويت،1973.
[4] : يوربيدس، مسرحيات يوربيدس، ترجمة: احمد سلامة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1948 .
[5] : كارون دي بومارشيه، مسرحيّة حلاق اشبيلية، ترجمة: زكي طليمات، سلسلة المسرح العالميّ1984، الكويت،1975.
[6] : روبرت بروستاين، المسرح الثوريّ، ترجمة: عبد الحليم البشلاوي، الهيئة المصريّة للتأليف والنّشر، القاهرة،1983، ص248.
[7] : يُراجع، يوجين أونيل، مسرحية: الغوريلا، ترجمة: محمد إسماعيل الموافي، ضمن كتاب: من الأعمال المختارة يوجين أونيل-4، ص 133-144.
[8] : جون كروكشانك، ألبيركامي وأدب التّمّرد، ترجمة: جلال العشري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986، ص 17.
[9] : جورج ولورث، مسرح الاحتجاج والتّناقض، ترجمة: عبد المنعم إسماعيل، المركز العربيّ للثقافة والعلوم، بيروت، ص76.
[10] : ينظر: ج.ل.ستيان، الدّراما الحديثة بين النّظرية والتّطبيق، ترجمة: محمد جمول، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، القاهرة، ص621.
[11] : جورج ولورث، مسرح الاحتجاج والتّناقض، مصدر سابق، ص91.
[12] : ينظر، د.يسري خميس، مقدمة مسرحية: مارا صاد، تأليف: بيتر فايس، ترجمة: يسري خميس، دار الكاتب العربيّ للطباعة والنّشر، بيروت، ص21.
[13] : إبسن هنريك، مسرحية: بيت الدّمية، ترجمة: سمير عزت نصار، دار النّسر، 1999
[14] : صبري حافظ، التّجريب والمسرح، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، القاهرة،1984، ص45.
[15] : كريستوفر اينز، المسرح الطّليعي، ترجمة: سامح فكري، مركز اللّغات والتّرجمة في أكاديمية الفنون، القاهرة، 1999، ص442.
[16] : كريستوفر اينز، المسرح الطليعي، ترجمة: سامح فكري، ص44.
[17] : يُراجع صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة: مأساة الحلاج، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1996، ص6-122
[18] : صلاح عبد الصّبور، مأساة مسرحية الحلاج، ص28.
[19] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج، ص67.
[20] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج، ص 87-88.
[21] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج، ص113.
[22] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج ، ص115-116
[23] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج، ص78.
[24] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج، ص10.
[25] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج ، ص112.
[26] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج ، ص112.
[27] : صلاح عبد الصّبور، مسرحيّة مأساة الحلاج، ص53.
عدد الزوار:24



