الأبعاد الدّلاليّة للصّورة الفنّيّة في الشّعر العربيّ الحديث
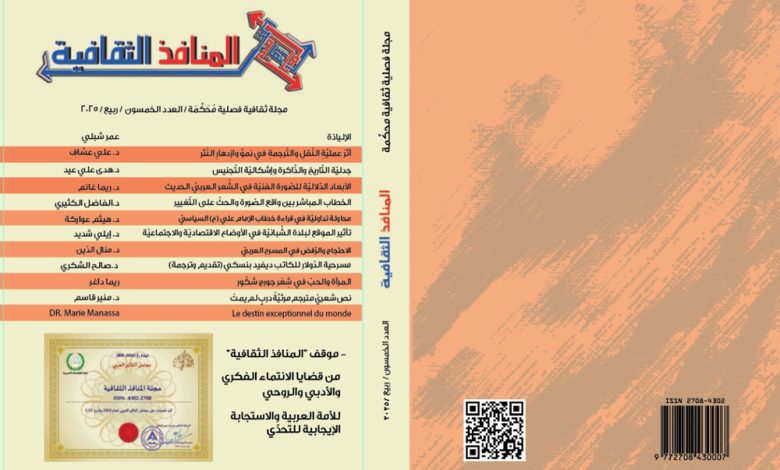
الأبعاد الدّلاليّة للصّورة الفنّيّة في الشّعر العربيّ الحديث
The Semantic Dimensions of Artistic Imagery in Modern Arabic Poetry
د. ريما أحمد غانم[1]
Dr. Rima Ahmad Ghanem
تاريخ الاستلام 30/12/ 2024 تاريخ القبول 21/1/2025
ملخّص
يتناول هذا البحث موضوعًا أدبيًّا يدور حول الصّورة الفنّيّة الّتي تظهر في القصيدة الشّعريّة بأشكال مختلفة، وبدلالات متنوّعة. ومن أبرز هذه الدّلالات أنّ الصّورة الشّعريّة تهدف إلى إظهار الانفعال العاطفيّ بشكل يُفهم منه أنّ الشّاعر يعاني هذا الانفعال المهيمن على كيانه نتيجة انصدامه بواقع المجتمع المتألّم بسبب الاعتداءات التي يتعرّض لها. وكذلك تتبدّى الصّورة الفنّيّة التّي تنطوي على دلالات الانتفاض والتّمرّد والرّفض نتيجةً للمعاناة التي كان يعيشها شعراء الحداثة من جرّاء رؤية أمّتهم تعاني الويلات والمصائب، إضافة إلى الصّورة التي تنطوي على معاني التّعاطف الإنسانيّ المنبعث من أعماق الشّاعر المتألّم لواقع الكادحين والمعذّبين في هذا المجتمع المضطرب والمتوتّر بفعل التّسلّط والهيمنة وإهدار حقوق الإنسان بالعيش الكريم، وعدم تفهّم احتياجاته وأحلامه. لذا كانت القصيدة العربيّة الحديثة بصورها الفنّيّة المتنوّعة رسالة لكلّ المجتمعات الّتي تبحث عن أمنها وسلامها. وكذلك تناول البحث صورة الحبّ والغرام الّتي ميّزت الكثير من قصائد شعراء النّهضة بجماليّة أسلوبها الإبداعيّ، وجعلتهم يبوحون بمشاعرهم وأمنياتهم وعواطفهم الجيّاشة.
الكلمات المفتاحيّة : أبعاد دلاليّة – صورة فنّيّة – صورة شعريّة- تعاطف إنسانيّ – انفعال
Abstract
This research addresses a literary topic focused on the artistic imagery found in poetry in its various forms and meanings. One of the most prominent of these meanings is that the poetic image aims to express emotional upheaval in a way that conveys the poet’s experience of a dominant emotional state due to the clash with a society suffering from the assaults it endures. Additionally, the artistic image reveals meanings of revolt, rebellion, and rejection as a result of the suffering experienced by the modernist poets, who witnessed their nation enduring misfortunes and calamities. Furthermore, the image also reflects a sense of human empathy that emanates from the poet’s suffering, who deeply feels the plight of the oppressed and the tortured in a society disturbed and tense due to oppression, dominance, and the violation of human rights, including the right to a dignified life, as well as the lack of understanding for their needs and dreams. Therefore, the modern Arabic poem, with its diverse artistic images, serves as a message to all societies seeking peace and security. The research also discusses the image of love and passion, which distinguished many of the poets of the Renaissance, with its aesthetic and creative style, allowing them to express their feelings, wishes, and intense emotions.
Keywords: Semantic dimensions – artistic image – poetic image- human empathy – emotion
مقدّمة
يتميّز الشّعر العربيّ، منذ نشأته، بحروفه اللّغويّة المعبّرة، وبصوره الفنّيّة الّتي تحمل في خفاياها الكثير من الدّلالات، أكانت دلالات رمزيّة، أو نفسيّة، أو اجتماعيّة، أو انتفاضيّة. وقد أثار الكثير من النّقّاد العرب هذه الميزة الّتي طبعت الشّعر العربيّ، قديمه وحديثه ، بعدد وفير من الصّور الّتي تحمل المعاني الدّالة على موضوعات لها صلة بالإنسان وبانتمائه الاجتماعيّ. وإذا انتقلنا إلى العصور الأدبيّة عبر التّاريخ، فإنّنا نقع على عدد وفير من القصائد الّتي تميّزت بلغتها الشّعريّة المميّزة الّتي تخفي، بين طيّات سطورها، صورًا فنّيّة معبّرة. فالصّورة الفنّيّة تتميّز بأبعادها الدّلاليّة وبتراكيبها اللّغويّة، فضلًا عن أشكالها الإيقاعيّة الّتي تؤدّي فيها النّغمة الموسيقيّة دورها الفنّيّ في إظهار أفكار الشّعراء ومشاعرهم.
تكمن أهمّية هذا الموضوع في ما تقدّمه هذه الصّورة في سياق التّعابير الإيقاعيّة من أبعاد دلاليّة تتستّر في كلّ كلمة، وفي كلّ جملة ترد في القصيدة، لأنّ الشّاعر المُبدع لا ينظم قصيدته المُميَّزة إلّا لينقل إلى السّامعين صورة عمّا يريده، وعمّا يشعر به، وعمّا يودّ أن يُنقذ به وضعًا إنسانيًّا يعانيه المجتمع البشريّ، وذلك من خلال أدبه وفنّه الإبداعيّ، لأنّ الأدب في نظر الكثيرين هو أداة تواصل وتعبير بين الأديب وبين سامعيه، فهو أداة فاعلة بيده يستعملها بقدراته الفنيّة، ليصوّر الحياة وآلامها، ويبثّ شكواه وآماله، وينشر مبادئه في حبّ الخير للإنسان، وغالبًا ما تكون وسائله المعتمَدة في نشر كلماته محصورة في سحر ألفاظه وصوره الفنّيّة، وما يمتلكه من طاقات كامنة تشحن القارئ وتثير انفعالاته، وتجذبه إلى أن يعيش لحظات من الاطمئنان والارتياح إلى إبداعيّة الشّعر وصوره الإبداعيّة. ولا عجَبَ أن ينتقل الأدب من وسيلة لتسجيل مظاهر الحياة إلى أدب يخترق أعماق النّفس الإنسانيّة،” حيث يتحوّل الأديب الفنّان إلى صوت كلّ امرئ يتمنّى أن يلمس السّعادة ويسعى، في كلّ لحظة، لنيل حياة كريمة” [2].
وبناء على ما سبق، عمدنا في بحثنا هذا إلى إلقاء نظرة على هذه الميزة الدّلاليّة واللّغويّة الّتي يتمتّع بها الأدب العربيّ، من خلال اعتمادنا على نخبة من شعراء العصر النّهضويّ الحديث، لكي نتلمّس ما قدّمته أشعارهم من دلالات معيّنة عبرَ صورهم الفنّيّة الّتي شعّت في حنايا قصائدهم المتنوّعة التي انطوت على أفكارهم البنّاءة، وحملت في خفاياها شعاع الأمل لكلّ مستمع وعاشق للفنّ الأدبيّ. ولن نتوسّع كثيرًا في عمليّة اختيار الشّعراء بل نكتفي بعدد من النّماذج الشّعريّة الّتي نستقيها من قصائدهم المتنوّعة.
لقد ارتأينا أن نقسّم بحثنا هذا إلى أربعة محاور: المحور الأوّل نتناول فيه صورة الانفعال والتّوتّر، والمحور الثّاني صورة الانتفاض والتّمرّد والرّفض، والثّالث نتحدّث فيه عن صورة التّعاطف الإنسانيّ، أمّا المحور الرّابع فحصرناه في إطار الصّورة الغراميّة أو صورة الحبّ والغرام. فكيف تجلّت دلالات هذه الصّور في شعرنا العربيّ الحديث؟
أوّلًا ــــ صورة الانفعال والتّوتّر
تخفي القصيدة الشّعريّة الحديثة دلالات معيّنة، ومن أبرز هذه الدّلالات أنّها تعبّر عن الانفعالات والاضطرابات النّفسيّة الّتي تصيب الشّاعر حينما يكون في مرحلة إعداد القصيدة وتأليف تناغمها الإيقاعيّ وتراكيب كلماتها، فيصبّ حالته المتوتّرة على أجواء هذه الصّورة. فإذا كان منفعلًا أو غاضبًا أو منتقدًا وضعًا لا يرتاح له، فالصّورة الشّعريّة ستأتي، حتمًا، حاملة في طيّاتها الكثير من المعاناة والارتباكات الّتي يكون الشّاعر غارقًا في أجوائها. لهذا نجد الكثير من الألفاظ التي تعبّر عن هذا الانفعال منثورة في حنايا القصيدة بحسب الوضع الانفعاليّ للشّاعر. فالصّورة الشّعريّة ترتبط، غالبًا، بالصّوت اللّغويّ المعبّر والمتجانس مع المعنى. فهذا الصّوت ما هو إلّا أداة التّواصل أو التّعبير عن الأحاسيس، وقد عرَّفَ ابن جنّي اللّغة بأنّها أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم[3].
إذا أمعنا النّظر في بعض القصائد العربيّة الحديثة سنلمس آثارًا متوتّرة وانفعاليّة، وذلك نتيجةً للوضع النّفسيّ الّذي يعانيه الشّاعر. فكم من قصيدة تعبّر عن حزن كاتبها، وعن ألمه وعن حبّه الفاشل، وعن ضعفه إزاء مشكلة تعترضه، فيصوّر جام غضبه، وانفعالاته في أدبه، من خلال ألفاظه وكلماته الإيقاعيّة الّتي تنقل الصّورة الفنّيّة محمّلة بخفايا هذا الانفعال. لهذا تعتبر الصّورة الفنيّة أداة الشّاعر ووسيلته الّتي يجسّد من خلالها ما يختلج بداخله من مشاعر وانفعالات، وهي الأساس الّذي نرتكز عليه لكي نتعرّف إلى جودة الشّاعر وأصالته. فهي قوام الشّعر الّذي لا غنى عنه، وجوهر من جواهره الأساسيّة[4]، كما نجد في قول أدونيس :
يَمحو وجهَه يكتشفُ وجهَه
يتقدَّم الخطفُ تلبسكِ فتنةٌ بفجرها الأوّل
يتقدّم الوقت .. أين المكان الذي تُزْمِنُ فيه الحياة؟
تتقدَّم العتمة أيّة رَجَّةٍ أنْ أوزِّعكِ في كريّات دمي
وأقولَ أنتِ المناخُ والدّورة والكُرَة
أيّة زلزلة؟ [5]
نستشفّ من خلال هذا الشّاهد الشّعريّ، كيف تسير ألفاظ الانفعال بين حنايا الكلمات لتهب الكلام نوعًا من الاهتزاز الّذي حرّك أعماق الشّاعر، وما يشعر به إزاء الوضع الاجتماعيّ المأزوم الّذي يعيشه. فهذا المحو للوجه، ومن ثمّ العودة إلى اكتشافه، والفتنة الّتي تلبس الحبيبة، والوقت الّذي يتقدّم.. كلّها ألفاظ تدلّنا على ارتباك الصّورة واضطراب الشّاعر الّذي يظهر انفعاله وتوتّره عبر هذه الكلمات أتت لتدلّنا على الصّورة الانفعاليّة الّتي رسمها حينما واجه مشاكله المتعدّدة. فسؤاله عن المكان وزمن الحياة ينطوي على تضعضع وارتباك، فهو تائه في خضمّ هذه الحياة ولم يعُد يُدرك حدود المكان، خصوصًا أنّ الوقت يتقدّم ولا يتوقّف، وأنّ العتمة بدأت تهيمن على أجوائه، والارتجاج بدأ يخترق كريات دمه، حتّى أنّ الكلمات (فتنة، رجّة، زلزلة) راحت تُضفي على أجواء هذه الصّورة نوعًا من الانفعال العاطفيّ إزاء ما يتعرّض له الشّاعر من معاناة مع حبيبته، فلا يقبل أن يحادثها بهدوء، وإنّما بنبرة فيها الكثير من المعاني المخفيّة، حين يستعين بأصوات الأحرف اللّغويّة ليصوّر المشهد وكأنّه يعيشه لحظة بلحظة. فكلمة زلزلة تتكوّن من أحرف صوتيّة مثيرة للمشاعر وللأحاسيس، فمجرّد أن تدخل أذن السّامعين، يدبّ في أعماقهم خوف وارتعاد، لأنّ الصّوت المنبعث من اتّحاد أحرف هذه الكلمة له دلالات بعيدة، من أبرزها دلالة الارتعاد، وكذلك في استخدامه لكلمة ( رجّة) الّتي لم يتأخّر عن إبراز البعد الدّلاليّ لها والّذي يمكن حصره بما تحمله كلمة زلزلة. فالرّجّة غالبًا ما تسبق الزّلزلة، في المفهوم الجغرافيّ، وهذا ما أراده شاعرنا لكي يجعلنا نستشعر بما يمرّ به من ألم ولوعة في تقاربه مع هذه الحبيبة الّتي أثارت فيه هذه الانفعالات والتّوتّرات العاطفيّة غير المستقرّة.
وما نلاحظه في كلام أدونيس، أيضًا، هيمنة الأفعال المضارعة ( يمحو، يكتشف، تُلبسك، يتقدّم، تتقدّم، أوزّعك) وهي أفعال لها وزن زمنيّ – أفعال مضارعة – معيّن له دلالة الاستمرار من دون توقّف. فالإحساس بهذا الزمن الحاضر يُضفي على أجواء القصيدة نوعًا من الحركة المستمرّة الّتي لا تتوقّف عند حدّ معيّن، وهذا ما قصده أدونيس حين أراد أن يربط الوقت بحركيّة المكان، ويربط هذين الاثنين بحركيّة الحياة (يتقدّم الوقت أين المكان الذي تُزْمِنُ فيه الحياة؟)، فالإحساس بالزّمن يحدّد موقف الشّاعر من العالم والوجود، حيث يخلع على المكان لونًا معيّنًا من خلال ربطه بحركيّة الزّمن، فيصبح الزّمان مرتبطًا بسلوك الشّاعر كقوّة محرّكة للفعل الإنسانيّ [6] . والتّرسيمة الآتية تكشف عمق توتّره الانفعاليّ:
يمحو وجهَهُ = يكشفُ وجهَهُ ( تناقض بين المحو والكشف)
الفتنةُ = تلبِسكِ = فجرَها الأوّل ( جمال الفجر يُلبِس الحبيبة)
يتقدّم الخطف = يتقدّم الوقتُ = تتقدّم العتمةُ ( استمراريّة الحياة)
أيّةُ رجّة = أيّةُ زلزلة ( اضطراب وزلزلات)
أنتِ = المناخ = الدّورة = الكرة
( الحبيبة هي الكون في نظر الشّاعر المتوتّر)
لنسمع الشّاعر أحمد عبد المعطي حجازي يقول :
ثورة ، ثورة .. شعبيّ في الشّطّ الأبيض ثارْ
ضرباتُ جناحك يا نسري، في الغرب ثارْ
آه، لو أنّ جناحَك فوقَ المشرق طار..
لو أنّ النّار سرت في باقي الدّار
يا ويلي يا ويلي، يا أحزاني يا قضبان اللّيل
غوري فطلائعنا فاضتْ كالسّيل [7]
يحاول الشّاعر، من خلال هذه الصّورة التّعبيريّة، أن يصوّر غضبه الانفعاليّ إزاء ما يحدث في الشّطّ الأبيض وفي المغرب، وأن يثير الحماسة في قلوب الّذين يستمعون إليه، وأبرز ما يهمّه أن يصوغ صورته هذه في محتوى انتفاضيّ معبّر، مستعملًا ألفاظًا مميّزة بصوتها الإيقاعيّ الّذي تفوح منه روائح الانفعال والغضب، فكلّما استمعنا إلى كلمة ثورة مكرّرة مرّتين نلاحظ أنّ الصّورة تخفي غضبًا وانفعالًا، ولا تدعو إلى الهدوء والاتّزان، وكذلك في استماعنا إلى قوله ( لو أنّ النّار سرت في باقي الدّار) نكتشف الدّعوة الثّائرة إلى تنفيس الغضب والاحتقان إزاء الغاصبين والمعتدين على أرض وطنه.
وفي نظرة معمّقة إلى الاستخدام اللّغويّ في هذا الشّاهد نلاحظ سيطرة حرف التّمنّي ( لو) على المضمون، وهذا يعني أنّ أسلوب التّمنّي الّذي لجأ إليه الشّاعر قد يكون يخفي دلالات معيّنة، من أبرزها أن يكون التّمنّي محصورًا بأمر لم يحدث، والشّاعر يتوق إلى أن يتمّ حصوله كي ترتاح أعماقه الثّائرة. فهذا التّفاعل بين كلمة (لو) وبين حرف ( أنّ) ألّف وحدة تركيبيّة أفرزت دلالة تواصليّة بين الشّاعر وبين أمنيته الّتي لم تتحقّق. فالجملة، في مفهوم اللّغويّين، تتركّب من وحدات دالّة، تتفاعل مع بعضها البعض لتشكّل العلاقة المعنويّة المتأتّية من الفعلين الماضيَين ( طار) و(سرت)، وهذا يعني أنّ التّمنّي لم يحصل في الماضي، وهذا لا يستدعي الحصول بل عدمه، لأنّ عدم الاستدعاء يدلّ على أنّ التّمنّي لم يقع في الماضي أو قد لا يقع في المستقبل[8]. وإلى جانب ذلك، استخدم الشّاعر حرف النّداء ( يا) الّذي تكرّر أربع مرّات (يا ويلي يا ويلي، يا أحزاني يا قضبان اللّيل)، وذلك ليُظهر أهميّة الويل الّذي أصابه وأصاب مجتمعه، وكلمة ويل بحدّ ذاتها تحمل دلالة المصيبة الّتي يرتعب منها النّاس بكلّ ألوانهم وأشكالهم. والتّركيز، هنا، كان في حصريّة الويل بذاتيّة الشّاعر، بأن جعل نداءه محصورًا بالمصيبة الّتي ألمّت به، وهذا ما أراده بأن تكون العلاقة بين المتكلّم والمخاطب واضحة في أن يكون الأمر محصورًا بالمتكلّم أي الشّاعر حتّى لا يقع المخاطب في لُبس في فهم المنطوق ، كي يفهم المخاطب رسالة المتكلّم الإبلاغيّة فهمًا صحيحًا دون أدنى ارتباك في هذا الفهم [9] . وفي مكان آخر، يقول البيّاتي معبّرًا عن انفعالاته:
سأدوس بقدمي دعاة الفنّ والمتحذلقين
وعجائز الشّعراء والمتسوّلين
وأحطّم الأشعار فوق رؤوسهم…[10]
يظهر تأثير التّوتّر والانفعال بوضوح في شعره، من خلال تشكيل هذه الصّورة التّعبيريّة وطريقة إبداعها، فالشّاعر غاضب من الّذين يدّعون الفنّ، ويتسولونه، ويتحذلقون، فهو يأبى أن يرى هذا الفنّ الجميل يخترقه المتسوّلون الّذين يدّعون أنّهم عباقرة الشّعر. فيستعمل، في كلامه هذا، صورًا صوتيّة معبّرة، تتجلّى من خلال المستويات الصّرفيّة، كاستعماله الأسماء المشتقّة “المتحذلقين” و”المتسوّلين”، وهي تعابير لفظيّة تثير معاني الدّهاء والرّيبة. كما أنّ المستوى الصّوتيّ في عبارة (سأدوس ) حمل معاني القوّة والشدّة، والّتي تخترقها مستويات الغضب والانفعال والتّوتّر، فالفعل (داس) له دلالة احتقاريّة وإذلاليّة، وهي الغاية الّتي قصدها الشّاعر، بحيث يكشف عن مدى انفعاله ممّا يحدث من خلال هؤلاء المتحذلقين الّذين يدّعون الفنّ وهم عنه غياب. من هنا يتبيّن أنّ الشّعر لا يحمل فقط صور الفرح والحبور، وإنّما يحمل أيضًا صور الاضطراب والقلق المنفعل. فاللّغة الشّعريّة، بحدّ ذاتها، لها مقوّماتها وبنيتها الّتي تجعلها وحدة متماسكة يصعب الفصل بين أركانها كي لا تضيع المعاني، وتختلط الأمور على القارئ والسّامع، على اعتبار أنّها نظام متكامل، فلا يمكننا النّظر إليها مفردة بل من خلال الإطار العامّ الذي يؤلّفه نظام لغة من اللّغات[11]. فاللّغات، كما يقول ابن خلدون، كلّها ملكات شبيهة بالصّناعة، إذ هي ملكات في اللّسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها، وليس ذلك بالنّظر إلى المفردات، ” وإنّما هو بالنّظر إلى التّراكيب، فإذا حصلت الملكة التّامة في تركيب الألفاظ المفردة للتّعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التّأليف الّذي يطبّق الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتكلّم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسّامع، وهذا هو معنى البلاغة” [12] . وإذا استمعنا للشّاعر نزار قبّاني يقول على لسان المرأة :
ماذا؟ أتبصقني؟
والقيءُ في حلقي يدمّرني
وأصابع الغثيان تخنقني
ووريثك المشؤوم في بدني
والعار يسحقني…[13]
لا شكّ في أنّ التّوتّر والانفعال اللّذَين انتابا الشّاعر إزاء واقع المرأة الأليم دفعاه لأن يصوّر، في شعره، ما يتوق إليه في عالم الواقع، وذلك بأن يعبّر عن غضبه إزاء ما تعانيه المرأة من الرّجل المتسلّط على كيانها. فهذه الصّور التّعبيريّة تحمل في طيّاتها رفضًا انفعاليًّا، وتتركّب من ألفاظ لها مكانتها التّصويريّة في هذا الكلام. فالألفاظ الآتية : أتبصقني، القيء، الغثيان، المشؤوم، هي ألفاظ تتميّز بصوتها المعبّر الّذي له تأثير في النّفس، ويحمل في أبعاده الدّلاليّة صورة التّحسّر والتّوتّر. فالشّاعر قد نجح في تصوير انفعال المرأة وغضبها من الّذي يتحكّم في مصير حياتها، فهي، من خلال تصوير الشّاعر لمعاناتها، تعبّر عن رفضها لاحتقار الرّجل لها، وعن أحاسيسها كامرأة منكوبة تحمل وريث هذا الرّجل المتنكّر لوجودها، والمتخلّي عنها، ما حمل الشّاعر إلى أن يتوتّر وينفعل من تصرّفه، فيبثّ نقمته على لسانها.
لقد استطاع نزار قبّاني، من خلال هذه الصّورة، أن يعبّر عن امتلاكه لعبة الانفعال الأنثويّ، وذلك عبر استخدامه الإبداعيّ لألفاظ معبّرة عن الصّورة الشّعريّة، فبين ( يدمّرني، ويخنقني، ويسحقني) صلة قرابة وتناغم، فالتّدمير والخنق والسّحق ألفاظ تحمل في أبعادها الدّلاليّة صورة الموت وما تخفيه من انفعال وتوتّر وغضب . ولا غرابة أن يقول نزار : “قصيدتي هي لافتة تحمل صوت التّمرّد، وتحدّد موقفها السّياسيّ بغير مواربـة، وهي بذلك عمل إنسانيّ يصطبغ بالضّجة والثّبات على المبدأ، وعليه فإنّني لا أهتمّ بصورة هـذه المظاهر، وكيف تبدو بقدر اهتمامي بجديّة الأثر الّذي تتركه، والنّتائج الّتي تحقّقها”[14] .
غالبًا ما يكون الانفعال في الصّور الشّعريّة مترافقًا مع التّوتّر والغضب، وبخاصّة في شعر الانتفاضات الشّعبيّة والثّورات، ولكنْ من ناحية ثانية قد يحمل شعر الغزل الكثير من الصّور المعبّرة عن حالات الغضب والانفعال في حال كانت العلاقة متوتّرة بين الشّاعر وحبيبته، يقول نزار قبّاني :
أحبّك جدًّا وأعرف أنّي أعيش بمنفى وأنتِ بمنفى
وبيني وبينك ريحٌ وغيمٌ وبرقٌ ورعدٌ وثلجٌ ونـار
وأعرف أنّ الوصول لعينيك وهمٌ،
وأعرف أنّ الوصول إليك انتحـار
ويسعدني أن أمزّق نفسي لأجلك أيّتها الغالية،
ولو خيّروني، لكرّرت حبّك للمرّة الثّانية [15]
الشّاعر، هنا، يصوّر انفعاله العاطفيّ الّذي لم يتقيّد بأصول السّيطرة على هذا الانفعال، بقدر ما اعتمد على المستويات اللّغويّة الّتي تحمل صور العاطفة المتوتّرة لكي يصوّر ما يعانيه. فالرّيح والبرق والرّعد والنّار هي ألفاظ صوتيّة تثير دلالات انفعاليّة وتعبّر عن معاناة الشّاعر الّذي تتحكّم فيه الحبيبة، ولا يقبل إلّا أن يعبّر عن عاطفته الغاضبة إزاء تلك المسافة الّتي تبعده عنها، فيقرّر أن يستعمل الفعل ( أمزّق نفسي) للدّلالة على توتّره العاطفيّ الذي يتحكّم بوضعيّته كشاعر مغروم بحبيبة لا يستطيع الوصول إليها. فالشّعر، إذًا، يقوم على اللّغة. وهذه اللّغة هي الّتي تتحكّم في صور الشّاعر وأبعاد ما يريده من المعاني. وكلّما كان متوتّرًا كلّما كانت اللّغة معبّرة عن ذلك، حتى وإن أراد هو أن يبتعد عن تصوير هذه المعاناة والتستّر عليها، فهي قد تظهر بفعل حالته النّفسيّة الّتي لا يقدر أن يتستّر عليها. فالشّعر يجنح، أحيانًا، إلى نسق من الأشياء يخالف ما نرى وما نعرف من أجل الوصول إلى حقائق مستقرّة باقية ومن أجل ارتياد كشف دفائن وأسرار[16]. ومن البديهيّ أن نقول إنّ الشّاعر لا ينقل لنا العالم الخارجيّ كما هو، إنّما يشكّله من جديد، بأسلوبه الخاصّ، فيهب له معنى هو خلاصة تجربته [17]. فالتّرسيمة الآتية تكشف عمق الانفعال في صدر شاعرنا:
الرّيح = لها قوّة ثائرة قد تطيح بالأشياء دون هوادة
الغيم = له قوّة التّعتيم والإخفاء وهيمنة الظّلام على الانقشاع
البرق = له تأثير قويّ على السّمع، ممّا يولّد الذّعر والخوف
الرّعد = له قوّة مرافقة للبرق وله تأثير مرعِب ومُخيف
النّار = لها قوّة التّدمير والحرق والاندثار
يقول خليل حاوي معبِّرًا عن اضطرابه الانفعاليّ :
عُدْتُ في عينيّ طوفانٌ مِنَ البَرْقِ ،
ومِنْ رعْدِ الجِبالِ الشّاهقَهْ،
عُدْتُ بالنّار الّتي مِنْ أجلِها،
عرَّضْتُ صدري عاريًا للصّاعقَه،
جَرفَتْ ذاكرَتي النّارُ وأمسي..
كلُّ أمسي فيكَ يا نَهْرَ الرّمادْ[18]
إنّ التّصوير الإبداعيّ المتجلّي في هذا الشّاهد، يرتكز على الألفاظ والتّعابير الّتي تشير إلى توتّر الشّاعر المضطرب، فكلماته تنطوي على أبعاد دلاليّة معيّنة، وتنسجم فيما بينها بشكل متوازٍ ومترابط. وفي تصويره لهذه الحالة الانفعاليّة نستشفّ مظهرًا من مظاهر حالته المتوتّرة، إذ بدت عاطفته تنوء بالعذاب والقهر، فهو لم يلجأ إلى هذه الكلمات : طوفان، برق، رعد، جبال شاهقة، النّار، الصّاعقة، نهر الرّماد، إلاّ ليعبِّر عن عمق مأساته وعن الغضب الّذي يعتمر صدره إزاء واقع أليم امتلك عليه عواطفه واضطرابه. فكلمة طوفان بتركيبتها الحرفيّة والصّوتيّة تدّلنا على عمق الانفعال وقوّة الاضطراب المشتعل في داخله، لأنّ انفعاله الوجدانيّ لم يجد له ما يعينه على سكون النّفس المتوتّرة، وما صورة نهر الرّماد سوى شكل من أشكال الحياة المتوقّفة عند شاطئ الموت، وما صورة الطّوفان بمعانيه اللّغوية سوى تعبير عن الغضب الشّاسع الّذي لا يحدّه حدّ، والّذي يجتاز كلّ شيء يقف أمامه، فكيف بالحريّ غضب شاعرنا وانفعاله اللّامحدود إزاء معاناته الدّاخليّة، فهو لم يلجأ إلى هذه الكلمة والكلمات الأخرى إلّا ليعبّر عن حقيقة واقعه الأليم، فالألم كان متحكّما في أعماقه، وذلك جرّاء ما كان يشعر به إزاء ما يحدث لمجتمعه العربيّ من تصدّعات وارتباكات، ما جعله يتأثّر، ويغضب، ويثور، وفي قلبه عاطفة انفعاليّة لا تهدأ، وهذا قدر كلّ شاعر يأبى أن يرى الوطن العربيّ تمزّقه الاضطرابات والإشكالات والأحداث الأليمة. هكذا بدت الصّورة الانفعاليّة، فكيف تبدو الصّورة الانتفاضيّة في شعرنا العربيّ الحديث؟
2- صورة الانتفاض والتّمرّد والرّفض
إذا ألقينا نظرة عميقة على الشّعر العربيّ الحديث سنقع حتمًا على صور فنّيّة متنوّعة ومعبّرة عن حالة الانتفاض والتّمرّد، وذلك بسبب ما كان يعيشه شعراء الحداثة في خضم من المشاكل السّياسيّة والاجتماعيّة الّتي كانت سائدة في عصرهم. فالانتفاض في هذه الصّورة الشّعريّة ينقل إلينا معاناة الشّعراء، ونظرتهم إلى الواقع الأليم. وها هو الشّاعر محمد الفيتوري لا يتوانى عن التّعبير عن رفضه لهذا الواقع من خلال صورته الفنّيّة الّتي تنقل الوضع مجبولًا بأحاسيس الرّفض والغضب، لنسمعه يقول :
لتنتفضْ جثّة تاريخنا، ولينتصِبْ تمثال أحقادنا
آنَ لهذا الأسود المنزوي المتوارى عن عيون السّنا
آنَ له أن يتحدّى الورى، آنَ له يتحدّى الفنا
فلتنحنِ الشّمسُ لهاماتنا.. ولتخشعِ الأرضُ لأصواتنا [19]
تحمل هذه الأبيات صورة معبّرة عن واقع الشّاعر الّذي يتالّم، في أعماقه، إزاء الأحقاد الّتي تنتشر في وطنه. فهو يأبى أن تكون هذه الأحقاد مغروزة في نفوس الكثيرين من أبناء بلده، ولا أحد قادر على السّيطرة والتحكّم بها. لهذا نراه ينتفض مطالبًا أن تشكّل الأحقاد تمثالاً جامدًا لا يتأثّر بما حوله من آلام وأخطاء وتحكّم في رقاب الشّعوب. ويأبى أيضًا أن يبقى المرء متواريًا وساكتًا على ما يحدث، فيرفض ذلك ويقف مناديًا بأعلى صوته لكي تنحني الشّمس، والورى والأرض أمام أصوات الأحرار المطالبين بالحرّيّة والمساواة والعدالة. وما لجوؤه إلى تصوير تطلّعاته من خلال الاستعانة بألفاظ مميّزة بأصواتها اللّغويّة المعبّرة سوى دليل على رفضه وعدم قبوله بهذا الواقع المأزوم. فالكلمات الآتية : تنتفض، تمثال الأحقاد والتّحدّي، والهامات، تصبّ في مجرى الانتقاد النّاقم الذي يلجأ إليه الشّاعر للتّعبير عن هذه الصّورة الفنيّة الّتي تشوبها دلالات التّوتّر والتمرّد والرّفض. وفي مكان آخر نستمع إلى الشّاعر توفيق زياد يقول :
أحبُّ لو استطعتُ بلحظة
أن أقلُبَ الدنيا لكم رأسًا على عَقِبْ
وأقطعَ دابرَ الطّغيان ..
أحرقَ كلّ مغتصِب..[20]
تتركّز هذه الصّورة الفنيّة في عنصرين أساسيّين من عناصر الانتفاض، وهما : الطّغيان، والمغتصِب. يرفض الشّاعر أن يعيش المواطن تحت نير الطّغيان، لهذا يصوّر رفضه وانتفاضته، من خلال دعوته على قلب الدنيا رأسًا على عقب، وعلى قطع دابر الطّغيان، وعلى حرق كلّ مغتصب أساء إلى الآخرين.
إنّ نظرة عميقة إلى توازن الأفعال المستخدمة في هذا الشّاهد الشّعريّ تكشف عن مدى الشّعور المنتفض القابع في أعماق الشّاعر، وهذه الأفعال الانتفاضيّة : أقلب، أقطع، أحرق، لا تتناسب مع الفعل الإيقاعيّ(أحبّ)، والّذي بدأ به شاعرنا، والّذي خفت ظلّه أمام دخول الأفعال الانتفاضيّة المذكورة، وهذا التّوازن المهتزّ بينه وبين بقيّة الأفعال يكشف أيضًا عن عمق الصّراع الأليم الّذي يجتاح أعماق الشّاعر المنتفض والمتمرّد على واقع مضطرب يؤرّقه ويُزعجه. فهذه الأفعال لها فاعل واحد هو الشّاعر الّذي يرسم تمرّده وانتفاضه على كلّ طاغية ومغتصب لحقوق الإنسان العربيّ.
وإذا تعمّقنا أكثر في الشّعر العربيّ الحديث سنقع أيضًا على مواقف رفضيّة وتمرّدية كانت تؤرّق مخيلة شعراء الحداثة، كما يقول الشّاعر محمد الفيتوري:
إنّي صحوتُ.. صحوتُ من أمسي
وذي فأسي تهدّ قبورَه هدّا
سأكونُ نارًا.. فالحياةُ تريدني نارا
وأرقصُ فوقَها رعدا [21]
الشّاعر، هنا، قد صحا من أمسه، وهذه الصّحوة لم تكن سهلة، إذ رافقها تمرّدٌ وانتفاض على أوضاع آلمته وهزّت كيانه، فاستلّ الفأس وقرّر تهديم القبور، وأن يتحوّل إلى نار تحرق كلّ شيء أساء إليه وإلى وطنه الجريح. ولا يكتفي بذلك، وإنّما يتمنّى أن يصبح رعدًا ليرقص فوق هذه الحياة الأليمة. فكلّ كلمة من كلمات هذا الشّاهد تحمل في ثناياها دعوة إلى الانتفاض والتّمرّد على أوضاع لم تكن ليرضى بها شاعرنا الثّائر. وإذا جمعنا هذه الكلمات ( نار – رعد – فأس– تهدّ) نعي عمق المأساة. فهي ألفاظ لا تتلاءم مع الأمان والسّلام، وهي كلمات ثورويّة معبّرة عن معاناة الشّاعر الّذي يأبى أن يكون فريسة لحياة لا تناسبه ولا تناسب أوضاع وطنه، فقرّر أن يثور، وثورته هذه كانت عبر أدوات لفظيّة أظهرتها تلك الكلمات المعبّرة عن هذه الصّورة الفنّيّة الواضحة. فالكلمة الانتفاضيّة يكون لها تأثير عميق في نفوس المستمعين الّذين يواكبون الشّاعر المنتفض والرّافض للأوضاع الاجتماعيّة والسّياسيّة الّتي تنوء تحت ظلّها المجتمعات البشريّة. وهذا عبد الوهاب البيّاتي الرّافض أيضًا للواقع الأليم الّذي يجتاح مجتمعه، فقد حلّقت تعابيره اللّفظيّة في أجواء هذه الصّورة الفنّيّة التّي رسمها لتعبّر عن آرائه، يقول :
لتحترق نوافذُ المدينة
ولتأكلِ الضّباعُ هذه الجيَفَ اللّعينة
ولتحكمِ الضّفادعُ العمياءُ
وليسُدِ العبيدُ والإماءُ
وماسحو أحذية الخليفة السّكران
والعور والخصيان [22]
هذه الدّعوة الى حرق النّوافذ وتحكّم الضّفادع العمياء تنطوي على إحساس انتقاميّ غاضب يعتمل صدر الشّاعر الّذي أبى إلّا أنّ يعبّر عن هذا الغضب من خلال صورة فنيّة رائعة، وإن شابتها ألفاظ مردودة اجتماعيًّا وإنسانيًّا، وهي صورة تلوّنت بألفاظ لها أصوات تعبيريّة واضحة، كالألفاظ الآتية: الضّباع والضّفادع العمياء والعور والخصيان، وهي ألفاظ صوتيّة بارزة تثير في أعماق السّامعين توتّرًا واقتناعًا بأنّ ما يقوله الشّاعر يعبّر صراحة عن غضب كلّ إنسان مأزوم ومضغوط بسبب العذاب الّذي يعانيه إزاء أوضاع اجتماعيّة مضطربة ، لا تحقّق له الأمان والاطمئنان ولا الاهتمام بضائقته المعيشيّة. وما عبارة ( ماسحو الأحذية) سوى صورة معبّرة عن الضّعف والهوان والاستجداء. وما لجوء الشّاعر إلى مثل هذه التّعابير إلّا ليبرز عمق المأساة وعمق العذاب الّذي يعانيه الشّعب. لذلك كان الفنّ اللّفظيّ في القصيدة هو صورة معبّرة عن الواقع الاجتماعيّ في كلّ أشكاله المريحة والمؤلمة. فالصّورة الشّعريّة كانت في الشّعر القديم حسّيّة، أو تزينيّة، أو عقليّة، أمّا في الشّعر الحديث فقد أصبحت تخضع لتجربة الشّاعر، وتلعب دورًا أساسيًّا في القصيدة[23].
ومن صور الانتفاض الّتي كان الشّاعر يعبّر من خلالها عن غضبه إزاء الأغنياء الّذين يتحكّمون بالفقراء وبالضّعفاء، ما قالته الشّاعرة فدوى طوقان :
وأركضُ خلفَ رغيفي وقوتي..
وفوق جبيني الضّنى والعرق
وكان لي الفنُّ والشّعرُ صوتًا
يجلجلُ في ثورة لا تلين
على الغاصبين حقوق الفقير
على السّارقين حتّى الكادحين [24]
صوت الشّاعرة، هنا، يعبّر عن أصوات الكادحين الفقراء والمعوزين في وجه مغتصبي الحقوق، بحيث بات كلامها يحمل ثورة عامرة على هؤلاء الظّالمين الّذين يتحكّمون بأوضاع العمّال الكادحين والّذين لا يحصلون على أبسط مقوّمات الحياة. فكلامها في هذا الشّاهد الشّعريّ هو دليل على غضبها وانتفاضتها على كلّ مغتصب لحقوق الفقراء والمحتاجين. فهي تشعر معهم وتتحسّس معاناتهم. فالصّورة الفنّيّة الّتي قدّمتها هنا أتت كلوحة معبّرة عن رفضها وتمرّدها على أولئك الغاصبين. وهذا دليل على أنّ الشّاعر هو صوت المعذّبين والمقهورين، وليس صوت الأثرياء المتحكّمين برقاب الكادحين. وما استعمالها لأصوات الألفاظ الآتية : الغاصبين، السّارقين، الكادحين، سوى دلالة على أنّ الصّوت المتناغم في القصيدة له تأثير نفسيّ في السّامع، بحيث يمكن أن يُثيره إمّا غضبًا أو حزنًا أو فرحًا. ولا غروَ إذا قلنا إنّ العمل الأدبيّ هو فنّ قوامه سلسلة من الأصوات التي تنبعث منها المعاني [25].
أمّا عن الواقع السّياسيّ العربيّ، فإنّ نزار قبّاني يأبى أن يرى الدّول العربيّة تنسى قضيّة فلسطين، فيثور، وينتفض على هذا الواقع الأليم حين يرى قضيّة الشّعب الفلسطينيّ تائهة في مجاهل التّاريخ، فيقول منتفضًا ومعبّرًا عن تعاطفه معهم:
يا وطني الحزين.. حوّلتني بلحظةٍ
من شاعرٍ يكتبُ شعرَ الحبّ والحَنين
لشاعر يكتبُ بالسّكين [26] ..
إنّ هذا التّناقض بين الحبّ وبين السّكين ينطوي على دلالة انتفاضيّة ورفضيّة لما يجري على السّاحة العربيّة. فاستخدام هذا التّناقض بين الكلمتين لم يكن سوى تعبير عن عمق الألم الّذي يعانيه شاعرنا إزاء القضيّة الفلسطينيّة. لقد تحوّل الشّاعر إلى ثائر منتفض حين رأى الحزن يهيمن على وطنه، فتحوّل إلى أداة انتقاميّة، لأنّ شعوره الوطنيّ يأبى أن يرى وطنه تسيطر عليه غيوم الحزن، فينتفض مستعملًا الألفاظ المناسبة والمعبّرة عن تمرّده وغضبه على واقع وطنه الحزين. فالشّعر لا يمكن أن يكون إلّا رسالة أو وسيلة تعبّر عن آراء الشّاعر وعن أحاسيسه وعن رفضه لكلّ ما يزعجه ويزعج إحساسه الوطنيّ. فالوطن بالنّسبة إليه ليس أداة تُباع وتُشترى أو أداة تمزّقها أيادي العدو وتزرع فيها الحزن والأسى. فالشّعر، عنده، كالوسيلة الإعلاميّة تنقل الأحداث كما هي، وتحمل بين طيّاتها أحلام الشّعراء وتطلّعاتهم وآراءهم وأحزانهم وأفراحهم وغضبهم. ولا عجب أن يكون نزار قبّاني من أبرز الشّعراء العرب الّذين اختاروا درب التّمرّد على كلّ شيء في الحياة، وراح ينظر إلى الكتابة على أنّها رسالة ومهمّة نبيلة، يُعرّي من خلالها الواقع الاجتماعيّ والسّياسيّ وكلّ ما يتعلّق بجوانب الحياة. وقد كان دَوْمًا يدعو إلى الثّورة وتغيير المجتمع[27] .
وإلى جانب هذه الصّور الانتفاضيّة، هناك صور فنيّة أخرى تنطوي على مشاعر إنسانيّة تتحكّم في أعمال شعراء الحداثة، وتكشف عن عمق أحاسيسهم المتعاطفة مع الآخرين. فكيف عبّروا عن إنسانيّتهم هذه؟
3– صورة التّعاطف الإنسانيّ
قد يتميّز الشّعر العربيّ الحديث بعدد من الميّزات الفنّيّة الّتي تتراءى في صوره التّعبيريّة الوصفيّة، ومن أبرز هذه الميّزات ظهور الصّور الفنيّة المعبّرة عن تلك النّزعة الإنسانيّة الّتي تقوم على أساس محبّة الآخرين والتّعاطف معهم، والدّعوة إلى مساعدة الفقراء والمعوزين، والعمل على انتشالهم من المصائب الّتي قد تواجههم أو قد يقعون في أتونها. ولم يتأخّر شعراء الحداثة عن التّعبير عمّا يشعرون به إزاء الواقع الاجتماعيّ الأليم، فكانوا يشاطرون الإنسان أحزانه وأفراحه، إن لم يكن بالمال، وإنّما بقوّة الشّعر الذي يحمل في طيّاته الكثير من المعاني المعبّرة عن أحاسيسهم وتطلّعاتهم نحو مجتمع متطوّر يقوم على محبّة الآخرين، والتّعاطف فيما بينهم. يقول الشّاعر محمد الماغوط :
إنّني أُعِدُّ ملفًّا ضَخْمًا
عَنِ العَذابِ البَشَريّ لأَرفقَهُ إلى اللَّهِ
فَوْرَ توقِيعِهِ بِشِفاهِ الجِياعْ
وَأهْدابِ المُنتَظرينْ [28]..
يرفض الشّاعر أن يرى إنسانًا على وجه هذه الأرض يتعذّب ويعيش القهر، فهو يرفض أن يشعر بالعذاب البشريّ يهيمن على المجتمع الإنسانيّ، فيستعين بشعره ليعبّر عن انتقاده لهذا الواقع الأليم، ويلجأ إلى إعداد ملفّ ضخم ليرفقه إلى الله الّذي يشفع بهؤلاء ويكون عونًا لهم ويُبعد عنهم شرور الآخرين. وفي صورته الفنّيّة هذه يستعين بأصوات الألفاظ المعبّرة الّتي تحمل المعاني البعيدة، ومن أبرزها شفاه الجياع وأهداب المنتظرين. فالشّفاه في دلالتها البعيدة تنطوي على قضيّة الإنسان الجائع أو الإنسان المُتخَم بالطّعام. وكذلك لفظة “أهداب” الّتي ترتبط بالعيون الّتي تنظر إلى واقعها الأليم بحرقة وحسرة. وهذه الصّورة الإنسانيّة المعبّرة تُغني القصيدة بصورٍ حسّيّة قابلة للحركة والنموّ. فحينما يكون الشّعر “جنسًا من التّصوير يعني هذا قدرته على إثارة صور بصريّة في ذهن المتلقّي، وهي فكرة تُعدّ المدخل الأوّل أو المقدّمة الأولى للعلاقة بين التّصوير والتّقديم الحسّيّ للمعنى” [29] . ويبدو أنّ شاعرنا كانت له نظرة تعاطفيّة إلى أبناء وطنه وإلى فئة اجتماعيّة معيّنة، هي فئة الفقراء الجياع الّذين ينتظرون لقمة عيشهم بشفاههم وأهدابهم. ولعلّ أبرز ما يدلّنا على عمق شعوره الإنسانيّ وتعاطفه مع الآخرين، أنّه يُعِدّ ملفًّا ضخمًا يرفعه إلى الله ويحتوي على الكثير من الأوجاع والعذابات الّتي يعانيها أولئك الفقراء الجائعين، ويشكو، في الوقت ذاته، من الأغنياء الّذين لا يأبهون لمعاناة الفقراء والمعوزين. ولهذا لم تعد لدى الشّاعر ثقة بالمسؤولين القائمين على الأرض، فثقته باللّه هي الأقوى وهي الّتي جعلته يحضّر الملفّ لربّ الخلْق، لأنّه الرّحيم الّذي يشفق على الإنسان بصورة عامّة.
لنستمع إلى أدونيس قائلًا :
وَلي هَذهِ السّهولُ الفِساحُ
لِيَ آهاتُ أُمَّتي وَأَمانيها
وَلِيَ كِبرياؤها والجِراحُ
أنا وَرْدٌ في هَذهِ الأرْضِ نَمّامٌ
وَعِطْرٌ مِنْ أُمَّتي فَوّاحُ [30]
إذا ألقينا نظرة عميقة إلى هذه الكلمات سنكتشف أهميّة هذا التّعاطف الإنسانيّ الّذي يكنّه الشّاعر لأبناء جلدته، فهو يمثّل صوت الأمّة، ويحمل بين ضلوعه معاناتها، ويتوق لتأمين سعادتها. وقد نجح شاعرنا في تصوير نفسه كأنّه نبض الشّعب، وهو إحساس مغلّف بإنسانيّة عميقة وبوطنيّة أعمق، وهذا واجب كلّ شاعر تعصف به مشاكل أمّته، وتترسّخ في كيانه عذاباتها وآلامها، فيرفض أن يبقى بعيدًا عن كلّ ذلك، فيلجأ للتّعبير عن وقوفه إلى جانب المعذّبين، محاولًا أن يخفّف من معاناتهم، ويكون، في آن، مداويًا لجراح الأمّة ، وناشرًا عطره الفوّاح بين أرجائها.
يرفض شاعرنا أن تكون أمّته خاضعة للذلّ والهوان، فهو يسعى بقوّته كشاعر أن يحطّم جدران الذلّ، ويمحو آثاره المتحكّمة في نفوس شعبه المقهور، لكي يجعل هذا الشّعب يستيقظ من كبوة الذلّ ويعود له عنفوانه و كبرياؤه ، ويقف كالمارد إزاء أيّ ظلم يحاول أن يذلّه أو يحتقره. وما استخدامه للعبارات الآتية : الورد النّمّام، والعطر الفوّاح سوى دليل على تعلّقه بأرضه وبوطنه وبشعبه، فالورد ينطوي على دلالات المحبّة والاطمئنان والأمان، والعطر ينطوي على دلالات الارتياح النّفسيّ والتّوسّع في نشر المحبّة بين أفراد المجتمع الإنسانيّ. فهو يوّد، في أعماقه، أن يكون رسول سلام وأمان لكلّ وطنه وشعبه المقهور. فاستخدامه لهذه اللّغة حملت دلالات معيّنة أبرزها ( الورد النّمّام والعطر الفوّاح) وهي عبارات تكشف عن عمق نزعته الإنسانيّة، لأنّ لغته هذه عبّرت عمّا يحمله في أعماقه من مشاعر المحبّة إزاء الآخرين. فلغته تنبع من داخله، من مشاعره وأحاسيسه، فالكثيرون يعتبرون أنّ اللّغة ركيزة أساسيّة من ركائز التّفاهم بين البشر، ولهذا يعتبر عدد من النقّاد بأنّ الكاتب يُعرَف بلغته وليس بأفكاره، فإنْ وجدَت الأفكار، فلا يمكن أن تحيا خارج نطاق اللّغة، لأنّها تتولّد منها، وبها تعرِّف عن نفسها[31]. وفي مكان آخر يقول الشّاعر خليل حاوي :
اخرسي يا بومَةً تَقْرَعُ صَدري
بومَةُ التّاريخِ مِنِّي ما تُريدْ ؟
في صَناديقي كُنوزٌ لا تَبيدْ
فَرَحي في كُلِّ ما أَطْعَمْتُ
مِنْ جَوْهَرِ عُمْري
فَرَحُ الأيدي الّتي أَعْطَتْ وإيمانٌ وذِكْرى
إنَّ لي جَمْراً وخَمْرا[32]
تتجلّى في هده الكلمات معاني التّضحية الّتي أبرزها الشّاعر من خلال كلّ كلمة نطق بها. فهو يعترف أنّ في صناديقه الكثير من العطاءات الّتي قدّمها للأيدي الّتي امتدّت إليه تطلب المعونة والمساعدة، وهو يعترف بأنّ فرح الأيدي كان فرحه هو في كلّ ما أعطى من جوهر عمره. فتعاطفه الإنسانيّ يتكشّف من خلال ثنايا كلماته، ويظهر في حلّته البهيّة، لأنّ خليل حاوي كان من الشّعراء الّذين يرفضون الخضوع للظّالمين والمغتصبين لأرض وطنه، لذلك نراه يخبّئ في صناديقه الكثير من الكنوز الّتي لا يمكن أن تندثر، لأنّها كنوز من العطاء والتّضحيات الّتي قدّمها هو بذاته للإنسانيّة جمعاء.
ما نلاحظه، في هذا الشّاهد، أنّ شاعرنا اعتمد عددًا من الألفاظ الّتي تشير إلى عمق تأثّره بالواقع الإنسانيّ الّذي يعيشه أبناء شعبه. فالألفاظ (فرح الأيدي، الزّاد، فرحي، جوهر عمري..) هي ألفاظ تحمل في أبعاد دلالاتها نوعًا من الشّعور العاطفيّ إزاء الآخرين، فلهذا مدّ يد المساعدة لهم، فانزرعت في أعماقه نغمات الفرح الّتي انبثقت من جوهر عمره رافضة بومة التّاريخ الّتي كانت تؤرّقه، فهو لا يودّ الرّجوع إلى الماضي الشّنيع، وإنّما يودّ أـن يبقى في الحاضر لكي يشعر بفرح ما أعطاه وما قدّمه من جوهر عمره لكلّ معذّب ومقهور. فهذه الكنوز الموجودة في صناديقه الّتي لا تبيد هي كنوز العطاء والتّضحيات والذّكريات الّتي عاشها وكانت بالنّسبة إليه الدّاعم الأساسيّ لحياته المعطاء. ولا نستغرب إذا علمنا أنّ شاعرنا الحاوي قد “حمل الهمّ القوميّ والأزمة الحضاريّة صليبًا اعتلاه، وسمّر يديه طوعًا على خشبته، ومات فدى إيمانه بالدّور الطّليعيّ للشّعر، وبالرّسالة الحضاريّة الّتي يحملها، وبالرّؤية المستقبليّة التي كرّس حياته للتّعبير عنها”[33] .
وها هو أدونيس يقول متغنّيًا بانتمائه الإنسانيّ :
أَنا جيلٌ في أُمَّتي، وأنا فَرْدٌ
مِنَ الجيلِ، بَلْ أنا كُلُّ جيلِ
أَيْنَما كُنْتُ، كُنْتُ في صَدْرِها أَحْيا
وَفي روحِها الكَبيرِ الأَصيلِ [34]
يفتخر أدونيس بانتمائه إلى أمّته، وقد برز ذلك من خلال التّناقض بين كلمتين تشكّلان أساسًا لكلامه، وهما (الجيل) و(الفرد)، وهذا دليل على اندماجه في الكلّ، وهو اندماج يدلّنا على تعاطفه الإنسانيّ إزاء جيل أمّته، وإنّ انتماءه كفرد له التّأثير الكبير في هذه الأمّة جمعاء، لأنّه يحيا في صدرها، وفي روحها. ولا يمكنه أن يتناول في حديثه هذه الأمّة إلّا ويكون فيها فردًا فاعلًا ومؤثّرًا في تطلّعاتها نحو الحرّيّة. ومن دونه لا يمكن لهذه الأمّة أن يكتب لها النّجاة، لأنّ الشّاعر بات يمثّل داخل الأمّة فردًا متفاعلًا مع بقيّة الأفراد ليكون لهم العون والقوّة التي يحتاجونها لمقاومة المغتصبين لأرضهم فهو له تأثير كبير فيهم، من خلال تعاطفه معهم، كأنّه الشّخص القادر على مساعدتهم وإعانتهم في كلّ ما يحتاجونه. والملاحظ أيضًا أنّ الشّاعر يمثّل بنفسه الجيل بالكامل حين يعتبر نفسه أنّه جيل الأمّة إلى جانب أنّه فرد منها. وهذا يدلّنا على محاولته الاندماج والذّوبان في الأمّة حتى تصبح هي ذاته وهو ذاتها، ممّا يعني أنّ هذا الاندماج ما هو إلّا دليل على حبّه لهذه الأمّة وتعاطفه مع مكوّناتها، فدعا إلى أن يكون هو جيل هذه الأمّة تستفيد منه ومن عطاءاته. وشعوره هذا يشكّل مظهرًا من مظاهر الأنانيّة والنّرجسيّة، حين يعتبر نفسه جيل الأمّة، لا بل كلّ الجيل. ويمكن أن نلاحظ التّكرار الّذي طغى على بنية الشّاهد، فالتّركيز على تكرار كلمة جيل ثلاث مرات دليل على أنّ هذه الكلمة لها تأثيرها الفعّال في نفسيّة الشّاعر وفي عمق مشاعره، وهي تحمل معنى أوسعَ يحوي الكثير من المعطيات الفكريّة. فالجيل هو مرحلة زمنيّة شاملة لمعطيات المكان والزمان، ولنوعيّة الّذين يقطعون في هذه المرحلة الزّمنيّة، وشاعرنا كان يهمّه أن يتحوّل إلى هذه المرحلة ليصبح عاملًا تاريخيًّا لأمّته، مجبولًا بتراثها ومتلوّنًا بتحرّكّها الزّمنيّ، لأنّ الجيل يشمل عددًا كبيرًا من الأفراد الّذين يعيشون في مرحلة زمنيّة معيّنة مميّزة بشكلها وبمقوّماتها التّاريخيّة. فهناك جيل الطّفولة، وجيل الشّباب، وجيل الكهولة. وكلّ جيل له استقلاليّته، ومنطلقاته الذّاتيّة.
وفي مكان آخر يطلّ أنسي الحج محاولًا إظهار نفسه واعظًا لمن يحاول أن يكون متعاطفًا مع الآخرين، لنسمعه يقول :
مَنْ لا يُنْفِقُ ذاتَهُ، مالَه، قُواهُ،
ماذا يَسْتطيعُ أَنْ يَضَعَ في كلامِهِ ..
السّخاءُ هو الخَلْقِ. لا أقولُ العطاءْ.
العَطاءُ صَغيرٌ أمامَ السّخاء
أقولُ السّخاءَ بَلِ الإفراطَ ..
لا هَوادَةَ في وَهْبِ الذّاتْ[35]
لقد توسَّل الشّاعر عددًا من الألفاظ ليبرهن عن عمق عاطفته الإنسانيّة، وذلك من خلال استخدامه كلمتين لهما التّأثير الدلّاليّ في معنى التّعاطف الإنسانيّ وهما ( السّخاء والعطاء) وهاتان الكلمتان تدلّان على معنى العطف والحنان والتّعاون، لأنّ العطاء يُقدّم للآخرين كمساعدة لهم في حال كانوا بحاجة إلى شيء ما، والسّخاء هو أقوى دلالة من العطاء لأنه ينتمي إلى الكرم والجود. فالعطاء، كما يقول الشّاعر، هو صغير أمام السّخاء. فالعطاء السّخيّ لا يسأل إلى مَن يُعطى، وإنّما هو يتستّر في لباس المساعدة والإعانة وسدّ احتياجات المجتمع الإنسانيّ. وكلّما كان السّخاء كثيفًا كلّما باتت الإنسانيّة مكتفيّة ولا ينقصها أيّ شيء آخر. فالسّخاء، باختصار، لا يكون في الإنفاق الماديّ كما يعتقد البعض، وإنّما في الإفراط بلا هوادة في التّضحية بالذّات كما يعبّر شاعرنا، وهذا ما نعتبره أسمى العطاء.
ما يلفت نظرنا في كلام أنسي الحج، ذلك التّركيز على قضيّة وَهْب الذّات، وهو ما يخفي نوعًا من التّضحية بالذّات من أجل الآخرين، وهذا النّوع من التّضحية يخفي نزعة إنسانيّة طالما تمتّع بها شعراء الحداثة، لأنّهم كانوا يلاحقون الأحداث الأليمة التي كان يرزح تحتها الشّعب العربيّ. فالإنسان يحاول بشتّى الطّرُق أن يُظهر قدرته على التّعاطي مع أبناء شعبه، أكان من خلال التّعاون أو من خلال التّضحية بالذّات من أجلهم. لهذا نرى الإنسان يجهل أوان رحيله وأوان مجيئه، ولكنّه ينظر إلى ذاته في محاولة لسبر أغوارها قدر المستطاع، ليجعل من نفسه المحور الأساسيّ الّذي تدور عليه أفعاله وهمومه ومعظم تفكيره [36]. ولا شكّ في أنّ الشّاعر هو إنسان قبل أيّ أمر آخر، يشعر ويحسّ إزاء أيّ أمر يراه مؤثّرًا في كيانه وفي أفكاره وفي أحلامه، ولهذا لا يتوانى عن ملاحقة كلّ الأحداث الّتي تجري أمام ناظريه، فيتفاعل معها وينسجم مع تغيّراتها، بحسب ما يتوافق مع تطلّعتاه ومعتقداته. هذا على صعيد صورة التّعاطف الإنسانيّ، أمّا على صعيد الحبّ والغرام والهُيام، فإنّ نظرة شعرائنا تأخد منحًى مختلفًا. فكيف ظهرت دلالات هذه الصّورة في شعرهم؟
4- صورة الحبّ والغرام
الحبّ في الشّعر له مقوّماته وأبعاده الفنّيّة، أكان عبر الألفاظ المستخدمة أو عبر الإيقاع الموسيقيّ، والتّناغم بين الصّور المعبّرة، فما من ديوان شعريّ إلّا وتخلّلته بعض القصائد الغراميّة التي عبّر الشّاعر من خلالها عن حبّه لحبيبته، أو صوَّر بالكلمة والحرف حالته النّفسيّة وعاطفته المضطربة إزاء الحبيب إذا سادت علاقتهما بعض الفتور أو الاضطرابات. وما من شاعر إلّا وكان موضعًا لانتقاد الحبيبة، أو لمعاتبته على تقصيره في ملاقاتها وفي عدم السّؤال عنها. فالشّعر كان دومًا الرّسالة الأكثر تأثيرًا في أيّ علاقة غراميّة بين الحبيبين، حيث كان الشّاعر يصبّ فيه كلّ ما يعانيه من هجر الحبيب له، أو كان سبيلًا للتّعبير عن حبّه الصّادق وإخلاصه للحبيب، حتى وإن كان بعيدًا عنه. يقول الشّاعر معبّرًا عن حبّه :
كانَ في وجْهِكِ المُسافِرِ، في وجْهِيَ
نَجْمٌ، وكانَ ليلٌ يَجوسُ
وتلاقَتْ يَدانا.. تلاقَتْ خُطانا
وتلاقَتْ رُؤانا.. وَهَبَطْنا، رَأيْنا وَغِبْنا
وَظَهَرْنا وَغِبْنا[37]
تظهر الصّورة الفنّيّة، هنا، من خلال تلك التّعابير الّتي تقف وراءها مشاعر الحبّ والانصهار في الحبيب، وهي تعابير تقوم على قوّة اللّفظة الّتي تنقل المشهد العاطفيّ بين الشّاعر وحبيبته. فهو يستخدم عددًا من الألفاظ الّتي تتميّز بنغمتها الإيقاعيّة ليعبّر عن عمق تعلّقه بها، وبخاصّة من خلال تكرار الفعل (تلاقت) الّذي يشير إلى انصهار اليدين والخطى والرّؤى، وكذلك إلى صورة التّباعد والتّلاقي عبر الكلمات الآتية (هبطنا، غبنا، ظهرنا). والأهمّ من كلّ ذلك أنّه كان هناك نجم مضيء يلتقي في وجهيهما. وهذا يدلّنا على أنّ الحبّ الّذي يجمعهما هو أسمى من الحبّ الأرضيّ بل هو حبّ سماويّ، تنيره النّجوم، فيهبط من العلاء ثم ّيغيب ويعود من سفره ليظهر، فتتلاقى الأيدي، والخطى والرّؤى، كما يقول شاعرنا. ويمكن تمثيل الصّورة بهذا الشّكل
| نجم | في وجهي | في وجهك المسافر | |
| تلاقت | يدانا | خطانا | رؤانا |
| هبطنا | رأينا | غبنا | ظهرنا |
ما يلفت نظرنا، في هذه الألفاظ، تلك الإيقاعيّة الموسيقيّة الّتي اعتمدها الشّاعر ليربط إحساسه الغراميّ بكلّ كلمة أوردها في الشّاهد الشّعريّ. وهل هناك ما هو أرقّ وأنعم وألطف من الكلمات المعبّرة الآتية : نجم، وجه، هبط، رأى، غاب، ظهر .. وكأنّ هذه الكلمات باتت تشكّل الألوان الّتي تزيّن الصّورة الّتي رسمتها يد الشّاعر الفنّان. وفي مكان آخر يتغنّى أحد الشّعراء قائلًا:
قبْلَ أن تَلُفّي الطّريق
خُذيني عَنِ الطّريقْ
قبْلَ أَنْ تدخُلي إلى هدوءِ البَيْتْ
الْتَفتي إلى الجنون في حُبّي حتّى الجنونْ
وإلى المَوْتِ في حُبّي حتّى المَوْتِ[38]
يأبى الشّاعر إلّا أن يرسم صورته الغراميّة هذه من خلال كلمتين مؤثّرتين في داخل هذا الشّاهد الشّعريّ، وهما: الجنون والموت، ومن خلال كلمتين أساسيتين هما : الطّريق والبيت. ففي هاتين اللّفظتين نستشفّ رغبة الشّاعر في أن تنقذه الحبيبة من وحدة الطّريق، وتأخذه إلى هدوء البيت حيث يشعر بالحبّ الدّافىء وبالصّمت والهدوء وراحة النّفس. فالصّورة الغراميّة تتجلّى ملامحها، إذًا، من خلال هذا التّناقض بين دلالات الألفاظ الرّئيسيّة في هذا الشّاهد وهما : الطّريق والبيت، ومن ثمّ الجنون والموت، فهو يرفض أن يعيش من دون حبّها، فحبّه لها هو الجنون، وإلّا فالموت بالنّسبة إليه بات قمّة هذا الحبّ الجنونيّ. وهكذا نلاحظ أنّ الشّاعر قد ينفعل أحيانًا في أحاسيسه الغراميّة المتوتّرة، فلا يعود واعيًا لما يقول، فيصبح الموت بالنّسبة إليه هو أقصى جنون الحبّ. فالموت في الحبّ صورة فنيّة لا يرسمها عقل الشّاعر وإنّما عاطفته المنفعلة هي الّتي تكون مسؤولة عن رسم هذه الصّورة. والشّعر لا يمكن أن يكون بعيدًا عن الأحاسيس والمشاعر العاطفيّة، فهو الملجأ الذي يلجأ إليه شعراء الحبّ والغرام، ليصبّوا فيه قوّة حبّهم، وأقصى ما يمتلكونه من أحاسيس ومشاعر إزاء الحبيب. يقول الشّاعر أدونيس متغنّيًا بحبّه :
أتخيّلُ حبّي : يتنفّسُ من رئةِ الشّيء
يأتي إلى الشّعرِ في وردةٍ أو غبارْ،
يتهامسُ مع كلّ شيء
ويهمسُ للكونِ أحواله
مثلما تفعلُ الرّيحُ والشّمسُ
حين تشقّان صدرَ الطّبيعةِ،
أو تسكبان على دفتر الأرضِ حِبْرَ النّهارْ [39]
نلاحظ في كلام الشّاعر أنّ الصّورة الفنيّة، هنا، ظهرت من خلال العناصر الطّبيعيّة الّتي تنحصر في الألفاظ الإيقاعيّة الآتية : وردة، غبار، كون، ريح، شمس، أرض.. فحبّ الشّاعر بات مرتبطًا بالأشياء، ويتنفّس من رئة هذه الأشياء الّتي تعود للطّبيعة، فهو يتهامس مع كلّ شيء، مثلما تفعل الرّيح والشّمس. وهنا تكمن قوّة الصّورة المعبّرة، حين يربط إيقاعه النّفسيّ بإيقاع الطّبيعة، وحين تشقّ الرّيح والشّمس صدر الطّبيعة، يشقّ الهمس الغراميّ رئة الأشياء، وهكذا يتنفّس الشّاعر حبّه من خلال رئة هذه الأشياء. فالصّورة الآتية تكشف تلك العلاقة الغراميّة بينه وبين الطّبيعة:
| الحبّ يتنفّس = من رئة الأشياء
الحبّ يتهامس = مع كلّ الأشياء = ويهمس للكون عن حالته الغراميّة الرّيح والشّمس = تشقّان = صدرَ الطّبيعة الرّيح والشّمس = تسكبان = حبر النّهار = على الأرض
|
هذه الصّورة المكوّنة من هذه العناصر باتت تشكّل لوحة فنيّة قوامها : الحبّ = الأشياء = الرّيح = الشّمس = صدر الطّبيعة = الأرض = حبر النّهار.. وهذا الحبر هو رمز الكتابة، بحيث باتت الأرض هي الدّفتر الّذي يُسجّل عليها تاريخ الشّاعر في حبّه وعلاقته بالأشياء. فالشّعراء- في معظمهم- غالبًا ما يصوّرون غرامهم مرتبطًا بالطّبّيعة، وهذا هو مُرتجى كلّ شعراء الرّومانسيّة الّذين يرون في الطّبيعة وجهًا من أوجه الغرام والحبّ، فيرسمونه بأجمل الصّور حين يكون موضوعهم محصورًا بصور حبّهم وهُيامهم وعلاقتهم مع الحبيب. يقول نزار قبّاني معترفًا بحبّه :
عندما حاولتُ أن أكتب عن حبّي ..
تعذّبت كثيرًا.. إنّني في داخلِ البحر …
وإحساسي بضغط الماءِ لا يعرفُه غيرُ مَنْ ضاعوا
بأعماقِ المحيطات دهورا.
ما الذي أكتبُ عن حبّكِ يا سيّدتي؟
كلُّ ما تذكرُه ذاكرتي.. أنّني استيقظتُ من نومي صَباحًا..
لأرى نفسي أَميرًا..[40]
يرتبط حبّ الشّاعر، هنا، بصورة الماء، ماء البحر والمحيط، وهذا ما يشير إلى أنّه يودّ أن يرسم صورة عريضة عن هذا الحبّ العميق والشّاسع، كعمق البحر ووسع المحيطات. ويتساءل عمّا سيكتب لها ليعترف بعمق حبّه، ثمّ يُنهي كلامه بأنّه لا يتذكّر إلّا أنّه استيقظ صباحًا ليرى نفسه أميرًا. وهذا جلّ حلمه، أن يكون أميرًا في الحبّ، له الكلمة والإمرة على الحبيب، وهذا ليس بغريب، فكثيرًا ما يشعر الحبيب أو الّذي يتوه في حبّه حتّى الأعماق بأنّه أصبح أميرًا وسيّدًا، فيسير في الطّرقات مختالًا وتعلوه ابتسامة النّصر كونه أصبح أميرًا في الحبّ. فالحبّ، هذا الإحساس اللّامتناهي، له سلطة مخفيّة على المحبّين، سلطة شبيهة بسلطة الأمراء والقادة والملوك، ولا يمكن لشاعر كنزار قبّاني أن يتنفّس من دون أن يكون الحبّ جزءًا من كيانه، متعلّقًا به، كما تتعلّق الطّفولة بجدران الأمومة.
والأبرز في كلامه أنّه يصوّر نفسه داخل البحر، يشعر بضغط الماء الّذي لا يعرفه إلّا من كان ضائعًا في هذا العمق، وكأنّنا به يحاول أن يبرهن لحبيبته أنّ حبّه عميق كعمق البحر، وأنّه لا يهمّه إذا تاه فيه وضاع، لأنّ المهمّ أن يكون ضياعه محصورًا بحبّه وهيامه بالحبيب. والتّرسيمة الآتية تكشف شدّة الهُيام في قلبه :
الكتابة في الحبّ العذاب الكثير
الإحساس بضغط ماء البحر ضياع مدى الدّهور
الاستيقاظ صباحًا الإحساس في كونه أميرًا
تكشف لنا هذه التّرسيمة أنّ الشّاعر مأسور بهذا الحبّ الذي يسبّب له العذاب الكبير، ويجعله يضيع في أعماق البحر والمحيط لمدّة زمنيّة تتحدّى الدّهور، فضلًا عن شعوره كأنّه أمير عندما تعود إليه ذاكرته في الصّباح. هل كان يعيش حلمًا أرّقه؟ أم أنّه يعيش أحلام اليقظة في وعيه وإدراكه؟ طبعًا فالشّاعر المغروم قادر أن يرسم لنا صورة فنّيّة تتحّدى الأطر العامّة لتصبح صورة مبالغًا فيها، وبخاصّة حين يجعل نفسه شبيهًا بأمير له السّلطة والكلمة. فنزار قبّاني في الحبّ أمير، وشعره تتخلّله الكثير من الصّور المعبّرة عن مشاعره ومغامراته في الحبّ والغرام. لنستمع إلى سعيد عقل يقول على لسان حبيبته :
حقًّا ضمَمتني بذراعِكَ؟
أنا لا أصدّقُ..
بعدها يا حبيبي، صرتُ أنا الرّوضَ..
والزّهرَ.. وندى الصّبح..
قُلْ لذراعكَ أنْ لا تطيلَ غيبة..[41]
الحبيبة تعترف بحبّها، وتدعو الحبيب إلى أن لا يطيل الغياب عنها، لأنّها مشتاقة إلى ذراعه الملتفّة حولها. وحبّها له بات أسيرًا لأجواء الغرام والهيام، وهي أجواء تجعلها تعشق الطّبيعة، وتصبح كالرّوض والزّهر وندى الصّباح. فالحبّ بالنّسبة إليها هو الطبّيعة بعناصرها الجميلة، وبخاصّة عند إطلالة الفجر حيث يكون النّدى مرشوشًا على الأزهار، والرّوض منتعشًا به وبوروده. لقد حاول الشّاعر، هنا، أن يُظهر لنا أهميّة ارتباط الحبّ بالطّبيعة، فلولاها لا يمكن لهذا الحبّ أن يدوم، لأنّ الأزهار وإطلالات الصّباح النّديّ هي الّذي ترفد الحبّ بالعاطفة الجيّاشة، وبالتعلّق بالحبيب، وجعل الحبّ طريقًا للفرح وللأحلام والتمنيّات. ولعلّ ذراع الحبيب باتت هي السّبب المؤثّر في علاقة الحبّ بينهما، لأنّها تدلّ على علاقة التآلف والتعلّق، واشتداد الشّوق إلى الحبيب. فالتّرسيمة الآتية تكشف هذه العلاقة :
ذراع الحبيب تضمّ الحبيبة بشوق وحنان
الدّهشة وعدم التّصديق تبدّل حالة الحبيبة
الحبيبة أصبحت الرّوض المُزهِر، وندى الصّباح الجليّ
الحلّ المنشود الدّعوة إلى عدم إطالة غيبة ذراع الحبيب
الاشتياق إلى الحبيب
هذه التّرسيمة تبيّن عمق العلاقة بين الشّاعر وحبيبته التي يتكلّم على لسانها، كما تبيّن الحدث المهمّ، وهو تغيّر الحبيبة وتحوّلها لتصبح الرّوضة الغنّاء بالزّهر وبندى الصّباح. فالحبّ في هذه الصّورة الشّعريّة لا يقف عند حدود المادّة، وإنّما يصبح كالحلم، منسوجًا من الخيال، في التّبدّل والتّحوّل من أمر ما إلى أمر آخر، كما تحوّلت الحبيبة لتصبح روضًا بحسب قول الشّاعر. فضلًا عن رغبة الحبيبة بألّا يطول غياب الحبيب فتغيب ذراعه الّتي تشتاقها وهي تلفّها بالحنان والحبّ والغرام. فالتّركيز، هنا، كان محصورًا برغبة الحبيبة بألّا تطول غيبة الذّراع الّتي لعبت دورًا مهمًّا في إطار هذه الصّورة، لأنّ الذّراع عدا كونها دليلًا للقوّة والمساعدة ، فهي دليل للعاطفة والحنان ورقّة الهيام متى كان سارحًا في أنفاس الحبيب.
نصل، إذًا إلى ختام هذا البحث حيث تحدّثنا في بعض النّماذج الشّعريّة، عن أهميّة الصّورة الفنّيّة في الشّعر الحديث وعن أبعاد دلالاتها المتنوّعة، والمأخوذة من سطور الكلمات الشّاعريّة الّتي نظمها الشّاعر ليرسم لنا حدثًا مهمًّا، أكان في ما يخصّ الانتفاض والرّفض ، أو في ما يخصّ الأوضاع الإنسانيّة أو الحبّ والغرام والانفعال والتّوتّر.
الخاتمة
لقد ظهر لنا من خلال هذه النّماذج الشّعريّة المعبّرة عن الصّور الفنّيّة الّتي امتلأت بها دواوين الشّعر العربيّ الحديث، أنّ القصيدة العربيّة لم ينظمها الشّاعر إلاّ لتكون وسيلة تعبير وإيصال لأفكاره إلى الآخرين، وليس هذا فحسب، وإنّما ليفجّر من خلالها كلّ ما يعانيه من آلام وأفراح إزاء أحداث كانت تضجّ بها المجتمعات العربيّة في مطلع النّهضة الحديثة بصورة خاصّة. وكان يعبّر عن ذلك من خلال ما يرسمه من صور فنّيّة معبّرة، تحمل الكثير من الدّلالات. لهذا كان يغلب على أعماله الشّعريّة عدد من الصّور الشّعريّة البارزة، ومنها صورة الانفعال والتّوتّر الّذي أظهرنا فيها مدى تفاعل الشّاعر مع الواقع انطلاقًا من أحاسيسه وانفعالاته. فكان لا يمكن أن يبقى بعيدًا عن ذلك دون أن ينفعل عاطفيًّا ونفسيًّا. وكذلك في صورته الانتفاضيّة، حيث كشفنا عن عمق المأساة التّي كانت تعتري المجتمع العربيّ، وكيف أنّ الشّاعر العربيّ الحديث كان يرفض هذا الذلّ أو المهانة الّتي كانت تصيب أمّـته، فيقف مدافعًا عنها برفضه وانتفاضته عبر كلمات شعريّة مؤثّرة. أمّا على صعيد الصّورة الإنسانيّة، فقد كشفنا إلى أيّ مدى كان الشّعر وسيلة للتّعبير عن محبّة الشّاعر لإخوانه، ولكلّ مجتمع يعاني العذاب والقهر، فكان يشعر مع الكادحين والمعذّبين، ويزرع من خلال كلماته في نفوسهم الإحساس بالصّمود والصّبر على تغيّرات الأوضاع وعلى آلامهم. أمّا في الصّورة الفنية المتعلّقة بالحبّ والغرام، فقد أظهرنا إلى أيّ مدى كان لموضوع الحبّ تأثير كبير في حنايا هذه الصّورة، وكيف أنّ شعراء الحداثة كانوا لا يتأخّرون عن رفد قصائدهم بصور حبّهم وهُيامهم، ومنهم مَن إذا تناول موضوعًا اجتماعيًّا أو سياسيًّا، نراه يبثّ في سطوره شيئًا من غرامه، ومن تأثّره بالحبيب وتعلّقه به إلى حدود لا سقفَ لها. وإزاء هذه الصّور الفنيّة الأربعة نكون قد وضّحنا في بحثنا هذا أهميّة الصّورة الشّعريّة والفنّيّة في الكشف عن معاناة الشّاعر وعن تطلّعاته وأحلامه وأمنيّاته ومدى تفاعله مع الواقع الاجتماعيّ.
المراجع :
- ابراهيم ، أيمن (2014)، أسلوب النّداء في العربيّة، مجلة كلّيّة الآداب، جامعة الملك سعود.
- ابن جنّي (1957)، الخصائص، تحقيق محمد علي النجّار، دار الكتب المصريّة.
- ابن خلدون ( عبد الرّحمن بن محمد)، مقدّمة ابن خلدون، دار الجيل، بيروت، لا. ت.
- أدونيس، الأعمال الشّعريّة (1996)، جزء ا، دار المدى للثّقافة والنّشر، دمشق.
- بابو، إبراهيم (2008)، أصول الدّلالة التركيبيّة في التّمنّي والترجّي، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدّراسات العلميّة، دمشق.
- البيّاتيّ، عبد الوهّاب (1979)، الدّيوان، دار العودة، بيروت.
- جيدة، عبد الحميد (1980)، مقدّمة لقصيدة الغزل العربيّة، منشورات جرّوس برس، طرابلس، لبنان.
- الحاج ، أنسي (1991)، خواتم ، منشورات رياض الرّيس، لندن.
- الحاج ، أنسي (1994)، ماذا صنعت بالذّهب ماذا فعلت بالوردة، دار الجديد، بيروت.
- حاوي، خليل (1972)، الدّيوان، دار العودة ، بيروت.
- حجازي، أحمد عبد المعطي (1973)، الدّيوان، دار العودة، بيروت.
- الحيصة، محمد (2015)، النّزعة الإنسانيّة في الشّعر الأردنيّ المعاصر، جامعة مؤتة.
- دى لويس، سيسيل (1968)، الصّورة الشّعريّة، المجلّة المصريّة، القاهرة، عدد 135.
- زياد، توفيق (2000)، الدّيوان، دار العودة، بيروت.
- صيّاح، أنطوان ( 1995)، دراسات في اللّغة العربيّة الفصحى وطرائق تعليمها، دار الفكر اللّبنانيّ، بيروت.
- طوقان، فدوى (1972)، الدّيوان، دار العودة، بيروت.
- الطّيب، عثماني (2016)، شعريّة التمرّد في الشّعر العربيّ الحديث، كليّة الآداب واللّغات، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر.
- عقل، سعيد (1991)، شعره ونثره، مج 5، دار نوبلس، بيروت.
- غيلان، حيدر (2004)، الصّورة الشّعريّة في النّقدين العربيّ والإنجليزيّ، دراسة مقارنة لمفاهيمها ومناهج دراستها في العصر الحديث. إصدارات وزارة الثّقافة والسّياحة، صنعاء.
- الفيتوري،محمد ، الدّيوان (1970)، مج 1، دار العودة، بيروت.
- قبّاني، نزار (1979)، الأعمال الشّعريّة الكاملة، منشورات قبّاني، بيروت.
- قبّاني، نزار (1980)، قصّتي مع الشّعر ، بيروت .
- قبّاني، نزار (1988)، أحلى قصائدي، منشورات نزار قبّاني، بيروت.
- قميحة، مفيد (1981)، الاتّجاه الإنسانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر، دار الآفاق.
- الماغوط ، محمّد (1998)، أعمال محمّد الماغوط، دار المدى للثّقافة والنّشر ، دمشق.
- مصباح، نسرين (2014)، أنماط من الصّورة الفنّيّة فى الشّعر العربىّ الحديث، المجلّة العلميّة لكليّة الآداب، جامعة دمياط، القاهرة.
- ناصف، مصطفى (1957)، الصّورة الأدبيّة، مكتبة مصر، القاهرة.
- ويليك، رينيه ، نظريّة الأدب، ترجمة محي الدّين صبحي، منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، دمشق، لا ت.
- Dorel, Jacques, Nature et histoire chez Albert Camus, Garnier, Paris, 1976
[1] أستاذة محاضرة في كليّة التّربية – الجامعة اللّبنانيّة
[2] – محمد الحيصة، النّزعة الإنسانيّة في الشّعر الأردنيّ المعاصر، جامعة مؤتة، 2015، ص 3
[3] – ابن جنّي، الخصائص، تحقيق محمّد علي النجّار، دار الكتب المصريّة، 1957، ج 1، ص 33
[4] – نسرين مصباح، أنماط من الصّورة الفنّيّة فى الشّعر العربىّ الحديث، المجلّة العلميّة لكليّة الآداب، جامعة دمياط، القاهرة، 2014، ص 419
[5] – أدونيس، الأعمال الشّعريّة، جزء ا، دار المدى للثّقافة والنّشر، دمشق، 1996، ص 89
[6] – عبد الحميد جيدة، مقدّمة لقصيدة الغزل العربيّة، منشورات جروس برس، طرابلس، لبنان، 1980، ص 29
[7] – أحمد عبد المعطي حجازي، الدّيوان، دار العودة، بيروت،1973، ص 4
[8] – إبراهيم بابو، أصول الدّلالة التّركيبيّة في التّمنّي والتّرجّي، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدّراسات العلميّة، دمشق، 2008ـ ص 157
[9] – أيمن إبراهيم، أسلوب النّداء في العربيّة، مجلّة كلّية الآداب، جامعة الملك سعود، 2014، ص 349
[10] – عبد الوهاب البيّاتي، الدّيوان، دار العودة، بيروت، 1979، ص 505
[11] – أنطوان صيَّاح، دراسات في اللّغة العربيّة الفصحى وطرائق تعليمها، دار الفكر اللّبناني، بيروت، 1995، ص 80
[12] – ابن خلدون ( عبد الرّحمن بن محمد)، مقدّمة ابن خلدون، دار الجيل، بيروت، لا. ت، ص 613.
[13] – نزار قبّاني، أحلى قصائدي، منشورات نزار قبّاني، بيروت، 1988، ص 77
[14] – نزار قبّاني، قصّتي مع الشّعر، بيروت ، ص.186
[15] – نزار قبّاني، أحلى قصائدي ، مرجع سابق، ص 189
[16] – مصطفى ناصف، الصّورة الأدبيّة، مكتبة مصر، القاهرة، 1957ـ ص 15
[17] – سيسيل دى لويس، الصّورة الشّعريّة، المجلّة المصريّة، القاهرة، عدد 135، 1968
[18] – خليل حاوي ، الدّيوان، دار العودة، بيروت ، 1979، ص 34
[19] – محمد الفيتوري، الدّيوان، مج 1، دار العودة، بيروت، 1970 ص 65
[20] – توفيق زياد، الدّيوان ، دار العودة، بيروت، 2000، ص 99
[21] – محمد الفيتوري، الدّيوان، مرجع سابق، ص 87
[22] – عبد الوهاب البيّاتي، الدّيوان، دار العودة، بيروت، 1979 ص 699
[23] – حيدر غيلان، الصّورة الشّعريّة في النقدين العربيّ والإنجليزيّ، دراسة مقارنة لمفاهيمها ومناهج دراستها في العصر الحديث. إصدارات وزارة الثّقافة والسّياحة، صنعاء، 2004، ص 47
[24] – فدوى طوقان، الدّيوان، دار العودة، بيروت، 1972 ، ص 284
[25] – رينيه ويليك، نظريّة الأدب، ترجمة محي الدّين صبحي، منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، دمشق لا ت. ص 205
[26] – نزار قبّاني، الأعمال الشّعريّة الكاملة، منشورات قباني، بيروت، 1989، ص 465
[27] – عثماني الطّيب، شعريّة التّمرّد في الشّعر العربيّ الحديث، كليّة الآداب واللّغات، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، 2016، ص 43
[28]– محمد الماغوط، أعمال محمّد الماغوط، دار المدى للثّقافة والنّشر ، دمشق، 1998.
[29] – جابر عصفور، الصّورة الفنّيّة في التّراث النقديّ والبلاغيّ عند العرب، المركز الثقافيّ العربيّ، بيروت، 1992، ص 260
[30] – أدونيس، الأعمال الشّعريّة، مرجع سابق، ص 30
[31] – Dorel, Jacques, Nature et histoire chez Albert Camus, Garnier, Paris, 1976, p.147
خليل حاوي، الدّيوان، دار العودة، بيروت، 1973، ص 58 – [32]
[33] – هذا ما ذكرته ريتا عوض عن خليل حاوي في مقدّمة ديوانه، صفحة 8.
[34] – أدونيس، الأعمال الشّعريّة، مرجع سابق، ص 29
[35] – أنسي الحاج، خواتم ، منشورات رياض الرّيس، لندن، 1991، ص 96 -97
[36] – مفيد قميحة، الاتّجاه الإنسانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر، دار الآفاق، 1981، ص 16
[37] – أدونيس ، الآثار الكاملة ، مرجع سابق، ص 295
[38] – الحاج، أنسي، ماذا صنعت بالذّهب ماذا فعلت بالوردة، دار الجديد، بيروت، 1994، ص 36
[39] – أدونيس، أول الجسد آخر البحر، دار السّاقي، بيروت، 2011، ص 7
[40] – نزار قبّاني، الأعمال الشّعريّة الكاملة، مرجع سابق، ص 45
[41] – سعيد عقل، شعره ونثره، مج 5، دار نوبليس، بيروت، 1991، ص 80
عدد الزوار:75


