أثرُ عمليَّةِ النّقلِ والتّرجمةِ في نموِّ وازدهارِ النّثرِ، انطلاقًا من العصر العبّاسيّ حتّى بداية القرن الواحد والعشرين
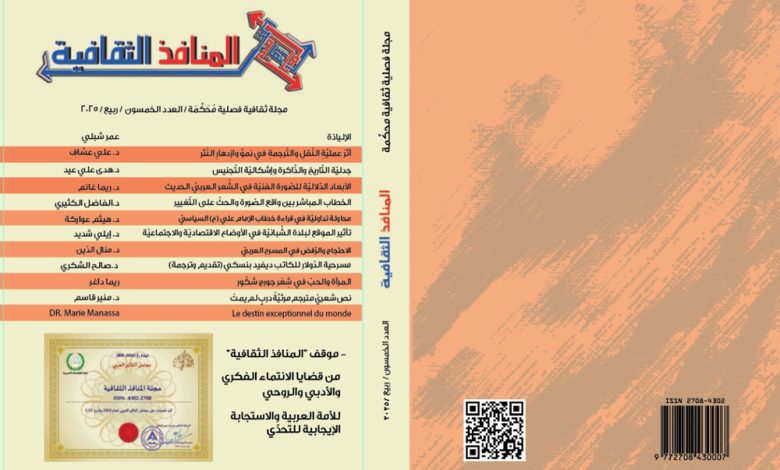
أثرُ عمليَّةِ النّقلِ والتّرجمةِ في نموِّ وازدهارِ النّثرِ، انطلاقًا من العصر العبّاسيّ حتّى بداية القرن الواحد والعشرين
The Impact of Translation and Transmission on the Growth and Prosperity of Prose, from the Abbasid Era to the Early 21st Century
د. علي حسن عسَّاف [1]
Dr. Ali Hassan Assaf
تاريخ الاستلام 28/8/2024 تاريخ القبول 14/9/2024
الملخّص
هدف هذا البحث للتّعرّف إلى مفهوم النّقل والتّرجمة، إضافةً إلى مفهوم النّثر، ودور عمليَّة النّقل والتّرجمة في ازدهار العصر العبّاسيّ وصولًا إلى العصور الحديثة.
وقد تناول هذا البحث أنواع النصوص النّثريَّة، والثّقافات الّتي كانت قائمة في العصر العبّاسيّ، وأبرز المترجمين في ذلك الوقت، إضافة إلى ذكر أهمّ المترجمين في العصور الّتي تلت العصر العبّاسيّ.
وقد توصّل البحث إلى نتائج مهمّة، أبرزها:
- لقد شهد العصر العبّاسيّ تطوّرًا هائلًا على صعيد النّقل والتّرجمة.
- ساعد تنوّع الثّقافات على إغناء اللّغة العربيّة بالمفردات والألفاظ الجديدة.
- شهدت اللّغة العربيَّة تراجعًا من جراء الاستعمار الّذي حصل في الدّول العربيَّة، ولكنّها ما لبثت أن استعادت تأثيرها ودورها الرّياديّ.
- إنَّ عمليّة التّرجمة تعدّ من أهمّ الوسائل المستخدمة في التواصل الإنسانيّ على الأصعدة كافّة.
الكلمات المفتاحيَّة: النّقل- التّرجمة- النّثر- العصر العبّاسيّ.
Abstract
The aim of this research is to learn about the concept of transmission and translation, in addition to the concept of prose, and the role of the process of transmission and translation in the prosperity of the Abbasid era up to modern times.
This research dealt with the types of prose texts, the cultures that existed in the Abbasid era, and the most prominent criminals at that time, in addition to mentioning the most important translators in the eras that followed the Abbasid era.
The research reached important results, the most notable of which are:
- The Abbasid era witnessed tremendous development in the field of transmission and translation.
- The diversity of cultures helped enrich the Arabic language with new vocabulary and expressions.
- The Arabic language witnessed a decline as a result of the colonialism that took place in the Arab countries, but it soon regained its influence and pioneering.
- The translation process is one of the most important means used in human communication at all levels.
Keywords: transmission- translation- prose- the Abbasid era.
المقدّمة
إنَّ التّواصل الثّقافي بين الحضارات هو أمر بالغ الأهمّيَّة لتعريفها ببعضها البعض، وخصوصًا في المجال الأدبيّ والثّقافي، وتتّخذ عمليَّة النّقل أشكالا وطرائق عدَّة. وتعدّ التّرجمة من أرقى الطّرائق المتّبعة في نقل الثّقافات الأخرى، والأفكار، والمعتقدات، فالتّاريخ هو من الأمور الخالدة الّتي لا تتبدّل ولا تتغيّر، والتّجارب الإنسانيَّة والإبداعيَّة لا بدّ لها من أن تكون دروسًا يُستفاد منها على مرّ الأزمنة.
هناك الكثير من العلماء والمفكّرين الّذين كانت لهم إنجازات كبيرة في المجال الأدبي والثّقافي، وقد أغنوا التّاريخ الحضاري بالعديد من المؤلّفات الّتي استلهم منها المؤرّخون فيما بعد، للتَّأكيد على عظمة الحضارات السّابقة وتأثيرها الكبير في البشريَّة، وخصوصًا العصر العبّاسيّ المليء بالإنجازات، والحافل بأخصب الأعمال، ففيه ازدهرت العلوم والآداب.
امتدَّ العصر العبّاسيّ أو كما كان يسمّى بالعصر الذّهبي، قرنًا من الزّمن (132هـ/ 750م- 232هـ- 847م)، وكان غنيًّا بالإنجازات. فالعرب القدامى وكما وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ٢﴾ (القرآن الكريم، الجمعة: 2)، أي كان معظمهم أمّيّين يعتمدون على الذّاكرة في تسجيل الأحداث التّاريخيَّة، إلى أن جاء هذا العصر واشتهر بالتّدوين ونقل الأفكار والآداب إلى الأمم الأخرى. وقد ازدهر النّثر في العصر العبّاسيّ نتيجة اختلاط الثّقافات فيه، كالثّقافة اليونانيَّة، والفارسيَّة، والهنديَّة، وفيه تجلّت أولى بدايات النّقل والتّرجمة، واستمرّت حتّى القرن الواحد والعشرين.
وانطلاقًا ممّا تقدّم، جاء هذا البحث لتسليط الضّوء على عمليَّة النّقل والتّرجمة الّتي ازدهرت في العصر العبّاسيّ وامتدّت إلى العصور الأخرى، الأمر الّذي جعل موضوع حوار الحضارات والتّواصل فيما بينها متطوّرًا ومنتشرًا إلى حدٍّ بعيد.
الإشكاليَّة
إنَّ النّهوض بعمليَّة النّقل والتّرجمة في العصر العبّاسيّ جعل هذا الأخير محطّ أنظار العلماء والمفكّرين العرب والأجانب، فباتت التّرجمة طريق كلّ من يريد التّعرّف إلى حضارات أخرى غير حضارته، واستمرّت عبر مرور الزّمن إلى العصور الحديثة الّتي وصلت فيها عمليّات التّرجمة إلى أوجها في المجالات كافّة.
وبما أنَّ النّثر هو من العلوم العظيمة والرّاسخة في التّراث العربي، فقد دخل طورًا جديدًا في العصر العبّاسيّ، وبقي في تطوّر دائم حتّى يومنا هذا.
والسّؤال الرّئيس المطروح في هذا البحث هو: ما مدى الأثر الّذي تركته عمليَّة النّقل والتّرجمة في نموّ وازدهار النّثر انطلاقًا من العصر العبّاسيّ وحتّى بداية القرن الواحد والعشرين؟
أمَّا الأسئلة الفرعيَّة، فتتلخّص بالأتي:
- ما التّرجمة؟ وما دوافعها؟
- ما النّثر؟ وكيف تجلّى في العصر العبّاسيّ والعصور اللّاحقة؟
- ما ملامح تطوّر عمليَّة النّقل والتّرجمة في العصر العباسي حتّى القرن الواحد والعشرين؟
- ما أبرز النّتائج المترتّبة على هذه العمليَّة؟
المنهج
لقد اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتّاريخي نظرًا للطّبيعة الّتي يتميّز بها هذا البحث، فهو يتحدّث عن تطوّر النّثر عبر التّاريخ الإسلامي منذ العصر العباسي وحتّى يومنا هذا.
الفرضيّات
يتمحور البحث حول عمليَّة التّرجمة والنّقل، وتأثيرها في نموّ النّثر. أمّا الفرضيّات فهي على الشّكل الآتي:
- أسهمت عمليَّة النّقل والتّرجمة في تطوّر النّثر منذ العصر العبّاسيّ وحتّى العصور الحديثة.
- من الممكن أن تؤدّي هذه العمليَّة إلى تعريف الحضارات الأخرى بالحضارة العبّاسيّة وما بعدها، والنّهل من معينها في مجالات العلوم والأدب.
الأهداف
يسعى هذا البحث إلى تحقيق أهداف، أهمّها:
- التّعرّف إلى مفهومي النّقل والتّرجمة.
- تحديد الملامح العامّة للعصر العبّاسيّ والعصور الحديثة فيما يختصّ بالنّثر.
- التّوصّل إلى الآثار الّتي تركتها عمليَّة النّقل والتّرجمة.
أوّلًا: النّقل والتّرجمة
- مفهوم النّقل
النّقل لغةً: جاء في لسان العرب: نقْل: تحويل الشّيء من موضع الى آخر، والتّنقّل: التّحوّل (ابن منظور، 1999، ص 709).
وجاء في المنجد: نقل: نقل الشّيء أي حوّله من موضع إلى موضع آخر، والكلام عن قائله: رواه عنه، والكتاب: نسخه، والكتاب إلى لغة كذا: ترجمه بها (الهنائي، 1960، ص 834).
أمَّا النّقل اصطلاحًا، فهو تحويل الكتاب أو المؤلّف من لغة إلى لغة أخرى، كتحويل الكتب التّاريخيَّة من اللّغة العربيَّة إلى اللّغة الإنكليزيَّة.
- مفهوم التّرجمة
التّرجمة لغةً: إنَّ التّرجمة مشتقّة من فعل “ترجم”، وعلى نحو ما جاء به لسان العرب يٌقال: “ترجم كلامه بمعنى فسّره بلسانٍ آخر” (ابن منظور، 1988، ص 316). أمّا في المنجد، فهي: “نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، وعلى التَّأويل والتّفسير والشّرح” (معلوف، 2001،).
أمّا التّرجمة اصطلاحًا، فهي: نقل الألفاظ والكلمات من لغة إلى أخرى، مع مراعاة احترام المعنى المنقول.
- دور التّرجمة وهدفها
تؤدّي التّرجمة دورًا كبيرًا على كافّة الأصعدة، وفي كلّ المجالات الثّقافيَّة، والاقتصاديَّة، والتّكنولوجيَّة، وذلك للاستفادة من علوم وآداب الآخرين، والتّواصل بين الأمم وتحسين التّبادل التّجاري وغيره، وتحقيق التّنمية الهادفة إلى ارتقاء الأفراد.
وللتّرجمة في هذا السّياق دور ثلاثي الأبعاد: لغوي، ومعرفيّ، وفكريّ، وهي أبعاد مترابطة في حلقة متسلسلة متكاملة يؤدّي أحدها إلى الآخر في علاقة خطّيّة دائريَّة. أمَّا دور التّرجمة اللّغوي، فلا ينحصر في إيجاد مقابلات عربيَّة لمصطلحات علميَّة جديدة، بل يتعدّاه إلى التَّأثير في تطوير اللّغة دلاليًّا وتركيبيًّا، وقد أفردت بحوثًا ودراساتٍ عدّة لهذا الأثر، وما زال الأمر يستحقّ المزيد، نظرًا للأهمّيَّة البالغة في عمليَّة التّطوُّر اللّغويّ. وأمَّا دورها المعرفيّ، فيتجلّى في نقل المعارف ونتاج الفكر العلميّ، والأدبيّ، والثّقافيّ عند اللّغات والحضارات الأخرى، وهذا يقتضي التّعريف بالمفاهيم والرّؤى الجديدة، وذكر دلالاتها المعاصرة بدقّة، وشرحها من دون لبس ضمن سياقها النَّصّي وسياقها الفكريّ العام (لواتي، 2016، ص 130).
ولا تستقي التّرجمة أهمّيّتها من كونها تأتي بمصطلحات جديدة في شتّى حقول العلم والمعرفة، وإنّما لكونها ناقلة للمفاهيم عن طريق شرح دلالات تلك المصطلحات، وإدراج مدلولاتها في المنظوفة الفكريَّة العربيَّة. فاستيعاب المصطلحات والتراكيب الاصطلاحيَّة الجديدة، وإيجاد مقابلات عربيَّة لها، وشرح دلالاتها، وتيسير تداولها يؤدّي إلى رفد الفكر العربي بمفاهيم محدثة وممارسات جديدة كانت غائبة أو مغيّبة، وتوجيهها للعمل وفق منهجيَّة محدّدة، ومن ثمّ خلق واقع فكريّ وسلوكيّ جديد، ينهض بالحاضر ويؤسّس للمستقبل (مشوح، 2001، ص 786).
إذًا، فالتّرجمة عمليَّة نقل رسالة من لغة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى، وبتعبيرٍ آخر، فهي تعني نقل المعنى من النّص المنطلق إلى النّص الهدف، وتحويل علامات اللّغة الأولى إلى علامات اللّغة الثّانية، ويقوم المترجم بتفكيك الشّيفرة اللّسانيَّة بعد أن تكون مشفّرة في لغة أخرى، ويتضمّن النّصّ المترجم مجموعة من العلامات السّيميائيَّة كالعلامات المنطقيَّة، والعلامات الاجتماعيَّة، والعلامات الجماليَّة، والعلامات اللّسانيَّة. ومن ثمّ، فالهدف الرّئيس لمترجمها هو الوصول إلى ترجمة صادقة، ووفيَّة، وقريبة من معاني النّص الأصلي (مشوح، ص 131).
ثانيًا: النّثر في العصر العبّاسيّ
- تعريف النّثر
النّثر لغةً: نثر: اللّيث: النّثر نثرك الشّيء بيدك ترمي به متفرّقًا مثل نثر الجوز واللّوز والسّكر، وكذلك نثر الحبّ إذًا بذر، هو النّثار، وقد نثره ينثره، وينثره نثرًا ونثارًا، ونثره فانتثر، وتناثر، والنّثارة: ما تناثر منه (ابن منظور، ص 189).
أمَّا النّثر اصطلاحًا، فهو: الكلام المكتوب باللّغة العربيَّة، وهو يتمتّع بجماليّة معيّنة نتيجة انتقائه بأسلوبٍ جاذبٍ للقرّاء. وهو الكلام المنطقيّ السّليم والمقنع، والكلام الّذي يخلو من الوزن، أي على عكس الشّعر، ومن الممكن أن يتخلّله بعض السّجع وبعض الصّور البيانيَّة ولكن بأسلوب نثري.
- واقع النّثر في العصر العبّاسيّ
كان العصر العبّاسيّ عصرًا مفصليًّا ومحوريًّا في تاريخ الأدب النّثري والأدب الشّعريّ على حدٍّ سواء. إذ لاقى هذا العصر نقلةً نوعيَّة على صعيد العلوم، وبلغ فيه النّثر ذروته، وقد انتشرت فيه فنون الكتابة على أشكال متعدّدة، مثل: الخطابة، والرّسائل، والوعظ، والقصص، والمناظرات. وفي هذا العصر كان هناك خليط من الحضارات كالفارسيَّة وغيرها، الأمر الّذي جعل النّثر يتأثّر بهذا الخليط أكثر من تأثّر الشّعر.
وهناك أنواع كثيرة من النّثر عُرفت آنذاك، ومن هذه الأنواع، نذكر:
- النّثر العلميّ: وفيه استعمالٌ للنّثر من أجل كتابة العلوم الشّرعيّة واللّغويّة.
- النّثر التّاريخيّ: ويُعنى هذا النّثر بتدوين الأحداث التّاريخيَّة.
- النّثر الأدبيّ: وهو كل ما له علاقة بالفنون الأدبيَّة، وكل ما هو جديد على هذا الصّعيد.
- النّثر الفلسفيّ: هو النّثر المختصّ بالكتابات الفلسفيَّة.
وبالنّسبة إلى النّثر الأدبيّ، فقد برزت فنونٌ أدبيَّة جمّة ، ومنها:
- الخطابة: كان فنّ الخطابة نشطًا في العصر العبّاسيّ وخصوصًا الخطابة السّياسيَّة، إذ كان الحاكم يجمع أنصاره ويخطب فيهم، وكانت تُقام المنافسات بين الخطباء على المنابر، حيث يكثر التّجييش ولكن بأسلوب فصيح، ومن أهمّ هؤلاء الخطباء كان الخليفة أبو العبّاس مؤسّس الدّولة العبّاسيّة. ومن بعدها انتشرت الخطابة الدّينيَّة للخلفاء، أمثال المهدي والرّشيد.
- المناظرات: لاقى أسلوب المناظرة ازدهارًا واسعًا في العصر العبّاسيّ، وهذا النّوع من النّثر هو نوعٌ جديد لم يكن موجودًا في السّابق. ففي الجاهليَّة كان يُعرف باسم أدب التّفاخر حيث كان الجاهليّون يتفاخرون ببعض صفاتهم، كالفروسيَّة، والكرم، والقوّة، والبأس، وغيرها من الصّفات. إلى أن جاء العصر العبّاسيّ فأضفى تجديدًا على المفاخرات، وعرفت بالمناظرات، إذ يقوم كل فرد بالإدلاء بآرائه وما يعرفه، وبالتّالي يقوم المناظر الآخر بالرّدّ عليه، والإدلاء بما لديه. وفي هذا العصر كانت تدور المناظرات حول الأمور الفقهيَّة واللّغويَّة.
- الرّسائل: مع تطوّر مفهوم الدّولة، وخصوصًا الإسلاميَّة، ظهر مصطلح الدّواوين الّتي تنظّم شؤون الدّولة، ولكلّ ديوان كان هناك كتّاب، والكاتب يجب أن يتميّز بثقافةٍ عالية، وبأسلوبٍ جميلٍ في الكتابة، ومن أبرز الكتّاب في العصر العبّاسيّ ابن المقفّع، وسهل ابن هارون وغيرهم.
- عمليَّة نقل وترجمة النّثر في العصر العبّاسيّ
لاقى النّثر نموًّا كبيرًا في العصر العبّاسيّ، نظرًا لاستقرار الدّولة العبّاسيّة وتمتّعها بالعلوم المتنوّعة نتيجة الفتوحات الإسلاميَّة الّتي حصلت. وقد عرف هذا العصر رواجًا لعمليَّة النّقل والتّرجمة، إذ عُني به الخلفاء العبّاسيّون ووزراؤهم، وهذه العمليَّة هي الّتي أثّرت بشكلٍ إيجابيّ في تطوّر العبّاسيّين، وتصنيفهم على أنّهم أصحاب إنجازات على الصّعيدين العلمي والأدبيّ. وكان ابن المقفّع أوّل المترجمين آنذاك، فقد استقى الكثير من الثّقافات الأجنبيَّة عبر ترجمة الكتب، وتحويلها إلى اللّغة العربيَّة كما فعل في كتاب (كليلة ودمنة) الّذي كان كتابًا هنديًّا في الأصل، إضافةً إلى كتاب (المنطق) لأرسطو. وعرفت التّرجمة تطوّرًا بالغًا وهائلًا في عهد الخليفة المأمون، وقد عمل على إنشاء خزانة للكتب وأسماها (دار الحكمة).
إنَّ النّثر العربي عند العبّاسيّين تميّز بمرونته وانفتاحه على استقبال كلّ ما هو جديد، وأصبح خزّانًا للثّقافات الأخرى وتنوّعها في العلوم كافَّة، كالنّثر العربي، والفلسفي، والعلمي. وتميّز هذا النّثر بالابتعاد من الألفاظ البدويَّة القديمة، والمعقّدة، والمبهمة المعاني، وفي نفس الوقت لم يعتمد المفردات المبتذلة، والعاميَّة، إذ استخدم اللّغة الفصحى بأسلوبٍ جميل، وواضح، وسهل الفهم، مع الاحتفاظ بجزالة اللّفظ، ورصانته، وأصوله البيّانيَّة الّتي تضفي جماليَّةً على النّصوص.
ونظرًا لوجود مزيج سكّاني في العصر العبّاسيّ ناتج من تعدّد الثّقافات، أرسى هذا المزيج بوتقة واحدة رعتها النّخبة السّياسيّة وقدّمت لها الحماية، ممّا أدّى إلى خلق ثقافة جديدة، نظرت إلى التّراث الضّخم للحضارات السّابقة نظرة إيجابيَّة فأخذت تنهل من هذا الإرث الضّخم في أكبر وأطول حركة ترجمة عرفها التّاريخ. وإذا كان للخلفاء العبّاسيّين الدّور الرّئيس في إطلاق حركة التّرجمة، وبخاصَّة الخليفة أبو جعفر المنصور، والّتي تتحدّث كتب التّاريخ أنّه أمرَ بإحضار بعض كتب الطّبّ لترجمتها، مع استدعاء بعض الأطبّاء من جند يسابور لمداواته من علّة أصابته، ومع اتّفاقنا على أنّ الخليفة المنصور كان له الفضل الأساسيّ في إطلاق هذه الحركة، إلَّا أنّنا نتّفق مع السّبب الّذي جعل الخليفة يتبنّى هذه الحركة، فحركة بهذا الشّمول، والّتي امتدّت بعده أكثر من قرنين لا يعقل أن تكون حركتها حاجة محدّدة لدى الخليفة، أضف إلى ذلك أنَّ المنصور أمر بترجمة بعض الكتب في المجالات الأخرى غير الطّبّ (غواتس، 2003، ص 55-56).
وأهمّ الثّقافات الّتي نُقلت وتُرجمت في العصر العبّاسيّ، نذكر:
- الثّقافة الفارسيَّة.
- الثّقافة اليونانيَّة والرّومانيَّة.
- الثّقافة الهنديَّة.
- نتائج عمليَّة النّقل والتّرجمة في العصر العبّاسيّ
لقد أفرزت عمليَّة التّرجمة في تلك الفترة، نتائج على قدر من الأهمّيَّة، وهي:
- توسّع رقعة المعرفة في العالم الإسلامي، ودخول فنون وفلسفات جديدة لم تكن مألوفة لدى العرب والإسلام من قبل، وأوجد التّفاعل بين الفكر الأجنبي والتّراث العربي إنتاجًا علميًّا وحضاريًّا فريدًا.
- أصبحت اللّغة العربيَّة لغة المعارف الإنسانيَّة، بعد أن كانت مقتصرةً على مجموعة من القبائل في الجزيرة العربيَّة.
- تلقّي المعجم العربي الكثير من المفردات الأجنبيَّة الّتي تمّ تعريبها لكي تناسب اللّغة العربيَّة، الأمر الّذي أثبت جدارة هذه اللّغة وقدرتها على استيعاب الثّقافات الأخرى المتنوّعة.
- فاقت الحضارة العربيَّة كل الحضارات الأخرى من حيث العظمة والغنى، فهي إضافةً إلى كونها حضارة أدبيَّة مليئة بالإنجازات، فإنَّ أرضها تمتلك الكثير من الثّروات والمقدّرات الّتي تميّزها عن باقي الحضارات.
- إنَّ الحضارة الإسلاميَّة أضحت صلة الوصل بين الحضارة القديمة، والحضارة الأوروبيَّة الحديثة.
- إنَّ علماء ومفكّري تلك الحقبة، أثروا المعارف العلميَّة، ممّا أحدث تقدّمًا وازدهارًا عارمًا في العصر العبّاسيّ وما بعده.
ثالثًا: عمليَّة النّقل والتّرجمة في العصر الحديث
على الرّغم من أصالة اللّغة العربيَّة إلَّا أنّها تأثّرت ببعض الألفاظ الأجنبيَّة، ولم يخف العرب من دخول تلك الألفاظ إلى لغتهم، فقاموا بتقريبها ووضعوها على أوزان عربيَّة، وأخضعوها لقواعد اللّغة العربيَّة، فأصبحت فيما بعد ألفاظًا معرّبة. وقد ازدهرت التّرجمة في العصر العبّاسيّ بوجود علماء، وفلاسفة، ومفكّرين تأثّروا بعمليَّة ترجمة المعارف القديمة، وكتبوا رسائل ومؤلّفات، ووضعوا المصطلحات لمواكبة ما وصلت إليه المعرفة الإنسانيَّة في مختلف مجالات العلوم، واجتهدوا في إغناء اللّغة، وتطويعها لتصبح لغة البحث العلميّ والتّدريس على جميع المستويات (التّميمي، 2013، ص 72).
جاء عصر الانحطاط وهي تلك الفترة الزّمنيَّة الممتدّة بين عام 1258م تاريخ سقوط بغداد وعام 1789م تاريخ حملة نابليون بونابرت على مصر، وامتدّ عصر الضّعف إلى عام 1916م تاريخ سقوط الخلافة العثمانيَّة. فتراجعت اللّغة العربيَّة وانكمشت في المساجد والكتاتيب، واقتصرت على العلوم الدّينيَّة، وأصبحت اللّغات الأجنبيَّة هي اللّغات الرّسميَّة، والدّارجة بين الجماهير نتيجة السّيطرة الاستعماريَّة العسكريَّة والفكريَّة، ومحاولتهم محو اللّغة العربيَّة وإحلال لغات أخرى محلّها (ص 73). إلّا أنّ محاولاتهم باءت بالفشل، فاللّغة العربيَّة هي لغة القرآن، وهي لغة لها تاريخها، ووجودها الحضاريّ والإنسانيّ.
وبعدها ظهر ما عرف ب”اليقظة العربيَّة” بين عامي 1800- 1950، وهذه الحركة ظهرت في البلاد العربيَّة بعد أن قامت فيها النّهضة، واستعادت اللّغة العربيَّة مجدها، وعادت إلى احتكاكها بباقي اللّغات، والحضارات المتقدّمة والمتطوّرة. وفي هذا العصر عرفت بلاد الشّام عمليَّة التّرجمة في بداية القرن التّاسع عشر، واقتصرت على الكتب الدّينيّة والأدبيَّة. أمّا في مصر فقد أولى محمد علي باشا اهتمامًا بالتّرجمة بهدف إحداث تغيير في الدّولة المصريّة، للوصول إلى الحداثة.
وقد أدّى الرّوّاد الأوائل من المترجمين في العصرين الأموي والعبّاسيّ، وعصر النّهضة، مثل الشّيخ الطّهطاوي، والكاتب اللّبناني بطرس البستاني، وإبراهيم اليازجي، ونجيب حدّاد الّذي نقل إلى العربيَّة مأساة شكسبير “روميو وجولييت”، والأدباء العرب، مثل أحمد حسن الزّيّات، وخليل مطران، وطه حسين، ومصطفى لطفي المنفلوطي وغيرهم دورًا عظيمًا في عمليَّة التّرجمة، وفي ترسيخ اللّغة العربيَّة وتنقيتها بفضل دأبهم، وعملهم المتواصل لصيانة اللّغة العربيَّة وتطويرها، إذ بذلوا جهودًا محمودة، ووضعوا مصطلحات تعبّر عن الجديد، وأصدروا مجلّات تخدم العلم، وأهدافه (ص 73).
- مظاهر تطّور النّثر العربي الحديث
إنَّ التّطوّر في النّثر، لم يجرِ بشكلٍ سريع، بل جاء نتيجة تراكم تجارب عدّة، من تواتر ثقافات متنوّعة. وهناك مظاهر لتطوّر هذا النّثر، وهي اللّغة، والموضوعات، والفنون.
- اللّغة: بعد ضعف الدّولة العربيَّة الإسلاميَّة، مالت اللّغة العربيَّة إلى التّعقيد اللّفظي المليء بالصّور البيانيَّة والمحسّنات البديعيَّة، وهذا أثّر في المعنى إلى حدِّ كبير، إذ باتت اللّغة صعبة الفهم، وبعيدة كلّ البعد من لغة الحياة. إلَّا أنَّ وجود مجموعة كبيرة من المفكّرين والمترجمين، وانتشار المعارف، أصبح الأسلوب اللّغويّ أكثر سلاسة، وسهولة، ووضوح، وابتعد من التّكلّف والتّعقيد.
ولكنَّ تحوّل اللّغة إلى هذا المستوى من السّلاسة لم يكن أمرًا سهلًا، بل تخلّله الكثير من العوائق، الّتي جاءت نتيجة الخصومات بين الأدباء، فكلٌّ منهم لديه رأي خاصّ به، وقد اختلفت الآراء بين المحدثين والقدماء على موضوع الأسلوب؛ فمنهم من نادى بضرورة الحفاظ على التّراث القديم بما فيه من تعقيدات، ومنهم من قال بضرورة التّغيير واعتماد أساليب جديدة. والمقصود في تغيير الأسلوب ليس عدم الاهتمام بالشّكل، إنّما إيلاء الاهتمام بالشّكل والمضمون.
إنَّ الغالبيَّة من الأدباء مالت إلى البساطة، والإيجاز، والبعد من التَّأنّق بكلّ أنواعه في الجوانب الشّكليَّة، حتّى يكون ما يكتبونه مفهومًا عند الجميع، فالأدباء والمترجمون لم يرجعوا إلى الأسلوب القديم الفصيح، أو الأسلوب المرسل الحر، بل أخذوا يبسّطون أسلوبهم تبسيطًا لا ينزل به إلى مستوى العامّة، أو إلى الابتذال، وفي الوقت ذاته لا يعلو عليهم، بحيث يشعرون بشيءٍ من العسر في قراءته وفهمه، إنّه أسلوبٌ بسيطٌ سهلٌ، لكنّه عربيٌّ فصيح (ضيف، 2004، ص 176).
- الموضوعات: تمثّل الموضوعات مظهرًا ثانيًا من مظاهر تطوّر النّثر العربيّ الحديث، إذ تعدّدت الموضوعات وتنوّعت. ونتيجة الوعي السّياسيّ في القرن التّاسع عشر، وانتشار الصّحف، حلّت موضوعات جديدة محلّ الموضوعات القديمة الّتي كانت تتّصف بالجمود والتّقليد، وقد حلّت الأمّة محلّ الفرد، فلم يعد الأديب يتوجّه إلى شخص معيّن، بل أصبحت كتاباته تعني الجميع على اختلافهم.
سعى النّثر إلى التّوسّع وعدم القوقعة، إذ إنَّ الكاتب أصبح يتمتّع بحرّيّة أكبر، ولم يعد مرتهنًا لزعيم أو قبيلة أو غير ذلك. يكتب أفكاره بكل ديمقراطيَّة بعيدًا من الضّغوط، وتحوّل إلى الجماعة الأكبر، ويهتمّ بها، ويسعى إلى استقطابها، وتحوّل الشّأن العام الشّغل الشّاغل للأدباء، بعدما كانوا يصبّون جلّ اهتمامهم على أشخاص بعينهم. وانتشرت الموضوعات السّياسيَّة والاجتماعيَّة الّتي تخصّ المجتمع والنّاس بشكلٍ عامّ، إلى جانب الموضوعات الأدبيَّة.
- الفنون: أمّا فيما يتعلّق بفنون النّثر، فقد تأثّر النّثر الحديث بالآداب الأوروبيَّة المترجمة، كانتشار الصّحف، والمقالةـ والقصّة، والمسرحيَّة. وقد ازدهرت الخطابة بشكلٍ كبير، وخصوصًا تلك الّتي تناولت قضايا سياسيَّة، والسّبب في ذلك يعود إلى التّأثّر بالقيم الغربيّة المنادية بالحرّيّة والدّفاع عن الحقوق، كما أنّ ظهور الأحزاب السّياسيَّة زاد من وجود الخطباء، وكلّ خطيب يسعى لشدّ عصب جمهوره، ومن أشهر الخطباء السّياسيّين، هناك في مصر سعد زغلول ومصطفى كامل.
أمَّا ما طرأ على النّثر، بالمعنى العامّ الّذي يعني الكتابة والتّأليف، من تطوّر وتغيير، فقد أوضحه جرجي زيدان على الوجه الآتي:
- سلاسة العبارة، وسهولتها بحيث لا يتكلّف القارئ إعمال الفكر في فهمها.
- تجنّب الألفاظ المهجورة والعبارات المنسجمة، إلَّا ما يجيء عفوًا ولا يثقل على السّمع.
- تقصير العبارة وتجريدها من التّنسيق والحشو، حتّى يكون اللّفظ على قدر المعنى.
- ترتيب الموضوع ترتيبًا منطقيًّا في حلقات متناسقة، يأخذ بعضها برقاب بعض، وتنطبق أوائلها على أواخرها.
- تقسيم الموضوعات إلى أبواب وفصول، وتصدير كل باب أو فصل بلفظ أو عبارة تدلّ على موضوعه.
- تذييل الكتب بفهارس أبجديَّة تسهّل البحث عن فروع الموضوع الأصليّ، وقد يجعلون للكتاب الواحد عدّة فهارس: فهرس الموضوعات، وثانٍ للأعلام، وثالث لغير ذلك.
- تنويع أشكال الحروف على مقتضى أهمّيّة الكلام، فيجعلون للمتن حرفًا، وللشّكل حرفًا، وللرّؤوسِ حرفًا.
- تسمية الكتب باسم يدلّ على موضوعها، كتسمية كتاب تاريخ مصر بتاريخ مصر، وكتاب الكيمياء بالكيمياء، وكتاب النّحو بالنّحو، وأبطلوا التّسجيع في أسمائها.
- تزيين المؤلّفات بالرّسوم، وضبط الألفاظ بالحركات عند الاقتضاء.
- إذا أرادوا إسناد الكلام إلى كتاب، أشاروا إلى ذلك في ذيل الصّحيفة.
- فصل الجمل بنقاط، أو علامات تدلّ على أغراض الكاتب، كالوقف، والتّعجّب، والاستفهام أو نحو ذلك، وعلامات الجمل المعترضة، أو تمييز بعض الأحوال (زيدان، 2014، ص 607-608).
إذًا، نخلص إلى القول بأنَّ النّثر العربي الحديث مزج بين الحضارات المختلفة، ونهل من معينها، مع الإبقاء على خصوصيَّة وفرادة اللّغة العربيَّة، واتّبع الأسلوب السّهل في المضمون بما يخدم البيئة والمحيط الّذي يعيشه الكاتب. فالكاتب أصبح أكثر واقعيَّة في العصر الحديث، يستلهم موضوعاته من ظروف الحياة الّتي يعيشها.
الخاتمة
إنَّ عمليَة النّقل والتّرجمة هي عمليَّة لا بدّ منها في المجال الأدبيّ والعلميّ، لأنّها صلة الوصل الّتي تربط بين مختلف الشّعوب والثّقافات، إذ تؤدّي إلى تحقيق النّموّ والازدهار من خلال تبادل الأفكار، والخبرات، والإصدارات، والمؤلّفات، وكل ما له علاقة بالإنتاج النّثري الأدبيّ.
لا يمكن أن يتحقّق أي تواصل بشري بين شعوب المعمورة إلّا عن طريق وجود ترجمة فاعلة ومؤثّرة، ولا سيّما أنّنا نعيش في عصر العولمة والتّقدّم التّكنولوجيّ المتسارع.
لقد كان العصر العبّاسيّ رائدًا في مجال النّقل والتّرجمة، إذ شهد على الكثير من التّداخل الثّقافي والحضاريّ، فقد استلهم من الحضارة القديمة وصحّح بعض أخطائها في مجالاتٍ عدّة، وفي الوقت ذاته انفتح على الحضارة الأجنبيَّة ونهل من معينها، ممّا أغنى هذه الحضارة بمفردات ومصطلحات اعتُمدت في الدّين، والقانون، والسّياسة، وغيرها.
واستكمل العصر الحديث، ما بدأ به العصر العبّاسيّ من اهتمام بالنّثر وترجمته، والاستقاء من الحضارات الأجنبيَّة في سبيل خدمة الحضارة العربيَّة وإغنائها بما هو جديد.
لائحة المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مكرم (1988). لسان العرب. بيروت: دار الجيل.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1999). لسان العرب، تق: عبد الله العلايلي. بيروت: دار لسان العرب.
- التّميمي، رجحان (2013). “حركة التّرجمة والتّعريب في الوطن العربيّ: تاريخها ومعطياتها”. مجلّة اتّحاد الجامعات العربيَّة للآداب 10 (1)، ص 71-88.
- زيدان، جرجي (2014). تاريخ آداب اللّغة العربيَّة (لا. ط). القاهرة: مؤسّسة هنداوي للنّشر والتّوزيع.
- ضيف، شوقي (2004). الأدب العربيّ المعاصر في مصر (لا. ط). مصر: دار المعارف.
- غوتاس، ديميتري (2003). الفكر اليوناني والثّقافة العربيَّة (لا. ط)، تر: نقولا زيادة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة.
- لواتي، فاطمة (2016). التّرجمة وحوار الحضارات. (رسالة ماجستير). جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر.
- معلوف، لويس (2001). المنجد في اللّغة العربيَّة المعاصرة (ط2). بيروت: دار المشرق.
- مشوح، لبانة (2001). “التّرجمة والتّنمية الفكريَّة- القطاع الإداري أنموذجًا”. مجلَّة جامعة دمشق 27 (3-4)، ص 786.
- الهنائي، علي بن الحسن (1960). المنجد في اللّغة والإعلام (ط21). بيروت: دار المشرق.
[1] أستاذ مساعد في الجامعة اللّبنانيّة – كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة – الفرع الخامس الاختصاص الدقيق (الأدب الروائي والمسرحي)
عدد الزوار:22




