محاولة تداوليّة في قراءة خطاب الإمام علي (ع) السّياسيّ سلطة الخطاب ونظامه في خطبة “الانصراف من حطّين” أنموذجًا
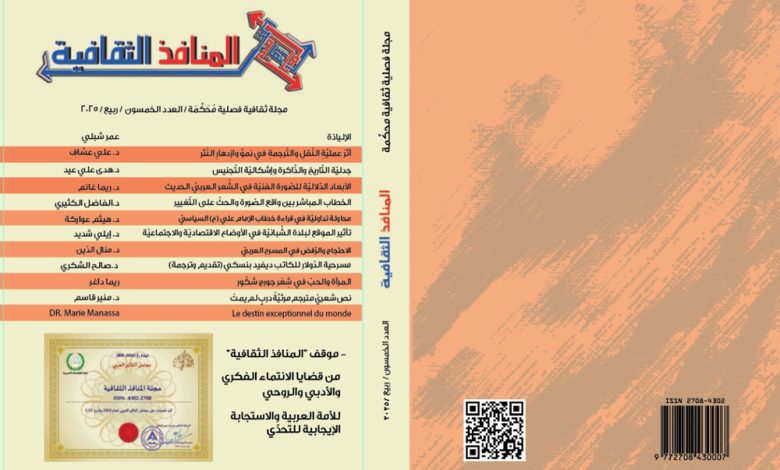
محاولة تداوليّة في قراءة خطاب الإمام علي (ع) السّياسيّ.
سلطة الخطاب ونظامه في خطبة “الانصراف من حطّين” أنموذجًا
Adeliberative attempt to read the political speech of Imam Ali
The authority and order of speech in the “Departure from Hattin” sermon as an example
د. هيثم قاسم عواركه
Haitham Qasim Awarka
تاريخ الاستلام 7/12/ 2024 تاريخ القبول 23/12/2024
ملخّص البحث
يحتلّ الإمام علي (ع) مكانة مرموقة في مجال البلاغة والأدب، فهو أمير من أمراء البلاغة، وخطاباته تشهد على هذا الزّخم اللّغويّ والأدبيّ الكبير الذي يتركه بعد كلّ خطاب. إنّ هذه المزايا تسمح للإمام علي (ع) أن يكون مادّة تحليليّة مهمّة، وفيها كمّ لغويّ من المعطيات والاستنتاجات، ولا سيّما إذا كنّا بحاجة إلى إثبات نظريّة خطابيّة- لغويّة ما. من أجل ذلك كان هذا البحث لمقاربة أثر خطبة من خطابات الإمام علي بناء على نظريّة “فوكو” الخطابيّة، وكانت ملاحظة الفرق بين الخطاب السّياسيّ النّفعيّ والخطاب الإيمانيّ المخلص لله سبحانه وتعالى ومصلحة الشعب، وهو خطاب الإمام علي (ع).
Abstract
Imam Ali occupies a prominent position in the field of rhetoric and literature, as he is one of the emirs of rhetoric, and his speeches testify to this great linguistic and literary momentum that he leaves after each speech. These advantages allow Imam Ali to be an important analytical material, and it contains a linguistic amount of data and conclusions, especially if we need to prove a rhetorical-linguistic theory. For this reason, this research was to approach the effect of one of the speeches of Imam Ali based on the rhetorical theory of “Foucault”, and the difference between the utilitarian political discourse and the faithful discourse of faith to God Almighty and the interest of the people, which is the speech of Imam Ali.
تمهيد
لا تنفكّ اللّغة عن الواقع السّياسيّ للأمم والشّعوب، وهذه لازمة حضاريّة سادت منذ أوّل تشكّل لغويّ عرفته البشريّة، فالسّياسة مرتبطة بالنّاس وتعبّر عن شؤونهم وأهدافهم وتقف على تحسينهم وتأمين قوانين معيشتهم؛ كي يسود النّظام في المجتمع وتتمأسس المؤسّسات التي تصون هذا النّظام، ولطالما كانت اللّغة اللاعب الأبرز في هذا المجال؛ فكلّما ارتقت اللّغة في الخطاب السّياسيّ وجاءت مشفوعة بأسلوب من استدلاليّ من البرهنة، زاد زخم الخطاب السّياسيّ وتأثيره في الثقافة المجتمعيّة التي يخوض فيها.
شهدت نظريّات الخطاب تطوّرًا ملحوظًا مع بروز الحقبة اللّسانيّة في العمل اللّغويّ، وهذا ما أدّى إلى حقول تخصّصيّة في المقاربات الخطابيّة، فبتنا نشهد خطاب اللّسانيّات الاجتماعيّة، وكذلك خطاب اللّسانيّات الثقافيّة، ثمّ خطاب الفقه الدّينيّ، أو الأصوليّات اللّغويّة… وعليه فإنّه لا يعد مستغربًا أن تنشأ على الإثر نظريّات تهتم بالخطاب السّلطويّ، أو سلطة الخطاب المنطلق من نظامه، فتتشكّل إجراءات وآليّات لدراسة الخطاب السّياسيّ.
ولعلّ “ميشيل فوكو”[1] من أبرز من تصدّى إلى قضيّة السّلطة وعلاقتها بالخطاب، ثمّ بالنّظام اللّغويّ الذي ينبني على محاولة تمتين الحكم من خلال إجراءاته؛ إلّا أنّ هذا الوضع غالبًا ما يصطدم بردّة فعل عكسيّة- وقائيّة من لدن الناس، إذ إنّهم يحاولون تفادي هذا الوضع التّسلّطيّ بإجراءات رقابيّة على الخطاب. وهذا ما تقصّدناه في انتخاب عيّنة خطابيّة من عيّنات الإمام علي (ع)، بما يضمن إظهار الميزة الخطابيّة الحداثيّة في طبيعة لغة الإمام علي (ع) إبّان وجوده في رئاسة العالم الإسلاميّ، وتلقّف مدى تطابق ظروف خطابه المتخصّص مع إجراءات الحداثة الخطابيّة ومعاييرها كما قوننها “فوكو” في نظريّته.
بالنّظر إلى طبيعة الموضوع وتشابكه بين أكثر من حقل معرفيّ، ومحاولة هندسته على أساس إجراءات ومعايير تحليليّة تفضي إلى نتائج ملموسة في طبيعة الخطاب السّياسيّ، فمن الممكن للإشكاليّة أن تندرج على النسق الآتي:
إشكاليّة البحث:
كيف يتكوّن الخطاب السّياسيّ في لغة الإمام علي (ع)؟ وإلى أيّ مدى يؤدّي هذا الخطاب إلى معالم رقابيّة تحدّ من سلطة الشخص إزاء مصلحة المجتمع؟ وعلى أيّ أساس تنبني سلطة خطاب الإمام علي (ع)؟ أمن شخصه؟ أم من الخطاب مجرّدًا من كينونة الإمام (ع) الذاتيّة؟ وكيف يبني المتلقّي رأيه بين خطاب الإمام علي (ع) وخطاب خصومه في السّياسة؟
وتأتي الفرضيّات المرصودة للإجابة من خلال التّحليل عن هذه الإشكاليّة كالآتي:
فرضيّات البحث
- يتكوّن خطاب الإمام علي (ع) من خلال المجتمع الذي يتواصل معه؛ أي من خلال أعراف الناس وما يعنيهم من تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم.
- كان خطاب الإمام علي (ع) ينتمي إلى الناس، إذ إنّه في حوزتهم على نسق الخطاب الموجّه إلى الجمهور، ما يؤدّي إلى موازنته ومراقبته؛ لأنّه مرصود من أجل المجتمع.
- يحاول الإمام علي (ع) إسباغ شخصه على خطابه، فيتّحد مع اللّغة التي يتقدّم بها خطابه، وهذا ما يدعو إلى دراسة خطاب الإمام علي (ع) بمعزل عن شخصيّته المتأمّنة أصلًا في خطابه.
- يبني المتلقّي رأيه بين خطاب الإمام علي (ع) وخطاب خصومه على أساس نفعيّ، وهذه درجات في المتعالقات الخارجيّة للخطاب، فكلّ متلقّ يتلقّف الخطاب بحسب مرجعيّته وثقافته وأيديلوجيّته ونظرته إلى الحياة والسّياسة.
والمنهج المرصود للمعالجة التّحليليّة في هذا البحث يكون المنهج التداوليّ.
منهج البحث
يتناسب المنهج التداوليّ ودراسة الخطاب البشريّ عمومًا، وذلك لإيمانه بالقيمة التواصليّة والمجتمعيّة للغة، وأنّ الخطاب يتحرّك بحيويّة في إطاره التواصليّ مع القاعدة الشعبيّة التي يُرصَد من أجلها، وذلك بتحفيز الأفعال اللّغويّة للإنجاز التواصليّ. ” التّداوليّة من مكونات النظرية السّيميائيّة الجوهريّة التي تدرس العلاقات بين العلامات ومستخدميها. ويشير فان دايك إلى أنّ التّداوليّة، ينبغي لها أن تخصص للمجال العملي أو الإجرائي الذي يقوم على قوانين اللّغة وما يكون لها من آثار في إنتاج المنطوقات وتفسيرها، وهي بوجه خاص لا بدّ من أن تسهم في تحليل الشروط التي تجعل المنطوقات مقبولة في موقف بعينه عند متكلمي اللّغة. استمدت التّداوليّة في جوهرها من فلسفة اللّغة، لاسيما نظرية أفعال الكلام، واستمدت من تحليل المخاطبات ومن الاختلافات الثقافية في التفاعل اللغوي على الشكل الذي تراه العلوم الاجتماعية”[2]. على هذه الأنساق التحليليّة يكون الاشتغال التطبيقيّ على خطبة الإمام علي (ع).
وقد وقع تقسيم البحث في شقّيْن: الأوّل هامش نظريّ لإيضاح رؤية “فوكو” لسلطة الخطاب السّياسيّ. وأمّا الثاني فللتطبيق على خطبة الإمام علي (ع).
أوّلًا: الهامش النظريّ
تدلّ حركة الخطاب السّياسيّ على وضع تشابكيّ معقّد بين أكثر من طرف، فالخطاب متشعّب ولا ينحصر في المدوّنة اللّغويّة وحسب؛ بل يتعدّى ذلك إلى اصطلاحات تواصليّة غالبًا ما تكون منتمية إلى موضوعات الخطاب وأفكاره والشّرائح المعنيّة فيه. وفي سياق متّصل يطلّ مصطلح السّياسة، وهو من العلوم المعرفيّة الواسعة، وحاله كحال الخطاب يرتبط هو الآخر بميادين المجتمع التواصليّ شتّى؛ لأنّ السّياسة محسوبة على علوم التنظيم البشريّ. يُنْشئ الخطاب السّياسيّ إذًا لغة وظيفيّة أي ذات طبيعة وظيفيّة تشغيليّة متخصّصة، تلك اللّغة التي تُوَظَّف في السّلطة، أو بناء الأيديولوجيّات، أو إنتاج الثقافات، وصولًا إلى معالجة مشكلات المجتمع وشؤونه وهمومه؛ على أساس أنّ المجتمع الإنسانيّ السليم يقوم على حصول المشكلات كي تتدخّل السّياسة بتخصّصها اللّغويّ للوقوف على هذه المشاكل وتفنيدها ومعالجتها، وتعين الحقول اللّسانيّة في هذا الأمر، إذ إنّها حقول معرفيّة، لعلّ من أبرز مزاياها أنّها فَرَقَت بين المصطلحات المفاهيميّة، كالفرق بين اللّغة واللسان مثلًا… وسرعان ما تسلّلت اللّسانيّات إلى المعارف الإنسانيّة، فبدأنا نسمع باللّسانيّات الاقتصاديّة، أو اللّسانيّات الثّقافيّة، ثمّ اللّسانيّات أو علم الاجتماع اللّغويّ، وقد تكون هذه اللّسانيّات الاجتماعيّة مدخلًا صائبًا لمقاربة الخطاب السّياسيّ.
تثير استعماليّة اللّغة وطرائق توظيفها في الميادين الحياتيّة المعيشة مشاكل قديمة؛ ولكنّها تتجدّد على الدوام، ولا سيّما في خضمّ الخطاب السّياسيّ، وهذا ما يتبيّن في نقاشات الفلاسفة وعلماء الثقافة والاجتماع السّياسيّ. تعود هذه السّجالات إلى عصور قديمة جدًّا، ولا سيّما في وقت درجت فيه مصطلحات “السّفسطة”، أو فرقة “السّفسطائيّون”[3]، إذ بدا لدى “أرسطو” و”أفلاطون” وغيرهما تنظير حيال هذا الموضوع، وخصوصًا عند الحاجة إلى ربط اللّغة بالواقع أو المنطق لغرض نفعيّ. شهدت هذه السّجالات تطوّرًا في دراسات الوعي اللّغويّ، أو ارتباط اللّغة بالفكر، كما ورد في أبحاث “ديكارت”، ثمّ تطوّرت لتطاول ارتباطات اللّغة بالمجتمع، ومعالجة إشكاليّة أيّ أثر تتركه اللّغة في البيئة المجتمعيّة التي تتداولها؛ ولكن لم تشهد هذه التنظيرات اكتمالًا إلّا على يد “سابير”[4] وتنظيراته فيما يخصّ نظام اللّغة الاجتماعيّ، أو علم اللّغة الاجتماعيّ. وكحصيلة لهذه الجهود، بات الخطاب اللّغويّ صفة ممنوحة إلى كلّ حالة تلفّظيّة تشتغل في مجتمعها، أي تصبح ممارسة اجتماعيّة.
قامت نظرة اللّسانيّات بالأصل على تحويل اللّغة خطابًا اجتماعيًّا؛ والمقصود بالخطاب الاجتماعيّ أن تغدو اللّغة فاعلة بحسب ممارستها في المجتمع: “اللّغة جزء من المجتمع…ويعني ثانيًا أنّ اللّغة صيرورة اجتماعية. وثالثًا أنّ اللّغة صيرورة مشروطة اجتماعيًّا، أي مشروطة بالجوانب غير اللغوية من المجتمع”[5]. على هذا النسق انبثقت تنظيرات تحاول ربط الخطاب اللّغويّ بميادين حياتيّة؛ بما يعدو اللّغة لأجل اللّغة، أو الخطاب الأدبيّ المتخصّص؛ بل تنتقل الأمور لمجاورة معالم أخرى: مثل الميدان الاجتماعيّ، أو الثقافيّ، أو الدّينيّ، أو السّياسيّ… هذه خطابات زاخرة باللّغة الوظيفيّة المتخصّصة، إذ إنّ طبيعتها اللّغويّة تحدّد هويّتها وتبيّن خصائصها، والاعتماد في هذا البحث ينصبّ على “ميشيل فوكو” ورؤيته للخطاب وكيفيّة توظيفه في المجتمع من بوّابة السّياسة ولغتها التأثيريّة، ومقاربة أثر الإمام علي (ع) في ضوء هذه المعايير التقعيديّة للخطاب.
لا بأس من مدخَل تاريخيّ – حضاريّ لقضيّة الخطاب السّياسيّ، ولعلّ هذا النوع من الخطابات النفعيّة اللّغويّة قد انضوى في بداية الأمر إلى مصطلح “السفسطة”، والسفسطائيّة نهج انتهجته فرقة من الناس بعد أن تلقّفت سلطة اللّغة والخطاب في التلاعب بالعقول وتغيير النفوس، خصوصًا عند استخدام أساليب اللّغة التّمويهيّة، من إغراء وتحذير وتجييش وتلغيز، وصولًا إلى خطاب المغالطات اللّغويّة، إذ يسهل على السّفسطائيّ الماهر إيقاع خصمه في المغالطة اللّغويّة. هذه المفارقات جعلت من اللّغة مسألة إشكاليّة، إشكاليّتها تقع من حيث خطورتها التي تتبدّى في قوّة الأثر، على أنّ لهذه القوّة أشكالًا مختلفة، فقد تكون من اللّغة ذاتها، أي بحدّ إمكانات الشخص (المخاطِب) ومعارفه أو مهاراته اللّغويّة، وقد تكون مدفوعة بسلطة لنصّ رديف كالنصّ الدّينيّ أو الثقافيّ أو العقائديّ الأيديولوجيّ، بما يدخل في صميم اعتبارات الناس، في خضمّ هذا الصراع تتسلّل آراء “ميشيل فوكو” حول جدليّة القوّة الخطابيّة التأثيريّة، ولا سيّما لعبة التناظر السّياسيّ، واللّغة المستَثْمَرة في هذا النوع من الخطاب: “وعلى هذا النحو لا يبقى الخطاب، كما اعتقد الموقف التفسيري، كنزا مليئا لا ينفذ… بل إنه سيغدو ثروة متناهية، ومحدودة ومرغوبة ومفيدة لها قوانين ظهورها، وأيضا شروط تملكها، واستثمارها. ثروة تطرح بالتالي، ما إن تظهر إلى الوجود… مسألة السّلطة، ثروة هي بطبيعتها موضوع صراع، صراع سياسي”[6]. يولّد هذا الرّأي الذي ينادي بجدّيّة اللّغة، ووجوديّة الخطاب، كمًّا من التساؤلات التأمّليّة؛ لأنّ الأمر يعدو مسألة القول العاديّ، أو فلنقل يرفعه إلى مستوى من الجدّيّة لأنّ: “ثقافتنا تنزع إلى تحويل نسبة متزايدة باستمرار، من أفعالنا الخطابية العادية، إلى أفعال خطابية جادة، وهو يرى في هذه النزعة التعبير عن إرادة في الحقيقة، تستمر في التوطُّد والتّجذُّر وفي فرض نفسها أكثر فأكثر”[7]. على ما يبدو أنّ “فوكو” أقرّ بوجود القوّة الخطابيّة من خلال توق الإنسان المستمرّ نحو الوجود، وأن يضفي بصمته المميّزة على المسائل من حوله، وهذا التّوق هو الذي يجعل لخطاباتنا سلطة مستلّة من نظام الخطاب أصلًا. يبني فوكو نظريّته على أسس معرفيّة- لغويّة ترافق هوامش القوّة السلطويّة، ومن آرائه ما لاحظه حول قيمة الخطاب في رفع ترقية السّلطة أو تسفيلها: “ففي الخطاب بالذات، هو ربط السّلطة بالمعرفة. نحن هنا إزاء زوجين من المفاهيم لا ينفك أحدهما عن الآخر، كما بينت تحليلات فوكو لكيفية تشكل السّلطة في المجتمع الحديث. فعلوم الإنسان في مجالات النفس والاجتماع والاناسة، لم تنشأ في عقول صافية يحركها شغف المعرفة لا غير، وإنما هي نشأت واصبحت ممكنة مع تشكل المجتمع الانضباطي والعصر الصناعي: إنتاج معرفة حول البشر، أفرادًا وجماعات، لإخضاعهم وتطويعهم. وهكذا لكل سلطة معرفتها، كما لكل حقيقة سياستها.”[8]. على هذا النّحو يمكن إفراد هذه النّقاط الآتية وصولًا إلى تبنّي آليات تسعفنا، في ضوء نظريّة فوكو، على تحليل خطاب الإمام علي(ع).
- لغة السّياسة وتشابك موضوعات الخطاب الوظيفيّ
تحكم السّياسة الخطاب بمجالات لغويّة متفرّعة ومتشعّبة وشديدة التّعقيد والانتقائيّة، فالأفكار كثرة، والموضوعات قد تتداخل في أطرها المعرفيّة، ومعلوم أنّ الخطاب السّياسيّ يؤسّس حركة انتقاليّة بين الحاضر وما سبقه، والواقع وما سيأتي حيالَ ظروف الناس وواقعهم، فالأجدى بالخطيب السّياسيّ أن يتميّز بصفة النّقد والمراجعة الإحصائيّة والشّاملة، ثمّ يلحقها ببناء جديد على أعقاب نقده. ومن الممكن حصر هذه الجوانب النقديّة في الجدول الآتي:
| حدّ الخطاب أو مفضياته الجوهريّة. | تغيير التصنيف المعياريّ للمسائل المعيشة. | عزل الخطاب من معياريّة تصنيفه في الحقول التخصّصيّة. |
| كان الخطاب منفتحًا، ولا سيّما في الحقل التاريخيّ، وهذا ما كان يسقطه في صراع التأويلات والتأصيلات. | قام الخطاب التقليديّ على تناقضات من حيث شكليّات قضايا المجتمع: كالأصالة والمعاصرة، والتقليد والتجديد، والمعياريّة والإبداع… | تصنّفَت الخطابات بردّها إلى تاريخ المنشأ، فأصبح كلّ محفل علميّ يرتبط بما يوازيه من حقول المعرفة، ولكن بناء على التاريخ الذي يخصّص كلّ حقل معرفيّ خطابيّ على حدة. |
| بناء على مقترحات “فوكو”، تغدو الأمور أكثر تحديدًا ومنهجيّةً، وتبلغ فيه النتائج مجالًا من الاستنتاجات التوافقيّة. | في رؤية “فوكو” اعتُمِدَ مبدأ التحليل والمقاربة عوضًا من المقارنة، وهذا ما يؤدّي إلى الإفادة النفعيّة التي تبني منهجيّة الخطاب الوظيفيّة. | هذا الوضع تعرّض إلى تعديل، واستُعيضَ عن التصنيفات المعياريّة بتحليلات تبحث في تكوينات الخطاب وتحليله وتكوّنه؛ أي باحترام تحوّلاته بحكم حقوله المعرفيّة المتعالقة. |
تؤدّي هذه المنبنيات إلى تغيير جذريّ يصيب الطروحات التحليليّة التي كانت تسمُ الخطاب، واحكمه في أطر تحليليّة مقيّدة، فالخطاب غير الممستقلّ لا يحظى باستقلاليّة؛ لأنّ قوّته في استقلاليّته، فالأصل في الخطاب السّياسيّ: “أنّه لا يتعامل مع وقائع التاريخ وأحداثه، بعقل سحري غيبي أو لاهوتي متعالٍ، وإنما حاول إرجاع الامور إلى نصابها. ذلك أن ما يوجد في النهاية هو الحاضر. أما الماضي بوثائقه ومخطوطاته وخطاباته، فهو يشكل جزءًا من بنية الحاضر والواقع الراهن.”[9].
يدلّ الجانب الأوّل من نظريّة فوكو على نوع من النّقد الذي وجّهه إلى الممارسة الخطابيّة، من حيث تجهيزها، وكان له في الجانب الثّاني حدّ الممارسة والتحليل، وكيفيّة تمايز الخطاب السّياسيّ من غيره، ويبدو ملحوظًا في تاريخ الحضارات أنّ الخطابات كانت تأتي على نسق توظيفات رمزيّة للوسم الحضاريّ، فقرن امتازت خطاباته بالصبغة الفلسفيّة، وآخر هيمنت عليه الحالة الطبّيّة، وكذا بالنّسبة إلى الحالة الدّينيّة، ثمّ حالة الدّين السّياسيّ، وهذا ما نحن في صدد مقاربته في بحثنا هذه. على أنّ هذه الخطابات بقيت مرتبطة حكمًا بما يتداخل فيها من أسباب الحضارة الأخرى؛ كدخول الدّين في العلم، مثل الذي حصل في أروربا إبّان الفلسفة الدّينيّة، وكذلك اضطرار الدّين أن يكون مكوّنًا في السّياسة كما حصل في الحضارة الإسلاميّة.
الخطاب السّياسيّ خطاب تنظيميّ، تعتمده الأمم بغرض تحسين شروط الحياة والقطاعات كافّة، ومن هذا المنطلق كان للخطاب السّياسيّ أن يحظى بشرعيّته، وكان له ان يستمدّ قوّته من استقلاليّته في منح حياة الناس التنظيم والقانون، ومن هذا القبيل مثلًا يتمكّن الخطاب السّياسيّ من توظيف الدّين ومهامّه بين الناس، بين أمور اقتصاديّة ماليّة، وأخرى اجتماعيّة، ثمّ في الإفتاء، وفي القتال والسّياسة…
مثل هذه الأنماط التحليليّة تفتح المجال أمام الخطاب السّياسيّ لفهم جزئيّات الموضوع، وأفكاره المتشعّبة، والوقوف على أبرز ارتباطاته، إذ تتوظّف هذه الارتباطات لتشي بطبيعة الخطاب الدّينيّ، وما أُرْفِق فيه من مهمات؛ أي تلك المنوطةة به لإظهارها وإبرازها في المجتمع، تتعيّن أوضاع الخطاب وكيفيّاته في هذا المجال “Positivité des discours” بمعنى أن يغدو الخطاب ذا قييمة تموضعيّة.
هذه الطروحات التي أمّنها “فوكو” في نظرته إلى الخطاب قد أسعفت المقام الإجرائيّ للخطاب السّياسيّ، على الأقل تمكّن الرجل من إحداث ميزة الفرق، أي إنّه خطاب يُحدِث فرقًا في مجتمعه، وعلى أساس قانون التواصل، لا مجال لحياة اللسان إلى في السوسيولسانيّات “Sociolinguistiques” كتوظيف المصطلح الدّينيّ مثلًا في أمرٍ مخصّص كالشأن السّياسيّ.
يترصّد المجتمع للخطاب بناءً على الكلام آنف الذكر، وتتعدّل مفاهيم “السّلطة الخطابيّة”، لتصبح مكوّنًا للنظام الخطابيّ برمّته؛ لأنّ الخطاب سيتّجه نحو التوظيف الرقابيّ، وسيصبح مادّة دسمة لسجالات الناس وتوظيفاتها، وتنبثق إشكاليّة مفادها كيفيّة استثمار السّلطة لقوّة الخطاب: أتراها تفيد منه لتطويع الرأي إليها واستمالة الناس للإيمان بمندرجاته؟ أم أنّ الخطاب السّياسيّ يشكّل سلطة قائمة بذاتها بمعزل عن أي توظيفات نفعيّة أخرى؟ لا جرم في أنّ الأمر يتّجه نحو طبيعة الخطاب ومناسبته، وكذلك ينظر في شخص من يتصدّى للخطاب ومكانته، علاوة على إمكاناته اللّغويّة. على هذا الأساس كان التمايز وتعديل النظر إلى مسألة سلطة الخطاب السّياسيّ.
- الخطاب والسّلطة بين حدّيْن: خطاب سياسيّ للناس أم عليهم؟
لطالما شكّل خطاب السّياسيّ في نظام اللّغويّ مادّة تثير ريبة الناس ومخاوفها، فالناس تهاب السّلطة، فخطاب السّياسة محتشد بملفوظات لغويّة محيّرة، قد نُظِمَت على تصرّف عال: ” ومن خلال النظر إلى التفرّد الوهمي للسلطة، فوكو كان قادرًا أيضًا على تصورها موضوعة ضد نفسها. وقد استطاع أن يفترض وبالتالي أن يدرس إمكانية أن السّلطة لا تفترض دائما شكلا واحدا فقط وأنه في ظل ذلك، يمكن أن تتعايش مع شكل معين من أشكال السّلطة جنبا إلى جنب مع أشكال أخرى من السّلطة أو حتى أن تتعارض معها. ومثل هذا التعايش والتعارض، بطبيعة الحال، ليست مجرّد مغامرات متضاربة، بل هي نوع من الأشياء التي يحتاج المرء إلى تحليلها تجريبيًا من أجل فهمها.”[10].
للخطاب حيثيّة وفاعليّة داخل المجتمع، فكيف إذا كان خطابًا سياسيًّا يوظّف الحوادث والمجريات، ويحاول تشغيل المجريات ضمن إجراءات لغويّة لصالحه، فتنبثق معالجم الربح والخسارة، والتحرّر والعبوديّة، والإيمان والكفران، والجهل واليقين، والوفاء والنكث والغدر بالمواثيق، وما تعارفت عليه الأمّة في لحظة تاريخيّة. مثل هذه الأمور كانت في بال الإمام علي (ع) إبّان تصدّيه لمواضع السّياسة في خطابه، خطاب يجمع بين الدّين والبلاغة وزهد السّياسة، فيميل خطابه للناس، إزاء ميلان خطاب سواه نحو السّلطة والحكم. إنّ المجتمع هو رقيب الخطاب السّياسيّ، ولطالما خوّفت السّلطة الناس إذا تمادت وبطشت؛ وفي المقابل أراحهم الخطاب السّياسيّ المتّزن الإيمانيّ.
عندما يعمد خطيب سياسيّ إلى الإدلاء بملفوظاته، يكون في باله هاجس الناس التي ترغب في الحدّ من مقدّرات السّلطة عليها، فالخطاب ها هنا يراعي المقامات الموازية لإنتاجه في سلطته، هذه الإجراءات الوظيفيّة تندرج على النحو الآتي:
- محيطات الخطاب: اعتبارات خارجيّة
تكون هذه المحيطات قريبة من ردود فعل الناس حيال الخطاب، مثل: المحظور والمكبوت المحرَّم، والفرق بين التعقّل واللاعقل- خطاب البِدَع، وميزان العدل: بين الحقّ والباطل.
المحظور والمكبوت المحرَّم: غالبًا ما تتكاثر التابوهات في المجتمعات الشرقيّة والإسلاميّة، وهذا طبيعيّ بحكم العادات والتقاليد والقيود، وكذلك سلطة النصوص الدّينيّة، كالتمرّد على القرآن الكريم مثلا وتعاليمه، أو مخالفة إرادة الرسول الأكرم (ص)… وعليه فإنّ من يتصدّى في خطابه لهكذا موضوعات، لا سكّ أنّه ذو مكانة أو قوّة ليستقطب هذا اللون من اللّغة المحرّمة. وعلى هذا الأساس يكون “الخطاب شكلًا من أشكال المراقبة والضبط، إذ يعملان ببراعة ولا يضربان الموضوع الذي يتم توجيهه كما تفعل السيادة. يعمل مبدأ المراقبة والضبط بمهارة أكثر بل وبرعاية دقيقة حتى، حتى تضمن طاعة الناس.”[11].
الفرق بين التّعقّل واللاعقل- خطاب البِدَع: قد تطغى خطابات البِدَع والافتراءات والتّلفيقات على الخطاب السّياسيّ، وهذا منطقيّ بحكم الرغبة الاستحواذيّة على العباد، فتُنْسَجُ توقّعات، وتؤَلَّف روايات، وتُنْسَبُ أحاديث… قد لا يقبلها العقل، وتحدث موازنة عندئذ لقياس الخطاب التعقّليّ من الخطاب البِدَعيّ.
ميزان العدل: بين الحقّ والباطل: عندما يتقاطع عنصران على هدف واحد، تسود معادلة حجاجيّة بين الطرفيْن، إذ يحشد كلّ طرف حجاجه زاعمًا أنّ الحقّ معه والباطل سمة الخصم. في هذه المرحلة الخطابيّة تبدو قوّة الحقيقة؛ أي الثابت المتَّفَق عليه في الدّين مثلًا، محطّ أنظار الجمهور ومكمن القوّة؛ لأنّ العدل في الحقّ ولكلمته ومناصرته، وهذا ثابت في تكوين الخطاب وتشكيل سلطته السّياسيّة.
- كينونة الخطاب الدّاخليّة
من المنطقيّ أن تتحدّد إجراءات لمقاربة الخطاب داخليًّا بعد إنضاج إجراءاته الخارجيّة، وهكذا يُستَكْمَل البنيان النظريّ، وهكذا جعل فوكو إجراءات داخليّة للخطاب، كي تنظر في مضامينه اللّغويّة من داخله، وهي: “إجراءات تعمل بالأحرى على شكل مبادئ للتصنيف والتّنظيم والتوزيع، كما لو أن الأمر يتعلّق هذه المرة بالتحكّم في بعد آخر من أبعاد الخطاب: بعد الحدث والصدفة”[12]. ومن الممكن تحديدها على الشكل الآتي:
مبدأ التّناص التّعالقيّ: إنّ الحضارات الإنسانيّة تنبني على تراكمات من الثّقافات، هذه الثّقافات تتشكّل في ملفوظات لغويّة تتوظّف لتتناسل فيما بينها داخل كلّ نصّ جديد. والخطاب السّياسيّ يعيد إنتاج التاريخ وقراءته بما يتناسب مع الحالة الحضاريّة التي يريد الحديث عنها، وفي هذا الصدد يُستَحْضَر الخطاب التأويليّ، على أساس أنّ أصول التعالق تشكّل معبرًا رمزيًّا، ليس بالضرورة أن يكون منطوقًا، على أن يصار إلى التصريح عنه وإيضاح مفاهيمه بعد فترة يسيرة من نضوج الخطاب. مثل هذا التفكير يتيح للخطاب تجلّيه بحسبانه حدثًا.
مُلقي الخطاب/ صاحب سلطة القول: من المعلوم أنّ الخطاب يحتاج إلى منتِج، هذا المنتج له شخصيّته وتاريخه؛ بيد أنّ الأولويّة ستنصبّ نحو طبيعة الخطاب بمعزل عن ملقيه. وعلى الرغم من ثقْل الاسم عند إلقاء الخطاب، إلّا أنّ الواقع يثبت ما للخطاب السّياسيّ من إمكانات قد تُفرغ الشخص من كيانه بحسبان طبيعة لغة الخطاب، وردّة فعل الأطراف الخارجيّة حياله. “اللحظة القوية للفردنة في تاريخ الفكر والمعارف والآداب، وفي تاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم”[13]. وهذا ما يُفَسّر طغيان بعض الخطابات في تاريخنا الإسلاميّ على أخرى، وذلك بمعزل عن صاحب القول، والمتأمّل في الحالة الخطابيّة للإمام علي (ع)، يُدرِك بعد فترة وجيزة من التحليل غَلَبة الخصوم على أرض الميدان الواقعيّ، ليس بالضرورة أن تكون لغة خطاباتهم أرصن، أو شخصهم أرفع وأرقى؛ لكنّهم خاطبوا الخارج بلغة الدنيا وديمومة النعم، وهذا ما يُفسّر قانون اندثار سلطة صاحب القول أحيانًا مقابل طبيعة الخطاب اللّغويّة. من جملة تطوّرات الحالة الخطابيّة أنّها باتت نفعيّة اجتماعيّة، والخطبة التي سنراها في الشقّ التحليليّ تثبت بوضح صحّة هذه الفرضيّة.
هكذا تتقمّص اللّغة الفرد، وتصبح موجّهة لشخصيّته، وليس من العسير على فرد أن ينسب قول إلى (فلان) من الناس بحكم اللّغة التي يتلمّسها في المدوّنة التي تُلقى أمامه: “فاللّغة هي التي تتكلم وليس المؤلف، أن أكتب معناه أن أبلغ، عن طريق محو أولي شخصي… تلك النقطة التي لا تعمل فيها إلا اللّغة، وليس “أنا””[14]. تتجلّى ثقافة اللّسانيّات الخطابيّة في هذا الكلام، وتتبدّى طروحات البنيويّة وأخواتها من التنظيرات التي أعانت في إبراز نظريذة جديدة للخطاب.
قضويّة الخطاب ومعياريّة ارتباطاته: من الإجراءات الكابحة للخطاب السّياسيّ، على الأقل أمام الجهاز الرقابيّ الخارجيّ، فالخطاب الذي يُنتَج في بيئة ما يحمل معالم هذه البيئة، ويتوافق نسبيًّا مع وضعها الحضاريّ، وإنْ لم يحظَ الخطاب بهذه المزية يفقد وزنه الاجتماعيّ أمام الناس. فلغة الخطاب السّياسيّ “يتعيّن عليها أن تسجّل نفسها ضمن أفق نظري معيّن… وأن تستجيب لمتطلبات معقدة وثقيلة حتى تستطيع أن تنتمي إلى مجموع فرع معرفي ما، يتعين عليها أن تكون -و كما يقول كانغيليم- واقعة (ضمن الحقيقي)، قبل أن يستطيع القول بأنها حقيقية أو خاطئة”[15]. وهذا أصل وجوديّ للخطاب.
يبحث الخطاب السّياسيّ عن الحقائق ليضغط فيها على الرأي العامّ، فهذا المجتمع توّاق إلى تلمّس الحقائق ثمّ بناء النعارف، فكيف إذا كانت هذه المعارف دينيّة؟ أي تنتمي إلى أمر حسّاس في حالة اللاوعي؟ هذه المسألة تدخل في صميم السّلطة الخطابيّة، كما تحتاج إلى متلقّين من أفرع ثقافيّة- معرفيّة مختلفة للبتّ في صوابيّتها المعرفيّة. “الفرع المعرفي مبدأ لمراقبة عملية إنتاج الخطاب، فهو يعيّن له حدودا بواسطة لعبة هوية تأخذ شكل بعث دائم للقواعد”[16]. المسألة في خطاب الهويّات إذًا، وهو من الخطابات المُعَقَّدة والدقيقة، وخصوصًا في خطابات الحضارة الإسلاميّة.
لم ينسَ “فوكو” ملاحظة البعد الإجرائيّ للخطاب، أي طريقة تنفيذه وإلقائه، ومن هذا المنطلق أثبت إجراءات تشغيليّة وظيفيّة للخطاب نجملها في النقطة الآتية.
- وظيفيّة الخطاب وإجراءاته التشغيليّة
هي اشتغالات تبدو في داخل الخطاب، وكذا فإنّها على صلة بمؤلّفه، من دون إغفال جوّه أو بيئته التي يُلقى فيها؛ ولكنّ هذا الاعتبار لا يعني استعادة الخطيب لمكانته أو سلطته المطلقة؛ ” على الرغم من ادعاءاته بالوجود المطلق للسلطة و الصراع، رفض فوكو النقد الذي يختصر كل شيء بالقوة. في الواقع علاقات السّلطة لا يمكن بأي حال أن تشرح جميع الظواهر التاريخية؛ السّلطة ليست مبدأ نهائيّ تعليليّ، لأن بقية القوى (من ضمنها القوى الاقتصادية) أسهمت في تشكيل التّاريخ أيضًا، وفي بعض الحالات، علاقات السّلطة لا تكون حاسمة. والأكثر من ذلك، أنّ القوّة ليست كلية النّفوذ. بل بالعكس: ناقش فوكو بأنّ توظيف العديد من علاقات السّلطة، العديد من أنظمة التّحكّم، والأشكال العديدة للمراقبة” توضح فقط ماهيّة القوة الضّعيفة. لقد أنكر أيضًا بأنّ الأشكال السّائدة للسّلطة تحدّد الأفراد بشكل كامل. وبما أنّ مثل هذه القوى تحدد بشكل انتقائي قدرات معينة، تسوقها وتجبرها، بينما تتجاهل البقية، فمن الممكن أن يستمتع الأفراد بهامش أكبر أو اقل من المناورة فيما يتعلق بهم. في الحقيقة لقد قال فوكو أنه كان مصعوقًا بأن يجد بعض القرّاء بكتاباته التّأكيد على الحتمية التي لا يمكن للفرد الهروب منها.”[17]. تُرصَد لهذه التوظيفات آليّات وإجراءات تأتي على النحو الآتي:
الخطاب المغلق: المؤسّسة الخطابيّة “Sociétés de discours” ليس خافيًا أنّ بعضًا من الخطابات السّياسيّة تكون حسّاسة، ولا سيذما عند ارتباطها بشأن دينيّ، هذا الأمر يعزّز من فرص انغلاقيّتها؛ أي تصبح مقيّدة وممنوعة من التداول المطلق، يختصّ بهذا النوع من الاشتغال الخطابيّ ما يدخل في صميم المقاربات القرآنيّة، ومسارد الأحاديث، وكذا بالنسبة إلى الروايات. وهذا معلم موجود في التطبيق لاحقًا.
الانتماء السّياسيّ والنّهج الدّينيّ “Doctrines PH,R ,P” يُعنى الخطاب السّياسيّ بتأمين انتشاريّته وتفشّيه بين الأوساط، وخصوصًا إذا كان مدفوعًا بالثقل الدّينيّ، عندئذ يأتي هذا الخطاب مدعومًا بزخم الحقائق الدّينيّة والمعرفيّة. تشهد السّاحة الخطابيّة عندئذ نزاعًا بين ما هو حقيقيّ وهو ينتمي إلى البِدَع؛ لأنّ هذا النوع من الخطابات يشتغل بغرض تأثريّ استقطابيّ، والهدف استمالة أكبر قدر ممكن من الشرائح للإيمان بجدوى المذهب وطروحاته.
خطابات التّنشئة والقولبة: المَلَكة الخطابيّة “L’Appropriation Sociale des discours” هي حالة من الأدلجة التي تعمد بعض الأنظمة إلى تربية الأجيال الصّاعدة على نسقها، والخطاب لا يخلو من محاولات الأدلجة بغضّ النظر عن فرعه المعرفيّ أو موضوعه، يرتبط الخطاب في هذه الحالة بما يتبنّاه النّظام، أو تنتهجه السّلطة من معطيات ثقافيّة وأيديولجيّة واستراتيجيّات تبني الحكم على أساسها. وعليه فإنّ مفهوم الخطاب يُتَداوَل بقدر ما يتوافق مع الاستراتيجيّة العاليا للنّظام أو السّلطة، وهكذا يتحدّد من حيث القوّة أو عدمها. تفضي هذه النظرة الداخليّة المُعَقَّدة إلى قرارات يتصرّف بها الفرد إزاء سطوة الخطاب، وقد حدّدها “فوكو” على النسق الآتي: “اتخاذ قرارات ثلاثة يقاومها فكرنا اليومي، وهي تقابل المجموعات الثلاث من الوظائف التي ذكرتها منذ لحظة: إعادة النظر في إرادتنا للحقيقة، إعادة طابع الحدث للخطاب، وأخيرا رفع سيادة الدال”[18]. تخلص نظريّة “فوكو” إلى مبادئ التحرّر الخطابيّ المندرجة على النسق الآتي:
قانون العزل Renversement :/ أي تحرّر الخطاب وعزله عن مؤلّفه؛ بمعنى النظر إلى الخطاب كحيّز تداوليّ بمعزل عن رأي صاحبه الشخصيّ.
قانون التحرّر من ثقل المادّة التاريخيّة:Discontinuité محاولة الوصول إلى أكثر النقاط تقاطعًا بين الواقع والتاريخ، والمستقبل، أي الهامش التداوليّ بصرف النظر عن حتميّة التحجّر في اللحظة التاريخيّة للخطاب السّياسيّ.
قانون حدّ الموضوع/ الهامش التخصّصيّ:Spécificité القصد فيه أن ينأى سياق الخطاب عن دلالات موسّعة قد تُشَتّت المتلقّي، وتدخله في نزاع التأويلات المتشعّبة، والاكتفاء بخطاب مخصّص موضوعًا وضمونًا وأفكارًا.[19].
نستنتج من كلامنا على نظريّة “فوكو” حول السّلطة الخطابيّة، والخطاب السّياسيّ، أنّ الخطابات غير مُلْزَمَة بأن تكون تعبيرًا عن رأي السّلطة كأنّها أداة لها وحسب، وليس شرطًا أن تكون منعكسة فيها كالمرآة، هناك تمفضلات معرفيّة ذاتيّة تنبني على الحقائق ينبغي ان تسود الدراسة التحليليّة لأيّ خطاب، وهكذا تُعزَل مفاهيم الموافقة والمعارضة المسبَقَة، ويحصل الاستماع العلميّ البنّاء لتحديد وجهات النظر وردود الأفعال تجاه الخطاب. فالخطاب كمّ من المعارف المتناسلة فيما بينها، وثمّة إجراءات تعين في تحديده الوسوميّ. إنّ معايير الجدّية لم تعد تكفي لوحدها من أجل تحديد القيم الخطابيّة، أو أن يكون للخطاب سلطة بموجب جدّيّته، وأنّ الذي يتفوّه به رجلًا عاقلًا أو ذا مكانة، وما هو بمجنون؛ فالخطاب بداخله وما يحتويه سلطة بالأصل، له لغة وأساليب ودلائل وحجج، على المحلّل أن يراعي المقدرة والقوّة المبثوثة بحدّ هذه الإجراءات للتمييز بين خطاب وآخر. ولعلّ هاتين النقطتيْن تشكّلان مفضيات أو تخريجات مناسبة للخلوص من نظريّة “فوكو”، والدخول في الحيّز التطبيقيّ:
- لا فضل لمؤلّف الخطاب، ولا لمؤسّسة الخطاب، ولا لمناسبة الخطاب؛ بل حتّى ليس من فضل لبناء الخطاب النحويّ، لكنّ العبرة في الممارسة الخطابيّة. هذه الممارسات هي التس تمنح الخطاب سلطته ونظامه، بحكم الاستنتاج الذي تضفيه بين السبب والنتيجة، علاوة على لحْظ الفوارق بين الأداء ونصّ القول اللّغويّ.
- لقد قدّمت نظريّة “فوكو الخطابيّة معالمًا واضحة في كيفيّة تشكّل سلطة الخطاب ونظامه، فالخطاب الذي يحاول التغيير الفاعل في مجتمعه، والذي يدخل في خضمّ التمذهبات، ويفضي بالمرء إلى مطاردة الحقيقة، هو النّظام الذي يُشَغّل الخطاب إجمالًا. “ولتحرير الخطابات من كل أصناف التأويلات والتحليلات الشكلية يقترح فوكو جملة من المبادئ، كالخصوصية والقطيعة والخارجية…إلخ، أي أن الخطاب مشروط بالصيرورة الاجتماعية ويشكل جزءا من المجتمع رغم ما يتميز به من قدرة وإمكانيات”[20].
على هذه الأسس يُقَدّم الشقّ التنظيريّ آليّات وإجراءات تُيَسّر الدخول في الهامش التطبيقيّ، وفي جوّ من الموازنة المعرفيّة بين نظريّة “فوكو”، وطبيعة خطاب الإمام علي (ع)، ثمّة تقاطعات بين الأمريْن، إذ إنّ إجراءات “فوكو” في النظر إلى سلطة الخطاب، والخطاب السّياسيّ، قد يجد لها المتأمّل مواضع واضحة في ما هو موجود لدى الإمام علي (ع) وخطابه الوظيفيّ الاشتغاليّ في المجتمع، بما هو أبعد من مفهوم السّلطة وتوظيفها لقوّة الشخص؛ بل لقوّة الخطاب بحكم ما فيه وما يحويه، سواء من لغته أو مضامينه وحجاجه وأسلبته.
ثانيًا: الحيّز التطبيقيّ
وقع الاختيار في هذا الهامش التّحليليّ على خطبة من خطب الإمام علي (ع) السّياسيّة، فهي من الخطب التي أدلى بها إبّان معركة “صفّين”[21] الشهيرة، وقد وسمها المحقّقون بعنوان مناسبتها؛ أي بالعودة إلى أسباب إلقائها، لتصبح موسومة بـ”خطبة بعد انصرافه من صفّين”[22]، واللافت في الخطبة أنّها تتمحور في محاور ثلاثة، بحسب ما ذكر المحقّقون إبّان وسمهم الخطبة، والمحاور تأتي على النحو الآتي:
- حال العرب قبل الإسلام؛ أي في الجاهليّة.
- خصال أهل البيت (ع)، وفضائلهم ومكارمهم.
- أوضاع خصوم أهل البيت، وارتدادهم عن تعاليم الدّين الحنيف.
وعلى هذا النّسق تبدو الخطبة من عناوينها الرّئيسة أنّها تحمل في طيّاتها سلطة خطابيّة معيّنة، وفيها قضايا سجاليّة واضحة، وتؤسّس إلى نواة خطابيّة مع مجتمعها على نحو تواصليّ، إذ يحصل تقاطع أو تشابك على أمور تُعنى بها الفئات الاجتماعيّة، بين أنصار الإمام علي (ع) وخصومه. ومن هذا المنطلق يُطَبَّق معيار الرقابة، ومبدأ إثارة انتباه الجهات الخارجيّة، أو عوامل الخطاب الخارجيّ، علاوة على مبادئ الحقّ والباطل، أي قانون المعاكسات، ثمّ أثر ذلك في لغة الخطاب المُقَدَّم سياسيًّا، ولا سيّما عند إثارة الأنا والآخر في الخطاب. وهذا نصّ الخطبة كاملًا.
ومن خطبة له بعد انصرافه من صفين: أحمده استتمامًا لنعمته، واستسلامًا لعزّته، واستعصامًا من معصيته. وأستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضلّ من هداه، ولا يئل[23] من عاداه، ولا يفترق من كفاه. فإنه أرجح ما وزن، وأفضل ما خزن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ممتحنًا إخلاصها، معتقدًا مصاصها[24]، نتمسك بها أبدًا ما أبقانا، وندّخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان، وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن، ومدحرة الشيطان. وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالدّين المشهور، والعلم المأثور، والكتاب المسطور، والنور الساطع، والضياء اللامع، والأمر الصادع، إزاحةً للشبهات، واحتجاجًا بالبيّنات، وتحذيرًا بالآيات، وتخويفًا بالمثلات[25]. والناس في فتن انجذم[26] فيها حبل الدّين، وتزعزعت سواري[27] اليقين، واختلف النّجر[28]، وتشتت الأمر، وضاق المخرج وعمي المصدر. فالهدى خامل والعمى شامل، عُصِيَ الرحمن، ونُصِرَ الشيطان، وخُذِلَ الإيمان فانهارت دعائمه، وتنكّرت معالمه، ودرست سبله، وعفت شركه[29]. أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه، ووردوا مناهله، بهم سارت أعلامه، وقام لواؤه في فتن داستهم بأخفافها، ووطئتهم بأظلافها، وقامت على سنابكها[30]. فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون في خير دار وشر جيران؛ نومهم سهود وكحلهم دموع، بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم (ومنها؛ يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام) موضع سره ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه وكهوف كتبه، وجبال دينه. بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه[31].
(ومنها؛ يعني قوما آخرين) زرعوا الفجور، وسقوه الغرور، وحصدوا الثبور، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدًا، هم أساس الدّين، وعماد اليقين، إليهم يفئ الغالي[32]، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حقّ الولاية، وفيهم الوصية والوراثة. الآن إذ رجع الحق إلى أهله، ونُقِل إلى منتقله.
إنّ مناسبة هذه الخطبة تُسهم إلى حدّ بعيد في إيضاح معالم خطابيّتها، وكذلك في منح الخطاب أسبابه ومندرجاته التي أفضت إليه، وقد أوضح تحقيق الخطبة مناسبتها. وهي خطبة أدلى بها الإمام علي (ع) على شكل تصريحات وبوحيّات تداوليّة وظيفيّة: والغرض من التصريحات بثّ نتيجة المعركة، فالحال أنّ الحرب قد وضعت أوزارها، وسيمضي كلّ طرف إلى حصنه، ولعلّ هذه النهاية غير المأمولة لمسار المعركة قد أزعجت الإمام (ع)، فكان أن بثّ هذه الخطبة وفيها من المراجعة الاستنتاجيّة لحالة الأمّة عمومًا ما فيخا. واللافت أنّ الخطبة نأت عن ذكر تفاصيل المعركة ونتيجة الحرب، حتّى ليظنّ متلقّيها أنّها مجافية واقع الأمور؛ لكنّ اطّلاعًا على منبنيات الحالة التلفّظيّة اللّغويّة لهذا الخطاب، وبمراقبة آليّات السّلطة الخطابيّة وأدبيّات الخطاب السّياسيّ بحسبان قيمه الالتزاميّة، وشرف القضيّة، بما هو أسمى من حالة الحرب، يميط اللثام عن أنّ هذه الخطبة تندرج ضمن إطار نظام الخطاب الحديث الذي لم يفت على الإمام (ع) التزامه معاييرًا خطابيّة توحي بقربه من الناس وأجواء ما هو ميتا- خطابيّ، أي ما هو خارج الخطاب، كي يسبغه على اشتغالاته اللّغويّة في ما هو داخل الخطاب. على أنّ الإمام (ع) انتقل من القاعدة الدّينيّة المحمّديّة الأصيلة السامية، على قاعدة أنّ هذه الحرب كانت نزاعًا بين الدّين المحمّديّ الأصيل، وما يخالف هذا الدّين من الهرطقات المذمومة، وعليه فإنّنا أمام خطاب سياسيّ – سلطويّ ينمّ عن رغبة تنظيميّة للغة الخطاب الهادفة.
تتّصل الإجراءات التحليليّة في هذا الصدد بما أرساه “فوكو” من إجراءات معينة، ونعمد إلى ثلاثة مراحل في تحليلنا الخطاب، وهي على النسق الآتي:
– مراعاة القاعدة القَبْل خطابيّة- أي الجماهيريّة.
– تشغيلات الخطاب اللّغويّة.
– حالة المتلقّي البَعْد خطابيّة- أي درجة التفاعل وطبيعته.
ننطلق من المرحلة الأولى كونها من المراحل التي تهيّء جوّ الخطاب لاستقطاب الأسماع، أي مرحلة الاستنتصات، نقول الاستنصات لأنّ الزمن الحضاريّ الذي كان سائدًا في تلك الآونة يحكم على صاحب الخطاب أن يثير انتباههم كي ينصتوا إلى قوله، وهذا من التنويهات الضروريّة التي راعاها “فوكو” في نسجه نظام الخطاب. وأمّا عن مسألة مراعاة القاعدة الجماهيريّة، أي “القَبْل- خطابيّة”، فمن الممكن تمييزها بخطاب المحظور المحرَّم؛ بما يعني أنّه من الحرّم على الناس عدم التفاتهم إلى الخطاب إبّان نطقه بها، وهي بمطلع الخطاب موسومة بالتلفّظات الآتية:
أحمده استتمامًا لنعمته، واستسلامًا لعزّته، واستعصامًا من معصيته
وأستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضلّ من هداه، ولا يئل من عاداه، ولا يفترق من كفاه.
مثل هذا الافتتاح الخطابيّ كفيل بجذب أنظار الناس كي يلتفتوا إلى الخطاب الذي ورد على اسم الله عزّ وجلّ وصفاته، علاوة على ذكر التزاميّة صاحب الخطاب بالله عزّ وجلّ، أي بالصفات الإلهيّة الحميدة، وإقراره بالضعف أمام مقام الله عزّ وجلّ. ترافق هذا الأداء الخطابيّ وفترة وجود الإمام علي (ع) في ولاية أمر المسلمين وقيادتهم، فإنّ معاني النعمة الإلهيّة، والعزّة الربّانيّة الكبرى، تُفضي إلى مسلّمة الرضوخ والإقرار من جانب الناس، خصوم الإمام علي (ع) قبل أصحابه، ولو شئنا في التحليل أن نقول إنّ الإمام علي (ع) يراعي نقيضه قبل من يتوافق معه لأصبنا، ولعلّ قانون المحظور ينعكس على الإمام علي (ع)؛ لكنّه ليس بالضرورة أن ينعكس على خصومه. فالإمام (ع) يقرّ بعزّة الله الجبّار، ويعترف بنعمه عليه ويحمده، وهذا غير متوافر لدى أخصامه.
يُزاد على هذا الإقرار ما يمكن وسمه بالاستعانة الإلهيّة العليا. لا شكّ أنّ الإمام علي (ع) كان يطرح إشكاليّة القوّة والكفاية والرأي الصائب أو السديد السليم، وقد قرن الإمام (ع) هذه المسائل مجتمعة في يد الباري عزّ وجلّ، وذلك ليُحَرّج على خصومه ويحظر عليهم أن يفكروا بغير العزّة الإلهيّة. وإن كبت هؤلاء الخصوم مسألة اغترارهم بقوّتهم وصواب رأيهم بمعزل عن الله سبحانه وتعالى؛ فإنّ عليًّا (ع) قد ردّ الأمور إلى نصابها المستقيم أي إلى الله عزّ وجلّ؛ على الرغم من رغبات الآخرين التي دارت في فلك قوّتهم الشخصيّة وتوظيفهم المفهوم الإلهيّ القويم لغير أغراضه المرصودة له.
أستعينه/ أهتدي به/ أكتفي به:
لا يكتفون بالله/ ضالّون/ يعادون الله.
مثل هذه التفاصيل يجيد الإمام (ع) توظيفها في مجالات التعريض والتلميح، وقد اماط اللثام عن رغبات القوم الآخرين، وحاربهم من خلال بلاغة الخطاب الذي فضح كبتهم وحقيقة ما يرغبون، وذلك قبل تسميتهم، بمعنى أنّ الإمام (ع) يؤهّل خطابه وموضوعاته منذ افتتاحه.
يبدو في الخطبة استثمارًا لمتعاكسات معنويّة بين الإمام (ع) وخصومه، وباطّلاع على الخطبة ومضامينها، يتجلّى بوضوح مبدأ المقارنة أو الفرق التعارضي (الالتزام والبدعة)، وبيَّنَ الإمام (ع) منذ البداية التزاميّته المطلقة بالله عزّ وجلّ، وألمح إلى استغناء الآخرين – الخصوم عن هذه الالتزاميّة ولوذهم إلى البدع التي ما عرفها الدّين المحمديّ الأصيل يومًا. ويبدو هذا الأمر بوضوح من خلال الملفوظات الآتية:
وندّخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان، وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن، ومدحرة الشيطان.
بعد التصريح بالشهادتيْن الإسلاميّتيْن المُقَدَّسَتيْن، طرأ على الخطاب أسلوب من الإطناب اللّغويّ، كأنّ الإمام علي (ع) يودّ إيضاح معنى هاتين الشهادتيْن، وهذا ما يفضي بنا إلى تأويل لغويّ يقوم على غموض في اصطلاحيّة الشهادتيْن عند الناس، ولا سيّما خصوم الإمام (ع)، فقام بتخريجه اللّغويّ الإطنابيّ رغبةً منه في إيضاح معنى الشهادتيْن ومفضياتهما التّداوليّة على أرض الواقع، فهي مُدَّخر عند هول الأمور، ومنها يستمدّ الإمام (ع) وحزبه عزيمتهم، ويسترضون باريهم، ويدحرون الشيطان عن نفوسهم؛ في مقابل أنّ الخصوم يعاكسون ببدعهم هذه العوامل جميعًا؛ بل على العكس يلوذون إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولا عرفها دين الإسلام قبل ذلك:
إزاحةً للشبهات، واحتجاجًا بالبيّنات، وتحذيرًا بالآيات، وتخويفًا بالمثلات.
حشد الإمام علي (ع) كثيرًا من ملفوظات البِدَع، وقد بدا ملحوظًا أنّه يشتكي من الشبهات، وعدم الرضوخ إلى قانون الآيات وما أفضت به من تحذيرات للناس علّهم يتّعظون، وكذا فإنّهم لا يخافون الله ربّهم سبحانه وتعالى، على الرغم من أنّ القرآن الكريم مكتظٌّ بالقصص والعبرات… إزاء هذا الموقف عمد الإمام (ع) إلى جعل الإيقاع منصوبًا على الحاليّة، أي الحال المنصوب، وذلك تأكيدًا للصفات وتثبيتًا إيّاها وإزاحة للشبهات ولخطابات البِدَع.
بالتوازي مع هذا التعميم الخطابيّ، تبرز ملفوظات الإجراء أو التصرّف؛ أي ما يحاكي التعميم السابق، وذلك بغرض الاستشهاد والدعم بالدليل الحيثيّ الميدانيّ، أتى هذا الدعم من خلال مناسبة الخطبة في البداية، ثمّ ما وازنته الناس أمام عينيها، فشرعت تقايسه وتلجأ فيه إلى منابع الفكر والوعي الإسلاميّ، سواء كان بشخصيّات أو بحديث أو بقرآن… هذه الأمور مجتمعة كانت بإقحام بدعة “التحكيم” إبّان “رفع المصاحف” في هذه المعركة تحديدًا؛ أي ما أدّى إلى تضييع عوامّ الناس من المسلمين، فالأمر بدعة لا محالة، ولكنّ الرأي العام قد انساق إلى شبهة الشكل، الشكل الذي أتى متوازيًا مع القضيّة؛ أي التحكيم، فموسوم الاحتكام إلى القرآن الكريم، ثم موازاته بشكل المصحف المرفوع، لا شكّ أنّه مدعى للريبة، وقد يؤدّي إلى حرف الناس عن جادّة الصواب، وهذا ما حصل، فقد أدّت هذه البِدعة إلى حرف كثير من الناس عن مولاة علي (ع)؛ فإمّا أنّهم ذهبوا إلى المعسكر الثاني (حلف معاوية)، أو أنّهم خرجوا على الإثنين معًا، وانبثقت فرقة “الخوارج” بعيْد المعركة مباشرة. هذه الأمور شبهات وصّفها الإمام علي (ع) بإيقاعيّات يغلب عليها القهر والحزن على مآلات الأمور، وهذه أبرز الملفوظات التي وردت في الخطاب على النسق الآتي:
والناس في فتن انجذم فيها حبل الدّين، وتزعزعت سواري اليقين… عُصِيَ الرحمن، ونُصِرَ الشيطان، وخُذِلَ الإيمان… أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه، ووردوا مناهله، بهم سارت أعلامه، وقام لواؤه في فتن داستهم بأخفافها.
في هذه الملفوظات غيض من فيض الإجراءات التي كان عهد الإمام علي (ع) يجابهها. وعندما رأينا أنّه ثمّة إيقاعيّات حزينة تُسَيّج الخطاب فقد رجع هذا الأمر إلى طبيعة المعجم المنتقى، وميزانه الصرفيّ، فعلى أساس زيادة المبنى ليلحق به المعنى زيادة كانت موازين: انفعل/ تفعلل. هذا ميزانان يحملان غلوًّا، فالناس قد شرعوا يغالون في تطبيق هذه المعطيات. لم يفت هذا الخطاب أن يستثمر قانون الفرضيّة والنتيجة؛ أي معادلة: (فعل) + (ف حرف عطف او جزاء/ ثمّ فعل استنتاجيّ)، مثال: أطاعوا فسلكوا ووردوا… حتّى إنّ فعلًا واحدًا من أفعال الشيطان يؤدّي إلى كمّ من النتائج التي لا تُحمَد عقباها. زد على ذلك أنّ لموضوع الفتنة حضورًا وفيرًا وبارزًا في هذا الخطاب، ولعلّ مسوّغ هذا الأمر، أنّ البدع تستجلب الفتن.
أمام هذه الشبهات والبدع كان لا بدّ من خطاب يوحي بالعدل؛ كي يفرق الناس بين الحقّ والباطل، خطاب يأتي لإقرار العدل وإحقاق الحقّ، وإن كره الظالمون وكان منطق الحقّ قد صعُبَ على الناس نظرًا إلى كمّ الفتن الهائل. ولكنّ عقيدة آل البيت (ع) الممثّلين بالإمام علي (ع) تمضي بتكليف إلهيّ- محمّديّ، وهذا ما يعني الاستمرار واليقين بأنّ آل البيت مع الحقّ، وأنّ الله سيحقّ حقّه ولو بعد حين. على أنّ نظامًا من التلفّظ الاصطفائيّ الانتخابيّ قد أباحت به ملفوظات هذا الشقّ، وقد بدا واضحًا أنّ آل البيت مصطفون من الله وهم ثقل الرسول (ص)، وهذا ما صرّح به الإمام (ع) بحسبانه حقًّا دامغًا، وحقيقة من حقائق العدل التي يقرّ بها المجتمع برمّته، وما هذه الملفوظات إلّا ردّ على الشبهات التي ضيّعت هذا الميزان، وجعلت بعضًا من شرائح المجتمع الإسلاميّ ينحرفون انحرافهم الأكبر هذا. وهذه أبرز الملفوظات التي نستعينها لإثبات معيار الحقّ وخطاب العدل:
موضع سره ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه وكهوف كتبه، وجبال دينه. بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه… هم أساس الدّين، وعماد اليقين، إليهم يفئ الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حقّ الولاية، وفيهم الوصية والوراثة. الآن إذ رجع الحق إلى أهله، ونُقِل إلى منتقله.
تدلّ هذه المواصفات على ملفوظات ارتباطيّة؛ أي لا ينفكّ ملفوظ عن الارتباط بالآخر، ومن البديهيّ أن تراعي علوم الخطاب سياق القول ومفضياته، وهذا ما كان موجودًا لدى استعراض الصفات الثابتة لأهل البيت (ع)، والفرق واضح بين آل البيت وخصومهم، ولقد ودّ الإمام علي (ع) أن يبتدع الفرق من خلال اللّغة، فجعل للخصوم المهرطقين الأفعال، للدلالة على ألاعيبهم وعدم ثباتهم، وقد منح آل البيت الأسماء الثابتة للدلالة على رسوخهم مع الحقّ. فالعدالة آتية لا محالة، وخلالها سيعود هذا الحقّ الإلهيّ الجليل، حقّ آل البيت ويقينهم، مقابل بِدَع خصومهم وأكاذيبهم.
خلاصة واستنتاجات
إنّ البحث في خطابات الإمام علي (ع) لا تكفيه بضع صفحات، ولكن حاولنا قد المستطاع في هذا البحث الثيام بعمليّة إدماجيّة بين الأدب العربيّ الأصيل، وتنظير غربيّ حديث. فكانت هذه المقاربة لأثر من آثار الإمام عليّ (ع) الخطابيّة مع نظريّة “ميشيل فوكو” في الخطاب ومقاربته في إجراءات وآليّات محدّدة، على أنّنا قمنا بتطبيق بعض من هذه الإجراءات. أفضى البحث إلى نقاط متنوّعة نجملها في الآتي:
- إنّ ميشيل فوكو رأى في نظريّته الخطابيّة، أنّ للخطاب نظامًا وسلطةً، ويمكن بيسر العثور على هذه المعادلة في خضمّ المجتمع، وحينما نتأمّل في خطاب السّلطة.
- لقد توافقت آراء “فوكو” وبدت منسجمة مع طبيعة خطاب الإمام علي (ع)، وهذا ما انسحب مرونة على الآليّات والإجراءات عند تطبيقها.
- يقيم الإمام علي (ع) في خطاباته وزنًا لحقّ الناس على حساب حقّه، وهذا ما يتجلّى بوضوح في ملفوظات جعل من نفسه وأهله رهينة بيد الله عزّ وجلّ، فخطابه خطاب ربّانيّ بامتياز، ينشد الحقّ والعدل.
- يسوّق الإمام (ع) نفسه بشكل مستساغ وطيّب، ويعود في خطابه وملفوظاته المعجميّة إلى زمن الرسول، وقوانين البعثة النبويّة الشريفة، وما تحمله المدوّنة القرآنيّة الكريمة من معلومات وأوامر ونواه توضح الحقّ، وبذلك فإنّ قوّة النّظام الخطابيّ لدى الإمام علي (ع) مستلٌّ من المنهل الذي يستحيل على احد أن الخروج عليه، وبهذا يكون الردّ على خطاب البدعة.
المصادر والمراجع
المراجع العربيّة والمعرّبة
- القرآن الكريم.
- ابن أبي طالب، عليّ، نهج البلاغة، جمع: الشريف الرضي محمد بن الحسين، تحقيق: محمد عبده وصبحي الصالح، دار الكتاب اللبنانيّة، بيروت، ط1، 1966.
- الزواوي بغوره، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 2000.
- العبد، محمد ، كتاب العبارة والإشارة دراسة في نظرية، مكتبة الآداب، الطبعة الثالثة، 2012.
- فوكو، ميشيل، تاريخ الجنسانيّة: إدارة المعرفة، ترجمة: سلمان حرفوش، دار التنوير، بيروت، ط1، 2017.
- فوكو، ميشيل، تأويل الذات، ترجمة: الزواوي بغوره، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2011.
- فوكو، ميشيل، دروس ميشل فوكو، ترجمة: محمد ميلاد، دار توبقال، المغرب، ط1، ص: 1988.
- فوكو، ميشيل، نظام الخطاب، ترجمة: محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر، المغرب، ط1، 2005.
- فيركلو، نورمان، الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية، ترجمة رشاد عبد القادر،في، الكرمل، مجلة فصلية ثقافية،تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية، العدد 64 صيف 2000.
- ورابينوف، دريفوس ؛ فوكو، ميشيل : مسيرة فلسفية.- ترجمة جورج ابي صالح،مراجعة، مطاع صفدي،مركز الانماء القومي، (ب-ت).-
المراجع الأجنبيّة
Foucault, Michel : L’archéologie du savoir.- Paris, Ed. Gallimard, 1969
Foucault, Michel : L’ordre du discours.- Op.cité
[1] ميشيل فوكو (بالفرنسية: Michel Foucault) (1926 – 1984) فيلسوف فرنسي، يعتبر من أهم فلاسفة النصف الأخير من القرن العشرين، تأثر بالبنيويين ودرس وحلل تاريخ الجنون في كتابه «تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي»، وعالج مواضيع مثل الإجرام والعقوبات والممارسات الاجتماعية في السجون. ابتكر مصطلح «أركيولوجية المعرفة». أرّخ للجنس أيضاً من «حب الغلمان عند اليونان» وصولاً إلى معالجاته الجدلية المعاصرة كما في «تاريخ الجنسانية».
[2] العبد، محمد ، كتاب العبارة والإشارة دراسة في نظرية، مكتبة الآداب، الطبعة الثالثة، 2012، ص: 76.
[3] السفسطائي (باليونانية: σοφιστής) صفة نبعت من مصطلح كلمة سفسطة، وهم كانوا نوعًا محددًا من المعلمين في اليونان القديمة، في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد. تخصص العديد من السفسطائيين باستخدام أدوات الفلسفة والبلاغة…
[4] يعتبر عالم الإنسانيات اللغوي الأمريكي إدوارد سابير الذي عاش في الفترة بين (26 كانون الثاني 1884- 4 شباط 1939) أحد أهم الشخصيات في التطور المبكر لعلم اللغويات.
[5] فيركلو، نورمان، الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية، ترجمة رشاد عبد القادر،في، الكرمل، مجلة فصلية ثقافية،تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية، العدد 64 صيف 2000.- ص.155.
[6] Foucault, Michel : L’archéologie du savoir.- Paris, Ed. Gallimard, 1969.- p. 156.
[7] ورابينوف، دريفوس ؛ فوكو، ميشيل : مسيرة فلسفية.- ترجمة جورج ابي صالح،مراجعة، مطاع صفدي،مركز الانماء القومي، (ب-ت).- ص.47.
[8] فوكو،ميشيل، نظام الخطاب، ترجمة: محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2005، ص: 5.
[9] فوكو، ميشيل، تاريخ الجنسانيّة: إدارة المعرفة، ترجمة: سلمان حرفوش، دار التنوير، بيروت، ط1، 2017، ص: 16.
[10] فوكو، ميشيل، تأويل الذات، ترجمة: الزواوي بغوره، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2011، ص: 201.
[11]فوكو، ميشيل، دروس ميشل فوكو، ترجمة: محمد ميلاد، دار توبقال، المغرب، ط1، ص: 1988، ص: 29.
[12]فوكو، ميشيل، دروس ميشل فوكو، م س، ص: 31.
[13] فوكو، ميشيل : ما المؤلف ؟.- ترجمة فريق الترجمة بمجلة الفكر العربي المعاصر، العددان6-7 ،1980.- ص.116.
[14] بارت، رولان. : موت المؤلف في درس السميولوجيا.- ترجمة عبد السلام بنعبد العال، تقديم عبد الفتاح كيليطو.- الدار البيضاء، المغرب، دار توبقال للنشر، ط02، 1986.- ص.82.
[15] Foucault, Michel : L’ordre du discours.- Op.cité.- p. 32.
[16] Ibid.- p. 33.
[17]فوكو، نظام الخطاب، م س، ص: 9.
[18]فوكو، نظام الخطاب، م س، ص: 14.
[19] Foucault, Michel : L’ordre du discours.- Op.cité.- p 61.
[20] الزواوي بغوره، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 2000، ص: 45 وصاعدًا..
[21] موقعة صفين هي معركةٌ وقعت في منطقة تُعرف حالياً بالحدود السورية العراقية بين جيش الإمام علي بن أبي طالب (ع) وجيش معاوية بن أبي سفيان في شهر صفر سنة 37 هـ؛ بعد موقعة الجمل بسنة تقريباً.
[22] ابن أبي طالب، عليّ، نهج البلاغة، جمع: الشريف الرضي محمد بن الحسين، تحقيق: محمد عبده وصبحي الصالح، دار الكتاب اللبنانيّة، بيروت، ط1، 1966، ص: 27-28.
[23] لا ينجو
[24] المُصاص: خالص كلّ شيء.
[25] المثلات: العقوبات.
[26] انقطع.
[27] السواري: جمع سارية، وهي الدعامة يدعم بها السقف.
[28] النجر: الطبع والأصل.
[29] طرائقه.
[30] من حوافر الخيل.
[31] الفرائص: جمع فريصة، وهي اللحمة بين الجنب والكتف ترعد عند الفزع.
[32] الباحث في بواطن الأشياء، والكاشف عن عللها، ولا سيّما في مسائل التعبّد الدينيّ.
عدد الزوار:20


