الخطاب المباشر بين واقع الصّورة والحثّ على التّغيير في شعر تميم البرغوثي أنموذجًا
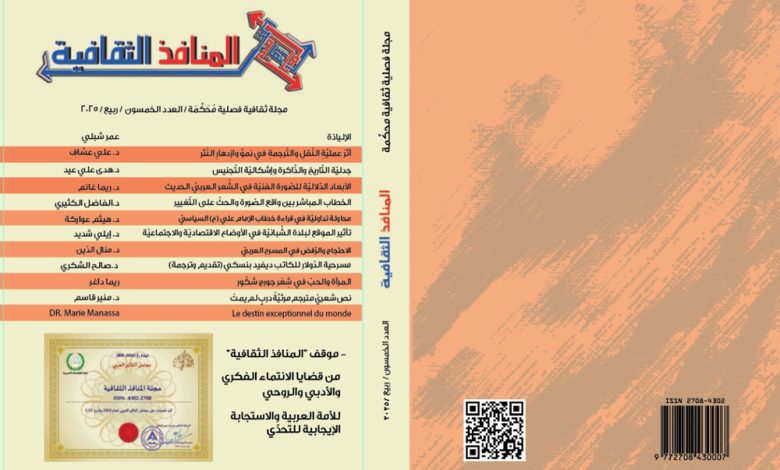
الخطاب المباشر بين واقع الصّورة والحثّ على التّغيير في شعر تميم البرغوثي أنموذجًا
Direct discourse between the reality of the image and the urge for change.
– Tamim Barghouti as a model-
د.الفاضل الكثيري[1]
DR.Fadhel Kathiri
تاريخ الاستلام 9/8/ 2024 تاريخ القبول 27/8/2024
الملخص
تتمحور هذه الدّراسة في إطار الكشف عن تداخل البيانات بين الصّورة المشهديّة في القصيدة وبين مساقات اللّغة الشعريّة المعاصرة في شعر تميم البرغوثي، وفهم البنى اللّغويّة في رسم الواقع الفلسطينيّ والبحث عن التقنيات التّعبيريّة التي رسمت في مجملها معالم القضيية الفلسطينيّة. وقد جاءت هذه الدّراسة التّحليليّة لقصيدة “إذا اعتاد الحكام” من ضمن الدّراسات النّقديّة المعاصرة والمواكبة للأحداث، فتركّز البحث على السّرديّة اللّغويّة وجماليّتها ودلالاتها الرّمزيّة في الجهد المقاوم في هذه القصيدة وفق شقين، وحاد نظريّ والثاني تطبيق يتتبّع الصّورة بدلالتها واللّغة بعمق معانيها وفق أقسام القصيدة الأربعة.
الكلمات المفتاحية: شعريّة النّص- النّص المقاوم- الطّفلة- السّرديّة الملحميّة- غزّة -القدس-الشّعب-الفرعون السّمين- الرّمز
Abstract
This study is centered within the framework of revealing the overlap of data between the scenic image in the poem and the contemporary poetic language courses in Tamim Barghouthi’s poetry, understanding the linguistic structures in drawing the Palestinian reality, and searching for the expressive techniques that have drawn the features of the Palestinian issue as a whole. This analytical study of the poem If the Rulers Used came from within contemporary critical studies that keep pace with events. The research focused on the linguistic narrative, its aesthetics, and its symbolic connotations in the resistance effort in this poem according to two parts, a sharp theoretical part and the second an application that traces the image with its significance and the language in the depth of its meanings according to the four sections of the poem>
مقدمة
عبّر الأدباء الفلسطنيون عن قضية فلسطين بأساليب شتّى، فبيّنوا عدالة هذه القضية وأحقية الشّعب في نيل استقلاله، وأظهروا بشاعة الاحتلال في أقصى تجليّات إجرامه، وبرز محمود درويش وأحمد مطر وبرز إبراهيم طوقان وفدى طوقان، كما برز مريد البرغوثي ورضوى عاشور في الكتابات الأدبيّة وبرز ناجي في فنّ الكاريكتور، فجاء حنظلة عنوانًا للنظال الفني بكل جوانبه، ثمّ جاء تميم البرغوثي فأحدث الشّعب الفلسطينيّ ثورة طوفان الأقصى ساعيًا إلى استعادة قضيته والمطالبة بحقوقه المسلوبة ورفع المظلمية التي طالته ومجازر الإبادة التي تعرّض لها، فكان هذا الحدث الشرارة التي أوقدت نار الحماسة وإعادة الأدباء للتّأكيد على قضيتهم، وكانت قصائد تميم البغوثي من جملة هذا الأدب المقاوم.
قصيدة إذا اعتاد الملوك
القصيدة: (إذا اعتاد الملوك) اختزلت معاناة الشّعب الفلسطينيّ، وقدّمت العديد من المواضيع التي أظهرت معاناة سكان الأراضي المحتلة، سواء أكانوا في أراض 48 أو الأراضي الّتي احتلت في سنة 1967 “[2] أو ما تعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات”[3]. وقد عرّت قصائد تميم البرغوثي جرائم الاحتلال الصّهيونيّ، كما أبرزت خذلان الأنظمة العربية و تواطؤها مع العدو، وكشفت لتّناقض الذي يعيشه العالم وأنظمة الغرب في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه المنطقة، بعدما سقط القناع في التّحالف الغربيّ الصّهيونيّ على غزّة؛ إذ يقول:
إذا اعتاد الملوك على الهوان فذكّرهم … بأن الموت دان
ومن صدف بقاء المرء حيا على مر الدقائق والثواني
وجثة طفلة بممر مشفى لها في العمر سبع أو ثمان
على برد البلاط بلا سرير ولا تحت أنقاض المباني
أتاها الموت قبل الخوف منه وكان نحوها يتسابقان
ولو خيرت بينهما كريما فإنّ الخوف يخسر في الرهان
يقول لك المجرب كل حرب لها طرفان دوما خائفان
وخوف المرء يدفعه أماما فيظهر كالشّجاعة للعيان
ترى الجيشين من خوف المنايا عليها يقدمان ويحجمان
بكل حديدة طنت ورنت وكل مكيدة يتسلحان
فمالك يا بنيتي لم تخافي ولم تثقي بسيف أو سنان
ما للجيش جاء بكل درع مخافة هذه الحدق الحسان
كأنك قلت لي يا بنت شيئا عزيزا لا يفسر باللّسان
عن الدّنيا وما فيها وعني وعن معنى المخافة والأمان
فديتك أية نزلت حديثا نذيرا للبرئ وللمدان
قد امتحنوا بها عشرين جيشا وجازت وحدها في الامتحان
فنادي المانعين الخبز عنها ومن سمحوا به بعد الآوان
وهنئهم بفرعون سمين كثير الجيش معمور المغاني
له لا للبراي النيل يجري له البستان والثمر الدواني
نحاصر من أخ أو من عدو سنغلب وحدنا وسيندمان
سنغلب والذي جعل المنايا بها أنف من الرجل الجبان
بقية كل سيف كثرتنا منايانا على مر الزمان
كأن الموت قابلة عجوز تزور الحي من آن لآن
نموت فيكثر الأشراف فينا وتختلط التعازي بالتهاني
كأن الحرب للأشراف أم مشبهة القساوة بالحنان
لذلك ليس تذكر في المراثي كثيرا وهي تذكر في الأغاني
سنغلب والذي رفع الضحايا من الأنقاذ رأسا للجبان
رماديين كالأنقاض شعثا تحددهم خيوط الأرجوان
يد ليد تسلمهم فتبدو سماء الله تحملها يدان
يد ليدن كمعراج طويل إلى باب الكريم المستعان
يد ليد وتحت القصف فاقرأ هناك ما تشاء من المعاني
صلاة جماعة في شبر أرض وطائرة تحوّم في المكان
تنادي ذلك الجمع المصلي لك الويلات ما لك لا تراني
فيمعن في تجاهلها فترمي قنابلها وتغرق في الدخان
وتقلع عن تشهد من يصلي وعن كرم جديد في الأذان
نقاتلهم على عطش وجوع وخذلان الأقاصي والأداني
نقاتلهم وظلم أبي أبينا نعانيه كأنا لا نعاني
نقاتلهم كأن اليوم يوم أخير ما له في الدهر ثان
بأيدينا لهذا الليل صبح وشمس لا تفر من البنان
بيان عسكري فاقرأوه فقد ختم النبي على بياني[4]
ينتمي هذا النّص إلى القصيدة الوصفيّة، وقد نسجه الشّاعر تميم البرغوثي على أربعة أقسام ، بدأ القسم الأوّل بأسلوب الشرط غير الجازم (إذا)، ليقدّم موعظة حكميّة في معادلة لغويّة تستند إلى منطق الزّمن:
إذا اعتاد الملوك على الهوان فذكرهم … بأن الموت دان
فأسند الفعل اعتاد إلى الملوك المسند وجاء القيد (على الهوان) وهي من أسفل دركات التّوصيف للوضع السّيء الذي يراه، ثم ربط جواب الشّرط بحرف الفاء مقرونة بفعل أمر (ذكرهم). والتّذكير هنا يحمل معادلة ثابتة (أنّ الموت دان)
من هذا البيت انطلق تميم البرغوثي في ولوج قصيدته، فقدّمها في أربعة أقسام تدرج فيها تصويرًا ورصدًا، فجاء القسم الأوّل مليئا بالتّصوير المشهديّ قدّم فيها مشهدًا دراميًّا حزينًا (جثة بنت شهيدة) والغريب أنّها أمام المشفى، فأظهر غدر الاحتلال الصّهيونيّ من دون أن يذكره ، واستقرأ ما في باطن هذه الطّفلة:
وجثة طفلة بممر مشفى لها في العمر سبع أو ثمان
على برد البلاط بلا سرير ولا تحت أنقاض المباني
وقدمّها على أن ّالموت الغادر جاءها صدفة، والفعل هذا يماثل فعل الجبان تسلّل خلصة لارتكاب جريمته حتّى قبل الخوف الّذي غالبًا ما يعمّ الأولاد الصّغار من هول المعركة، وقد دحض دعاية العدو الصّهيونيّ الذي يروج للتّصدّي للإرهاب المزعوم، والذي يدعي زورا وبهتانا امتلاكه الأرض الفلسطينيّة، وقد تجلى فعله الإجرامي في قتل الأطفال.
أتاها الموت قبل الخوف منه وكان نحوها يتسابقان
ولو خيرت بينهما كريما فإنّ الخوف يخسر في الرهان
يقول لك المجرب كل حرب لها طرفان دوما خائفان
وخوف المرء يدفعه أماما فيظهر كالشجاعة للعيان
ترى الجيشين من خوف المنايا عليها يقدمان ويحجمان
بكل حديدة طنت ورنت وكلّ مكيدة يتسلحان
فمالك يا بنيتي لم تخافي ولم تثقي بسيف أو سنان
ما للجيش جاء بكل درع مخافة هذه الحدق الحسان
كأنك قلت لي يا بنت شيئا عزيزا لا يفسر باللّسان
أبعاد النّص
يراوح النّص بين البعد الرّمزي والبعد الملحميّ، فالأوّل تمثّله طفلة صغيرة وهي رمز لكل أطفال غزّة بل هي رمز لغزّة نفسها ، إذ أن اللفظة لها دلالة لغوية خاصة فالطّفلة ملتقى البراءة ، ولا تعرف الشّر مطلقًا.
أ – بعد الإجرام
تمثّل في فعل القتل والإبادة وجاءت دلالاته تؤكد صلف العدو واستعماله كل جهات القتل: فالطّائرات التي تقصف غطت السّماء، والدّروع غطت الأرض، والمصائد التي نصبت في البحر تتصيد أطفال القطاع بهذه الآلات القاتلة ليكتمل فعل الإرهاب الصّهيونيّ بحصار المكان ( تقصف -درع – حديدة – مكيدة …). وقد استعملت أدوات الجريمة النّكراء من دون حسبان لشرعة حقوق الإنسان، ولا أي بعد إنسانيّ (الطّائرة الّتي تقصف، القنابل– الجيشان– الموت).
ب- البعد الإنسانيّ
تمثّل البعد الإنسانيّ في تصوير الواقع لأناس عانوا ويلات الجرب العدوانيّة التي يشنّها الكيان الصّهيونيّ على الإنسان الفلسطينيّ، من دون أن يراعي الأبعاد الإنسانيّة للشّيوخ والنّساء والأطفال وحتى دور العبادة بما فيها المسجد الأقصى. فالعدو لا يراعي حرمة الصّلاة، بل يراها تهديدًا له لذلك يحاصرها بآلات القتل:
صلاة جماعة في شبر أرض وطائرة تحوّم في المكان
تنادي ذلك الجمع المصلي لك الويلات ما لك لا تراني
فيمعن في تجاهلها فترمي قنابلها وتغرق في الدخان
هكذا تتقدّم صورة القتل حتى لأولئك المصلين دون حرمة أو رادع أو أي ضابط إنسانيّ، ثم يستمر مسلسل الإجرام ليشمل الأطفال، في مشهد الطّفلة الطفولة المقتولة:
وجثة طفلة بممر مشفى لها في العمر سبع أو ثمان
على برد البلاط بلا سرير ولا تحت أنقاض المباني
أتاها الموت قبل الخوف منه وكان نحوها يتسابقان
………………………………………………………..
كأنّك قلت لي يا بنت شيئا عزيزا لا يفسر باللسان
هنا يبدو البعد الإنسانيّ مسطحًا عاى الرّغم من مشهد التّوحش الصّهيونيّ فصورة الطّفلة القتيلة تعبّر عن ذاتها في اتجاهين؛ الأوّل يدلّ على الجريمة، والثّاني يدل على الاستنكار من قبل الضّحية المقتولة. والحقيقة أنّ البعد الإنسانيّ يتمظهر بين الصّورة كواقع ماديّ يبكي الحجر، ودلالة لغويّة في استفهام ومشابهة لالتباس الوعي في التّصريح بفعل الإدانة وضبابيّة في رؤية المجرم و التّعامي عن تصور الجرم.
ج- البعد المأساويّ
تجسّد البعد المأساويّ في العاطفة الإنسانيّة وما تختزله من الخوف، كما تجسّد في صورة الجثّة الهامدة الملقاة على الرّصيف، وكأنّ الشّاعر هنا يركز على مسرح الجريمة، وهو الطّريق في إطار بلورة ما هو معلوم من الإجرام الصّهيونيّ، إذ ليس من التباس في فعل القتل؛ بل إنّ القاتل متعمد في عدائيته غير المسوّغة. وحمّل هذا كله معجمًا لغويًّا يعكس الأفعال العدائيّة للمحتل الصّهيونيّ الذي يسعى إلى إبادة شعب أعزل: الخوف -المو ت – التّدمير – أنقاض المباني- نموت -المنايا- نقتل -الويلات- ترمي القنابل – الطاّئرة – القنابل- الدّخان- القصف. وكل هذا يقع على مرّ الدّقائق والثّواني في جريمة لم تعرف الإنسانيّة لها مثيلًا.
وظائف الكلام
تمثّلت وظائف الكلام في ما قدمه الشّاعر من صور مشهديّة، وما ونتج عنه من انفعالات، وجاءت على التّوالي:الانفعاليّة والإفهاميّة والمرجعيّة وذلك انطلاقًا من التّركيز على ضمير المتكلّم أو المخاطب أو الغائب، وقد اعتمد جاكبسون على هذه الوظائف ووسّعها إلى ستّ جاكبسون[5]. وبما أنّ اللّسانيّات علم يشمل جميع الأنساق والبنيات اللّفظيّة. فإنّه من اللافت القول إنّه لا بدّ لأيّ رسالة من وظيفة على الأقل، ويصعب إيجاد رسائل تؤدي وظيفة واحدة لا غير. ويأتي تصنيف الوظائف معتمدًا على المرسل والمرسل إليه والرّسالة والسّنن والسّياق والقناة. وهنا فإنّ البرغوثي قد حاول أن يراعي هذه العناصر، فهو المرسل وصاحب المرسلة لذلك توجّب عليه أن يستهدف المرسل إليه بشيء من التّأثير بمشهديّة عالية وصورة مدهشة وسياقات غير معهودة. وهذا ما يتجلى في:
–الوظيفة الانفعاليّة التّعبيريّة: توخى الشّاعر هذه الوظيفة؛ لأنّ رسالته صرخة إنسان في عمقه جرح ومظلومية. وهنا ترتكز الانفعاليّة ( Emotive) عند المرسل بشكل تقريعي مرة ، وبشكل وعظي مرة أخرى. إذ تدلّ هذه الوظيفة الكلامية بصفة مباشرة عن موقف المتكلّم حيال ما يتحدّث عنه، وتنزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معيّن صادق أو كاذب. يتجلّى باعتماد آليتين: الأولى دلاليّة صرفة كصيغة التّعجب والاستغاثة والندبة، ثانية فيزيولوجيّة تعتمد النّبر والتّفخيم والتّرقيق والجهر والهمس وارتفاع الصّوت وانحداره”[6].
-الوظيفة الإفهاميّة التّفسيريّة: استعمل الشّاعر في القسم الأوّل الإيحاء التّفسيريّ المتمثّل في الشّرط (مرتين) إذا اعتاد… فذكرهم بأنّ الموت دان) ، كما استعمل الوصف لتّأكيد حال الواقع الفلسطينيّ وتوضيحها للعالم.
ومن صدف بقاء المرء حيا على مر الدقائق والثواني
ولو خيرت بينهما كريما فإنّ الخوف يخسر في الرّهان
كلا البيتين فيه حكمة. وقد تكثّف الجانب الحكمي، وطفا في تلك الصّورة الفنيّة التي تعج ّ بالإيحاءات المدهشة التي تصوّر الإنسان الفلسطينيّ مقاتلًا متمسّكًا بالحقّ في الأرض والعرض والدّين، في حين تأتي صور أخرى لتبرز الصّهيونيّ قاتلًا ماكرًا ، وتأتي صورة الحاكم العربيّ متآمرًا خانعًا متصهينًا منساقًا كالمسحور في فلك الأمريكيّ الصّهيونيّ.
-الوظيفة الإبلاغية وتتمثّل في فعل الأمر من خلال قوله:
وهنئهم بفرعون سمين كثير الجيش معمور المغاني
والفعل الماضي كونه يدلّ على توصيف الأحداث التي جسّدت البطولة الخارقة واللامتناهية التي تتجاوز الموت نفسه:
ولو خيرت بينهما كريما فإنّ الخوف يخسر في الرهان
ويواصل في القسم الثّاني الحديث عن الفتاة في رمزيتها/غزّة؛ فهي الآية والنّذير والفائزة في الامتحان والمحاصرة والممنوعة من الخبز.
عن الدّنيا وما فيها وعني وعن معنى المخافة والأمان
فديتك أية نزلت حديثا نذيرا للبرئ وللمدان
قد امتحنوا بها عشرين جيشا وجازت وحدها في الامتحان
فنادي المانعين الخبز عنها ومن سمحوا به بعد الآوان
وهنا يتطرّق إلى رمز آخر لكنّه ليس ممن ينتصرون للحقّ والعدل، بل هو رمز من رموز الكفر والخذلان وإعانة الظّلمة وقهر النّاس، ليقدمه للسّاكتين والمتخاذلين والصّهاينة، فيقول:
وهنئهم بفرعون سمين كثير الجيش معمور المغاني
له لا للبراي النيل يجوي له البستان والثمر الدواني
وقد استعمل الشّاعر ضمير (ي) المتكلّم مجرورا بحرف الجر “عن” (عني) وضمير (ت) في الفعل الماضي (فديتك) لآلية حضورية ذاتيّة لم يغيب فرصتها.هنا تجلّت ثنائيّات متعدّدة فيها قتل وظلم والتّواطؤ وخذلان، ومظلومية شعب حطم أسطورة الصمود وتجاوز فعل القتل والإبادة للكيان الغاصب، وهنا يبرز الشّاعر قسوة الإجرام الصّهيونيّ كما يبرز خذلان الإخوة في لحظات التّوحش الصّهيونيّ ولتعزيز فكرته هنأ المتخاذلين بفرعون سمين بما هذه المفردة من دلالة وإيحاء في المخيال الجمعيّ عند العرب ولدل عليه عند المسلمين.
–الوظيفة المرجعيّة اعتمد الشاعر على المرجعيات المكانيّة والزمانية، فالموت مرجعيّة مهمة في تنبيه الغافلين وفرعون له مرجعيّة وظيفية للدّلالة على الطغيان والعتو، والأطفال هم مرجعيّة الحاضر في رسم معالم الغد. وقد عبّرت هذه الوظيفة عن العلاقة بين الكلمات كانعكاس للأحداث، كما عبّرت عن الأحداث كأشياء تجاوزت المألوف. فالقصيدة هنا هي رسالة تنطق بلغة تنقلنا إلى أشياء وموجودات تقوم فيها اللّغة مقام الرّمز إلى هذه الأشياء، حيث تكون اللّغة رموزًا معبرة عن أشياء[7].
والمرجعيّة هنا تتمثّل في المكان المشهديّ الرّصيف – المشفى السّماء – البحر الطّرقات، حديث الطّفلة، حديث الجماعة وفعلها الجهادي في المدينة بمعالمها فالشّاعر يتكلّم عنها بشكل وصفيّ واضح بوديانها ومعالمها. ويجعل كل معلم رمزًا مقاومًا.
ويأتي القسم الثّالث من القصيدة ليصوّر لنا صورة الفلسطينيّ المحاصر من إخوانه العرب، والمحارب من قبل العدو الصّهيونيّ. وفي واقع الاستغراق في المأساة الممزوجة، يبرز إصرار الشّعب على النّصر في معادلة العين والمغرز، والدّم الذي يقاوم السّيف. فقد قدّم الشّاعر أفرقاء متحالفين (الأخ والعدو) في معادلة محيّرة استوت فيها الأضداد فكلاهما يحاصران الفلسطينيّ. وهنا يتوعدهما بالنّصر مهما فعلا، وأنّ فعليهما هذا سيجلب لهما الّندامة والخسران.
نحاصر من أخ أو من عدو سنغلب وحدنا وسيندمان
سنغلب والذي جعل المنايا بها أنف من الرجل الجبان
بقية كل سيف كثرتنا منايانا على مر الزمان
كأن الموت قابلة عجوز تزور الحي من آن لآن
نموت فيكثر الأشراف فينا وتختلط التعازي بالتهاني
كأن الحرب للأشراف أم مشبهة القساوة بالحنان
لذلك ليس تذكر في المراثي كثيرا وهي تذكر في الأغاني
سنغلب والذي رفع الضحايا من الأنقاذ رأسا للجبان
رماديين كالأنقاض شعثا تحددهم خيوط الأرجوان
وفي هذا القسم بدا التّكرار حاضرًا في إرادة الفعل المقاوم لإيضاح المشهد البطوليّ المتمثّل في عدم الاستسلام والمقاومة، على الرّغم من بؤس الوضع وقلة الإمكانيات: فكرّر كلمة سنغلب، والفعل فيه إصرار وتحدّ وإيمان بالنّصر والغلبة لا لشيء إلاّ لعدالة القضية. وكرّر كلمة تذكر لما لفعل الصّهاينة من إجرام متأصل دأبوا عليه منذ عرفهم التاريخ، ومن وقف معهم من فداحة لا تمحى من ذاكرة الأحرار أبدًا. ثم كرّر كلمة يد لما ترمز إلى تعاقب الأجيال التي تسلّم الرّايات إلى بعضها البعض ولو كان ذلك تحت القصف؛ فهي المساعدة والمرفوعة بالدّعاء والظّاهرة من تحت الركام، وكأنّ اليد هنا مشهد الرّمز المتعدّد الدّلالات في هذه الأبيات:
يد ليد تسلمهم فتبدو سماء الله تحملها يدان
يد ليدن كمعراج طويل إلى باب الكريم المستعان
يد ليد وتحت القصف فاقرأ هناك ما تشاء من المعاني
أمّا من حيث استعمال الأفعال في هذا المقطع فيتكثّف الفعل المضارع دلالة على الحضور المشهديّ الحالي من خلال استعمال( نحاصر سنغلب – تزور -نموت – تحددهم -تذكر-تسلمهم -تحملها – ما تشاء ) وهذه الأفعال هي تتعلّق بتقابل الأضداد، فالحصار فعل بغي يستلزم محاصر ومحاصر، والغاية منه الإخضاع والتّطويع في أبسط حالاته والإبادة والتّرحيل في تجليّات جرائمه، ولكن الإيمان بالمغالبة وسنّة التّدافع والتمسك بالحقوق جعل الفلسطينيّ مقتنعًا أنّ حياته تكمن في مقاومته، وأنّ هذه المقاومة هي فعل وجود للبقاء والثّبات وصيانة الأرض والمقدسات على الرّغم ممّا يتعرّض له من فعل الإبادة والتّدمير، وقد عدّ هذه الجرائم ولاّدة للأبطال المقاومين الأشراف الذين يسطرون الملاحم أمام عدوّ عنده من القوّة والعتاد الرّهيب ما لا حصر لها.
نموت فيكثر الأشراف فينا وتختلط التعازي بالتهاني
كأن الحرب للأشراف أم مشبهة القساوة بالحنان
ويصف القسم الأخير من القصيدة: صلاة جماعة في شبر أرض وطائرة تحوّم في المكان، تدخل الصّلاة كدلالة إشاريّة على الرّابطة الجماعيّة الرّاسخة في الأرض، المتعلّقة بالإيمان. فالصّلاة مؤشّر دلاليّ لتجليّات الواقع في تذكير بالمقدّس في بلاد القبلتين، وهي رمز للإيمان، ورمز للنّقاء والصّفاء ضد الشّيطنة التي يمارسها الصّهاينة والوهم المزعوم الذي بنوا عليه تفكيرهم السّادي المتوحّش الذي لا يحسب النّاس في مقاسهم التّلموديّ سوى خدم ودون درجة منهم.
تنادي ذلك الجمع المصلي لك الويلات ما لك لا تراني
فيمعن في تجاهلها فترمي قنابلها وتغرق في الدخان
وتقلع عن تشهد من يصلي وعن كرم جديد في الأذان
نقاتلهم على عطش وجوع وخذلان الأقاصي والأداني
نقاتلهم وظلم أبي أبينا نعانيه كأنا لا نعاني
نقاتلهم كأن اليوم يوم أخير ما له في الدهر ثان
وتأتي هذه الأبيات لتدلّ أنّ شاعرنا المتنمي إلى هذه الجماعة المقاومة (بأيدنا) سيصنع النّصر وسيكون الصّبح قريبًا، وينهي كلامه بجعل قصيدته بيانًا عسكريًّا يجب أن يقرأه كل شريف وحتى كل عدو:
بأيدينا لهذا الليل صبح وشمس لا تفر من البنان
بيان عسكري فاقرأوه فقد ختم النبي على بياني”[8]
وهنا يقدم الشاعر واقعًا جديدًا إلى الأدب المقاوم وترسم القصيدة في أرقى تجليّاتها من الشّعر الموزون ببحره الوافر وبوزنه( مفاعلتن- مفاعلتن- فعولن ) مختارًا حرف النّون رويًّا لهذه القصيدة، وهو حرف مستقل في المخرج ، يتميّز بصفات أربع متضادة وهي: الجهر والتّوسط ـوالاستفال والانفتاح”، ولها وصفة واحدة من الصّفات غير المتضادة وهي مستقلة[9]، إذا حسبنا الغنة من خاصية النّون؛ التي تمتزج بشيء من اللّحن الشّجيّ والصّدى القريب من الأنّات العميقة المتتابعة. فالنون بطبيعتها رخيمة، لذلك فإن وقعها في الأذن مؤثر. فالشّاعر لا يُنطق النّص فحسب، بل أنطق الحجر والشّجر والبشر وكل ما خلق الله. ولا يرصد الواقع بل يقدّمه صامدًا عاى الرّغم من أيامه الكلمى.
المميزات الأسلوبيّة للخطاب
والحقيقة إنّ المميزات الأسلوبيّة للخطاب ذي الطّابع الإفهاميّ تمحورت في نقاط متعدّدة أهمها:
أ- التّأثير: الحدث اللّسانيّ رباط بين الباثّ والمتقبّل يضفي إليه الأوّل بصماته التّأثيريّة التي تعتمد على معادلة ”المفاجأة والتّشبّع”، إنّ مسألة التّأثير التي تأتت في شعر البرغوثي كانت من جراء الصّورة الشعريّة السّاخرة أكثر من كونها تصوريًّا للجرح الفلسطينيّ النّازف. فالنّقمة على تخاذل الأنظمة العربيّة، وتقديم المقاربات المشهديّة بين سواد تعيشه الأمة وبصيرة يعيشها المقاومون، وهذا لا يترك مجالًا للشّك في رسم الفارق اللّغويّ بين غرابيب سود كدلالة على البؤس العربيّ وبين رجال الله في الميدان كدلالة على فعل المقاومة.
وهنا يصبح الفعل المقاوم فعلًا حضاريًّا تحرريًّا في حين يصبح السّكون جبنًا بل هو الخذلان بعينه الذي لا يرتضيه حر. وبين هذا وذاك تنمو اللّغة وفق حقل معجمي مقارن وواضع الحدود بين فريقين؛ واحد متمسك بأرضه، والآخر سمسار يتاجر بتوابيت الشّهداء الذين يقاومون الاحتلال الصّهيونيّ. وقد أثر هذا الواقع في الشّاعر نفسه.
ب- المفاجأة: تعدّ عنصرًا مهمًّا في شعر تميم البرغوثي غير منتظر؛ وهي من الأمور المعقولة العاديّة التي لا تلفت نظر القارئ أو السّامع إلا بدخولها ضمن هذا النّسق الأسلوبيّ المفاجئ المميز ولا تتشكّل المفاجأة إلا إذا توافرت العناصر المتضادة فتتناغم وتتكامل: أي مبدأ تكامل الأضداد. والمفاجأة نبضات انفعاليّة عالية في عمق الخطاب السّاكن. والواضح أنّ شعريّة تميم التّراثيّة لا تنفصل عن تراث الأجداد المجيد وتاريخنا التّليد.
والتّناص بارز، وصوره ظاهرة، والحماسة فيه متجليّة كما هو الحال لقصائد أبي الطيب المتنبي وربما رجع هذا لتأثره به؛ لذلك أنتج قصيدة رائعة وقويّة فهو بهذا النّص يستند إلى القرآن الكريم وخاصة قصة فرعون وإخوة يوسف عليه السلام فكان بذلك يقترب بلغته من لغة السّامع بحسه الإنسانيّ ورحابة صدره وثقافته الواسعة العميقة، وشجاعة متناهية سطّرها بكل ثقة نصه وقدّمه على كل من معه من الشعراء.
ج- التّشبع: وهي عملية تكراريّة كلّما كثرت تنازلت حدة التأثير. تهتّز النّفس للمفاجأة بفضل شحنتها التّأثيريّة العالية كونها غير منتظرة بينما الشّحنات المتكررة بشكل متواتر تحدث تشبّعًا في نفس المستقبل فتضعف استجابته لارتداداتها.
د- الإقناع: ويتمثّل في توظيف الحجج المنطقيّة التي لا تكتسي صيغة الإكراه ولا تُدرج على منهج القمع، وإنّما تسلك سبلًا استدلاليّة تجرّ الغير جرًا إلى الإقناع.
ه- الإمتاع: تهدف الرّسالة الإمتاعيّة إلى إدخال النّشوة في نفس المستقبل فينطفئ المنطق العقلانيّ وتحلّ محله نفثات الارتياح الوجدانيّ في محاولات لاسترضاء وجدان المتلقّي وعاطفته.
و- الإثارة: هي حال من استفزاز يحرّك في المتلقّي نوازع ردود فعل. لا تجتمع جميع المميزات في خطاب واحد، فالخطاب الشّعريّ غير العلميّ والسّياسيّ غير التّجاري، الخ…وعلى الرّغم من اختلاف الرّسائل فهي تركّز على المرسل إليه. كما أنّ مؤشّرات الإثارة تكمن في الإبهام وهو ” ليس إبهامًا سهل الإزاحة والتبديد. وعلى هذا فالدّلالة في هذا الشّعر ممعنة في الغياب” .[10]
أمام ما قدّم البرغوثي من قصائد يبقى شعرًا قاصرًا على تصوير جانب من واقع أمتنا غير مجبول بالبحث في الهوية الإسلاميّة التي وجد فيها ابن باديس الأفق الرّحب لنسج مدونته الشعريّة في ربط الشّعب بالإسلام”[11]
شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب
أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب
يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب
خذ للجياة سلاحها زخذ الخطوب ولا تهب
أرفع منار العدل والإحسان وأصدم من الغضب”[12]
وإن كانت المقارنة هنا تحتاج إلى الكثير من الجهد لكن تميم البرغوثي مثّل بحق لونًا شعريًّا متقدّمًا في رسم الصّورة الشّعريّة للأدب المقاوم النّاقد للواقع، لكنّه لم يستوفه حقّه وتمثيله مقارنة بما قدمه الشّعب الفلسطينيّ المجاهد، ويكتمل المشهد بالمقاومة اللّبنانيّة وقوفها التّاريخي في رواية المساندة ووقفة العزّ المتواصل تجاه بوصلة القدس خاصة في هذه القصيد ة لتتضّح الصّورة بعد عاصفة الغبار التي حدّت من وضوح الصّورة. فمتى تكتمل المشهد يّة في التّغريبة الفلسطينيّة وفق المخيال الشّعريّ عند ساسة العرب؟
الخاتمة
وفي المحصلة جمع تميم بين الاعتداد بفنيّة شعره من حيث جزالة اللفّظ وأصالته وجودته واللّذة والطّرب في الإلقاء، وتبيان قضية بلاده فلسطين وتقديم صورة فنية راقية جسدت الأدب المقاوم في عذوبة لفظه وظهرت صيحة مدوية ضد الطغاة والاحتلال الصّهيونيّ، في قصيدة تتقد بنار عاطفته الجياشة وإيقاعه الموسيقى الجميل، والحقيقة أن المفاضلة التي تتم بين الشعراء وقصيدهم ليس هين، لما لكلّ منهم من تمايز يصعب الحكم عليه، وهذا إن دلّ فإنّما يدلّ على أنّ هناك شعراء أفذاذًا يعيشون واقع الأمة.
وإذا كان تميم سليل عائلة الأدب والعلم فإنّ بيئته نمت فيه أن يكون محاربًا بالأدب ينتظم المقاطع الشّعريّة ما بين العموديّ والتّفعيلة، فجاءت كالعقد الذي يتجانس فيه الحبّ فانتظم أيما انتظام؛ أعطى شكلًا جميلًا غاية في الرّوعة والأناقة والدّقة والجمال، وقد نسج قصيدته بأروع وأجمل خيوط الفنّ، فكان كلامه ما بين اللّحن والغناء منظومًا منسقًا، وازن فيه بين أوّل القصيدة وآخرها فكانت كأنّها جملة أو كلمة واحدة أو كأنهّا جسم متكامل، ومثل هذا الشّعر غالبًا ما يكون مؤثرًّا في السّامع مستساغًا عنده؛ لأنّه واضح المعالم والصّور للقاصي والدّاني والعادي وغير العادي من القراءة، ومثل شعر تميم لا يمرّ مرّ الكرام وصفحًا سريعًا، بل لا بد للمتلقي من الوقوف عنده للتّمتع بمذاق التّعبير الفواح، نعم لا بد من التمعّن في أقواله وأشعاره ورصد جميع معانيه. إنّ التّعبير القوي هو ما يميز بين قصيدة وأخرى وشاعر وشاعر لتبقى تلك القشعريرة أو التّأثير الدّاخليّ هو المحرّك الذي يرغبه المتلقي من اللذة والشّعور الجميل الذي يشعر به.
وتبقى الكلمة بندقية في قصيدة الثّكنة وهو ما يجعل أي الشّاعر يتميز بجدارة واستحقاق عن ذاك الآخر في التّعبير عن التزامه بقضايا أمته ونهجه المقاوم ليرسم محورها محطّاتها الجهاديّة.
المصادر والمراجع
– البرغوثي، تميم: ديوان تميم البرغوثي، قصيدة بيان عسكري 2015م.
-بن عجيلة، الحسن: أشعار ابن باديس، القصائد والمقطوعات والنّتف الشّعرية، منشورات دار قرطبة، الجزائر، (2018).
– ابن الجزري، محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي: الجزرية، دار الصحابة للتّراث، طنطا ، مصر. 2000م.
– جاكبسون، رومان: نظريات وظائف الكلام، دار الشرق للطباعة والنّشر، بيروت. 1978م.
– فضل، صلاح: في النّقد الأدبي، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ط:1، 2007م.
– الصنهاجي،عبد الحميد محمد بن باديس (المتوفى: 1359هـ) مؤلفات ابن باديس; المحقق. عمار طالبي ; الناشر. دار ومكتبة الشركة الجزائرية ; الطبعة. الأولى (عام 1388 هـ – 1968 ميلادية)
– العبد، محمود بن محمد عبد المنعم بن عبد السلام بن محمد: الروضة الندية شرح متن الجزرية، تحقيق: السادات السيد منصور أحمد، المكتبة الأزهرية للتراث / 2001م.
-عمار نعيم: التّوَاصُل اللساني والشعريّة مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، مجلة المركز التربوي للبحوث والأنماء، بيروت. 2022م.
– القعود، محمد: الإبهام في شعر الحداثة، سلسلة عالم المعرفة، العدد:279، المجلس الوطني للثقافة والآداب والعلوم، الكويت2011م.
– الكيالي، عبد الوهاب: تاريخ فلسطين الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1970.عبدالله
– معروف، عبدالله: المدخل إلى دراسة المسجد الأقصى، دار العلم للملايين، بيروت، 2005م.
[1] الجامعة الإسلاميّة/ وكلية الدّعوة-لبنان- بيروت.
[2] عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1970، ص: 38 وما بعدها.
[3] عبدالله معروف: المدخل إلى دراسة المسجد الأقصى ، دار العلم للملايين ، بيروت، 2005م. ص: 18.
[4] تميم البغوثي: غزة تنتصر، بيان عسكري، 2024.
[5] جاكبسون، رومان: 1978 نظريات وظائف الكلام، دار الشّرق، بيروت.
[6] نعيم عمار: (2022) التّوَاصُل اللساني والشعريّة مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، مجلة المركز التربوي للبحوث والأنماء، بيروت، ص: 64
[7] صلاح فضل (2007)، في النقد الأدبي (الطبعة الأولى)، دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
[8] تميم البرغوثي: بيان عسكري، ص: 48.
[9] ابن الجزري: الجزرية، ص: 6.
[10] محمد القعود: الإبهام في شعر الحداثة، سلسلة عالم المعرفة، العدد:279، المجلس الوطني للثقافة والآداب و العلوم ، الكويت2011م. ص:379.
[11] عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوفى: 1359هـ) مؤلفات ابن باديس; المحقق. عمار طالبي ; الناشر. دار ومكتبة الشركة الجزائرية ; الطبعة. الأولى (عام 1388 هـ – 1968 ميلادية)
[12]الحسن بن عجيلة: (2018) أشعار ابن باديس، القصائد والمقطوعات والنتف الشعرية، منشورات دار قرطبة، الجزائر، ص: 47.
عدد الزوار:30
