إشكالية المقدّس اللّغويّ في العربيّة
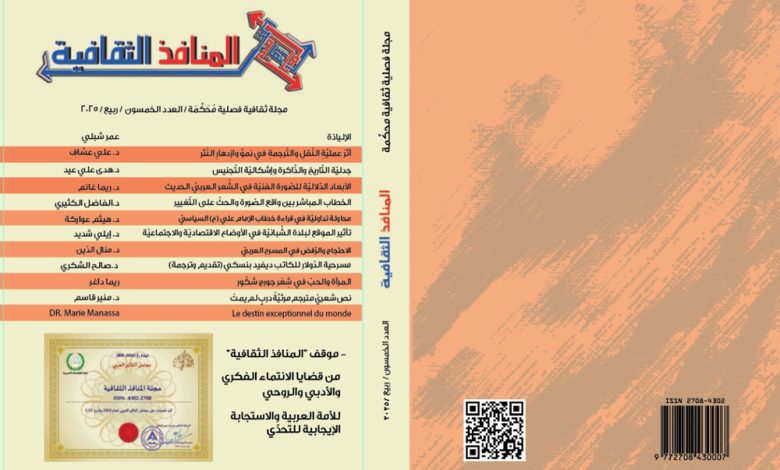
إشكالية المقدّس اللّغويّ في العربيّة
The Problematic Of The Linguistic Sacred In Arabic
د. محمود خليل([1])
Dr. Mahmoud Khalil
تاريخ الاستلام 16/8/2024 تاريخ القبول 28/8/2024
الملخص
يتناول بحثنا هذا قضية “إشكاليّة المقدّس في اللّغة العربيّة” ويبيّن أنّها – أي اللّغة – تميّزت عن سواها من الألسن الأخرى بمجموعة كبيرة من المزايا والخصائص التي جعلتها في موقع الصّدارة بين سائر اللّغات.. ثم حاولت هذه الدّراسة أن تعالج قضية المقدّس اللّغويّ كإشكالية ظاهرة على مستوى الوجود اللّغويّ في العربيّة، وعملت على ما قدمته من خلال بعدين اثنين: السّمات الطّبيعيّة في العربيّة، والنّص ذاته وما يمثله من قداسة حتمية ذاتيّة. وذلك من خلال تحوّلاتها المختلفة، وأيضًا من خلال قداستها في القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشريف، وبعض النّصوص الأدبيّة الراقية “نماذج مختارة” وصولًا إلى الدّرس اللّغويّ عند ثلة من علماء العربيّة الأقدمين.
الكلمات المفاتيح: الإشكاليّة – المقدّس – اللّغة – اللّسان – النّص – القرآن الكريم – الحديث النّبويّ – النّثر – الشّعر – المعنى – المبنى – التّحوّل – الإبداع.
Abstract
This research deals with the issue of the sacred in the Arabic language, and it shows that this language is distinguished from all other languages by a large number of features and characteristics that have placed it in a leading position, among all those languages. Then, the study at hands has tried to address the issue of the linguistic sacred as a problem that appears at the level of linguistic existence in Arabic and worked on what it has presented through two dimensions: the natural features in Arabic, and the text itself and what it represents in terms of inevitable intrinsic sanctity, through its various transformations and also its sanctity in the Holy Qur’an, the Noble Prophetic Hadith, and some high-level literary texts “sample models,” including the linguistic study of a group of ancient Arabic scholars.
Keywords:
The problematic – The sacred – Language – Text – The Holy Qur’an – Hadith – Prose – Poetry – Meaning – Style – Transformation – Creativity.
- المقدِّمة
تميّزت العربيّة عن سواها من الألسن بمجموعة كبيرة من المزايا والخصائص التي جعلتها في موقع الصدارة بين سائر الألسن. وقد جرى اللّسان بين النقاد والباحثين على استخدام لفظ “اللّغة” في موقع اللّغة واللّسان على حدٍّ سواء، أما فيما يختص، بموقفنا نحن تجاه هذه المسألة، وتجاه التمييز بين اللّغة واللّسان، فإننا وإن كنا نقرّ اللّسان على أنّه خصوصية لغوية يقوم ما أو شعب ما، فنحن نفضل إطلاق لفظ “اللّغة” على العربيّة رغم معرفتنا بأن اللّغة هي ذلك النّظام العام الذي يستخدمه سائر الناس وهو نظام مشترك بين جميع أفراد البشر، وما يدفعنا إلى ذلك ذلك الاتساع الهائل للغة العربيّة على مستوى دلالاتها من جهة، وعلى مستوى غناها اللفظي من جهة أخرى. فنحن نرى أنّ العربيّة نظام قائم بذاته، له مزاياه النحوية والبلاغية، والسياقية بما لا يشبه سائر ألسن البشر. فمن ناحية سعة اللّغة العربيّة فإنّ فيها ما لا يوازيه لسان في العالم فمفرداتها تكاد لا تحصى، ففي الحقل الدلالي المختص بالحزن – مثلًا – تجد الأسى، والكرب والهم، والتّرح، والشجن، والغم، والوجد، والكآبة، والجزع، والأسف، واللهفة، والحسرة والجوى، واللوعة، والحرقة وسواها في الحقل الدلالي نفسه، ولكل (لفظ) من هذا الحقل خصوصية دلالية قائمة بذاتها، ويضاف إلى هذا القدرة لدى العربيّة في التمييز بين المذكر والمؤنث في اللفظ الواحد من خلال زيادة التاء المربوطة، كما في قولك قارئ وقارئة أو قاتل وقاتلة في حين يعبر بالإنكليزية عن هذين المعنيين في التذكير والتأنيث بمعنى واحد كما في قولك (Reader, Killer). وتكاد لا تحصى تلك الخصائص التي تتميّز بها العربيّة عن سواها كخاصية التّخفيف كما في قولك (ميعاد) وأصلها الصرفي (موعاد) فأُبدلت الواو بالياء وذلك لتسهيل وتخفيف النطق، ومن أبرز ما يعنينا في هذا المقام وصف العربيّة بأنها لغة معجزة، ونقصد بمصطلح المعجزة عدم قابلية العربيّة للترجمة في معظم مبانيها الدلالية حيث تمتنع الكثير من المعاني والدّلالات عن الانتقال إلى غير العربيّةن وبطريق خاص الشّعر العربيّ والنّص الدّينيّ العربيّ، ولهذا نجد أنّ معظم النّصوص المتميّزة بمستويات دلالية عالية لم يتمكّن أحد من ترجمتها وما سمي لها من ترجمات لا يعدو كونه نقلًا للمعنى – ليس إلاّ – ونجد تلك النّصوص المترجمة إلى غير العربيّة قد فقد الكثير الكثير من مستويات دلالاتها وسقطت من أعلى إلى أسفل، في حين نجد العكس تمامًا عندما ننقل نصًا من لسان غير العربيّة إلى العربيّة حيث “يعلو النّص إلى مستوى أرفع عندما يتلبس بالعربيّة”([2]).
لقد كانت ولا تزال العربيّة لغة قادرة على استيعاب أي معنى في الحياة، وهي لغة مطواعة تمنح ناطقيها والعارفين بأسرارها من جهة الإبداع والتفوق لمن كان يرجو الإبداع والتفوق. وليست الحال واحدة في جميع اللّغات جميعها أو الألسن كما يعتقد بعضنا وذلك يرجع إلى خصوصية كل لسان على حدة، فإن أي لغة تمنح ناطقيها مجالًا كبيرًا ومساحة واسعة للتّعبير، لكن الأمر مختلف في العربيّة والفرق شاسع وكبير بين ما تقدمه العربيّة وسائر الألسن. وفي بحثنا هذا نتقصى واحدة من أعظم ميزات العربيّة، وهي صفة القداسة، بما تمثّلت به من عظمة بالغة بعد نزول القرآن الكريم، وسنسعى في بحثنا هذا إلى تظهير هذه الإشكاليّة وملابساتها وما يرتبط بها.
2- إشكالية البحث
يطرح بحثنا هذا “إشكالية المقدّس اللّغويّ” المقدّس اللّغويّ كإشكالية ظاهرة على مستوى الوجود اللّغويّ في العربيّة ويبحث في الموقف العام من الظاهرة، وطريقة التّعاطي معها، وما نقصده بالمقدّس اللّغويّ هو موجود ببعدين:
الأول: السّمات الطّبيعيّة في اللّغة العربيّة.
الثاني: النّص ذاته وما يمثله من قداسة حتمية ذاتية.
وبناءً على هذا الموجود فإن البحث يطرح جملة من التساؤلات ويجيب بطريق علمي وبدقة متناهية ومن جملة ما يطرح البحث:
- ما هو المقدّس اللّغويّ وما هي ملامحه في اللّغة العربيّة؟
- ما آثار المقدّس اللّغويّ على مستوى فهم النّصوص العربيّة؟
- هل من الممكن تجاوز هذا المقدّس الموجود معياريّ؟
ومن غير الممكن لنا أن نجيب على هذه التّساؤلات من غير الوقوف الدّقيق على مفهوم اللّغة وتعريفها وتاريخها، وعلى تلك التّحوّلات الكبرى التي حصلت للغة العربيّة منذ بدايات استخدامها إلى يومنا هذا، وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أنّ مسألة القداسة اللّغويّة، – أو المقدّس اللّغويّ – كما افترضنا من عنوان لبحثنا هذا لا تعدو كونها مسألة افتراضية، ويرجع السبب في ذلك إلى أنّ أحدًا لم يلتفت لهذه المسألة من قبل، وجلّ ما التفتوا إليه هو أن مثل ما ذكرنا من أمر وصفناه بالمقدّس اللّغويّ لا يعدو كونه مسلمات معيارية واعتبارية، وقد جرت سنن الأولين والآخرين على هذا المنوال في البحث اللّغويّ حتى صار الأمر طبيعيًّا ومن المسلّمات، لكن هذه المسلّمات – هي مقدسات بالمعنى الدقيق ولا يمكن لنا أو لأيّ باحث عارفٍ باللّغة العربيّة أن يتجاوز هذه المقدّسات أو يهملها.
إن ما نفترضه في بحثنا حول “المقدّس اللّغويّ” هو فرض بالمعنى الوجودي الدقيق لواحدة من أهم ما ميّز اللّغة العربيّة من صفات رفعت مستوى أدائها وميزتها عن أي لسان منطوقٍ في العالم. فما هي هذه اللّغة وما هو هذا المكوّن السحري الذي بواسطته تتحقق المعرفة شكلًا وتتلبس موضوعًا في الخارج؟
- ماهيّة اللّغة
عبّر ابن جنّي في تعريفه للغة بالقول: “أما حدّها فإنّها أصوات يعبّر كل قوم عن أغراضهم”([3]). وهذا التعريف لا يعدو كونه تعريفًا موضوعيًا يحدد اللّغة بماهيتها الظاهرية على أنّها مجموع أصوات وهي مستخدمة لأجل التعبير عن أغراض متعددة مختلفة، وهي ذات صفة ألسنية متعددة حيث لكل قوم لسانهم الخاص بهم والذي يتواصلون به وهو يختلف بالشيء القليل أو الكثير عن سواه، وتُعدّ اللّغة العربيّة واحدة “من اللّغات السامية المعروفة منذ القدم، وقد كانت لغة عاد، وثمود، وجدّيس، وجرهم، وكانت منتشرةً في اليمن، والعراق، وتعدّ مرحلة الحجاز مرحلة النّضوج والاستقرار، وعلى وجه الخصوص عندما صارت لغة الدّين الإسلاميّ الحنيف حيث تحوّلت إلى ضرورة وحاجة ماسة لكل مسلم مؤمن بالدّين الإسلاميّ، وفي سياق الحديث عن ماهية اللّغة نذكر أنّ اللّغة نظام اجتماعي تابع للإنسان دون سواه حيث تشكّل أداة للتواصل ووسيلة فهم وإفهام، ووسيلة أساسية لتدوين العلوم وسائر النشاط الفكري. ووصف علماء الألسنية اللّغة بأنها كائن حي، وذلك لارتباط اللّغة بالإنسان، وهذه الفكرة نشأت في بيئة غربية حيث ربط الباحثون بين حركة تطور اللّغة والإنسان، والربط هذا نفهمه ببساطة تامة أما اعتبار اللّغة كائن حي من وجهة فسيولوجية تأخذ بعين الاعتبار مسالة نمو الخلايا وموتها بعد ضعفها، فإننا لا نؤيد هذا الرأي ولا نصدّق هذا القول، حيث لم تمت لفظة منذ الجاهليّة إلى يومنا هذا، وفي قبالة هذا قد نعترف بإهمال لفظة ما والتوقف عن استخدامها في زمن ما لكنّ هذا لا يعني موتها، ويمكن القول: “إنّ مقولة اللّغة كائن حي إذا فهمت من جانب فسيولوجي، وقورنت بالكائنات الحية التي تموت أنسجتها وخلاياها. ثم تظهر أنسجة جديدة، وفق نظام مقدّر من الله تعالى، فهي مرفوضة. وإذا فهمت من خلال ارتباط مصيرها بمصير الكائن الحي الناطق بها، فهي مقبولة، ويمكن تطبيقها على اللّغة العربيّة([4]).
خلاصة القول في ماهية اللّغة تقضي بالاعتراف بأنّ بين اللّغة والإنسان علاقة ثابتة، حيث لا تنفك اللّغة عن الإنسان ولا ينفك عنها، كما وتُمثّل اللّغة الظهور الإنساني الأكبر والأعظم، حيث تتمظهر بواسطة اللّغة جميع أنشطة الإنسان الفكرية والثّقافيّة، والمعرفية، وهي التجسيد الأكثر ملاءمة للنشاط الفكري، واللّغة مدمجة في وجودها مع الإنسان منذ بداية الخلق والتّكوين إلى يومنا هذا، وهي شيء من الخلقة الإنسانيّة كما السّمع، وكما البصر، وسائر الحواس، والحديث عن ماهيتها حديث تكتنفه الضّبابيّة ويعتريه الغموض، ويحيط به التّساؤل، وذلك لأن اللّغة متعلقة الإنسان ولا تنفك عنه وهي نشاط عظيم مرتبط بعقل الإنسان وفكره وحاجاته.
- تحوّلات اللّغة العربيّة
لا نقصد بتحوّلات اللّغة العربيّة تلك التّحوّلات الخاصة على مستوى متفرِّق، كما هو الحال في لغة الشّعر التي شهدت تحوّلات كبيرة منذ بدايات الشّعر العربيّ في العصر الجاهلي إلى يومنا هذا؟ إذ شهدت لغة الشّعر العربيّ تحوّلات متفاوتة منذ الجاهليّة إلى يومنا هذا؛ بل نقصد بالتّحوّلات تلك التّحوّلات التي طاولت اللّغة العربيّة بشكل عام، ومنها التّحوّل اللّغويّ بين الفصحى والعامية على سبيل المثال، أو تراجع اللّغة من مستوى عالميّ في انتشارها إلى مستوى أدنى كما حصل للعربيّة بعد عصر النّهضة وتراجعها من مستوى انتشار دوليّ في العصر العبّاسيّ إلى مستوى انحسارها واقتصارها على العالم العربيّ كلغة رسميّة. لكن هذه التّحوّلات لا تعنينا الآن في بحثنا بطريق محدد وواضح، إنما يعنينا ذلك التّحوّل الكبير المرتبط بمجمل بحثنا، “المقدّس اللّغويّ”، وهو نزول القرآن الكريم، الكتاب السّماوي الذي أحدث أعظم تحوّل في اللّغة العربيّة على مستوى وجودها، وخلق لها نظامًا تعبيريًّا ذا مزايا خاصة تختلف عن جميع أساليب اللّغة العربيّة من قبل، ومن بعد. ولهذا السّبب أطلقنا على الطّريقة القرآنية لفظ النّظام ولم نسمه بالأسلوب، لأنّ النّظام موحّد، والنّظام إطار عام كبير يندرج في طياته الأسلوب وليس العكس.
بالطّبع شهدت اللّغة العربيّة العديد من التّحوّلات الظّاهريّة التي أصابتها بسبب التّغيرات الثّقافيّة والحضارية على مرّ العصور. وكان أبرزها وأعظمها التّحوّل الكبير الذي طرأ في عصر الحداثة، مع بدايات التّحوّل اللّغويّ عند شعراء الحداثة وأدبائها. وليس من شكّ في أنّ هذا التّحوّل وقع إثر عوامل كثيرة ومتعددة، كان أبرزها الاحتكاك الواقع مع الغرب، والانتقال الحضاري الذي عقّد الحياة ودفع بها نحو رفاهية عظمى وتبدلات كبيرة، هذه التبدلات خلقت معاني جديدة ألزمت الناطقين بالعربيّة بمواكبتها والعمل الدؤوب على استيعابها. وقد أدّت الحضارة بما خلقت من جديد نحو خلق كمّ هائل من الألفاظ الجديدة، وشحن العديد من الألفاظ بطاقة دلالية جديدة. وبين القديم والجديد يظلّ تحوّل نزول القرآن هو التّحوّل الأعظم الذي أصاب اللّغة العربيّة، وهو تحوّل أصاب ماهيّة اللّغة، وروحها، إذ دفع القرآن باللّغة من مستوى إلى مستوى أعظم وأعلى، وهذه القداسة التي منحها هذا النّص الدّينيّ للعربيّة سرعة في اللّغة العربيّة في كلّ الاتجاهات وظهرت آثاره في الشّعر، والأدب، والنثر وشكّل تحديًا كبيرًا بالعربيّة للعربيّة على كافة المستويات في التعبير، والأشكال، والموسيقى، والدّلالة. وبناءً على ما تقدّم ينبغي كشف اللثام عن هذا التّحوّل الذي جرى منذ سنة 610 ميلادية أي ما يقارب ألفًا وأربع مائة وعشر سنوات.
- التّحوّل الدّينيّ في اللّغة العربيّة
شهدت العربيّة تحولًا متميزًا عن أي تحوُّل قد يصيب أي لغة في العالم، وبقولنا التّحوّل الدّينيّ فإننا لا نقصر التّحوّل على القرآن الكريم وما أحدثه؛ بل على الحديث النّبويّ الشريف أيضًا بالدرجة الأولى بعد القرآن الكريم، ثم تلك الثّقافة الدّينيّة التي انتشرت في أرجاء الصحراء العريبة، وسائر العالم بعد انتشار الإسلام في العالم، بين بلاد فارس، وبلاد الشام، وإسبانيا وسواها، والبداية من دون أدنى شك مع القرآن الكريم.
القرآن الكريم:
لقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بجملة من الصّفات التي ظهرت في آيات القرآن الكريم، وقد ذكر الله تعالى لكتابه العزيز العديد من الأسماء، ومنها: القرآن، والكتاب، والذكر، وغير ذلك، “مما يدل على شرف المسمى وعلو شأنه ([5]). وعندما كانت المهمة الأولى المناطة بالقرآن الكريم هي الهداية والإرشاد، كان لا بدّ أن يكون مبيِّنًا وكاشفًا للحقائق، وفي هذا يقول تعالى: ﴿الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ وَقُرۡءَانٖ مُّبِينٖ﴾ ([6]). و﴿﴿طسٓمٓ١ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ٢﴾ ([7]). ووصف تعالى القرآن بأنه عظيم: ﴿وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ٨٧﴾ ([8])، تم وصفه بأنه مجيد: ﴿قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ١﴾([9])، وغير ذلك من الصّفات التي تدل على عظمة هذا الكتاب وشأنه العظيم. وأبرز وأهم ما يعنينا في مقام بحثنا هذا، صفة القرآن العربيّة، ومن قوله تعالى في هذا الصدد: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا ٢﴾([10]). وفي هذه الآية دلالة صريحة على تلبس القرآن بالعربيّة حال النّزول، ويشير الله تعالى في مكان آخر إلى الحقيقة ذاتها في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ٣﴾([11]). “وفي الآية إشارة دقيقة إلى أنّ هذا الجعل أنّ القرآن كان شيئًا وصار شيئًا آخر خلال التنزيل”([12]). ولا ينبغي لنا أن نفصل القرآن الكريم عن مرسله وموحيه ومنزِّله، وهو الله تعالى، وهو العلي العظيم والقدوس، الذي أضفى على النّص القرآني قداسة منقطعة النّظير لم تتوفر لنص ديني آخر ولم تتوفر تاليًا لأي نصّ غير ديني أيضًا.
إنّ مرسل القرآن الكريم الله تعالى، وهو تجسيد لإرادته وما من شك في أنّ هذا الكتاب شكّل تحديًا منقطع النظير لأهل اللّغة العربيّة وللغة العربيّة في منظومتها العامة بين الناطقين بها، ومن أعظم ما دلّ على قداسة هذا الكتاب تلك النّصوص الظاهرة بسماتها الدقيقة والتي تصف القرآن الكريم وصفًا يدلّ على علوّ شأنه، ورفعة مكانته وقداسته المطلقة، ومن هذه النّصوص نختار واحدًا من أبرزها لسيِّد البلاغة العربيّة وصاحب نهج البلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام حيث يقول:
“ثم أنزل عليه الكتاب نورًا لا تطفأ مصابيحه وسراجًا لا يخبو نوقده وبحرًا لا يدرك مقره ومنهاجًا لا يضلّ نهجه وشعاعًا لا يظلم ضوؤه وفرقانًا لا يخمد برهانه، وتبيانًا لا تهدم أركانه، وشفاءً لا تخشى أسقامه، وعزًّا ألا تهزم أنصاره، وحقًا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان، وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافيّ الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيظانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيونٌ لا ينضبها الماحون، ومناهل لا يفيضها الواردون، ومناهل لا يضلُّ نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريًّا لعطش العلماء، وربيعًا لقلوب الفقهاء، ومحاجّ لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورًا ليس معه ظلمة، وحبلًا وثيقًا عروته، ومعقلًا منبعها ذِروته، وعزّا لمن تولاّه، وسلمًا لمن دخله، وهدى لمن ائتمّ به، وملجأ لمن حاج به، وحاملًا من حمله، ومطيّة لمن أعمله، وآية لمن توسّم، وجنّة لمن استلأم، وعلمًا لمن وعى، وحديثًا لمن روى، وحكمًا لمن قضى([13])، ويدلّ هذا النّص على مدى عظمة النّص القرآني وقداسته، وما يتميز به عن سواه في الموروث اللّغويّ. وقد شكّل هذا القرآن تحديًا لغويًا رفيع المستوى للناطقين بالعربيّة، وذلك بنظامه المعجز الذي تميّز به في هندسته السياقية، إذ أن السياق القرآني هو أحد أكبر وجوه الإعجاز القرآني، بل إنّه الإعجاز الأعظم الذي من خلاله تتفرع سائر الإعجازات البلاغية، والتصويرية، والموسيقية. وفي سياق البحث في قداسة النّص القرآني فإننا نلتفت إلى ما أحاط به الباحثون في النّص القرآني هذا الكتاب من قداسة تأسست على حذرٍ شديد في عملية التعاطي مع تفسير آياته، فقد نهى رسول الله (ص) النّاس عن تفسير القرآن الكريم بالرأي، وقال فيما قال: “من فسّر القرآن بالرأي فقد كفر”([14]). وقد دأب جمع من المسلمين زمن الرسول الأكرم (ص) وبعده على حفظ القرآن بالكامل ظهرًا عن قلب، وذلك لاعتقادهم القطعي بقداسة هذا النّص وبالكرامة العظيمة التي تلحق بحافظ القرآن من جراء حفظه له، هذا إضافة إلى الكثير من المرويات عن النبي (ص) التي تحضّ على حفظه وتعليمه وتعلّمه، إذ هو دستور الحياة ومرشد الناس إلى النور ومخرجهم من الظلمات والضلال وهو ربيع القلوب وبه تطمئن القلوب، وفيه معرفة ما كان وما سيكون([15]).
هكذا أحاط العرب المسلمون القرآن الكريم بهالة من القداسة، والاحترام الشّديد في طريق التّعامل مع هذا الكتاب، وذلك على عدّة مستويات:
أولًا: قراءة القرآن وتجويده ورسمه وتفسيره
حدد العرب طريقة دقيقة لقراءة القرآن وتجويده، وذلك منعًا لأي خطأ قد يرد في تلاوته وفي نيله، وصار تجويد قراءة القرآن فنًا قائمًا بذاته له قواعده وأصوله، وصار له كبار المقرئين الذين يتفننون بتجويده وترتيله، كما وصار للتجويد مدارس كبرى في جميع أمصار البلاد العربيّة، وكذلك تفنن العرب في إتقان صناعة ورق الكتاب وتذهيبه وزخرفته، وصار للقرآن الكريم إملاء خاص به يعرف بالرسم العثماني ولا يخرج مصحف في كنايته عن قواعده([16]). ولحقت بالمصحف الشريف جملة من الأحكام الشرعية الفقهية المختصة بطريقة التعامل مع القرآن الكريم ومنها حرمة لمس كتابة القرآن وحروفه لمن لم يكن متوضئًا، وقد استند الفقهاء في ذلك على قوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ٧٩﴾([17]). كما حرم فقهاء الدّين نقل آية كريمة بالتلاوة غيبًا مع احتمال وجود خطأ في تلاوتها([18]). هذا كله من جهة مادية حسيّة وأما على مستوى التعاطي مع النّص القرآني من ناحية التأويل والتفسير، فإن العرب أحاطوا البحث القرآني بهالة عظمى من القداسة، وكانوا على أعلى قدرٍ من الحذر والخوف من خوض غمار الكلام في القرآن الكريم والبحث فيه. ولهذا السبب نجد معظم النشاط القرآني في بدايات نشأته كان لغويًا ولم يتعد حدود النقل عن رسول الله (ص) وأهل بيته عليهم السلام، وكانت معظم التفاسير القرآنية لا تتعدى حدود اللفظ والتقلبات الدلالية “التي تقترب من الصياغة المعجمية”([19]). وكان التشدد واضحًا، والحذر باديًا في فهم النّص القرآني، وهذا كله نابع من خلفية ارتباط القرآن الكريم بالخالق العظيم، الله جل وعلا، حيث يمثل هذا الكتاب وما فيه إرادة الله تعالى وبالتالي فإنّ الوقوف على حقيقة ما يريد الله هو أمر صعب مستصعب وليس من السهل الوقوف على حقيقته، لا سيما أن القرآن له ظاهر وباطن، وهو جمال وجوهٍ كما وصفه آل بيت رسول الله (ص) ([20]). وما من سبيل لحصر مسألة قداسة القرآن الكريم عند نقطة واحدة، فعدا كل ما يتعلق بمرسل ومنزل القرآن فإن للنص القرآني قداسة خاصة بذاته تنبع من نظامه المعجز الذي لم يستطع أحد في الكون أن يجاريه، أو يحدّ أسراره، ويستطلع مضامينه، وما ذكرناه في هذا المقام ليس غير مقدمة ميسّر مختصرة في خصوصيات النّص القرآني، وأسراره، وقداسته وبعد هذا سيجري البحث في انعكاس هذه القداسة على اللّغة العربيّة وآثار هذه القداسة في البحث اللّغويّ، وفيما يلي ننتقل إلى البعد الثاني في مضمار التّحوّل الدّينيّ في اللّغة وهو الحديث:
ثانيًا: الحديث
يقصد بالحديث كلّ ما ورد على لسان رسول الله (ص) من حديث غير القرآن الكريم، وهو مقسوم إلى قسمين: النّبويّ الشريف، والقدسيّ.
الحديث النّبويّ الشريف: وهي مجموع ما ورد على لسان رسول الله (ص) وهي من عنده ومن اجتهاده وكلماته وسميت تلك الأحاديث بالأحاديث النّبويّة الشريفة، وقد عمل المسلمون على طول الزمان في حفظها وتدوينها والتحقيق بصحة سندها، كما حرّم فقهاء الدّين الكذب على الله وتلاوة القرآن بطريق غير صحيح وبكلمات تنقل المعنى بغير ما نزل به في القرآن الكريم فإنّ الفقهاء حرّموا أيضًا الكذب على رسول الله (ص)، ومنعوا تحريف حديثه إلا أنه سمحوا بنقل الرواية عن الرسول الأعظم بالمعنى، على أن لا يُحدث هذا النقل تحولًا في إرادة الرسول أو تحريفًا في المعنى الذي نقل عنه (ص)، واكتسبت هذه الأحاديث مع الوقت قداسة تأتي في الدرجة الثانية بعد قداسة القرآن الكريم، وقد صنّف له المسلمون والمؤرخون كتبًا عديدة، وحققوا فيها وفي سندها وصحتها رواتها، ونشأ بسبب هذه الأحاديث علمٌ مستقلٌّ بذاته هو علم الرجال، الذي يعني في عدالة الرواة وصدقهم وصحّة ما رووا عن الرسول الأعظم (ص).
- الحديث القدسيّ: إلى جانب الحديث النّبويّ الشريف، نُقل عن رسول الله (ص) جملةً من الأحاديث عرفت بالأحاديث القدسيّة، وهي تلك الأحادث التي نقلها رسول الله (ص) عن الله تعالى بواسطة أمين الوحي جبرائيل عليه السلام وهي ليست من القرآن، وكما اعتنت الدراسات بالحديث النّبويّ الشريف وتصنيف كتب له، كذلك قامت الدراسات حول الأحاديث القدسيّة، وتوسّعت العناية بها، وبرواتها، وبمعانيها، ودلالاتها.
لقد هيأ القرآن الكريم والحديث النّبويّ بشقّيه الأرضية الخصية لولادة ثقافة متميزة بعد نزول القرآن الكريم، كان لها ميزاتها الخاصة، ومعاييرها التي تتقدم بها، ولقد كان لهذه الثّقافة الأثر البالغ في خلق أجواء جديدة على مستوى إحاطة اللّغة العربيّة بهالة من القداسة، فما هي هذه الثّقافة وعلى ماذا تأسست، ونمت، وكيف انتشرت؟
الثّقافة الإسلاميّة
حصل تحوّل بالغ وشديد في مسار الثّقافة العربيّة بعد نزول القرآن الكريم وانتشار الحديث النّبويّ الشريف، ويعتبر القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشريف المصدر الرئيسي للثقافة الإسلاميّة والمرتكز الأكبر في أسسها، ومع مرور الوقت وانتشار الدّين الحنيف قامت جملة من العلوم كانت في معظمها تدور في فلك القرآن الكريم ومنها:
- معاني ألفاظ القرآن الكريم.
- أسباب نزول الآيات.
- تفسير القرآن الكريم.
- تأويل القرآن الكريم.
- تجويد القرآن الكريم.
- رسم القرآن الكريم.
- دراسات في حركة تاريخ القرآن الكريم ونزوله (مكي – مدني).
- دراسات الموضوعات القرآنيّة.
مع تطور الحياة استحدثت الكثير من العلوم التي قامت على أسس قرآنيّة ومنها:
- المباني الحضاريّة في القرآن الكريم.
- القرآن والسنن التّاريخيّة وحركة الكون.
- دراسات جغرافية مستندة إلى القرآن الكريم.
- دراسات علميّة رياضيّة فلكيّة في القرآن الكريم.
- دراسات حسابيّة وزمنيّة ورقميّة في القرآن الكريم.
- دراسات لغويّة ذات سمة متطورة جدًا.
وقام حول الحديث النّبويّ الشريف جملة من العلوم منها:
- دراسة الدّلالات والمعاني.
- تحقيق الأحاديث.
- علم الرجال.
- التّعديل والتّجريح.
- علوم الكلام والفلسفة.
وبناءً على ما تقدّم قامت حركة فكرية وثقافية ناشطة واسعة الانتشار تأسست على مناخ معرفي جديد وبأصول جديدة، فانتشرت العلوم في كل الأمصار وصار القرآن والحديث النّبويّ الشريف مادة للمطارحات الفكرية، وعلوم الكلام، والفلسفة، وقامت نهضة فكرية منقطعة النظير وانتقل العرب من خلالها من طور إلى طور ومن حياة إلى حياة، وازدهرت حركة الترجمة والتعريب، وتأسست الجامعات وصار للعرب أطروحتهم الفكرية والإسلاميّة، والفلسفية الخاصة بهم، وتحولت الحياة الاجتماعية من طور البداوة إلى الترف وازدهار العلوم، ونمو النشاط العقلي، حيث أعطي العقل الدور الأبرز الذي أراده الله له في حياة الإنسان. وفي مدّة وجيزة بعد نزول القرآن الكريم وفي العصر العباسيّ على وجه التحديد بلغت الحركة العلمية والفكرية أوجها ومداها الأقصى وازدهرت معظم العلوم ومنها:
- العلوم التّبطيقيّة من فيزياء وكيمياء ورياضيات وطبّ وهندسة.
- علوم الكلام من فلسفة ومنطق وسواها.
- علوم تفسير القرآن وتأويله والحديث النّبويّ.
- الدّراسات الفقهية المستندة إلى القرآن والسّنة.
- الدّراسات اللّغويّة وعلم المعاجم والألفاظ، والصّرف والنّحو والبلاغة وسواها.
ولقد حظيت الآداب والشّعر على وجه التّحديد تطوّرات هائلة على مستوى الشّكل والمضمون وقامت فنون أدبيّة جديدة على خلفية الثّقافة الإسلاميّة كفنّ الخطابة وما إلى ذلك.
لقد كانت حياة ثقافية متميّزة، وغنية متعددة الوجوه حيث تداخلت في الثّقافة العربيّة جملة من العناصر كان أبرزها:
- العناصر الدخيلة، الفارسي، الهندي، اليوناني.
- القرآن والسنّة الشريفة.
- الموروثات العربيّة القديمة.
وكان في جملة هذه الثّقافة المتميّزة ما تركه أهل النخبة من بيت رسول الله عليهم السلام، ويأتي على رأس هذا التراث كتاب خليفة رسول الله (ص) الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام “نهج البلاغة” إذ وصفه رسول الله (ص) بالقول: “كلامك يا علي فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق”([21])، ويعد هذا الكتاب من أعظم الموروثات الثّقافيّة في تراث الأمة بعد القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى ما تركه آل بيت الرسول من أبناء الإمام علي عليه السلام. وقد ترك كلّ واحد منهم كمًا هائلًا من الأحاديث والخطب التي لا حصر لها ومنها الصحيفة السجاديّة للإمام زين العابدين، وهنا تجدر الإشارة إلى تلك الأدعية المشهورة التي أطلقها آل بيت رسول الله وعلى رأسها أدعية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأعظمها: “دعاء كميل” و”دعاء الصباح”.
لا يمكن لأحد أن ينكر أن الإسلام بكليته تحول إلى ثقافة كبرى على مستوى شبه الجزيرة العربيّة، وعلى مساحة الانتشار الكبير للدولة الإسلاميّة. كما ولا يخفى على أحد أن المسلمين مارسوا هذه الثّقافة انطلاقًا من روحية الشريعة الإسلاميّة التي تحضّ على نشر الدعوة الإسلاميّة وتعليم القرآن الكريم، إذ يقول رسول الله (ص) “خيركم من تعلم القرآن وعلّمه”([22]). وقد حضّ القرآن الكريم على العلم ودعا إلى تحكيم وإجراء العقل في كل مقتضيات الحياة، وفي هذا المقام يقول تعالى: ﴿يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ٣٣﴾([23]).
لقد طبع الإسلام الحياة الثّقافيّة للعرب بطابع الإيمان والروحانية والدّين، وكان للقرآن الكريم الأثر الأكبر في هذه الثّقافة، التي بدورها خلقت مناخًا أدبيًا جديدًا على مستوى اللّغة العربيّة والأدب العربيّ، وفيما يلي من بحثنا هذا ندخل ي عمق الموضوع حول إشكالية القداسة في اللّغة العربيّة والمنشأ الذي تأسست عليه فكرة القداسة، وكيف تحولت الكثير من الأعمال اللّغويّة والأدبية إلى مستوى القداسة بمعايير عرفية منذ أول التاريخ إلى يومنا هذا.
- مصطلح القداسة
قداسة (اسم)، وقداسة المكان طهارته وجلاله، والقداسة الطهر والبركة وتقديس الله: تعظيمه وتبجيله وتنزيهه عما لا يليق به([24]). وما يفهم من القديس، هو كلُّ شخص عاش الفضائل الإلهية من إيمان ورجاء ومحبّة، وتأتي كلمة “قدس” في معجم الفيروزآبادي بمعنى التنزيه والترفع عن كل نقص وسوء، والتصقت القداسة كصفة بخيرة البشر من أنبياء ورسل وملائكة وأولياء وأوصياء، كما وعرفت بعض الأماكن بأنها أماكن مقدّسة كمكة المكرّمة، والحرم النّبويّ، والقدس في فلسطين، وكربلاء في العراق وغيرها من الأماكن التي قدّستها الشعوب لسبب أو لآخر. ويمكن فيما يلي رصد جميع أو معظم المعاني المرتبطة بمعنى القداسة:
- البركة والتبرك.
- الترفع عن كل سوء أو نقص أو عيب.
- الطهارة عن كل دنس.
- إسقاط كل ما يليق.
- الرفعة عما هو معتاد.
- المبالغة في قيمة الموصوف.
- التعظيم والتبجيل.
- الخير الكبير.
- الصّفات الكريمة.
وفي القرآن الكريم ورد “القدوس” في الآية الكريمة: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ٢٣﴾([25]). وهو تعالى المنزّه عن كلِّ عيب وشرّ، ونقص، والمنزّه عما لا يليق به. والقدوس صفة لله عز وجل من صفات الذات الإلهية الموجودة مع وجوده جلّ وعلا ولما كان وجوده أزليًا فإن القداسة أزلية متلازمة مع وجوده. ونحن نعتقد بأن جميع إفاضات القداسة على الحياة بعد الإسلام إنما ناجمة عن الله عز وجل وعلا وفائضة من فيوضاته الوجودية، ونورانية صفاته المتالية والمطلقة، وقد انعكست هذه القداسة على لغة العرب لأسباب عديدة نناقشها فيما يلي.
- قداسة اللّغة العربيّة في القرآن الكريم
كانت العربيّة موجودة قبل الإسلام وقبل القرآن الكريم، وكان العرب ينطقون بها ويستخدمونها في حياتهم اليومية وفي تواصلهم فيما بينهم، ثم نزل القرآن الكريم على نبي الأمة الرسول الأعظم محمد (ص)، “”فما كاد العرب يتلقفونه من رسول الله (ص) حتى أخذتهم الدهشة وسلبت ألبابهم روعة الصنعة”([26]). ولقد شكّل القرآن الكريم تحديًا كبيرًا للعرب على مستوى لغتهم رغم أنه كتاب بالعربيّة وألفاظه عربية وكانت مما أنسته أذهان العرب. وفي طريق البحث المتأخر طرحت إشكالية كبرى مفادها في السؤال التالي: “هل لأنّ القرآن الكريم كتاب مقدّس وهو باللّغة العربيّة فإنّه يفيض على لغة العرب بصفة القداسة؟” و”هل منحها القرآن الكريم درجة رفيعة بين سائر لغات العالم لأنه نزل بها وتلبسها”؟ وهنا يمكن تفنيد الموضوع من ناحية منطقية دقيقة وبطريق علمي واضح. وبالتالي لا بدّ من أن نضع لغة القرآن الموصوفة في القرآن بأنها عربية لقوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ٢﴾([27]). أمام لغة العرب التي كانت سائدة في زمن الجاهليّة قبل الإسلام، ولقد كانت هذه اللّغة وسيلة التواصل بين الناطقين بها وبها عبّروا عن حاجاتهم، وعن علاقاتهم بالوجود وبالآخر، وكتبوا بواسطتها أشعارهم التي شغلت حيّزًا كبيرًا من التراث العربيّ القديم، وتثبت الدراسات النّصوص أن هذه اللّغة – العربيّة الفصحى – امتازت بكثير من الصّفات الجمالية والموسيقية، وبالطواعية، والقدرة على التشكل في معانٍ مختلفة، ودليلنا على ذلك ما خلّفه العرب من أشعار جميلة ومتقنة في زمن الجاهليّة، ولما نزل القرآن الكريم نزل بالعربيّة والأدلة واضحة، وأعظمها النّص المكتوب بين ايدينا فهو نص متلبّس بالعربيّة من غير أدنى شك. لكن العرب وحسب مالهم قد التبس عليهم الأمر في فهم الآية الكريمة: ﴿إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ٣﴾([28]). حيث ظنوا أن هذا القرآن قد نزل بوصفه العربيّ طبق ما هو عليه في لغتهم، في حين كان ينبغي أن يعوا حقيقة الآية على أنها تبشر بنزول القرآن بحسب اللّسان العربيّ، أما نظامه فمختلف اختلافًا كبيرًا، ولذلك نحن نعتقد بأن القرآن الكريم هو في لغته يمثل العربيّة على ما هو عليه في وجهها الحقيقي، والدليل بسيط في ذلك ويتمثل بالواقع الحقيقي للقرآن من حيث كونه قول الله تعالى وكلام الله وسائر اللّغة قول البشر ولما كان تعالى منزهًا عن سائر من نطق وكتب بالعربيّة فإن العربيّة في صورتها الفضلى وقداستها وعظمتها تتجسّد بالقرآن الكريم من دون أدنى شك([29]). لكننا نؤمن من دون أدنى شك بأن القرآن الكريم كتاب مقدّس ولا يأتيه الباطل لا من قريب ولا من بعيد، وإنه منزّه عن أي نقص أو باطل وبالتالي فإن هذه القداسة مؤكّدة ومؤسسة على مبدأ يتعلق بمرسل القرآن الكريم، وعندما نتحدث عن القرآن الكريم فإننا نتحدث عن كتاب كريم عظيم مقدّس بمضامينه وماهيته، وإذا كان هذا الكتاب مقدّسًا فنحن لا نشكّ بقداسة آياته على الإطلاق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو: “هل أضفى القرآن الكريم قداسةً على الألفاظ وجعلها مقدّسة حتى خارج النّص القرآني؟ وللإجابة على مثل هذا السؤال لا بد من التأمل في المسألة فلفظ الجلالة على سبيل المثال كان موجودًا قبل القرآن الكريم وقد عرفته العرب منذ زمن الجاهليّة، إلا أن الذي لا نشك فيه هو أن هذا القرآن أعطى لفظ الجلالة قداسة مطلقة من غير الممكن أن تنفك عنها لا داخل النّص القرآني ولا خارج النّص القرآني بما تعنيه اللفظة من اسم للخالق عز وجل وعلا، لكن استخدام اللفظ عينه في لحاظ آلهة الجاهليّة لا قيمة له في السياق إن كان المقصود به غير الله جل جلاله، وكذلك الرحمن والقدوس، والعزيز، والجبار، والمتكبر، والمصور، والخالق، والبارئ وغير ذلك. ولقد اخترنا هذه الأسماء نماذج خاصة لنؤكد على أنها اكتسبت قداستها في سياق ما تستخدم فيه من معانٍ وجمل ومقاصد. لكن لو خرجت هذه الكلمات من سياقها القرآني ودلالاتها القرآنية والمقاصد الموضوعة لها، ففي قداستها عندئذٍ نظر بالغ، وبعيد عن الحقيقة التي عرفناها من خلال القرآن الكريم، فما بالك بسائر الألفاظ وما شابه، ففي القرآن الكريم حروف الجر وحروف المعاني والكثير الكثير من ألفاظ العربيّة التي كانت القبائل تستخدمها في تواصلها فيما بينها. وكل هذا يقودنا إلى سؤال حساس ودقيق: “هل ألفاظ العربيّة مقدّسة بذاتها؟ وبالتالي هل اللّغة العربيّة لغة مقدّسة بذاتها؟ أم أن الاستخدام في طريقة ما ومن قبل جهة ما منحها صفة القداسة؟ وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي النظر إلى القرآن الكريم بموضوعية بالغة وتامة، ففي المقام الأول نحن نعلم أن هذا الكتاب هو وحي من رب العالميّن وتكمن قداسته في هذه النقطة أولًا وأخيرًا، والتصديق بهذه القداسة إنما نابعة من إيماننا بأن هذا الكتاب من عند الله العزيز الحكيم، والسلام القدوس ومن آمن بالله آمن بكتبه وأنبيائه وسائر رسله، وآمن بأنهم مقدّسون بالمعنى التام، وأنهم منزّهون عن أي خطأ أو نقص أو عيب، وهذا معلوم ومعروف ومدرك بأبسط الأدلة العقلية وهو ضرورة تنزّه أي مرشد وهادٍ عن أي عيب أو نقص وإلا لم يعد بالإمكان تصديق دعوته أو اتباع تعاليمه وما يقول وما يفعل([30])، ونعود ونؤكد على أن الدافع إلى تقديس القرآن الكريم هو إيماننا بالله العزيز، وبأنه قدوس وقد عصم كتابه من أي خطأ أو نقص أو عيب، ومن لم يؤمن بالله، لن يؤمن بكتابه من دون أدنى شك في ذلك، وبالتالي لا قداسة لهذا الكتاب لديه، لكن نفي الإيمان عند أحدهم لسبب أو لآخر لا ينفي القداسة عن الكتاب من دون أدنى شك أيضًا، ولهذا السبب فإن الكلام حول قداسة الكتاب مؤسس على خلفية أنه وحي من عند الله، ولا يأتيه النقص أو العيب لا من قريب ولا من بعيد، لكن إيماننا بالكتاب وبقداسته هو إيمان مؤسس على قداسة معانيه ومضامينه بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية فإن مادة الكتاب حروفًا وكلمات وآيات مقدّسة ايضًا لا تقبل بالمساس بها بالمعنى المادي، ولهذا يعترض المسلمون على أي إساءة إلى هذا الكتاب مادية كانت أو معنوية، كما رفضوا أي إساءة إلى شخص النبي الكريم محمد (ص). وعند هذه النقطة يمكن طرح السؤال التالي: هل سرت القداسة من القرآن الكريم إلى اللّغة العربيّة؟ وتمامًا وبالموضوعية ذاتها التي عالجنا بها السؤال السابق نقول: إنه من غير المنطقي أن نقبل بقداسة اللّغة العربيّة لمجرد أن القرآن الكريم هو كتاب تلبس بالعربيّة عندما أوحى الله به لنبيه (ص). والقبول بهذه الفكرة هو أمر افتراضي لا يستند إلى منطق، ولا يرتكز إلى دليل، وهو لا يعدو كونه رجمًا بالغيب. ولو تقبلنا الأمر فإنه ينبغي علينا تقبله كما هو بالنسبة لسائر الألسن العربيّة، وإنا لنعلم أن الله تعالى أنزل عددًا كبيرًا من الرسالات على أنبيائه تباعًا في الأرض، وبالتالي ينبغي القول وبناء على قداسة المرسل وقداسة الأنبياء – بأن جميع لغات تلك الكتب – الإنجيل، والتوراة، والزبور، وسواها – هي لغات مقدّسة، وحروفها، وألفاظها كذلك. ولا يمكن في قِبال ذلك أن ينكر أحد تلك الخصوصية البالغة للغة القرآن الكريم، وعظمة أدائه ونظامه المتميز، فهو – من دون ادنى شك – كلام الله وقوله، ويمثل إرادته، وفيه ما فيه من أدلة تدل على تمييزه البالغ عمن سواه من مادة لغوية، وفي الأصل تحدّى الله تعالى الناس بأن يأتوا بآية من مثله أو بسورة وقال فيما قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾([31]). وقال تعالى أيضًا: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾([32]). وبناءً على ما تقدّم من مضامين الآيتين الكريمتين، فإننا نقر بأن القداسة تأتت من المرسل المقدّس – القدوس – الله ومن كيفية رسم النّظام اللّغويّ الذي نزلت به الآيات وهي متلبسة بالعربيّة. وانطلاقًا من مبدأ الآية الكريمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾([33])، فالله تعالى قادرٌ على أن ينزل على عبده أيّ كتاب بأي لغة يختارها هو، وبالتالي ستكون لغة مقدّسة بلا ريب في لحاظ النّص ذاته. كل هذا على مستوى القرآن الكريم فماذا عن اللّغة العربيّة وقداستها في لحاظ الحديث النّبويّ الشريف.
- اللّغة العربيّة في الحديث النّبويّ الشريف
كان للعربيّة موقعها المتميّز عند العرب الناطقين بها، وقد وصلنا منها تراث شعري كبير يُعتدّ به وبقيمته، ولا نجد ضرورة للكشف عن جماليات العربيّة وطواعيتها، ومدى قابليتها لاستيعاب المعاني الحياتية من حولها، والنبي الأكرم محمد (ص) عربيٌّ ومن أصول عربية وقد أحب العربيّة وأتقنها إتقانًا كبيرًا، وهو (ص) أوّل من أطلق عليها إسم “لغة الضاد”([34])، وقال: “أنا أفصح من نطق بالضاد”، كما نقل عن رسول الله (ص) قوله: (أُحبّ العربيّة لثلاث: لأنّي عربيٌّ، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي)([35]).
لا ريب في أن النبي الأعظم (ص) كان أفصح من نطق بالعربيّة، وقد أوتي جوامع الكلم والبلاغة والفصاحة، وترك تراثًا لغويًا كبيرًا تأسس عليه الكثير من الأحكام الفقهية كما شكّل قاعدة لغوية وشاهدًا لغويًا على كثير من القضايا اللّغويّة، وقد ذكر الكثير من المحققين اللّغويّين أنّ للحديث الشريف مدخلًا في الاستشهاد وللقواعد اللّغويّة النحوية، وهذا هو مذهب أبي محمّد ابن مالك وابن هشام وغيرهما من أكابر علماء العربيّة. وأما معاجم اللّغة العربيّة وقواميسها فهي زاخرة بالشواهد من الحديث الشريف، وقد تفرد على الحديث الكثير من القضايا النحوية. ولا يخفى على أحد ذلك الأثر البالغ للحديث النّبويّ الشريف في إغناء العربيّة بالمعاني والدّلالات والاشتقاقات.
إن ما يستوقفنا في الحديث الذي ذكرناه قول رسول الله (ص) “وكلام أهل الجنة” وعند هذه النقطة تحديدًا توقف القائلون بقداسة اللّغة العربيّة، فهل قول النبي الأعظم (ص) أن لغة أهل الجنة العربيّة يعني قداسة هذه اللّغة، وبموضوعية تامة لا يمكن تحميل الحديث النّبويّ الشريف فوق طاقته ولا ينبغي لنا ذلك مطلقًا وفي الاعتقاد بالأمر مصادرة واضحة وادعاء غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصِلة، ولو كانت العربيّة مقدّسة بالمعيار الوجودي لصرّح الرسول الأعظم بهذه الحقيقة لو كانت حقيقة، ورغم هذا فإننا مؤمنون بأنّ ما نصه رسول الله (ص) يحمل مضامين مقدّسة ولا يمكن التشكيك بقداستها من ناحية دلالية ومعنوية لكننا لا نستطيع أن نسرِّي هذه القداسة إلى العربيّة بطريق من الطرق. ولمجرد أنّ الرسول الأكرم نطق بالعربيّة وكان أفصح من نطق بها، ولأنه قال بأن العربيّة كلام أهل الجنة.
يأتي بعد الحديث النّبويّ الشريف نصوص في العربيّة لا تقل شأنية عن الحديث النّبويّ الشريف وتعد في مرتبة أرقى وأعلى من كلام البشر ونقصد بها تلك النّصوص والأحاديث الواردة على لسان العترة الطاهرة من آل بيت الرسول الأعظم (ص) والتي تشكّل جزءًا كبيرًا من تراث العربيّة النفيس، ويأتي في مقدِّمتها كتاب أمير المؤمنين الذي جمع خطب الإمام علي “ع” والمعروف باسم نهج البلاغة، بالإضافة إلى ما خلّفه عترة أهل البيت من تراث عظيم له قيمته الإرشادية واللّغويّة الكبرى وفيما يلي نعرض لهذه الأهمية التي كان لها الأثر البالغ في دفع البعض إلى التصديق بقداسة اللّغة العربيّة.
- نصوص أرقى من الإبداع
زخر تراثنا العربيّ والإسلاميّ بنتاج كبير فيه من الإبداع ما يجعله متقدمًا على رسواه قيمة ودرجةً، ومن هذا التراث أيضًا ما فاق الإبداع والمبدعين، في كلام وصفه رسول الله (ص) “بأنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق”([36])، وهناك الكثير من الكلام الذي يصف كتاب نهج البلاغة من قِبل أدباء ومفكرين وعظماء في التاريخ، ومن هؤلاء:
- أبو الحسن علي بن زيد البيهقي، فريد خراسان المتوفي سنة 565هـ في شرحه نهج البلاغة الذي سمّاه “معارج نهج البلاغة، في الصفحة 3، حيث يقول: “هذا الكتاب النفيس مملوء من ألفاظ يتهذب بها المتكلم ويتدرب بها المتعلم فيه من القول أحسنه، ومن المعاني أرصنه، كلام أحلى من نغم القيان، وأبهى من نعم الجنان، كلام مطلعه كهيئة البدر، ومشرعه مورد أهل الفضل، وكلامه كلام يجري مجرى السحر الحلال، ويرتفع درجته عن نعوت الكمال، كأنه اليواقيت في النّظام، أو مواقيت الأعياد والأيام…”. وقال قطب الدّين الراوندي المتوفي سنة 573هـ في أول شرحه على نهج البلاغة والمسمى “منهاج البراعة” في الجزء الأول الصفحة الرابعة: “وهو كلام عند أهل الفطنة والنظر دون كلام الله ورسوله وفوق كلام البشر، واضحه مناره، مشرقة آثاره”. وفي الحقيقة لا يتسع المقام لذكر جزء ولو يسير مما ذُكر من قِبَل أعلام الفكر واللّغة في القديم والحديث حول كتاب أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى جانب هذا التراث الكبير بقيمته العلمية واللّغويّة ترك لنا أهل بيت النبي (ص) من أبناء علي عليه السلام تراثًا فكريًا وأدبيًا ولغويًا لا يقل قيمةً من الذي خلّفه علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد تميزت كلماتهم بالمستوى الرفيع من البلاغة والتعبير الفصيح وسعة الدّلالة وشمولية الفكرة.
ومن هذه الأجواء التي ذكرنا حول كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأبنائه تولدت فكرة قداسة كلماتهم والتي اثرت في فكرة تقديس العربيّة. وفي حقيقة الموقف فإن الإمامية أو ما يعرف بالمذهب الجعفري في الإسلام، أي أتباع أمير المؤمنين وأبنائه قالوا بعصمة الإمام علي وأبنائه الذين سماهم رسول الله (ص)، فصارت بذلك كلماتهم وأفعالهم صادرة عن معصوم قولهم فتنزّل قول رسول الله (ص)، وتجدر الإشارة إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصف نفسه وأهل بيته في قولٍ شهير يتعلق بفصاحتهم وبلاغتهم فيقول: “ألا إنّا أمراء الكلام، منا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه”([37])، ويحمل الحديث إشارة من قِبل الإمام علي عليه السلام إلى أنه وأهل بيته أمراء الكلام أي أمراء العربيّة؛ بل إن أصوات هذه اللّغة عائدة لهم هم فمنهم تنشبت عروقه وعليهم تهدلت غصونه فهم شجرة هذه اللّغة وفروعها وأصولها.
إنّ الذي ذكرناه في لحاظ القرآن الكريم يجري على الحديث النّبويّ الشريف وأحاديث أهل بيته من علي وأبنائه لنقرر أن القداسة في لحاظ المرسِل وليس في لحاظ المرسلة ذاتًا وإن قبلنا – وبالطبع نقبل- بقداسة النّص القرآني فإننا لم نسرِّ تلك القداسة من النّص القرآني إلى سائر اللّغة العربيّة، وكذلك الحال فإننا إن قبلنا بقداسة مضامين الحديث النّبويّ الشريف وقداسة أحاديث العترة الطاهرة، فإننا لا نستطيع أيضًا أن نسرِّي قداسة نص الحديث النّبويّ وحديث أهل البيت إلى سائر اللّغة العربيّة، وهذا خلاف أدنى قواعد وأصول المنطق والعقل، وهذا أيضًا ما لم يقل به النبي ولا أهل بيته في حال من الأحوال.
بعد هذا العرض لواقع حال اللّغة في القرآن الكريم، ولواقعه حيال الحديث النّبويّ الشريف وحديث أهل بيته ينبغي الالتفات إلى نوع آخر من القداسة التي ادعاها البعض من أهل العربيّة في جزء من التراث اللّغويّ في العربيّة، وهو أشبه ما يكون بدعوى باطلة.
- الدرس اللّغويّ وبداياته
مارس العرب لغتهم، واستخدموها في التواصل فيما بينهم وكتبوا بواسطتها أشعارهم وأتقنوها إتقانًا بالغًا، إلاّ أنهم لم يقعِّدوها ولم يؤسسوا قبل الإسلام لمثل هذا لا بالقليل ولا بالكثير، ولم يعرف العرب قبل الإسلام أي بحث لغوي يذكر، وهم كسواهم من الأمم لم يكن البحث اللّغويّ لديهم إلا خدمة للكتب الدّينيّة وكتب الشريعة، وذلك من أجل تفسيرها وفهم معانيها، ورغم تأخر الدرس اللّغويّ عند العرب إلى القرن الثاني للهجرة، إلا أنّ العلماء العرب قد أتقنوا الدرس اللّغويّ، فجاءت بحوثهم شبه كاملة وشبه شاملة لكل علوم اللّغة العربيّة من نحو وصرف ومعاجم ودراسة أصوات، وينبغي التنبه إلى حقيقة واضحة ترتبط بنزول القرآن الكريم، وهي أن نزول القرآن الكريم كان الحافز الأول الكامن وراء قيامة الدرس اللّغويّ عند العرب، والسبب في ذلك يرجع إلى أن القرآن نزل باللّغة العربيّة بالدرجة الأولى، وأنّ الدرس اللّغويّ بات ضرورة ملحّة في الواقع العربيّ الجديد، حيث توقفت جميع الأحكام الفقهية، والعقائد، والأحكام، والموضوعات على فهم النّص القرآني وتفسيره، ويمر فهم النّص القرآني عبر بداية اللّغة العربيّة وأحكامها، فبالتالي كان الدرس اللّغويّ حاجة ماسة لا بد منها لضبط قواعدها ولحفظ ألفاظها منعًا لوقوع التحريف في نص القرآن إملاءً ودلاليًا من جهة، ومن جهة أخرى تمهيدًا لفهمه ووضع اليد علي الصحيح بالحكم. وقد حضر اللّغويّون العرب مصادرهم التي استقوا منها مادتهم وأسسوا عليها قواعدهم في خمسة مصادر:
- القرآن الكريم.
- القراءات القرآنية.
- الحديث النّبويّ الشريف.
- الشّعر العربيّ – الجاهلي.
- الشواهد النثرية.
وبعد أن دوّن العرب الحديث النّبويّ وألّفوا في الفقه الإسلاميّ والتفسير القرآني اتجه العلماء العرب إلى تسجيل العلوم غير الشرعية كالنحو واللّغة و”إن لم تقصد لذاتها بل خدمة للنص الدّينيّ”([38]). وكان أول ما انصبت عليه عناية العرب، فقه الألفاظ أو معانيها في تقلبات سياقاتها ولهذا كان أوّل ما صنفه العرب من مصنفات كان في شرح غريب ألفاظ القرآن الكريم ومنها كتاب الراغب الأصفهاني في شرح غريب مفردات القرآن([39]). وكان ذلك مؤسسًا على اعتقاد مبدئي عند العرب أن تفسير القرآن يستند إلى فهم دقيق لألفاظه، ومن ثم وضع العرب أوّل معجم على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي، المعروف بكتاب العين، حيث يبدأ الفراهيدي كتابه بحرف العين، وقد جمع فيه معظم ألفاظ العربيّة في تاريخه([40]). وهكذا جرى النشاط اللّغويّ العربيّ للأئمة العربيّة، وتوالت المؤلفات وراحت تتطور شيئًا فشيئًا حتى ظهرت العديد من المصنفات في اللّغة والنحو والبلاغة، وكانت عناية العرب بعد مصنفات الألفاظ منصبة على النحو فكان أول من كتب في النحو، وكان له نشاطٌ نحوي دقيق هو أبو الأسود الدؤلي تلميذ علي بن أبي طالب “ع” الذي قرأ عليه القرآن وكان الدؤلي يحركه ويصححه بين يديه، فكان هذا النشاط أول نشاط نحوي بعد نزول القرآن، وكان في عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعد ذلك أخذ عن الدؤلي من ذلك العلم جماعة آخرون منهم:
- ميمون الأقرن.
- أبو عمرو بن العلاء.
- الخليل بن أحمد الفراهيدي.
- سيبويه.
- الكسائي.
ثم انقسم علماء اللّغة والنحو بعد ذلك فريقين، واحدٌ في الكوفة، وآخر في البصرة، حيث كانت البصرة والكوفة منابع الثّقافة واللّغة العربيّة وما زال الناس يتداولون ويتناقلون أخبار النحو عن هاتين المدرستين إلى يومنا هذا. ولا نريد هنا أن نستطيل البحث والعرض في حركة تطور الدرس اللّغويّ منذ بداياته إلى يومنا هذا، إلا أنّ الحقيقة باتت واضحة بأن الدرس اللّغويّ في العربيّة بدأ بعد نزول القرآن الكريم، وقد نشأ على خلفية دينية مؤسسة على القرآن الكريم وعلى الحديث النّبويّ الشريف، وتستعين بالشواهد الشّعرية من الجاهليّة. وفيما يلي نعرض لبعض المصنفات والكتب التي وضعها العرب واكتسبت فيما بعد قداسة محددة وبنسب مختلفة، وتجديد الإشارة أيضًا إلى انتشار بعض المصنفات الخاصة بتفسير القرآن الكريم، وكتب وطبقات الرجال والشّعراء وغيرهم.
تحولت الكثير من المصنفات اللّغويّة ودواوين بعض الشّعراء إلى نقطة جذب للقراء واكتسبت قداسة مفتعلة غير حقيقية، ونحن إذ نضع بعضًا من هذه المصنفات تحت مجهر النقد فإننا لا نريد التقليل من قيمتها، ولا من قيمة الجهود المبذولة في وضعها أو من قيمتها العلمية ولن نراعي الترتيب التاريخي في ذلك.
أولًا: كتاب الخصائص لابن جني
يعتبر كتاب الخصائص أحد أشهر الكتب التي كتبت في فقه اللّغة وفلسفتها، وأسرار العربيّة ووقائعها، وقد وضع هذا المصنف وذكر في مقدمته “كتاب لم أزل على خارطة الحال، وتقادم الوقت، ملاحظًا له، عاكف الفكر عليه منجذب الرأي والروية إليه-” ويناقش ابن جني في هذا الكتاب بنية اللّغة وفقهها، وأصولها، ويبدأ الكتاب بباب في مناقشة إلهامية اللّغة واصطلاحيتها، وعرض لأصول اللّغة من قياس، واستحسان، وعلل وحقيقة ومجاز، وتقديم وتأطير، وسواه، وقد طبع الكتاب كاملًا محققًا على يد محمّد علي النجار عام 1955. ونحن لا نريد هنا أن نناقش ابن جني في بعض القضايا والآراء التي لا نعتبرها دقيقة بالمعنى الكامل والتام، إنما المشكلات في من يقدِّس كتاب الخصائص لمجرد أنه كتاب لغوي قديم وآراؤه صحيحة وتامة ومن غير الممكن مناقشتها، وبالطبع عندما كتب ابن جنّي كتابه لم يدّع قداسة لكتابه أو عصمة، وقد ناقش كثيرون من أهل اللّغة في العصر الحديث بعض آراء ابن جني التي كانت موضع نقد قاسٍ([41])، ومن هذه الآراء النقدية ما هو مصيب جدًا. ومن غريب ما نواجهه في بعض المؤلفات اللّغويّة الحديثة وبعض أطاريح ورسائلهم في الجامعات أنه الطالب يأخذ من هذا المصدر وسواه دون أدنى مناقشة، وذلك خوفًا منه من أن يكون قد تجرّأ على علم كبير كإبن جني، أو سواه وهذا الأمر ينسحب على الكثير من المؤلفات في اللّغة، والتفسير، وسائر العلوم اللّغويّة.
لقد أحاط جمهور العربيّة ومثقّفوها والمختصون بها ابن جنِّي بنوع من القداسة وأحاطوه بالكثير من التبجيل والتقدير، وتمنّع أهل اللّغة عن أيّ دراسة نقدية تضع ابن جني في ميزان النقد الموضوعي الدقيق، وتعطيه حقّه الحقيقي وتزيل عنه هالة القداسة المزعومة، والتي لم يدّعِ ابن جني بذاته هذه القداسة.
ثانيًا: عبد القاهر الجرجاني
هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني (400 – 471هـ) نحوي ومتكلم، ولد في جرجان لأسرة فقيرة الحال، وكان ولوعًا بالعلم، شغوفًا به، محبًا للثقافة مقبلًا على اللّغة، وقد قيل فيه أنّه معجزة عصره، وفريد دهره، ومؤسس علم البلاغة، وقيل فيه أنّه أحدث نقلة نوعية في فهم إعجاز القرآن الكريم حين جاء بنظرية النظم. ومجددًا نؤكد على عظيم الجهد الذي بذله الجرجاني في محاولة استيعاب بلاغة القرآن الكريم، وما أنجزه في هذا المضمار ليس بالشيء السهل، لكن هل حقيقة لا تشوب مؤلفات عبد القاهر الجرجاني شائبة حتى يمنح هذه العظمة وهذه القداسة المنقطعة النظير؟
لا ننكر أن الأمة كانت مولعة ولعًا شديدًا بكثرة التأليف، لكن على ضعف النظر والتدقيق فيما ألّف وكتب، ولو أمعن النظر في جميع ما صنّف من مؤلفات في اللّغة وسواها لوجدنا الكثير من الوهن والاضطراب في تلك المصنفات، ومما يؤخذ على عبد القاهر الجرجاني ما يلي:
- عرّف عبد القاهر الجرجاني المجاز تعريفًا تفسيريًا فقال “المجاز مفصل من جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاه وإذا عُدِّل باللفظ عما يوحيه أصل اللّغة وصف بأنه مجازٌ على معنى أنهم جاوزوا به موضعه الأصلي أو جاز مكانه الذي وضع فيه أولًا”([42]). وحسب ما يظهر من هذا الكلام أن المعنى واحدٌ في كلا التعريفين، فسواء كان اللفظ عنده معنىً أصلي واستعمل لغير هذا المعنى للتمثيل أو للتشابه أو للاستعارة أو للكناية فهو مجاز. “ونلاحظ في هذا تناقضًا شديدًا ما بين التعريف وما بين الواقع العملي، إذ لا تجد أحدًا منهم وضع اللفظ (الواحد) معنى أصليًا بل أن اللفظ عندهم له عمليًا معانٍ متعددة ولكن حينما يبحثون عن (مجازات) يجعلون المعنى اصطلاحًا أصلًا، والأمر الأكثر سوءًا هو أنهم خالفوا التعريف في جميع (المجازات المزعومة). فحينما جعلوا المعنى الاصطلاحي هو الأصل قاسوا عليه، فما خالفه صار مجازًا وما طابقه صار هو الحقيقي بينما المعنى الاصطلاحي وفق التعريف هو أول المجازات”([43]). ولكي تكون الفكرة التي نطرحها واضحة نقدِّم بعض النماذج التي توضح فكرة المجاز والإشكال على ما أسس له عبد القاهر الجرجاني.
يقول الزمخشري في كتابه الكشاف حول الآية الكريمة: ﴿ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ١٩﴾([44]). “والمعنى أنّهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به حقيقةً([45])، وهذا يعني أنّ لفظ “محيط” عنده مجاز لأنه لم يستعمل وفق الأصل، وهنا نسأله ما هو الأصل؟ وبالطبع فالأصل عنده هو الإحاطة المكانية ذات الأبعاد المادية أو كما عبّر عنه البعض إحاطة السوار بالمعصم([46])، في حين يكتشف أيّ إنسان لهما كانت معرفته محدودة في اللّغة أنّ الإحاطة في الأصل هي أبعد من هذا بكثير وهي معنى عام يتضمن الاحتواء والسيطرة. في حين أن الإحاطة المادية هي وضع اصطلاحي بسيط وجزء من المعنى الأوسع. ولذلك نسوا قوله تعالى على لسان الهدهد مخاطبًا النبي سليمان عليه السلام: ﴿فَمَكَثَ غَيۡرَ بَعِيدٖ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِۦ وَجِئۡتُكَ مِن سَبَإِۭ بِنَبَإٖ يَقِينٍ ٢٢﴾([47]). ناهيك عن عدد كبير من الآيات التي يستعمل يها لفظ محيط أو يحيط.. أو أحيط بالمعنى الإصطلاحي الحقيقي العام أي الإحاطة المعنوية.
مثال آخر في التشبيه والبلاغة:
يشير الجرجاني في لحاظ الآية المباركة: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوۡرَىٰةَ ثُمَّ لَمۡ يَحۡمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلۡحِمَارِ يَحۡمِلُ أَسۡفَارَۢاۚ بِئۡسَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥﴾([48]). إلى حقيقة رآها هو فقال: “إن التشبيه في الآية لا ينصرف إلى (الحمل) بل القصد ما يوجبه تعدي الحمل إلى الأسفار مع اقتران الجهل بها”([49]) ثم قال: “فإن قلت ففي اليهود شبه من الحمل من حيث هو حمل على أي حال وذلك أنّ الحامل للشيء بقلبه يشبه الحامل للشيء على ظهره، ومن يقال حملة الحديث وحملة العلم، فالجواب أن الأمر وإن كان كذلك فإنّ هذا الشبه لم يقصد هنا وإنما قصد ما يوحيه تعدي الحمل إلى الأسفار مع اقتران الجهل به، ومثل قولك لرجل يحمل في كمه دفاتر علم وهو بليد ولا يفهم: إن كان يحمل كتب العلم فالحمار أيضًا قد يحمل، تريد أن تبطل دعواه أن له في حمله فائدة”([50]).
“وبالتالي فقد ظن الجرجاني أن التشبيه بين اليهود والحمار!” ([51]). وهذا أمرٌ محال لأنّ الله أجلّ وأعزّ وأبعد من أن يعقد مقارنة مباشرة بين الإنسان والحيوان. والشبه في الآية معقود بين “المثلُ” الأول (حملوا التوراة) ونحن لا ندري ما يكون مثلهم، والمثلُ الثاني وهو الحمار ونحن لا ندري أيضًا ما يكون، وفي النهاية فإن القرينة بين شيئين لا نعرف ما هما وفي دراسة ورأي الجرجاني في الآية نظر وتأمل لا يخلو من إشكال، وحقيقة الواقع فإن هذا البحث لا يتسع لإدراج جميع ما يرد على الجرجاني من ملاحظات علمية دقيقة وهي تحتاج إلى كتاب كبير مستقل بذاته؛ لكننا لا نجد مبررًا بالمطلق لتقديس الناس للجرجاني ولكتبه، ولا مبرر لاعتبار آرائه قطعية ولا يشوبها شائبة. ومن الممكن لأي راغب في التزود بمثل هذه الردود المنطقية على إشكالات الجرجاني أن يرجع إلى كتابي عالم سبيط النبلي: “الحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية” وكتاب “النّظام القرآني”، ومهما يكن من حال فإننا لا نستطيع أن ننكر على الرجل جهوده التي بذلها في دراسة اللّغة مهما شابه من وهن.
ثالثًا: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ت 502هـ) ([52])
مثّل كتاب الراغب الأصفهاني في شرح غريب ألفاظ القرآن الكريم قاعدةً ومنطلقًا لمعظم المفسرين من الأقدمين ومن العصور اللاحقة القريبة، واعتمدوا عليه في فكّ رموز العديد من الآيات في القرآن الكريم لكن المتتبع والمتصفح في الكتاب يرى بوضوح مدى الاضطراب البالغ الذي يعاني منه الكتاب في منهجيته وفيما يقدِّمه من تقلبات للمعاني في لحاظ ألفاظها وفيما يلي تعرض لتلك النماذج اللفظية التي وقع فيها الراغب في كتابه ولم يصب فيها شيئًا من الصواب، ولم يراع خلالها أدنى قواعد السياق اللّغويّ ومنها:
الوضع، وضع:
يشير الراغب الأصفهني في كتابه المفردات في غريب القرآن في متن الصفحة خمسمائة وخمس وعشرين (525)، في شرح مادة “وضع” وتقلباتها فيقول: “قال تعالى: ﴿وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ١٠﴾([53]). فهذا الوضع عبارة عن الخلق والإيجاد، ووضعت المرأة الحمل وضعًا، قال: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ ٣٦﴾([54]).
نلاحظ فيما قدّمنا من كتاب الرغب في شرحه لمادة وضع في قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، أنه يقول: (فهذا الوضع عبارة عن الإيجاد والخلق) ومستلهمًا هذا المعنى من قوله تعالى: (فلما وضعتها قالت ربِّ إني وضعتها أنثى) والوضع في سياق الآية إشارة إلى الولادة بسياق قوله (إني وضعتها أنثى) فعندما علمت أنها أنثى وليس ذكرًا، فهذا يعني أنها كانت قد ولدتها ورأتها ونظرت إليها فوجدتها أنثى، ما يدل دلالة قطعية على أن الوضع هو الولادة، وأما الخلق فهو من أفعال الخالق جلّ وعلا ولا سواه يخلق، فكيف يربط بين (والأرض وضعها) و(إني وضعتها) فيقول (والأرض وضعها) بمعنى الإيجاد والخلق، في حين أن الله تعالى خلق الأرض من قبل، ولما يقول تعالى: (وضعها للأنام) فإنه يمعنى كيَّفها وجعلها ملائمة للخلقة الإنسانية وضعية هذه الخلقة، وكثرهم المفسرون الذين أخذوا عن الراغب فسقطوا بما سقط.
- أعلام مقدّسون
كما في الدرس اللّغويّ، وفي العديد من المصنفات اللّغويّة، كذلك حصل في لحاظ عدد كبير من الشّعراء العرب الذين قدّست أشعارهم لتفوقهم الشّعري ولغتهم الشّعرية ومن الأمثلة على ذلك:
- أبو الطيّب المتنبي:
لا ينكر أحد على المتنبي شاعريته الفذّة، وتجربته الشّعرية التي تضرب عمقًا في تاريخ اللّغة العربيّة، ولا نفكر أنه جزء عظيم من تراث العرب الشّعري واللّغويّ، حتى أننا نعترف بصراحه بالغة أنه عالم عصره ومنافس شعراء مرّوا من قبل ومن بعد، وكان ديوانه ولا يزال مرجعًا وشاهدًا لغويًا، من أغنى دواوين العرب، وهو سجلّ ثقافي وحضاري يزخر بالحكمة، والبلاغة، ويعتبر ديوان المتنبي شاهدًا حضاريًا وثقافيًا على عصره، وهو ديوان عمل المتنبي على تنقيحه ومراجعته، كما وعرضه على ابن جنّي في زمانه؛ لكننا لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بتقديس المتنبي أو بتقديس شعره، فلا المتنبي مقدّس، ولا ما جاء به مقدّس، ولا ننسى أبدًا أن المتنبي كان من طلاب السلطة، والإمارة وظلّ يلح على سيف الدولة في أن يولّيه إمارةً؛ لكن سيف الدولة ظل يؤجّله ولا يستجيب له حتى أوقع الوشاة بينه وسيف الدولة، فتركه وقصد كافور الإخشيدي حاكم مصر، الذي استهل علاقته به بقصيدة امتدحه بها يُحدّث من عيون ديوانه، وعندما لم يستجب كافور للمتنبي، ولم يولِّه إمارة هجاه ونكّل به في قصيدة متميّزة، هي أيضًا من عيون الشّعر العربيّ مطلعها:
عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد
ولو لم يستطع أن يرشي السجان ويخرج من سجنه لظلّ سجينًا بين يدي كافور إلى أن يموت، هذا من جهة شخصيته، ومن جهة شعره وديوانه لم يخل ديوانه من اضطرابات لغوية وموسيقية، فمن أين نأتي القداسة للأشخاص ولأشعارهم وآثارهم ونعلم ما مدى ما حققه المتنبي من قداسة بسبب ضآلة ثقافة الناس وافتقادها لروح النقد وللموضعية في التعاطي مع نتاجات الأمة الفكرية والثّقافيّة والأدبية في وقت لا يمكن لنا أن نغفل عن حق هؤلاء الشّعراء والأدباء بحسن التقدير وكبر الاحترام لعظيم ما أنجزوه، وحفظوه من تراث لغوي وفني، إلاّ انّ التقدير والاحترام، والتبجيل شيء، ومنح القداسة والتقديس شيء آخر. ولا نريد أن نسترسل في ذكر شعراء وأدباء قدّسهم التاريخ من أمثال المتنبي، كأبي تمام، والبحتري، وأبي نؤاس، والجاحظ وسواهم كثر من الذي نال تراثهم مرتبة القداسة، والقداسة والمقدّس منصرفان عن هكذا مقام.
وفي هذا المقام فإننا نحمل المسؤولية في ذلك لأهل المعرفة والعلم، وأصحاب النظر النافذ في النقد والمعرفة، وما ينبغي القيام به، إعادة النظر بكامل هذا التراث وبشكل كلِّي، والتدقيق في قراءته ونخص بالذكر تراثنا اللّغويّ والفكري وجميع كتب تفسير القرآن الكريم إذ في هذا التراث ما فيه من وهن ودسّ، ومغالطات، وما لا يليق بالمؤلف ولا يليق بالأمة، وكلّ ما ينقصنا الشجاعة وإسقاط هالة التقديس عن هذا التراث الذي لا زال يعتبر إرثًا ثقافيًا، ومعرفيًا، وعلميًا، وحافظًا، ومخزونًا لغويًا كبيرًا يعتدّ به، ونرى أنّه ليس من سبيل للاستمرار في هذا الإهمال في ترك هذا التراث الكبير مهملًا من ناحية نقدية تصوبه من زمان إلى زمان، وتحفظه من أن يقع فريسة نقّاد لا يرحمونه ذات يوم، فيسقطون منه ويسقطونه، لا سيما أجيالنا تنحو منحىً عقليًا، ووعيًا شديدًا، ومن غير الممكن الاستمرار “بأكذوبة المقدّس” على أنّه مقدّس في التاريخ ومن الماضي ولا يمكن المساس به، أو توجيه أدنى ملاحظة له، ويجب أن تطال هذه العملية جميع التراث الفكري والثقافي والدّينيّ والعلمي من:
- كتب التفسير المتخصصة بالقرآن الكريم.
- كتب الحديث وسائر العلوم المتعلقة به (علم الرجال).
- كتب اللّغة، صرف، ونحو، وبلاغة، وفقه.
- كتب الأدب والتاريخ.
ولا نعتقد أن الأمر بهذه السهولة؛ بل يحتاج إلى جهد حثيث وكبير، ونشاط جماعي مؤسساتي، وليس على مستوى الأفراد، والأهم من هذا كله الانفتاح العقلي لدى الجميع الذي يمكن أن يُحدث تحوّلًا وتغييرًا حقيقيًا في ثقافة الأمة حيث لا بدّ من إعادة النظر في كلِّ شيء. والأهم من كلّ شيء إعادة النظر بالدرس اللّغويّ والمصنفات اللّغويّة، حيث تأسست على تلك المغالطات اللّغويّة جميع اضطرابات الثّقافة اللّغويّة من بعدها، والتي طاولت كتب ومصنفات تفسير القرآن الكريم، “والتي أحدثت خللًا واضحًا على مستوى فهم النّص القرآني وتفسير آياته الكريمة”([55]). وما تأكيدنا على المصنفات اللّغويّة: “إلا من هذا الباب حيث أخذت مباحث الألفاظ حيزًا كبيرًا في اللّغة وكانت تفرعاتها مشتركة بين علم الكلام من جهة، وأصول الفقه من جهة أخرى، واستعملت على نطاق واسع في التفسير سواءً كان للنص القرآني أو غيره، كشرح الحديث ودراسة متون المرويات ونصوص الصحابة ونصوص وخطب الأئمة عليهم السلام، كشروح نهج البلاغة وغيرها. وقد استعمِلت على نطاق أضيق وبمصطلحات مختلفة في علم البيان أو البلاغة”([56]).
خلاصة البحث
طرحنا في بحثنا هذا قضية المقدّس اللّغويّ، وقد توخّينا الدقة فيما تقصينا، والموضوعية، وفيما يلي نلخص أبرز ما توصل له بحثنا من نتائج:
أولًا: إن إشكالية المقدّس اللّغويّ حقيقة ثابتة وموجودة ولا يمكن إنكارها وقد ذهب إليها الكثيرون ممن اشتغلوا في اللّغة.
ثانيًا: نشأت فكرة تقديس اللّغة العربيّة من مبعثين رئيسيين، القرآن الكريم والحديث النّبويّ بشقّيه “الشريف والمقدّس” بالإضافة إلى نصوص عترة آل بيت رسول الله (ع).
ثالثًا: رغم اعترافنا المؤكّد بقداسة القرآن الكريم، ومضامينه، وآياته؛ إلا أننا لا نعتقد بسريان هذه القداسة إلى اللّغة العربيّة ذاتها، واعتبرنا القول بذلك مصادرة، وتبرع، وخارج أطر المنطق العلمي.
رابعًا: ما قررناه بخصوص عدم سريان القداسة من النّص القرآني إلى سائر اللّغة نؤكده على مستوى الحديث النّبويّ بشقيه “الشريف والقدسيّ”.
خامسًا: إنّ القداسة والمقدّس إنما صادر عن ذات مقدّسة، وعظمة النّص إنّما ناجمة من نظم اللّغة.
سادسًا: حاولت الأمة أن تضفي القداسة على سائر الذات العربيّ من مصنفات عديدة في التفسير وعلوم الكلام واللّغة، وقد قدّسنا نماذج دقيقة تدل على عدم إمكانية قبول الفكرة، وما رفضناه في لحاظ النّص الدّينيّ من غير الممكن أن نقبل به في لحاظ غير الدّينيّ.
سابعًا: يوحي البحث بإعادة النظر بالتراث العربيّ كله وخاصة التأثر اللّغويّ لما يؤثر في سائر المصنفات الدّينيّة، وتفسير القرآن وما شابه.
ثبت بالمصادر والمراجع
القرآن الكريم.
- ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. بيروت، دار المفيد.
- ابن جنِّي، الخصائص، تحقيق عبد الحميد هنداية، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، دار النوادر.
- الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد. المفدرات في غريب القرآن (ت 502هـ)، بيروت، دار المعرفة.
- الجابري، عبد الستار محمد علي. أساسيات الدرس اللّغويّ عند العرب، قم، مؤسسة أهل البيت، ط1، 1980.
- الجبوري، محمود كامل. تاريخ الخط العربيّ، بغداد، دار التراث.
- الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة، بيروت، دار المفيد.
- جوني، حسن جميل. القرآن بين العربيّة والعربيّة، بيروت، دار المرتضى، ط1، سنة 2016م، 1437هـ.
- حسني، ماجد عبد الإله. الأصول الثابتة، دار المرتضى.
- الخوئي، السيد أبو القاسم مباني منهاج الصالحين. دار المفيد.
- الزبيدي، محمد مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط1، سنة 1306هـ.
- الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد. تفسير الكشاف، بيروت، دار المرتضى.
- سليماني، حسين عابد. تاريخ القرآن الكريم، الإمساء، مكتبة الرسول الأعظم، لا ط، لا سنة، محفوظ رقم 3106.
- شداد، أيمن خالد. اللّغة العربيّة كائن حي، توافق أم تعارض، مقالة علمية منشورة في مجلة اللّغة العربيّة، العدد 316، سنة 2012، الأردن.
- صادقي، حسين آغا علي. اللّغة في خدمة الدّين، مكتبة قم المقدّسة، ترجمة حسين فيصل.
- الصغير، محمد حسين. الصورة الفنية في القرآن الكريم، دار الهلال، بغداد.
- عبد الإله، محمد صابر. أُحادية اللّغة العربيّة، بغداد، دار الشروق، 1975.
- علي بن أبي طالب “ع”، نهج البلاغة، بيروت، دار البلوغ.
- علي بن أبي طالب عليه السلام، نهج البلاغة، دار المفيد.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد. (ت 170هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية.
- المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار، دار الرسول الأعظم.
- النبلي. عالم سبيط. النّظام القرآني. دار المحجة البيضاء، ط1، سنة 2007.
- النبلي، عالم سبيط. الحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية، بيروت، دار المحجة البيضاء، ط1، سنة 2007.
(([1] أستاذ مساعد في الجامعة اللّبنانيّة الدّولية.
Assistant professor at Lebanese International University.
Email: dr.mahmoud-khalil73@outlook.com
([2]) محمّد صابر عبد الإله، أُحادية اللغة العربية، بغداد، دار الشروق، 1975، ص 30 – 34.
([3]) أبو الفتح عثمان جنِّي، الخصائص، تحقيق عبد الحميد هنداية، بيروت، دار الكتب العلمية، جزء 1، ص 33.
([4]) أيمن خالد شداد، اللغة العربية كائن حي، توافق أم تعارض، مقالة علمية منشورة في مجلة اللغة العربية، العدد 316، سنة 2012، الأردن.
([5]) محمّد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط1، سنة 1306هـ، جزء 1، ص 100.
([12]) حسن جميل جوني، القرآن بين العربية والعربية، بيروت، دار المرتضى، ط1، سنة 2016م، 1437هـ.
([13]) علي بن أبي طالب “ع”، نهج البلاغة، بيروت، دار البلوغ، ص 160.
([14]) محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، دار الرسول الأعظم، جزء 25، ص 82.
([15]) حسين علي صابر السعيدة، ربيع القلوب، بغداد، دار التراث، 1954، لا ط، لا سنة، ص 73.
([16]) محمود كامل الجبوري، تاريخ الخط العربي، بغداد، دار التراث، ص 120.
([18]) مباني منهاج الصالحين، السيد أبو القاسم الخوئي، دار المفيد، جزء 2، ص 210.
([19]) عالم سبط النيلي، النظام القرآني، بيروت، دار المحجة البيضاء، 2008، ص 48.
([20]) حسين عابد سليماني، تاريخ القرآن الكريم، الإمساء، مكتبة الرسول الأعظم، لا ط، لا سنة، محفوظ رقم 3106، ص 120.
([21]) محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، جزء 23، ص 160.
([24]) ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، دار النوادر، جزء 10، ص 63.
([26]) حسن جوني، القرآن بين العربية والعربية، ص 73.
([29]) حسن جوني، القرآن بين العربية والعربية، ص 107.
([30]) ماجد عبد الإله حسني، الأصول الثابتة، دار المرتضى، جزء 2، ص 40.
([32]) قرآن كريم، البقرة 88- 89.
([34]) ذكره الزركشي والسخاوي في المقاصد، حديث 185.
([35]) ذكره البيهقي في الشعب ورواه ابن منصور وابن أبي شيبة.
([36]) راجع شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد، بيروت، دار المفيد، جزء 1، ص 16.
([37]) علي بن أبي طالب عليه السلام، نهج البلاغة، دار المفيد، جزء 1، ص 120.
([38]) عبد الستار محمد علي الجابري، أساسيات الدرس اللغوي عند العرب، قم، المقدّمة ، مؤسسة أهل البيت، ط1، 1980، ص 138.
([39]) أبو القاسم الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني، المفدرات في غريب القرآن (ت 502هـ)، بيروت، دار المعرفة.
([40]) الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية.
([41]) راجع كتاب النظام القرآني، عالم سبيط النبلي، دار المحجة البيضاء، ط1، سنة 2007، ص 35- 40.
([42]) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، بيروت، دار المفيد، ص 365.
([43]) عالم سبيط النبلي، النظام القرآني، بيروت، دار المحجة البيضاء، ط1، سنة 2007، ص 99 – 100.
([45]) محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، تفسير الكشاف، بيروت، دار المرتضى، جزء 1، ص 385.
([46]) محمّد حسين الصغير، الصورة الفنية في القرآن الكريم، دار الهلال، بغداد، ص 63.
([49]) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 250.
([51]) عالم سبيط النبلي، الحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية، بيروت، دار المحجة البيضاء، ط1، سنة 2007، ص 279 – 280.
([52]) جميع مؤلفات هذا العالِم موجودة في دار المحجة البيضاء، بيروت.
([53]) القرآن الكريم، سورة الرحمن 10.
([54]) القرآن الكريم، سورة المائدة 36.
([55]) حسين آغا علي صادقي، اللغة في خدمة الدين، مكتبة قم المقدّسة، ترجمة حسين فيصل، ص 87.
([56]) عالم سبيط النبلي، الحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية، ص 5، المقدِّمة.
عدد الزوار:152

