تجليّات الصّراع النّفسيّ بين الانتحار والأمل في ديوان نهر الرّماد لخليل حاوي
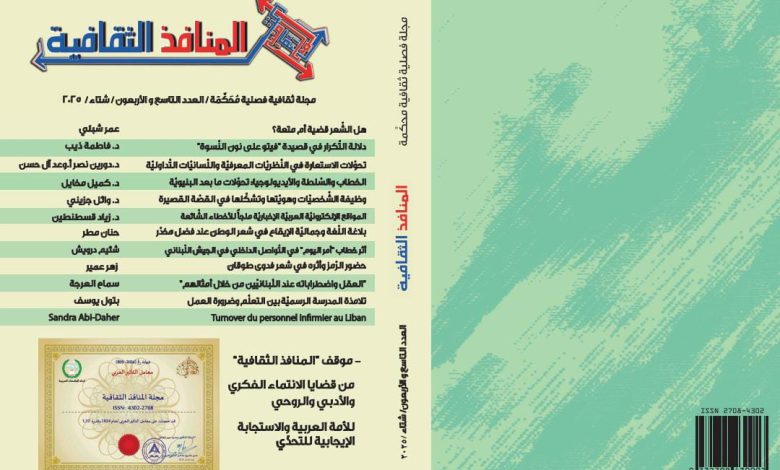
تجليّات الصّراع النّفسيّ بين الانتحار والأمل في ديوان نهر الرّماد لخليل حاوي
(قراءة أسلوبيّة نفسيّة على مستويي الدّلالة والمعجم)
Psychological Conflict Between Suicide and Hope in the Collection River of Ashes by Khalil Hawi
(A Psychological Stylistic Reading of semantics and lexicon)
نورهان قاسم غدّار[1]
Nourhan Ghaddar
تاريخ الاستلام 23/8/2024 تاريخ القبول 15/9/2024
المستخلص
ذهب أغلب النّقاد إلى أنّ خليل حاوي هو شاعر الانبعاث والإحياء، غير أنّهم لم يتطرّقوا لمسألة الصّراع النّفسيّ العميق الذي تعرّض له هذا الشّاعر، والذي تبدّى واضحًا في ديوانه نهر الرّماد. فقد كانت الدّعوة للإحياء والثّورة على الواقع مصبوغة بصبغة الموت واليأس، وبرزت الأفكار المتناقضة في هذه المدوّنة من خلال تحليل مستوى الدّلالة، المعجم، والصّورة الشّعريّة، لتوضّح بدورها أزمة المنتج النّفسيّة. اعتمد هذا البحث المقتضب المنهج الأسلوبيّ وتحديدًا الاتجاه النّفسيّ فيه، والذي يقوم على تحليل نفسيّة المنتج، ومن ثمّ تحليل آثار النّصّ في الجمهور المتلقي، من خلال ملاحظة سلوكه وردّة فعله بعد التّلقي.
الكلمات المفتاحيّة: الصّراع النّفسيّ- نهر الرّماد-مستوى الدّلالة-مستوى المعجم
Abstract
Most critics believe that Khalil Hawi is the poet of revival. However, they did not address the deep psychological conflict that this poet was subjected to, which was clearly evident in his collection River of Ashes. As we read the texts, we realize that the call for revival and revolution against reality was tinged with death and despair. Contradictory ideas in this corpus were emerged through an analysis of semantics, lexicon, and poetic imagery, which clarifies the poet’s psychological crisis. This brief research adopted the stylistic psychological approach, which is based on analyzing the psychology of the writer, and then analyzing the effects of the text on the audience, by observing their behavior and reaction after receiving.
Key words: Psychological insistence- River of ashes- Semantic level- Lexical level
المقدّمة
كثرت تعريفات الشّعر منذ القدم، وأجمع النّقاد على أنّه ظاهرة فنّيّة وجماليّة فريدة، يعبّر الشّاعر من خلالها عن مشاعره. وقد سيطرت الرّومانسيّة والفرديّة على الشّعر العربيّ ردحًا من الزّمن، غير أنّ عبور الشّعر من الرّومانسيّة إلى الواقعيّة، منحه قوّة اجتماعيّة وسياسيّة أصبح بلحاظها سلاحًا يقاتل به الشّاعر. فالشّعر الملتزم بقضيّة لسان الأمّة، وسجلّها التّاريخيّ، والحافز الذي يدفعها إلى الثّورة والتّغيير. فالشّاعر أو الأديب في هذه الحالة نبيّ، تخرج كلماته الشّعوب والأمم من الظّلمات إلى النّور، وهذا الأصل في الشّعر ووظيفته الرّئيسة التي اضطلع بها في مرحلة ما قبل الرّومانسيّة، فهذا الدّور هو ” الدّور الذي كان يقوم به الشّعر في الأطوار الأولى من الحضارة الإنسانيّة، حين كان الشّاعر نبيّ القوم وكاهنهم وساحرهم، وقائدهم السّياسيّ والاجتماعيّ” (عوض،1979،ص97). فهذا المفهوم الذي يجب أن نعقله إذا أردنا الكلام على شعر خليل حاوي بكلّ وظائفه وأبعاده، إذ إنّه لم يغرق في ذاتيّته وهمومه بمعزل عن مجتمعه، بل “تحوّل -هذا- الشّاعر الحديث إلى شاعر الرّؤى الحضاريّة، وامتدّت مسافة المعاناة والعذاب والتّموّج الدّاخليّ والحنين ضمن التّجربة الشّعريّة الذّاتيّة الواحدة المتوحّدة ” (ميخائيل، 1968،ص38). وهذا يعني أنّ التّجربة العامّة انصهرت في تجربة الشّاعر الذّاتيّة الشّعوريّة، واتّحد بها حدّ الفناء والموت لأجلها.
رأى الكثير من النّقاد أن حاوي هو شاعر البعث والإحياء في الموروث الشّعريّ العربيّ الحديث، ذلك لأنّ “غاية الشّعر عنده غاية حضاريّة، بمعنى أنّ القصيدة تلتزم بمواجهة ما في الأعماق من تردٍ وانكفاء، لتحيلها إلى أعماق دافقة عاصفة، تعيد بعث حضارة إنسانها العربيّ من خلال اقتناعها برؤيا الانبعاث التي يحملها الشّاعر” (علي،1995،ص22). غير أنّهم أغفلوا أزمة الصّراع النّفسيّ الواضحة في شعره حتّى عندما كان متفائلًا، يدعو للثّورة والانبعاث والتّغيير. فالمتأمّل في ديوان نهر الرّماد يقف على تأرجح الشّاعر النّفسيّ وتعرّضه للضّغط النّفسيّ الذي يعرف بأنّه “ردّ فعل لا نوعي لجسم ما على تأثير بيئيّ” (ستورا،1997،ص10). أي أزمة نفسيّة ناتجة عن صراع سببته البيئة أو المجتمع المحيط. وإذا عدنا إلى ما ذهب إليه معظم الدّراسين والنّقاد، من انصهار حاوي في الأزمة الحضاريّة ومعاناته وألمه بسببها، نجد أنّ هذا الصّراع نتاج طبيعيّ لما يعيشه شاعر الأمّة.
المنهج
إنّ الوقوف على الصّراع النّفسيّ الدّاخليّ للشاعر واستجابة الشّعب أمرٌ تسعى إليه هذه الدّراسة المقتضبة من خلال المنهج الأسلوبيّ النّفسيّ الذي أسّسه عالم اللّغة والنّفس ليو سبيتزر (1960-1887)[2] وذلك بتطبيق المنهج الذي يسمح “باكتشاف الواقع النّفسيّ للشاعر، ثمّ السّعي إلى إدراك روح الجماعة” (عزّام،1989،ص102)، من خلال التّحليل اللّغويّ النّفسيّ لبنى النّصّ “فالفهم الصحيح للبنية هو الذي يقيم توحّدًا بين الذّات والموضوع، وبين المنتج والخاصيّة الأسلوبيّة”(صمود،2018،صص114). فالشّاعر هنا لا يعكس تجربة ذاتيّة خاصّة، بل يتمثّل تجربة أمّة بأكملها من خلال اللّغة. وهنا تكمن الجدّة، إذ إنّ غير ناقد ودارس تناول خليل حاوي ودواوينه، غير أنّهم لم يذكروا ما تعرّض له هذا الشّاعر من صراع نفسيّ خاص، ناتج عن الصّراع النّفسيّ العام الذي يتعرّض له الشّعب، وتأثير صدمة انتحار الشّاعر فيه. فهذه الدّراسة تهتمّ بما يعرف التّفسير النّفس جماعيّ فضلًا عن التّفسير النّفسيّ الفرديّ.
الإشكاليّة
كيف برز الصّراع النّفسيّ عند خليل حاوي في ديوان نهر الرّماد؟ أو بعبارة أخرى كيف أخبرنا أنّه سينتحر قبل أن يفعلها؟ وإلى أي مدى استجاب وتفاعل الشّعب مع قضيّة الشّاعر وما هي ردّة فعله؟
أوّلًا: الإيحاءات النّفسيّة للعتبة النّصيّة: نهر الرّماد
يعدّ هذا العنوان رمزًا أو شيفرة لغويّة قائمة بحدّ ذاتها، فالرّمز من أهمّ تقنيّات الشّعر وتشكيل الصّورة. فهو ما يتيح لنا “أن نتأمّل شيئًا آخر وراء النّصّ، فهو معنى خفيّ وإيحاء إنّه اللّغة التي تبدأ حين تنتهي لغة النّصّ، أو القصيدة التي تتكوّن في وعيك بعد قراءة القصيدة… فهو اندفاع صوب الجوهر”(أدونيس،1978،ص160)، فالرّمز يعبّر عمّا في أعماق الشّاعر من مشاعر، هواجس، مخاوف… فهو يأتي من الأعماق، ويصل إلى الأعماق، أي إنّه يأخذ حيّزًا مهمًّا في إيصال الدّلالة الفكريّة والنّفسيّة للمتلقي في العمليّة التّواصليّة.
جاء في لسان العرب “النّهر من مجاري المياه والجمع أنهار ونُهرٌ ونهور، ونهر الماء إذا جرى في الأرض وجعل لنفسه نهرًا…”(ابن منظور،1988،مادّة نّهّرّ). والنّهر “رمز الارتواء والنّمو في الطّبيعة، لأنّ مياهه صالحة للشرب، ودائمًا تكون الحياة مزدهرة جنب النّهر، فهو بمنزلة الشّريان الذي يجري في جسد الطّبيعة ليبعث فيها الرّوح والألق والحياة” (البريكي،2019،ص103). ولكن هل حمل النّهر في هذا العنوان طاقة نفسيّة إيجابيّة تدلّل على الحياة والأمل؟
لغويًا العنوان مبتدأ (نهر) ومضاف إليه (الرّماد)، ولا نعلم ما بال هذا النّهر إذ لا يظهر الخبر واضحًا. فنهر الرّماد يبقى عنوانًا غامضًا للوهلة الأولى، فهل نهر الرّماد يجري أم ينضب ويموت؟! إذا تعمقنا في كلمة نهر، نرى أنّه يجمع كميّة كبيرة من الماء ثمّ يصبّ في البحر، فالرّحلة الطّويلة التي يجتازها النّهر تنتهي بالموت عند البحر حيث يختفي النّهر وتمتزج مياهه بمياه البحر، فتفقد حلاوتها وبرودتها، وقدرتها على منح الحياة. ويمكن قراءة النّهر على أنّه نهر دموع، غير أنّ الشّاعر أضاف الرّماد، فكيف للرّماد الخفيف الذي يتطاير مع الهواء أن يشكّل نهرًا؟
الرّماد ينتج عن الاحتراق بالنّار ويمكن القول إنّه موت الجمر، أمّا أن يتشكّل نهر من الرّماد فهو دليل على كثرة تكرّر عمليّة الاحتراق، أي تكرر الألم، المعناة، والموت كلّ يوم، ومع الأيام والسّنين ومن كثرة الاحتراق تكوّن نهر من الرّماد. إنّه نهر ثابت، جامدٌ لا حياة فيه، ولا يمنح الحياة. فالمقصود هنا من النّهر ليس الارتواء الحسيّ والرّوحيّ، بل الموت المحتّم في نهاية المسير. وكذلك فإنّ ما قصد من الرّماد، ليس التوهّج والاشتعال، بل الموت والفناء، لأنّه قال نهر الرّماد، لا نهر الجمر. من هنا يسيطر على العنوان مناخ نفسيّ قاتم، يوحي بالغموض، الألم، النّهاية، الموت…
يمكن أن تحمل كلمة مثل نهر، دلالات نفسيّة إيجابيّة بحدّ ذاتها، مثل: الحياة، النّمو، الكرم، العطاء، النّشاط… غير أنّ إضافة الرّماد إلى النّهر يجعل إمكانيّة تلقي الدّلالة السّلبيّة أكبر، فكلمة رماد لا تحمل حمولة نفسيّة إيجابيّة، نظرًا لأنّها حاصل الاحتراق. من هنا يمكن الاستدلال قبل قراءة الدّيوان على التّناقض والصّراع النّفسيّ، لأنّه استخدم لفظ مثل النّهر للدّلالة على الموت، وأضافه إلى الرّماد أيضًا. فهو من جهة يريد الحياة، ومن جهة أخرى يريد الموت، من هنا تبدو حيرته، ومأزقه النّفسيّ المتمثّل بصراع داخليّ بين الحياة والموت واضحًا من خلال العنوان.
ثانيًا: المستوى الدّلاليّ: الأبعاد النّفسيّة للحقول الدّلاليّة في توضيح أزمة الصّراع
يقصد بالمستوى الدّلاليّ دراسة الدّلالة العامّة لديوان نهر الرّماد من خلال رصد الحقول الدّلاليّة التي سيطرت عليه، والتّركيز على موضوعاتها وعلاقاتها من أجل الوقوف على الصّراع النّفسيّ الدّاخليّ عند الشاعر. وقد بدأنا التّحليل بالمستوى الدّلاليّ لأنّه الأهم في هذه الدّراسة، وتأتي المستويات اللّغويّة الأخرى لدعمه. ويتناول المستوى هذا عادةً “انتقال معاني الكلمات لتشتمل على معانٍ أبعد وأعمق أي الانزياح الدّلالي والمجاز” (Hock and Joseph,1996,p188).
الحقل الدّلاليّ “هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع تحت لفظ عام يجمعها” (عمر،1998، ص79)، لذا فموضوعات الحقول تدلّ بالضّرورة على المعاني والدّلالات المسيطرة وذلك تبعًا لاتساعها وضيقها. وعند تحليل هذا الدّيوان نرصد الحقول الآتية:
أ-حقل رفض الواقع واليأس منه: ومن الكلمات والتّعابير الدّالة عليه: الثّلج الحزين-ماتت-متنا-خفافيش-براكين الجحيم-أحرق القرية-نحن عواميد ملح مسوخ من بلاهات السّنين-الموت-سرب غربان-جنازة مرسومة على الجدار-جنازة خرساء لا تنوح-ماتت عروق الأرض-طفلهم يولد خفاشًا عجوز-أكفان-الغريق-فراغ الأفق-صنمًا خلّفه الكهّان للريح-جلدًا وحرقا-وحيد-الرّماد-نادمنا الطّواغيت الكبار-اعتصرنا الخمر من جوع العذارى والتهمنا لحم أطفال صغار-عمرنا الميت-الوحش الرّهيب-نموت-سكوت-أسى الصّمت-محنة الصّلب-أعياد الطّغاة-المدى المجهول-ماتت بعيني منارات الطّريق-رعشة الموت الأكيد…
– من ضمنه الحقل الخاص بألفاظ جهنّم: سحبًا حمراء حرّى-أمطرت جمرًا وكبريتًا-وملحًا مسموم-وبراكين الجحيم-براكين-الغاز الجحيميّ-السّعير-سحب صفرا…
-من ضمنه حقل السّوداويّة والعتمة: ومن الكلمات والتّعابير الدّالة عليه: عتمات الطّريق-كهوف- ليالي الضّيق والحرمان-ليالي بيروت-زوايا اللّيل-الكهف الخراب-نعاني اللّيل-الرّؤى السّوداء-بركة سوداء يطفو في أساها-ليلة-آخر ليلة-ليل-الجروح السّود-في جوف الحوت-ليل السّجن-سواد رطب-طين عتيق-تمتصني عتمة سجني-ليالي الميتين-مطرح الشّمس رماد وسواد-الكهوف-مطرح رطب يميت الحسّ-عتمة المجهول-كان صباحًا شاحبًا أتعس من ليل حزين…
-من ضمنه الحقل الدّال على الموت: ومن الكلمات والتّعابير الدّالة عليه: وصف الدّراويش: عراة-زهد-اجتازوا الحياة-ينمو طفيليّ النّبات-طحلب-غائب عن حسّه لن يستفيق-شاع في البيت مناخ القبر-رثّت عظامي-رعشة الموت الأكيد…
يرتبط هذا الحقل (أ) نفسيًا، بالرّفض، الاستنكار، التّمرّد، والإلحاح على التّغيير… فالشّاعر لا يريد أن تعيش الأمّة الواقع المفروض عليها أيًا كان. ونلاحظ سيطرة السّوداويّة والتّشاؤم على أسلوبيّة النّصوص عند وصف الواقع. ونقصد بالسّوداويّة سيطرة الجو أو الفضاء الأسود واللّيل بشكل عام على القصائد، وحتّى عندما لا يحدّد الشّاعر الزّمن، فهو يضفي على المشهد شحنات من السّوداويّة مثل: مشهد البحار التّائه، الدّرويش الذي دوخته حلقات الذّكر فهي تشير إلى الموت، وكذلك مشهد: الجلاد والسّوط المدمى- ليتني ما زلت في الشّارع اصطاد الذّباب أنا والأعمى والمغني والكلاب… فالمشهاديّات التي تدعو للتفاؤل والأمل نادرة بالقياس إلى مشهديّات التّعاسة والبؤس.
من هنا نجد أنّه من الضّروريّ فهم ماهيّة اللّون؛ فاللّون اصطلاحًا هو “إحساس وليس له أي وجود خارج الجهاز العصبي للكائنات الحيّة” (أسماء، 2020، ص21). فإذا تجاوزنا التّعريفات الفيزيائيّة، وجدنا اللّون طاقة، أو شعورًا نشعر به إثر رؤيتنا لهذا اللّون تّحديدًا. واللّون الأسود في علم النّفس، وفي اختبار ماكس لوشر (Max Lüscher)[3] يشير إلى العدم، التّعاسة، النّهاية… ففي هذا الاختبار تعدّ الألوان طاقات شعوريّة تدرس من خلالها نفسيّة المريض، أو الشّاعر… حيث يستفيد النّاقد “من اللّون شعوريًا ولا شعوريًا، ليتمكّن من تحليل النّصّ ويكتشف ما في ضمير الشّاعر…فكما يؤثّر اللّون في نفس الإنسان، فإنّنا يمكن أن نحلّل وندرس شخصيّة كلّ إنسان من خلال نزوعه البارز إلى بعض الألوان الخاصّة”(التّميمي،2018،ص656).
الكلمات هي شيفرات لغويّة دالّة، نتجت عن الشّاعر قاصدًا منها معنىً معيّنًا، على أنّ هذه الألفاظ المنتجة ليست معزولة عن البنية النّفسيّة للشاعر، لأنّ اللّفظ يعبّر عن فكرة في عقل الشّاعر، ولهذه الفكرة أعماقها النّفسيّة. وقد أكّد سوسير “سيكولوجيّة الإشارة اللّغويّة بجانبيها فهو يقصر تولّد الدّلالة داخل النّطاق النّفسيّ بين الدّال والمدلول”(مبارك،1987،ص43)، والبديهيّ أنّه لا شعر ولا رواية بلا لغة. فكلّما حاول حاوي توصيف هذا الواقع استخدم أحلك الألفاظ والتّعابير لتوضيح قباحته. فالمسألة هنا ترتبط بالدّرجة الأولى بمفهوم الرّفض النّفسيّ المقترن بالإلحاح[4] على تغيير سريع. فالواضح أنّه لا يطيق الواقع ويريد تغييره بأي طريقة.
ب-حقل الأمل بالتّغيير أو الانبعاث: الشّمس-العنقاء-النّار-الرّماد-يتولّى خلقه طفلًا جديد-غسله بالزّيت والكبريت من نتن الصّديد-يا معاد الثّلج لن أخشاك-أنا في حبّكم أعاني الموت في حبّ الحياة-مرضعة الأمس الرّحيمة-ضحكات أطفال-سرير دافئ-حكايات بجنب النّار-أعياد-وليمة-في بقايا شعرنا يزهر وهج الثّلج-لهب أخضر في العروق-من مستنقع الشّرق إلى الشّرق الجديد-أضلعي امتدّت لهم جسرًا وطيد-لي خمر وجمر للمعاد-وكفاني أنّ لي عيد الحصاد-يا إله الخصب-يا شمس الحصيد-أنت يا تموز-يا فصحًا مجيد…
ج- حقل التّشكيك بالأمل: من الكلمات والتّعابير الدّالة عليه: غير أنّي ما حملت الحبّ للموتى-طفلهم يولد خفاشًا عجوز-متى يخجل مصباح الخفير (لا يريد الأمل) -ضوء الشّمس يخزيه (كأنّه خفّاش أو مصاص دماء) -كان قبل اليوم يغري العفو ويغري الفرار- عبثًا نسكب شهوة وحبّ الحياة جمرًا وخمرًا-عبثًا كنّا نصلي ونصلي (في الدّعاء) دون جدوى دون إيمان بفردوس قريب … ولإبراز التّناقض في بعض العبارات نعرض الجدول الآتي:
جدول رقم 1: توضيح الصّراع النّفسيّ والتّناقض من خلال التّناقض الدّلاليّ
| الحقل (ب): التّفاؤل | الحقل (ج): التّشكيك بالتّفاؤل |
| طالما أغرى الصّدى قلبي وجفني، طالما راوغني صوت المغنّي | ليس يغوينا ابتهال- صوت المغنّي لم يعد يخدع كفيّ وجفني-لم يعد يخدعني العفو اللّعين |
| أنت يا تموز يا شمس الحصيد | مطرح الشّمس رماد وسواد |
| حبّنا أقوى من الموت | عبثًا كنّا نهزّ الموت- غير أنّ الحبّ لم ينبت من اللّحم القديد |
1-العلاقة بين الحقول وتوضيح الصّراع النّفسيّ
يرتبط الحقل (أ) بالحقل (ب) بعلاقة تعارض وتناقض، غير أنّنا نلاحظ أنّ الحقل (أ) هو الحقل الغالب على مساحة النّص المدروس. وجاء التّداخل بين الحقلين في أغلب القصائد، ليوضّح أنّ الشّاعر لا يعيش استقرارًا نفسيًّا. بل تتجاذبه أفكار متعارضة فمن جهة هو يرفض الواقع بإلحاحٍ مرضيّ، ومن جهة أخرى يحلم بالوصول إلى الواقع لأمّة متماسكة، إلى شرقٍ جديد. ويرتبط الحقلان (أ) و (ج) بعلاقة تعارض، فهو يرى أنّ التّمرّد على الواقع واجب من جهة، ومن جهة أخرى يشكّ في إمكانيّة هذه الأمّة تحقيق الحلم المنشود والوصول إلى الشّرق الجديد. وكذلك، يرتبط الحقلان (ب) و (ج) بعلاقة تعارض وتناقض. من هنا نرى أن التّناقض هو الذي يحكم شبكة العلاقات الدّلاليّة في هذا الدّيوان. وهذا يدلّ بالضّرورة على الشّتات الفكريّ المرتبط بالصّراع النّفسيّ، الذي يعرّف بأنّه “حالة انفعاليّة غير سارّة تحدث لدى الفرد نتيجة وجود رغبتين أو فكرتين متناقضتين في وقت واحد، مما يؤدّي للشعور بالحيرة، الارتباك، التّردد، والضّيق نتيجة عدم القدرة الفرد على الوصول إلى حلّ” (الدّسوقي،1999،ص121). فالرّغبة بالانتفاض والثّورة هنا تتبلور ببعدها المرضيّ، فهي رغبة يعلم الشّاعر أنّه لا يمكن تحقيقها، أو على الأقلّ صعب تحقيقها في وقته. وما حصل فعليًا هو: أنّه واجه هذه الرّغبة المرضيّة الآتية من الهو، غير أنّ الظّروف الاجتماعيّة، السّياسيّة الخارجيّة توجّه ضغطًا مركّزًا يمنع هذه الرّغبة من التّحقق، عندها اضطر الشّاعر لكبت هذه الرّغبة، والواضح أنّ عمليّة الكبت والأوليّات الدّفاعيّة الأخرى لم تنجح في كبح جماح هذه الرّغبة، ما أوصله للانتحار. ويعرّف الكبت أنّه “عمليّة نفسيّة لا واعية تطرد بواسطتها نزوات معيّنة وكلّ ما يرتبط بها من معارف وخبرات إلى اللاوعي وهذه العمليّة تبقى نشطة، ويستعان بباقي الأوليّات الدّفاعيّة في حال إخفاقها” (الموسى،2016،ص162). أمّا الأوليّات الدّفاعيّة فهي “عمليّات نفسيّة لا شعوريّة تهدف للحفاظ على التّوازن في الجهاز النّفسيّ وحمايته من الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة” (صلاح الدّين،2020،ص22). إذًا فمن الواضح أنّ الشّاعر كان يحاول طرد كلّ ما يتعلّق بهذه التّجربة إلى اللاوعي، والتّعويض عن عدم إمكانيّة تحقيق الرّغبة من خلال الأدب وتحديدًا الشّعر. وهذا بدوره أوليّة دفاعيّة تعرف بالتّسامي، أي إخراج الضّغط النّفسيّ بأشكال راقية مثل: الموسيقى، الشّعر… ويعرّف التّسامي بأنّه “عمليّة تقوم على تحريف الطّاقات العدوانيّة والجنسيّة إلى أهداف ساميّة لها قيمة اجتماعيّة، رياضيّة، أو فنيّة” (الموسى،2016،ص163). وقد جاءت عدوانيّة الشّاعر، ونقمته هنا على الواقع، وتكفي العودة إلى الحقول الدّلاليّة السّابقة لمعرفة شدّة رفض الشّاعر له. عادةً يخفف التّسامي من حدّة الصّراع النّفسيّ، غير أنّ حالة الشّاعر المرضيّة التي طالبت بإلحاح، جعلت التّسامي يخفق في تخفيف حدّة المشكلة بل وتزايدت مع الوقت لتنتهي بالانتحار.
ذهب فرويد إلى الرّبط المباشر بين الأدب واللّغة ونظريّة التّحليل النّفسيّ، إذ إنّ مظاهر الإبداع الأدبيّ واللّغويّ عنده تؤكد الطّابع الكبتيّ للإبداع، حيث قال “الشّعراء والرّوائيون حلفاء كرام من الواجب تقدير شهاداتهم حق قدرها…لأنّهم يعرفون أشياء كثيرة لا تجرؤ حكمتنا المدرسيّة على أن تحلم بها”(فرويد،1978،ص7). إذ يرى هذا الأخير أنّ الفرد يقوم بتشفير تجربته الفرديّة التي خاضها وأثّرت فيه من خلال اللّغة في قالب أدبيّ، ومن ثمّ يمكن كشف المشاكل النّفسيّة الفرديّة من خلال التّحليل اللّغويّ. وبما أنّ حاوي جعل تجربة الجماعة هي تجربة الفرد المبدع، فقد قام بتشفير تجربة الشّاعر العامّة الخاصّة، ومكّننا من كشف المشاكل النّفسيّة العامّة (حسب وصفه هو لطبيعة هذا الشّعب)، والخاصّة. إذًا، فالحقول الدّلاليّة تسهم في توضيح جدّية المأزق النّفسيّ للشاعر من خلال موضوعاتها، وعلاقاتها المتناقضة.
ثالثًا: المستوى المعجميّ بين وهم الأسطورة ومرارة الواقع
لا ينفصل المستوى المعجميّ عن المستوى الدّلاليّ، لأنّه لا قيمة للكلمات بمعزل عن الدّلالة. ويجب التّركيز في التّحليل هنا على القيمة المعجميّة للألفاظ وعلاقتها بإنشاء الدّلالة، ونعني بهذه القيمة المعنى المعجميّ للألفاظ الذي يشكّل جزءًا ضئيلًا من الدّلالة الكليّة، بالإضافة لما تحمله من إنزياحات وخيالات تكتسب الأهميّة الكبرى في عمليّة التّدليل، وذلك من خلال ما يسمّى بالانتقال الدّلاليّ. ويعرّف المعجم بأنّه” تلك المجموعة القارّة من التّرابطات المخزّنة التي تحصل بين الأشكال الصّرفيّة ومعانيها أو استعمالاتها أي قيمها الدّلاليّة والتّركيبيّة، ويسمّى كلّ ترابط مدخلًا معجميًا” (جحفة،2014،ص110-114). ولمّا كان المستوى المعجميّ متصلًا بالدّلالة كانت نقطة لقائهما المعنى المعجميّ، فكلّ كلمة هي خيار لغويّ قصد الشّاعر منه معنًى محدّدًا. غير أنّ الدّلالة لا تقف عند المعنى القاموسيّ، بل تتجاوزه لتشكيل دلالات جديدة لامتناهية.[5] وفي تحليل هذا المستوى أكثر ما يفيدنا هو السّؤال لماذا استخدم الشّاعر هذه الألفاظ بالتّحديد دون سواها من الكلمات الأخرى؟ ولماذا تكرّر لفظ معيّن في أغلب القصائد؟ وما الأبعاد النّفسيّة لتكرار هذه الألفاظ؟ وكيف تسهم في فهمنا لمشكلة الصّراع النّفسيّ عند الشّاعر؟ ذلك لأنّ “أي رمز معجميّ مكرر بوتيرة معينة يمكن أن يغيّر في الدّلالة الكبرى للمدوّنة، فالتّرميز المعجميّ يمكّن الباحث من كشف نسبة مساهمة كلّ لفظ في إنتاج المعنى”(Milroy,1978,p133).
الدّلالة هي “كون الشّيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشّيء الأوّل هو الدّال والثّاني هو المدلول”(الجرجاني، 2009، ص174). إذًا فهي دراسة العلاقة بين كلمات الشّاعر، تكرارها، والأزمة النّفسيّة. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّنا لا نستطيع الكلام على مفردات خليل حاوي بمعزل عن كونها رموزًا سيميائيّة تشتمل على غير معنى ودلالة، وذلك لما تحمله من تناص أسطوريّ وتاريخيّ. ولتوضيح ذلك نعرض جدولًا يضمّ أبرز الكلمات المكرّرة:
جدول رقم 2: تكرار بعض الألفاظ في الدّيوان
| الكلمة | التّكرار |
| الموت | 51 مرّة |
| الرّماد | 15 مرّة |
| نار | 18 مرّة |
| عتمة-ليل | 28 مرّة |
| تموز-إله | 16 مرّة |
نلاحظ أنّ هذه الألفاظ مرتبطة مباشرة بالحقول المعجميّة السّابقة، والواضح أنّ حقل اليأس والرّفض (أ) قد سيطر على كامل مساحة النّصّ، لأنّ مفرداته هي الأكثر من حيث العدد والتّكرار. ولن نطيل في شرح معاني هذه الألفاظ المعجميّة لأنّها واضحة، وما يهمّنا من الأمر أبعادها الأسطوريّة التّاريخيّة النّفسيّة. وقد برزت لفظة موت بوصفها الكلمة الموضوع التي ترتكز عليها النّصوص الشّعريّة، فهي مكرّرة بشكل صريح في أغلب القصائد، وإن لم تذكر بوضوح ترد معانٍ تشير إليها (اجتازوا الحياة). ولئن كانت هذه الكلمة محمّلة بأبعادٍ أسطوريّة فهذا لا يعني أنّنا ندرس التّناص هنا، لكنّ دلالة الموت لا تنفك عن أسطورة طائر الفينيق أو الطّائر المحترق الذي يحترق ويموت، ثمّ يحال رمادًا، ليعود إلى الحياة مجدّدًا. حيث أشار الماجدي (2020) إلى أنّ “الفينيق يمثّل فكرة الانبعاث الدّائم، حيث يحترق ومن رماده يبعث من جديد. ونجد جذرًا لهذه الفكرة في دورة الشّمس حيث يظهر النّسر في الأساطير المصريّة وهو يحمل في كلّ فجر الشّمس بقدميه ويغرب أو يموت مع غروبها لينبعث مرّة أخرى صباح اليوم التّالي، وهو يبعث الشّمس معه” (ص531). ونلاحظ أنّ الألفاظ المرتبطة بهذه الأسطورة هي الأكثر تكرارًا لأنّها الخيط الذي يجمع القصائد بعضها ببعض. إذًا فالحمولة الأسطوريّة المرتبطة بالموت، النّار، الرّماد تبدو حمولة بائسة لا تجد غير الموت طريقًا لنجاة الأمّة، فحتّى لو كانت النّتيجة البعث، إلّا أنّ الثّمن هو الموت والفناء. ثمّ إنّ الأسطورة تقول باحتراق الطّائر وانبعاثه كلّ فجر، فهل يحترق الشّعب ويبعث كلّ يوم؟ أم يحرق مرّة واحدة، ويبعث بعدها شعبًا أقوى وإلى الأبد؟! وما بين جدليّة طاقة الحمولة الأسطوريّة -أهي إيجابيّة أم سلبيّة- والآراء المتباينة حولها، نجد أنّه لابدّ من الوقوف على الحمولة النّفسيّة لهذه الألفاظ.
إذا أولينا كلمة موت دقّة في التّحليل وعمقًا في الرّؤيا، نجد أنّها تقع لغويًا تحت ما عرف عند العلماء العرب بالأضداد. “ولا نعني بالأضداد ما يعنيه علماء اللّغة المحدثون من وجود لفظين يختلفان نطقًا ويتضادان معنًى؛ كالقصير مقابل الطّويل والجميل مقابل القبيح، وإنّما نعني بها مفهومها القديم وهو اللّفظ الواحد المستعمل في معنين متضادّين”(عمر،1998،ص191). فالموت عند حاوي يعني الفناء والحياة في الوقت نفسه، فالشّعب لا يحيا إلّا بالموت، ولا يموت إلّا ليحيا من جديد، إذًا فالموت عنده يعني الحياة أيضًا. ولعلّ الخلفيّة الأسطوريّة لأسطورة الفينيق جعلت البعض يغفل عن مسألة الصّراع النّفسيّ المتجلية في هذا اللّفظ بالتّحديد. فماذا يعني أن يكون الموت هو الحياة؟ وهل القوّة الإيديولوجيّة التي تستند إليها أسطورة الفينيق كافية لجعل الموت حياة؟
إذا بحثنا في التّاريخ البشريّ نجد في فلسفة بعض الفرق الدّينيّة أنّ الموت حياة، وهذا ما يقوم عليه مفهوم الشّهادة عند المسلمين، حيث تعرّف الشّهادة بأنّها “الموت الذي يتّجه نحوه القتيل تحقيقًا لهدف مقدّس، إنسانيّ…”(مطهري،2000،ص15)، غير أنّ الإرث الإيديولوجيّ الواقعيّ الضّخم للمسلمين يمكن العودة إليه بوصفه عقيدة تفسّر كيفيّة تحوّل الموت الذي يقع تحت اسم الشّهادة، والذي يبرز بوصفه تضحيّة في سبيل قضيّة ما إلى حياة. فهذا الموت ليس موتًا عشوائيًا اعتباطيًا، فهو ليس انتحارًا لمجرّد الاستنكار، إنّه الموت الذي يحافظ على القضيّة التي يموت الفرد لأجلها. وقد أشار عالم الاجتماع دوركهايم إلى أنّ “العوامل الأساسيّة للانتحار تتّصل بشكّ الفرد بمحيطه الاجتماعيّ والقيود التي تحكمه”(Monde,1978,p:8). وهذا ما نراه بوضوح عند حاوي، إذ يرد عنده حقل الأمل بالانبعاث وبشرق جديد (ب)، ثمّ ما يلبث يشكّك بهذا الأمل، وبقدرة الشّعب على صناعة الغد الجديد (ج)، بسبب قيودٍ سياسيّة وفكريّة… إذًا فقد كرّر الشّاعر كلمة موت كثيرًا، جاعلًا منها الكلمة الموضوع للديوان بأكمله، ويبدو أنّ الموت عنده لا يستند إلّا إلى أسطورة فينيقيّة قديمة، أمّا قضيّته فهي بناء جيل جديد ومحاربة الواقع المرير. وهذا لا يعني إنكارنا أهميّة ربط القصائد بالمرجعيّات والإحالات التّراثيّة الخارجيّة، “فما يحفظ للصورة الشّعريّة رمزيّتها، ويهبّ للعمل الشّعريّ حياة عبر العصور… هو الارتباط بالتّراث الثّقافيّ الحضاريّ”(عوض،1992،ص119). فالمسألة هنا ليست الاستخفاف بالتّراث الأسطوريّ، بل الإيمان به حدّ الموت.
وبالعودة إلى مسألة التّضاد وتحليلها النّفسيّ، نجد أنّ الشّاعر يشعر بالحيرة والتّناقض حيال قضية الشّرق الجديد. فهي ليست مسألة أن تستخدم لفظ مثل مولى بمعنى العبد، أو السيد، لأنّنا ندرس الأبعاد النّفسيّة للكلمة. ويعدّ الصّراع النّفسيّ ” جزءًا من سنّة الحياة فأي إنسان قد يكون عرضةً لهذا الصّراع، لكنّ الفشل في مواجهته يؤدّي إلى العديد من الاضطرابات والأمراض النّفسيّة، فخطورة هذا الصّراع ليست في وجوده إنّما في استمراره وشدّته، الأمر الذي يؤدّي إلى استنفاذ طاقة الفرد النّفسيّة” (الدّسوقي،2007،ص165). وهذا ما نراه واضحًا عند الشّاعر، إذ يبدو أنّه لا يشعر بالأمل بالانبعاث ولا يثق بقدرة الأمّة على تغيير واقعها أبدًا. ويبدو الصّراع مستمرًّا ومتطّورًا تصاعديًا على كامل مساحة النّصّ. والواقع أنّ تلقي هذا النّصّ (ديوان نهر الرّماد) قد يحمل مشاعر الخيبة، والقلق للقارئ فكيف بالمنتج؟ لقد استنقذ الشّاعر طاقته النّفسيّة في وصف الواقع المرير، في محاولة لتوجيه النّقد للمجتمع والأمّة، ولحثّهم على الثّورة والتّغيير، مع عدم إيمانه بوصولهم إلى الهدف. ولكن لماذا كلّ هذا التّأزّم النّفسيّ حيال قضيّة عامّة لا تمسّ ذات الشّاعر مباشرة؟ الواقع أنّ حاوي كما قدّمنا صهر تجربته بالتّجربة الجماعيّة، لتصبح هذه التّجربة هي التّجربة الذّاتيّة المحوريّة، وقد ذهب بعض علماء النّفس إلى أنّ “الصّراع النّفسيّ ينشأ عندما يواجه موقفًا يحول دون تحقيق إنسانيّته، فيكون الصّراع بين إرادة الفرد على تحقيق إنسانيّته، وبين القوى التي تمنعه من ذلك”(عبد الغفار،1996،ص107). وهنا كانت بدايات الصّراع حيث نشأ صراع بين إرادة الشّاعر المحبّة للحياة، التي تتمنّى تغيّر حال الأمّة العربيّة وشعبه خاصّة، وبين الظّروف القاهرة التي تمنع تحقيق هذا الهدف، فاشتدّت حدّة الصّراع النّفسيّ الدّاخليّ النّاتجة عن الصّراعات الخارجيّة. وفي مقابل الصّراع نجد مفهوم الصّلابة النّفسيّة وهي “مجموعة من السّمات الشّخصيّة التي تعمل على مواجهة أحداث الحياة الصّعبة. وهي اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليّته وقدرته على استخدام الموارد البيئيّة والنّفسيّة المتاحة حتّى يكون قادرًا على مواجهة أحداث الحياة الضّاغطة بفاعليّة وجدارة”(Kobasa,1979,p169). وهذا ما لم يقدر شاعرنا عليه، لأنّه أصلًا لم يؤمن بفاعليّته وقدرته على مواجهة الأحداث الضّاغطة.
أشرنا سابقًا إلى الدّلالة النّفسيّة للعتمة واللّيل والأسود، التي تبدو روح القصائد غارقة فيها حدّ الموت والبؤس. على أنّنا لا نكرّر هنا ما ذكرناه سابقًا، بل ننطلق من أسطورة طائر الشّمس نفسها. ألم تقل الأسطورة: أنّ الطّائر يبعث كلّ صباح ويبعث معه الشّمس؟! إذًا لماذا تسيطر العتمة، والسّواد على الأجواء النّفسيّة الدّاخليّة للديوان بأكمله؟ أليس من المفترض بشاعر يؤمن بالبعث أن تشرق الشّمس، وتحلّق العنقاء بين أبياته وصوره؟ إنّ المفردات لتساعدنا في رسم صورة أوليّة لمشهدين متضادين: مشهد الموت والبؤس، مقابل مشهد البعث. غير أنّ الواقع المرير سيطر بحقوله الدّلاليّة، ألفاظه، وأبعاده النّفسيّة على أغلب مساحة النّصّ، ولم يترك مكانًا إلّا لأمل بائس لا يشرق إلّا بعد الموت.
أمّا تموز أو دموزي كما ورد في بعض المراجع بوصفه “الإله الرّاعي أو إله الخصب”(علي،1999،ص18)، فهو الإله الذي يناديه الشّاعر لينقذ هذا الشّعب من محنته حيث قال : “أنت يا تموز يا شمس الحصيد”(حاوي، السنة،ص119). وقد تكرّر ذكره في قصيدة ما بعد الجليد غير مرّة بصيغة الدّعاء كأنّه يرجو من تموز تحقيق أمنيته بالوصول إلى شرقٍ جديد. وبالرّغم من كون تموز إله الخصب، وزواجه من عشتار أو إنانا آلهة الحبّ والجنس، إلّا أنّ أسطورة تموز في حدّ ذاتها تحمل بعدًا مأساويًا، إذ تعرف بمأساة تموز، فما حصل أنّ ” إنانا واصت سفرها فوصلت إلى مدينة دموزي زوجها وحبيب صباها، فوجدته على خلاف ما تقتضيه سنن الموت والعزاء والحزن الجماعيّ، رأته متربعًا على عرشه مرتديًا حلل الأعياد والأفراح ونايه يصدح بأعذب الأنغام. فاستشاطت غضبًا، وصوّبت عليه نظرة الموت، وأسلمته إلى أيدي المردة القساة ليحملوه إلى العالم الأسفل بديلًا لها، فصدم دموزي وامتقع لونه…” (الأميري،2020،ص37-38). وهكذا فإنّ حكاية تموز بحدّ ذاتها حكاية تراجيديّة مأساويّة حيث أنزلت عشتار تموز بدلًا منها إلى العالم السّفليّ[6]، وقد كان تموز البديل القرباني لها. وما يهمنا من الأمر، انطواء رمز تموز على غير معنى ودلالة، فصحيح أنّه إله الخصب، لكنّه إله تعرّض للمأساة أيضًا. من هنا يمكن أن يحمل تموز بحدّ ذاته حمولة نفسيّة متناقضة، يشتمل بعضها على عناصر إيجابيّة مرتبطة بالحبّ والخصب، في حين يشتمل بعضها الآخر على حمولة سلبيّة مرتبطة بالمأساة والموت، وقد وردت ثنائيّة الموت-الحبّ في الدّيوان بشكل واضح: “حبّنا أقوى من الموت” (حاوي،1993،ص123) وهذا يحيلنا على مبدأي التّضاد، والصّراع النّفسيّ الذين تكلّمنا عليهما سابقًا.
رابعًا: التّناص والصّورة الشّعريّة في تأكيد جدليّة الصّراع النّفسيّ
1-الإحالات الدّينيّة والتّاريخيّة
بدايةً لابدّ من فهم ماهيّة الصّورة الشّعريّة من أجل تحليل أبعادها النّفسيّة، وقياس مدى توافقها مع التّحليل المقدّم في المستويين السّابقين. ولن نبالغ في الخوض في مفهوم الصّورة الشّعريّة، لأنّها مفهوم نقديّ تكلّم عليه الشّعراء العرب منذ القدم. فتحقّق الصّورة الشّعريّة في المعيار الأسلوبيّ “يتمّ في إطار الانزياح التّركيبيّ الذي ينشأ عن العلاقات بين الوحدات المعجميّة، والانزياح الدّلاليّ الذي يقوم على الاستعارة بحسبانها استبدالًا” (بلغيث،2009،ص27)، غير أنّ التّصوير لا يقتصر على الاستعارة، بل يشتمل على باقي فنون البيان البلاغيّ. وقد ذهب أرسطو إلى أنّ “السّيطرة على الاستعارة هي أعظم من أي أمر آخر، وهي ما لا يمكن تعليمه للشاعر لإنّها سمة العبقريّة” (عوض،1990،ص40)، وللخيال دور كبير في تشكيل الصّورة وتوحيد الإحساس العام في الدّيوان، فهو “القوّة التي بواسطتها تستطيع صورة معيّنة أو إحساس واحد أن يهيمن على باقي الصّور أو الأحاسيس في القصائد، فيحقّق الوحدة بينها بطريقة أشبه بالصّهر” (عبدالله،1998،ص46). وإنّ كيفيّة وماهيّة الصّورة الشّعريّة هي التي تكسب العمل الشّعريّ بعده الفنيّ والنّفسيّ، فالصّورة هي ما يتخيّله الشّاعر، وما يحاول قوله، وهي في الوقت نفسه ما يصل من صور ذهنيّة، وانفعالات نفسيّة إلى المتلقي. من هنا يمكن مقاربة النّصّ المرسَل وفقًا لنظريّة Roman Jacobson، فهذه المرسلة الإبداعيّة تشتمل على شيفرات لغويّة زاخرة بالأبعاد النّفسيّة إذ إنّ معنى العبارة أو الكلمة في الواقع هو “الحافز الذي يدعو إلى التّلفظ بها والاستجابة التي يستدعيها من المستمع”(جحفة، 2014،ص31). وبين قوّة وتكثيف الصّورة الشّعريّة، واحالاتها النّفسيّة، يجد النّاقد أنّه لا بدّ من فهم التّناص التّاريخيّ والأسطوريّ الدّينيّ… الذي ترتكز عليه هذه الصّورة. وقد استخدم باختين في البداية مصطلح الحواريّة الذي يعني “العلاقة بين أي تعبير والتّعبيرات الأخرى”(باختين،1990،ص143)، وتلا ذلك مفهوم التّعالق النّصيّ، من هنا ننطلق لفهم شبكة العلاقات بين النّصّ المدروس ونصوص أخرى، لفهم البعد النّفسيّ للشّاعر، سواء أكانت تشبيهًا أم استعارة أم كناية… لأنّ ما يهمّنا هنا ليس نوع الصّورة، بل أبعادها النّفسيّة.
بالعودة إلى صورة الدّراويش في قصيدة البحار والدّرويش يقول:
“آه لو يسعفه زهد الدّراويش العراة
دوّختهم حلقات الذّكر
فاجتازوا الحياة” (حاوي،1993،ص42-43)
إنّ استحضار الدّرويش بحدّ ذاته ومن دون الإشارة إلى الموت، تكشف عن الرّغبة في الانسلاخ عن الحياة، لأنّ الدّرويش المتصوّف يرتبط مباشرة بالزّهد واعتزال الحياة وملذّاتها، والابتعاد من كلّ الماديّات، من أجل الاتحاد بالمحبوب النّهائيّ والفناء فيه. غير أنّ سفر الشّاعر المعنويّ لم يقتصر على حلقات الذّكر، والتّعبّد في الكهوف، حيث أشار إلى الموت عند قوله: “اجتازوا الحياة، شرّشت رجلاه في الوحل وبات ساكنًا، في مطاوي جلده ينمو طفيليّ النّبات…”(ص43)، فالدّرويش يشير إلى الزّهد في الحياة، والعبارات السّابقة تضيف مفهوم الموت. والسّؤال الذي يطرح هنا: لماذا يرى حاوي أنّه بحاجة للعزلة والوحدة على لرّغم من أنّ قضيّته قضيّة عامّة، تقتضي توجيه الأمّة، وأن يكون بين النّاس لا منعزلًا عنهم؟
نفسيًا ذهب العلماء إلى أنّه “إذا كان الشّخص ينكر المجتمع الذي يعيش فيه، ويراه لا يلبي احتياجاته، فقد يرغب بالانفصال عنه باستخدام العزلة وسيلة لذلك” (محمود،2022،ص357). وهذا ما حصل مع حاوي الذي لا يشعر بقدرة المجتمع على الثّورة والتّغيير، فانكفأ مبتعدًا عن الواقع، معتزلًا في صومعته لا يصدّق الأمل أبدًا. كما وتعدّ العزلة نفسيًا من علامات الكآبة، التي توصل بدورها إلى الانتحار.
وبالانتقال إلى بعض صور ومشاهد التّناص الدّينيّ نجد ما يلي:
-“من يقوينا على حمل الصّليب” (حاوي،1993،ص52)، من قصيدة ليالي بيروت.
-“رست في جوف الحوت”(ص94) من قصيدة في جوف الحوت.
– “دوّت جلجلة الرّعد”(ص112) من قصيدة سدوم.
-“طوفان من برق، سفر أيوب”(149) من قصيدة عودة إلى السّدوم.
-“وعبدناه إلهًا يتجلّى في المغارة”(ص145) من قصيدة المجوس في أوروبا.
جاء التّناص الدّينيّ المسيحيّ هنا ليعود ويصبّ في خانة الموت، الألم، والعذاب. فذكرى الصّلب وحمل الجلجلة حادثة مفجعة تقوم على تضحية المسيح بنفسه من أجل غسل خطايا البشر، وبعد ثلاثة أيام يقوم المسيح. إذًا، فهو مفهوم الموت المقرون بقيامة جديدة من أجل تحقيق غد أفضل وهذا يتقاطع مع أسطورة العنقاء. فهو يرى الموت طريقًا إلى الحياة. كما وجاءت الصّورة الدّينيّة ذات المرجعيّة الإسلاميّة لتعبّر عن الوحدة، الظّلمات، والمعاناة كما حصل مع النبيّ يونس في جوف الحوت، وكما عانى النبي أيوب من المرض. وإنّ مفهوم الموت والعتمة يتقاطع مع الحقول الدّلاليّة المدروسة، التي تبرز هنا بوصفها صورة تسيطر على المناخ النّفسيّ العام للديوان. كما وعبّرت هذه المرجعيّة عن القيامة بعد الفناء من خلال مفهوم الطّوفان.
ذهب علماء النّفس إلى أنّ كثرة تكرار قول أمر ما، يدلّ بالضّرورة على التّفكير العميق به. فمن يفكّر في أمر يولّد طاقة تجذب فكرته إلى الواقع، “فالتّفكير الاعتياديّ والتّخيليّ يكوّن ويشكّل مصير الإنسان وشخصيّته، فالإنسان يصير حسبما يرى نفسه في عقله الباطن” (ميرفي،2018،ص15). من هنا كان حاوي يرى أنّ موته تضحية لابدّ منها، لذا شفّر ذلك في قصائده حينًا، وصرّح به أحيانًا عندما قال: )بيدي سمّ الانتحار-باسم ما أحرقت نفسي بنفسي لأصفي وجه التّاريخ وأمسي-أطعمت من جوهر عمري..(
وإذا أشرنا إلى التّناص التّاريخيّ سريعًا نجد: خاتم شهرزاد- دمع ليلى (حاوي،1993،ص149)، نجد أنّ الإحالات التّاريخيّة تدعم ما تقدّم. فشهرزاد هي المرأة المهدّدة بالموت عند كلّ فجر جديد، وليلى هي الحبيبة التي تعاني آلام الحبّ والبعد. فهذه المرجعيات التّاريخيّة مرتبطة أيضًا بالألم والمعاناة والموت بطريقة أو بأخرى، وهي تؤكّد ما ذهبنا إليه سابقًا.
هذا وقد اشتملت الصّورة العامّة على نقدٍ لاذع، يمكن توصيفه في العمليّة التّواصليّة بالحافز، أي سبب غلبة البؤس واليأس على الدّيوان، حيث قال “مهنة التّمسيح في الفندق لا يبرع فيها إلّا اشباه الرّجال- خرقًا ممسحة في فندق الشّرق الكبير” (ص156). فهو يشبّه الخاضعين الخانعين بالمماسح والخرق، ويذهب إلى ما ذهب إليه الإمام علي بن أبي طالب عندما قال: “يا أشباه الرّجال ولا رجال”(بن أبي طالب،2009،ص309)، للتّعبير مباشرةً عن غضبه ويأسه من واقع هذه الأمّة التي لا تحرّك ساكنًا، فحتّى الشّاعر حائر، ضائع، لا يعلم ما يصنع حيث نراه يناقض نفسه في الدّيوان نفسه فيقول: “ردّ لي يا صبح وجهي المستعار- اخلعوا هذه الوجوه المستعارة”(ص56)، والاستعارة الأولى تكشف عن علاقة الشّاعر المأساويّة بالصّباح رمز النّور، الأمل، والبدايات الجديدة وتوضّح سيطرة العتمة والظّلام على الدّيوان. وفي ذلك قال: “هي ذكرى ذلك الصّبح اللّعين-كان صبحًا شاحبًا أتعس من ليل حزين”(ص111)، وأضاف: ” وأنا في الصّبح عبد للطواغيت الكبار، وأنا في الصّبح شيءٌ تافهٌ آه من الصّبح ومن جبروت النّهار”(ص57). من هنا ففجر البعث الذي تولد فيه العنقاء من جديد، والذي تبقى فيه شهرزاد على قيد الحياة، يشكّل صبحه مصدر قلق وخوف للشاعر، الذي يخلع ليلًا وجه الذّل والعبوديّة ليغرق في يأسه وحزنه، ويجد نفسه في الصّبح مضطرًا أن يخلع وجه الحقيقة ويلبس الوجه المستعار بسبب ضعف الشّعب، ولبسه الأقنعة بدون كلل أو ملل أو نقدٍ أو ثورة. فما قوله اخلعوا الوجد المستعارة، إلّا دليل أنّه لا يستطيع خلع الوجه وحده، بل هو في انتظارهم يشكّ في رغبتهم وقدرتهم على خلع هذه الوجوه. فقد قال: ” لو كان فينا جمرة خضرا لثارت واستحالت خنجرًا يصيح من لهب أخضر في الجروح”(ص89). وقد استعار هنا اللّون الأخضر وأسنده للجمر للدلالة على حيويّة هذه القضيّة، فالجمر المشتعل رمز القوّة والثّورة والأخضر رمز الحياة والنّضارة وفي ماكس لوشر يشير الأخضر إلى طاقة القلب الذي ينبض بالحياة. إذًا فالصّورة الشّعريّة توضّح عمق التّناقض والصّراع النّفسيّ الدّاخليّ الذي أشرنا إليه سابقًا.
يبقى أن نشير إلى مرجعيّة الأرض-الأمّ في علم النّفس، حيث يفترض النّقاد أنّ ذكر الأمّ هو إشارة إلى الأرض والوطن. وقد جاء ذكرها على النّحو الآتي: ” غصتي الحرّى على مرضعة الأمس الرّحيمة- رحمةً كانت على الأمّ الرّحيمة-امرأة تخفي بكف عينها المزرقة الرّهيبة، تعيا بثقل الشّمس والحقيبة، تمضي إلى محطّة القطار، مرارة وعار”(ص62-88). والمرأة في هذه الصّور تشير إلى الأرض والوطن لبنان، غير أنّ صورة هذه المرأة بحدّ ذاتها لم تكن ثابتة، بل ظهر الصّراع النّفسيّ من خلالها أيضًا. فتارة يصوّرها على أنّها المرضع التي تهبه الحبّ والحنان، وتارة يصوّرها امرأة هاربة تمضي إلى محطّة القطار يقهرها الشّعور بالمرارة والعار.. على أنّ الصّورتين متناقضتين أوّلهما تحمل دلالة الحياة، والثّانية تحمل دلالة الموت، الانكسار، الاستسلام، الرّحيل… فهو يحاول القول إنّ الوطن حزين منكسر، بسبب تخاذل شعبه عن القيام بواجبه وتغيير الواقع. وهنا تحديدًا نعود إلى مسألة الإلحاح النّفسيّ على التّغيير، إذ يبدو من خلال التّحليل أنّ الشّاعر يتحدّث عن الموت والحياة والثّورة، على كلّ المستويات، وكذلك في العنوان. وقد أشارت جمعة (2022) في دراستها لحاوي إلى “الصّراع الفكريّ، الذّهنيّ، النّفسيّ، الوجوديّ في شعره، مؤكّدة دراميّة شعره”(ص151-166)، وقد ظهر الصّراع الوجوديّ واضحًا في “قصيدة ما بعد الجليد، فهو صراعٌ بين عوامل الفناء وعوامل الحياة”(ص167). وهذا يدعم ما ذهبنا إليه من وجود تناقض، تجلّى في الصّراع بين فكرتيّ الحياة والموت، نتج عنه صراعٌ نفسيّ حاد.
2-النّكوص الحضاريّ: الحنين إلى ظلال فينيقيا
أشرنا سابقًا إلى أسطورة العنقاء، تلك الأسطورة التي استند إليها نصّ الدّيوان بأكمله، حيث عوّل الشّاعر على انبعاث الشّعب من بعد موته واحتراقه. غير أنّ الأزمة النّفسيّة لا تتوضّح من خلال إيمان الشّاعر بهذه الأسطورة، وتأكيده لها في كلّ قصيدة، بل في ذهابه للتصديق بيقينيّتها حدّ التّماهي الميتافيزيقيّ مع طائر العنقاء. فما معنى هذا؟
يعرّف التّماهي بأنّه “تقليد أنموذج معيّن وهو آليّة مهمّة في تشكيل الشّخصيّة والأفكار وتكوينها” (الموسى،2016،ص163)، في حال كان من يتماهى يشكّل شخصيّته، والتّماهي لا ينحصر في تشكيل السّمات الشّخصيّة للفرد والجماعة، بل يشمل أيضًا تشكيل الأفكار والقناعات التي تنشأ عن نسخ بعض الأفكار والمعتقدات. ويمكن توضيح التّماهي بصورة أدقّ بأنّه “عمليّة نفسيّة يتمثّل الشّخص وبواسطتها أحد مظاهر أو خصائص صفات وخصائص شخص أو شيء آخر ويتحوّل كلّيًا أو جزيئيًا لأنموذج منه…” (مالكي وبلعربي،2017،ص39). فإذا تناولنا الشّاعر بوصفه حالة تخضع للفحص النّفسيّ، نرى أنّه تماهى كليًا مع العنقاء، فاكسب نفسه خصائص هذا الطّائر وسماته في لا وعيه، فصار يؤمن بفكرة الموت من أجل تحقيق حياة أفضل، في حين أنّ موته في الحقيقة لم يتبعه انبعاث الأمّة، والثّورة. وهذا ما قصدناه من خلال لفظ ميتافيزيقيّ، فالبعد الماورائيّ في أسطورة العنقاء يتمثّل في صفات وقدرات هذا الطّائر الخارقة في القيام والانبعاث كلّ يوم بعد الموت والاحتراق، والميتافيزيقيا هي “العلم بموجودات لا تدرك بواسطة الحواس، حيث تقع في عالم ما فوق التّجربة وما راء الطّبيعة” (محمد،2010،ص129)، وهذا يصدق على مفهوم الموت. وقد يطرح المتلقي هنا سؤالًا منطقيًا: كيف استطاعت الأسطورة أن تأخذ هذا الحيّز الواسع في تشكيل فكر ونفسيّة الشّاعر؟
هنا يجدر بنا الإشارة إلى ما يُعرف بالصّلابة النّفسيّة Psychological Hardiness وهو المفهوم الذي يساعد الإنسان على تخطّي العقبات والتّحدّيات التي يتعرّض لها في الحياة، ويعرّف بأنّه “مجموعة متكاملة من الخصال الشّخصيّة ذات طبيعة نفسيّة اجتماعيّة، وهي خصال فرعيّة تضمّ: الالتزام، التّحدّي، التّحكّم. حيث يرى الفرد أنّها خصال مهمّة في التّصدّي للمواقف الصّعبة أو المثيرة للمشقّة النّفسيّة والتّعايش معها بنجاح” (محمّد،2002،ص35). والواضح أنّ الشّاعر لم يمتلك الصّلابة النّفسيّة المطلوبة لمواجهة الضّغط النّفسيّ الدّاخليّ النّاتج عن الصّراع بين رغباته الملحّة وبين الواقع المأساويّ، الذي نتج بدوره عن الضّغوطات الخارجيّة. فالضّغط في هذه الحالة ضغط مركّب من عدّة عوامل، بشكل يصعب القول إنّه ضغط ناتج عن ظروف خاصّة داخليّة، أو خارجيّة فقط.
تشكّل المقارنة التّاريخيّة جزءًا مهمًّا من الصّراع النّفسيّ، فشاعر الانبعاث لا يكفّ عن ترديد أسطورة العنقاء فينيقيّة الأصل، وهذا يعني أنّه يحنّ إلى أمجاد السّلف حضاريًّا ومن النّاحية النّفسيّة يعرف هذا بالنّكوص وهو “الارتداد إلى الوراء والعودة إلى أساليب سابقة في التّصرّف مرتبطة بمرحلة قد تجاوزناها” (الموسى،2016،ص162)، مثل أن يعود العجوز إلى اللّعب بألعاب الأطفال للتعبير عن الحرمان الذي تعرّض له في مرحلة الطّفولة. فالشّاعر يعود إلى الماضي أي إلى الحضارة الفينيقيّة العريقة تحديدًا، لأنّها الحضارة التي يحلم أن تكون واقعه، ولا يتقبّل فكرة التّقهقر الذي أصاب هذه البلاد. فقد كان الفينيقيون “من الطّراز القويّ والماهر والمخترع والمبتكر، سلمًا وحربًا، ففضلًا عن أساطيلهم البحريّة تركوا أبجديّتهم تؤسس أبجديّات أوروبا والعالم كلّه، وتركوا إرثًا اسطوريًّا وشعبيًّا يصعب حصره” (الماجدي،2020،ص413). ولكن أين نحن اليوم ممّا كان الأجداد سابقًا؟ أين الإبداع والابتكار والثّقافة؟! إنّ أزمة خليل حاوي ليست أزمة حريّة الشّعب واحتلال إسرائيل للبلاد فقط، فقضيّته أعمق من ذلك، لأنّه يرفض التّراجع الحضاريّ الذي أصاب بلاده، بل وكلّ البلاد العربيّة. وبين ما كان عليه الأجداد، وما كان عليه الشّعب في زمن حاوي، تولد أزمة نفسيّة تتمثّل بالحنين المستمرّ للعيش في صور الماضي، ورفض الحاضر رفضًا قاطعًا مع إلحاح على التّغيير يعلم أنّه لن يحدث، ولهذا نرى هذا الإيمان بأسطورة الموت والانبعاث، فهي الأمل الوحيد الذي ينقذ الواقع. نعم الأسطورة كانت الأمل الوحيد لتغيير الواقع وإنقاذه…
خامسًا: البعد الدّراميّ: استجابة الشّعب لمأساة موت الشّاعر
من أجل فهم الأبعاد الدّراميّة لهذا الدّيوان لابدّ من أن نفهم أنّ ربط الشّعر بالموضوعيّة والعقلانيّة أي تحميله حمولة إيديولوجيّة نقديّة فضلًا عن وظيفته الانفعاليّة أدّى إلى ظهور الدّراما في الشعر. فالدّراما تقوم على “التّخيّل ومحاولة فهم مجموعة من الظّواهر الطّبيعيّة والإنسانيّة، فهي تقوم بربط عالم الإنسان الدّاخليّ المتصارع بالعالم الخارجيّ الذي يتوافق أو يتصارع معه… وقد ارتبطت الدّراما بفكرة الصّراع” (نسارك،2019،ص24). وهذا ما نراه واضحًا عند حاوي إذ توسّعنا في شرح الصّراع النّفسيّ عنده. ومن خصائص الشّعر الدّراميّ “اعتماد تقنيّة السّرد لنقل التّجربة إلى المتلقي، حيث تنتظم الصّور الشّعريّة في بناء سرديّ محكم يحمل رؤية الشّاعر فتتابع الصّور ويمتزج الماضي بالحاضر” (عيسى،1997،ص171)، ولعلّ القارئ يسأل كيف تمّ ذلك؟ لم يسرد الشّاعر قصّة كاملة تقوم على حوار بين الشّخصيّات، وقد اختلف ذلك من قصيدة إلى أخرى: ففي قصيدة البحّار والدّرويش الشّخصيّات الدّرويش والبحار واستخدم الضّمائر العائدة إليهما (راوغه-رماه-رجلاه-جلده)، والشّاعر إذ ورد الضّمير العائد إليه مباشرة (بكوخي- ماتت بعيني …)، أمّا في قصيدة ليالي بيروت فيتوجّه مباشرة إلى القارئ (من يقوينا على حمل الصّليب؟) كأنّه يحدّثه، وفي قصيدة جحيم بارد يتحدّث عن نفسه (ليتني ما زلت اصطاد الذّباب…) وعن شخصيّة مجهولة (ليته ما لمّني من وحلة الشّارع..) فمن هي هذه الشّخصيّة؟ أمّا في قصيدة الجروح السّود فهناك امرأة مجهولة (خلّيتها تروح.. تمضي إلى محطّة القطار..) الخ… ويبدو الشّاعر شخصيّة مشتركة حاضرة في أغلب القصائد، وكثير من شخصياته مجهولة يقصد من خلالها إضفاء مسحة الحزن والغموض والتّغرّب على الدّيوان، فالقارئ يحزن لحال هذه المرأة ولا يعرف من تكون، ثمّ يتضّح أنّها الأرض الأمّ. وقد اعتمد السّرد من خلال الأفعال الماضية، التّصوير الخياليّ، عقدة خاصّة لكلّ قصيدة، وعقدة عامّة تجمع بين القصائد، مع غياب وضع نهائيّ إذ لا يبدو أفق حلّ المشكلة واضحًا.
إنّ الشّعر الدّرامي هو الشّعر الذي “تحكي أحداثه موقفًا تاريخيًا أو خياليًا مستلهمًا من الحياة الإنسانيّة، وهو على ضربين المأساة والملهاة”(صالح،2017،ص84)، وهدفه الأوّل والأساس التّأثير في المتلقي من أجل إحداث تغيير ما. وبالرّغم من عدم وجود قصّة مباشرة في هذا الدّيوان، إلّا أنّ الطّابع الدّراميّ المأساويّ يسيطر عليه من خلال المشهديّات التي يصوّرها، فهو حين يتحدّث عن نفسه والمغني في الشّارع يصطاد الذّباب، فهو لا يقصد ذاته ونفسه مباشرة، ذلك لأنّ الذّات عنده هي ذات الجماعة، ولا مكان للفرادة والقضايا الشّخصيّة. ففي كلّ مشهد يصوّره حكاية قصيرة، وكلّها تشير إلى الموت، أي المأساة. هذا وقد صرّح حاوي مباشرة بالانتحار حيث قال “ويدي تمسك بخذلانها خنجر الغدر وسمّ الانتحار “(حاوي،1993،ص56). أمّا مشاهد الموت، أو ما نسميه هنا بموت الشّاعر الورقيّ الشّعريّ الذي سبق موته الفعليّ، حدث يهدف لضرب النّفسيّة الجماعيّة من خلال إحداث صدمة عند الشّعب تدفعه للثورة أو التّغيير، غير أنّ هذا لم يحدث.
لابدّ من التّعامل مع الدّيوان بوصفه مرسلة لغويّة فنيّة جماليّة، يريد المبدع قول شيء ما من خلالها من أجل معرفة تأثيرها في الجمهور المتلقي، لأنّ مقولات الأسلوبيّة النّفسيّة تتطلّب دراسة نفسيّة المنتج والمستقبل على حدّ سواء. ولأنّه يستحيل إنتاج عمل فنيّ مهما كان نوعه (موسيقى، رسم، شعر…) لا يعني شيئًا، كما يستحيل أن يقول الإنسان مقولةً لا تعني شيئًا إلّا إذا كان مخمورًا أو مجنونًا، فوظيفة اللّغة الرّئيسة “هي الابلاغيّة، حيث يريد المتكلّم إبلاغ السّامع أو القارئ بموضوع المرسلة”(مونان،1981،ص 70)، وذلك لإحداث استجابة ما عنده، حيث أشار جحفة (2014) إلى أنّ “المعاني ما هي انعكاس لوضعيّة محفّزة، أو لاستجابة بالمعنى النّفسيّ” (ص31). من هنا فإنّ كلّ عنصر لغويّ يسهم في تشكيل الدّلالة الكبرى، وقد تناولنا مستوى الدّلالة، المعجم، والصّورة الشّعريّة، من دون الكلام على مستوييّ الصّوت والتّركيب، لأنّ المجال لا يتّسع لنتوسّع فيهما هنا.
بات واضحًا أنّ الشّاعر شفّر تجربته النّفسيّة وصراعاته الوجوديّة في قالبٍ لغويّ فنيّ نسميه قصيدة أو شعرًا. وكانت الرّموز اللّغويّة والتّناص أداة هذا التّشفير، فهي عمليّة بوح خفيّة، حيث يقول ما لا يستطيع قوله صراحة وبوضوح. والشّعر قبل كلّ شيء لغة، واللّغة “هي الوسيلة التي بواسطتها تنقل الأفكار إلى الآخرين، ويتمّ من خلالها التّواصل الإنسانيّ والتّفاهم” (عطيّة،1995،ص16)، وقد ذهب سوسير إلى أنّ ” المركّبة الصّوتيّة تشكّل مع المعنى أو الفكرة وحدة مركّبة فيزيولوجيّة ذهنيّة” (سوسير،1987،ص217). من هنا لا يمكن فصل الإنتاج اللّغوي عن الفكر، فكلّ قصيدة أو بيت أو صورة تعبّر بالضّرورة عن فكرة ما. فالإشارة أو العلامة اللّغويّة دال ومدلول، والدّال هو الكلمات أو الأبيات التي يقرؤها المتلقي، وهي صادرة عن البنية الفكريّة العقليّة والنّفسيّة للشاعر، ولا يمكن عزلها عنها ولا بأي شكل من الأشكال، خاصّة إذا تعلّق الأمر بدراسة الشّعر بوصفه فنًّا تعبيريًّا انفعاليًا. ذلك لأنّ “مجال الدّراسة النّفسيّة للغة هو كيفيّة تحويل المنتج للاستجابة إلى رموز to encode وينتج عن هذه العمليّة العقليّة مرسلة لغويّة، عندما تصل إلى المتلقي يقوم بفك الشّيفرة to decode وتحويل الرّموز إلى معانٍ في ذهنه… وهكذا تتكوّن المعاني النّفسيّة”(ص23). إذًا، فنحن هنا بصدد المعاني النّفسيّة، وقد بيّنا عمق أزمة الصّراع النّفسيّ الوجوديّ عند الشّاعر من خلال كلّ ما تقدّم، أمّا الآن فنركّز على استجابة المتلقي، وتلقي المرسلة.
“لا يخفى أنّ الرّموز تسهم في تشكّل الدّلالات غير المباشرة، لتحقيق التّواصل الإنسانيّ المباشر وغير المباشر، فمن غير الرّموز تستحيل عمليّة التّواصل الإنسانيّ إذ تستحيل الحياة من دون رموز، وتستحيل الرّموز من دون الحياة الإنسانيّة. فالرّمز يتّصف بطابع العموم والشّمول لأنّه ظاهرة إنسانيّة ضاربة الجذور إذ ينذر أن تجد سلوكًا إنسانيًا أو فعلًا اجتماعيًا يبتعد من الرّمزيّة” (ابن رشيق،1981،ص302). ففي هذا الدّيوان كثرت الرّموز والإحالات التي تشير إلى الموت، الألم، المعاناة… وقد تكلمنا عليها سابقًا فكيف يتلقاها القارئ فكريًا ونفسيًا؟
إنّ سيطرة إيديولوجيا الموت والضّياع والصّراع، على المجال النّفسيّ للمرسلة تجعل هذه المشاعر تنتقل هي نفسها إلى المتلقي. فالإنسان في الواقع يتكوّن من ذات، ثمّ لاوعي فرديّ يخزّن فيه كلّ تجاربه السّلبيّة والإيجابيّة وكلّ ما يتعرّض له في مرحلة الطّفولة، ولا وعي جمعيّ وهو ” البوتقة التي تنصهر فيها كلّ النّماذج البدائيّة والرّواسب القديمة والتّراكمات الموروثة…” (يونغ،2007،ص191-194). والموت في الخافية الجماعيّة مرتبط بالحروب والمآسي، وبالرّغم من فلسفة الموت فلسفة إيجابيّة في معظم الأديان مثل المسيحيّة والإسلام، إلّا أنّنا نرى أنّ هذه اللّفظة لا ترتبط لدى الشّعب والأمّة بذكريّات إيجابيّة تاريخيًا. إذًا فما هي الطّاقة النّفسيّة التي ستثيرها الحقول المعجميّة المرتبطة بالموت، والألم، والعتمة عند الشّعب المتلقي؟ وقد تكلمنا هنا على اللاوعي الجمعيّ، لأنّ حاوي شاعر الحضارة والأمّة كما أشرنا سابقًا، يخاطب الجماعة لا الفرد في أعماله. ولا يمكن إهمال مسألة اللاوعي الجمعيّ وكيفيّة تلقيه للمفاهيم والدّلالات الواردة في العمل الفنيّ، ذلك لأنّه “ناتج عن خبرة بشريّة تكوّنت منذ آلاف السّنين” (الموسى،2016،ص160). وبالعودة إلى ما سبق فإنّ الحقول الدّلاليّة المحمّلة بطاقة سلبيّة هي الأكثر انتشارًا، كما إنّ دلالات موضوعاتها في اللاوعي الجمعيّ دلالات سلبيّة، قاتمة، تبعث اليأس وتكرّس التّناقض والتّوتّر النّاتج عن صراع المنتج نفسه. ونحن هنا لا نقصد أنّه لا يمكن للشاعر توصيف الواقع المأساويّ، لكنّ ربطه بالموت، وتكرار فعل الموت، ورهن الحياة بالموت الأكيد، يولّد في النّفس البشريّة للمتلقي شعورًا باليأس. وإنّ كثرة تكرار الفعل (الموت)، هو بمنزلة تعزيز للفكرة وهذا ما سمّاه Skinner بالتّعزيز اللّغويّ أي reinforcement، فكلّما كرّر المتكلّم أو المنتج فكرة ما، دلّ ذلك على اهتمامه بها وجدّيتها بالنّسبة إليه من جهة، وهذا ما قرأناه في جديّة قضيّة الموت عنده، فهو لا يشير إلى الموت بوصفه أسطورة فحسب، بل يعزز الفكرة ليقوم بتنفيذها. ومن جهة أخرى، كلّما تكرّر ذكر فكرة ما: الموت أو الانتحار مثلًا، تسلّلت هذه الفكرة إلى لاوعي المتلقي وتأثّر بها لا شعوريًا حتّى لو لم يرد ذلك، ” فمن وظائف التّكرار في اللّغة التّوكيد، المبالغة، والتّهكّم”(الشّهراني،1983،ص380-386). وهذا ما فعله الشّاعر عندما كرّر باستمرار فكرة الموت، “فالسّوداويّة الوجوديّة -عند الشّاعر- تنتقل لتعزيز فكرة الحداد اللاشعوريّ على الموضوع المفقود -الحريّة والثّورة والتّطوّر الحضاريّ- الأمر الذي عطّل الوظيفة الوجوديّة عنده وشوّه ديناميّته النّفس اجتماعيّة” (مزهر،2012،ص187)، فهو يريد السّخرية من الواقع من خلال تأكيد فكرة الموت، على أنّ هذا التّأكيد والتّكرار ليس عبثيًا، بل يكشف عن رغبة الشّاعر في الموت والتّضحية كما سماها، وعن جديّة بثّ فكر الموت في شعره إلى لاوعي المتلقي حتى لو لم يقصد. على أنّ التّركيز على هذه الفكرة بهذه الطّريقة قد يولّد استجابة عكسيّة في أغلب الأحيان، فالدّعوة إلى الموت من أجل الانبعاث دعوة أسطوريّة. ومهما كان من الأمر فإنّ الدّعوة إلى التّقدّم والتّطوّر يجب أن تكون دعوة إلى الحياة، لا إلى الموت. وإن كان يريد استجابة حقيقيّة من الشّعب يجب أن يوجّه فكره، ليفكّر تفكيرًا نقديًا واعيًا يقوده أخيرًا إلى تحسين حياته، ورفض الظّلم، القمع، والعدوان، أي رفض ما عبّر عنه (عبد للطواغيت الكبار). فالشّاعر المثقّف النّاقد وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الشّعب واعيًا ناقدًا لإحداث تغيير حضاريّ بالمستوى الذي يدعو إليه حاوي.
إنّ وظائف الكلام المسيطرة على الدّيوان توضّح مدى تأثيره في المتلقي، فإذا تجاوزنا الوظيفة الانفعاليّة التّعبيريّة “التي ترتبط بالمرسِل مباشرةً وتعبّر عن موقفه تجاه ما يحدث”(هويدي،2012،ص262)، بوصفها الوظيفة الأكيدة والأولى، نجد تركيزًا على الوظيفة التّأثيريّة أو الافهاميّة “التي تتّجه إلى المرسل إليه، وتهدف لإثارة انتباهه وحثّه على القيام بعمل ما، ومن خلالها يأخذ النّصّ قيمته التّداوليّة”(262)، إذًا فالهدف ليس التّعبير عن المشاعر فحسب، بل التّأثير في المتلقي، ولكن أي أثر؟! لقد رأى بعض نقاد عصر ما بعد الحداثة أنّ الشّاعر أو الفنان نبيٌّ يخرج الشّعب من الظّلمات إلى النّور، فيحمل قضاياه وآلامه ويناضل من أجله، وإذ بنا نرى الشّاعر هنا يعيش صراعًا نفسيًا وحيرة نتجا عن عمق تأثّره بالقضيّة، وعن رغبته النّفسيّة الملحّة التي تطلب التّغيير، فنقل مشاعره المضطربة هذه إلى المتلقي. وهنا تتوقّف الاستجابة على نوع القارئ أو المتلقي، وخلفيّاته النّفسيّة، الفكريّة والثّقافيّة، ذلك لأنّ قوّة هذا الدّيوان الفكريّة، والانفعاليّة، والنّفسيّة، تجعل القارئ يقف حائرًا بالفعل أمام المعضلة الوجوديّة يردّد: إذا لم أعش كما أريد حرًا بل عبدًا عند الطّواغيت الكبار فما الفائدة من العيش؟ إذا لم يتغيّر الواقع المذلّ فما الفائدة من العيش؟ وما الفائدة من وجودنا إذا كنّا لا نقوى على شيء؟ وهذا يبدو واضحًا في غير مكان لاسيّما عندما يشبّه حالة الشّعب بالدّب القطبيّ فيقول: “وغفونا عفو دبّ قطبيّ كهفه منطمسٌ أعمى الجدار”(حاوي،1993،ص58)، فهو يقصد أنّ هذه الأمّة لهي أشبه بدبّ قطبيّ دخل في سباتٍ طويل ولا يفيق منه أبدًا.
يمكن فهم الشّعب المتلقي من خلال التّفسير نفس جماعيّ، ويقوم هذا التّفسير على مراقبة سلوكيّات هذا الشّعب. فقبل مأساة موت الشّاعر يشبه ما بعدها، إذ لم تقم الثّورات، ولم يحصل التّغيير الدّراماتيكيّ الذي يفترض أن يحدثه موت شاعر، وهذا يدلّ على طبيعة هذا الشّعب الذي يتّجه للخضوع والتّكيّف مع ظروفه الصّعبة، بدلًا من محاربتها والقيام عليها. والمطلوب من الشّعب ليس الموت العبثيّ والانتحار من أجل الحياة، بل العمل بصدق ووطنيّة من أجل إيجاد غد أفضل، ذلك الغد الذي لمّا يجده اللّبنانيّون حتّى اليوم. ذلك لأنّ العبرة ليست في الموت، وليست في تحرير البلاد فقط، بل في تحرير الفكر والعقول، والتّحلي بالإخلاص للوطن والأرض الأمّ، عندها ستعود الحضارة الفينيقيّة أقوى مما كانت سابقًا. والحال فإنّنا نرى أنّ جزءًا من أزمة حاوي وهو الجزء المتعلّق بالتّراجع الحضاريّ ما يزال قائمًا حتّى اليوم في بلادنا. فهل يجد الشّعراء، المفكرون، والشّعب طريقهم إلى التّغيير سؤالٌ نسأله علّه لا يموت.
الخاتمة
إنّ ضرب اللاوعي الجمعيّ بانتحار ورقيّ أو فعليّ، لم يوصل إلى النّتائج المتوقّعة من الشّاعر، ذلك لأنّ الصّدمة وحدها لا تكفي لتحريك شعب أو أمّة باتجاه الثّورة، فالمطلوب دراسة إيديولوجيا هذا الشّعب والعمل على اكتشاف مواطن الضّعف فيها، لأنّ الفكر في الأساس هو ما يحرّك الشّعوب. ولذلك تحاول السّلطات الدّكتاتوريّة قمع الفكر والثّقافة، في حين تحاول التّيارات السّياسيّة تشريب الشّعب ثقافتها وإيديولوجيا خاصّة بها. والحال فقد ظهر صراع الشّاعر النّفسيّ واضحًا في هذا الدّيوان من خلال رغبتين متناقضتين: الموت والحياة، وإنّ هذا الصّراع وهذا التّناقض ينتقل إلى المتلقي ليؤثّر فيه نفسيًا بطريقة أو بأخرى، وتبقى استجابة المتلقي وردّة فعله مرهونة بوعيه وثقافته ونفسيّته. أمّا استجابة الشّعب وفهمه للرسالة الشّعريّة الحضاريّة في الدّيوان، فيمكن إجراء أبحاث عليها حتّى يومنا هذا، لأنّه لم يتحرّك بعد باتجاه ثورة وطنيّة حقيقيّة تقوده إلى تغيير المصير والواقع.
المصادر والمراجع العربيّة
ابن أبي طالب، علي (2009). نهج البلاغة (3). بيروت: مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات
ابن رشيق، أبو علي الحسن (1981). العمدة في محاسن الشّعر وآدابه. بيروت: دار صادر للطباعة والنّشر
ابن منظور، جمال الدّين (1998). لسان العرب. بيروت: دار إحياء التّراث العربيّ
أسماء، سيرين (2020). دراسة سيميائيّة لرواية هديّة من السّماء لهشام بوشامة. (رسالة ماستر بإشراف د. علوات كمال). جامعة أكلي، الجزائر
أدونيس، علي أحمد سعيد إسبر (1978). زمن الشّعر. بيروت: دار إحياء التّراث العربيّ
الأميري، ماجد (2020). إنانا ودموزي دراما الحبّ والموت. بيروت: دار الرّافدين
التّميميّ، إله (11-2018). “توظيف اللّون في شعر سعاد صباح وفقًا لنظريّة ماكس لوشر”. مجلّة آداب الكوفة (37)، 655-684
الجرجانيّ، علي بن محمد بن علي الحسينيّ (2009). التّعريفات (1). الجزائر: شركة ابن باديس للكتاب
الدّسوقي، مجدي محمد (1999). مقياس الصّراع النّفسيّ. القاهرة: المكتبة الأنجلو مصريّة
الدّسوقي، مجدي محمد (2007). مدى فاعليّة برنامج إرشاديّ في تنمية بعض العلاقات الشّخصيّة لدى طلاب الجامعة من الجنسين. القاهرة: المكتبة الإنكلو مصريّة
الشّهرانيّ، عبد الرحمن محمد (1938). التّكرار مظاهره وأسراره. (رسالة ماستر بإشراف د. علي محمد حسن العماري). جامعة أم القرى، السعوديّة
الماجدي، خزعل (2020). ميثولوجيا شام: دراسة في الأساطير والآلهة الكنعانيّة، الأوغاريتيّة، الفينيقيّة، البونيّة. بيروت: دار الرّافدين
الموسى، أنور (2016). نحو نظريّة سيكولوجيّة في دراسة علوم البلاغة العربيّة (1). بيروت: دار المواسم
باختين، طودورف (1990). الشّعريّة. تر. شكري المخبوت. المغرب: دار توبقال للنشر والدّار البيضاء
بلغيث، عبد الرّازق (2009). الصّورة الشّعريّة عند الشّاعر عزّ الدّين المهيوني: دراسة أسلوبيّة. (رسالة ماستر بإشراف د. علي ملاحي). جامعة بوزريعة، الجزائر
بلاوي، رسول (2019). “رمزيّة مفردة النّهر وإنتاجها الدّلاليّ في مجموعة عكاز الرّيح للشاعر محمد البريكي”. مجلة التّواصليّة (19)، 95-119
جحفة، عبد المجيد (2014). مدخل إلى الدّلالة الحديثة (2). المغرب: الدّار البيضاء
دي سوسير، فردينان (1985). علم اللغة العام. تر. د. يوئيل يوسف عزيز. بغداد: آفاق عربيّة
ستورا، جان بنجمان (1997). الضّغط النّفسيّ (1). تر. وجيه سعد. الشّام: دار البشائر
صالح، كامل (2018). حركيّة الأدب وفاعليّته. بيروت: دار الحداثة
صلاح الدّين، عليوش (2020). دراسة اكلينيكيّة لميكانزمات الدّفاع خلال مقياس أساليب الدّفاع لدى التّلميذ المتمدرس الرّاسب. (رسالة ماستر بإشراف د. شطر حسين). جامعة قالمة، الجزائر
صمود، حمادي (2018). الوجه والقفا في تلازم التّراث والحداثة. قطر: دار الكتاب الجديد
عايدى، جمعة (2022). شعر خليل حاوي: دراسة نفسيّة. الجيزة: وكالة الصّحافة العربيّة
عبد الغفار، عبد السّلام (1996). مقدّمة في الصّحّة النّفسيّة. القاهرة: دار النّهضة العربيّة
عزّام، محمد (1989). الأسلوبيّة منهجًا نقديًّا. دمشق: وزارة الثّقافة
عطيّة، نوال (1995). علم النّفس اللّغويّ. القاهرة: المكتبة الأكاديميّة
علي، عبد الرّضا (1995). دراسات في الشّعر العربيّ المعاصر، القناع، التّوليف، الأصول. بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر
علي، فاضل عبد الواحد (1999). عشتار ومأساة تموز. دمشق: دار الأهالي للطباعة والنّشر والتّوزيع
عمر، أحمد مختار (1998). علم الدّلالة (5). لا مكان: مكتبة لسان العرب
عوض، ريتا (1992). بنية القصيدة الجاهليّة- الصّورة الشّعريّة لدى امرأ القيس. بيروت: دار الآداب
عوض، ريتا (1979). أدبنا الحديث بين الرّؤيا والتّعبير. بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر
عيسى، فوزي (1997). تجليّات الشّعريّة. الإسكندريّة: منشأة المعارف
الغذامي، عبد الله محمد (1998). الخطيئة والتّفكير من البنيويّة إلى التّشريحيّة. مصر: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب
فرويد، سيغموند، (1978). الهذيان والأحلام في الفنّ (1). تر. جورج طرابيشي. بيروت: دار الطّليعة
مالكي، ربيعة (2017). الصّورة الوالديّة لدى المراهق العنيف. (رسالة ماستر بإشراف د. سامية دويدي). جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر
مبارك، حنون (1987). مدخل للسانيّات سوسير (1). المغرب: الدّار البيضاء
محمّد، إبراهيم (2002). الهويّة والقلق والإبداع. القاهرة: دار القاهرة
محمّد، كرد (2010). “ما الميتافيزيقيا”. الموافق للبحوث والدّراسات في المجتمع والتّاريخ (5)، 129-137
محمود، عنان (2022). “الضّغط النّفسيّ وعلاقته بالعزلة الاجتماعيّة لدى طلبة المرحلة المتوسطة (الطّلبة النّازحين أنموذجًا). مجلّة الأستاذ للعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة (3)، 355-377
مزهر، عباس (2012). زلزال في أرض الميعاد. بيروت: دار وكتبة البصائر
مطهري، مرتضى (2000). شهيد يتحدّث عن شهيد. تر. بقية الله الأعظم. بيروت: الدّار الإسلاميّة
مونان، جورج (1981). مفاتيح الألسنيّة (1). تر. الطّيب البكوش. تونس: منشورات الجديد
ميخائيل، أمطانيوس (1986). دراسات في الشّعر العربيّ الحديث. بيروت: المكتبة العصريّة
نسارك، زينب (2019). شعريّة السّرد في القصيدة الجزائريّة المعاصرة. الجزائر: جامعة سطيف
هويدي، خالد (2012). التّفكير الدّلاليّ في الدّرس اللسانيّ العربيّ الحديث (1). بيروت: الدّار العربيّة للعلوم ناشرون
يونغ، ك. غ. (1997). علم النّفس التّحليليّ (2). تر. نهاد خياطة. اللاذقيّة: دار الحوار للنشر والتّوزيع
References
Hock, H. (1996). Language History, Language Change, Language Relationship: An Introduction to Historical and Comparative Linguistics. Berlin and New York: Mouton de Gruyter
Kobasa, S. (1979). Stressful Life Events, Personality, and Health, An Inquiry into Hardiness. Journal of personality and social psychology, 37(1), 1-11
Le Monde: Arts et Société. Paru en France. Du 18-7-1978
Milroy, L. (1987). Observing and Analyzing Natural Language. Oxford: Blackwell
[1] –ماجستير في اللّغة العربيّة-الجامعة اللبنانيّة
[2] ولد في فرنسا ودرس فيها. تأثّر بالفلسفة الجماليّة، المثاليّة… وأكّد وجود علاقة بين الاختيار اللّغويّ والعالم النّفسيّ للفرد، ومن هنا جاء بالاتجاه النّفسيّ في النّقد الأسلوبيّ. للمزيد ينظر بحث: في الفكر اللّساني الحديث ليو سبيتزر واسلوبيّته التّكوينيّة (عامر،2011،ص1-5).
[3] للمزيد ينظر اختبار ماكس لوشر، وهو اختبار يحلل الشّخصيّة، النّفسيّة، الاضطرابات، الضّغوطات والأمراض من خلال الألوان.
[4] في اختبار ماكس لوشر يشير الإلحاح المتزايد على تغيير واقع ما إلى بداية اضطراب نفسيّ، وهذا يتجاوز مرحلة الضّغوطات النّفسيّة.
[5]للمزيد ينظر: نظريّة العلامة وسيرورتها عند شارلز سندرس بيرس.
[6] للمزيد، ينظر: كتاب إنانا ودموزي دراما الحبّ والموت، الدّكتور ماجد الأميري.
عدد الزوار:295


